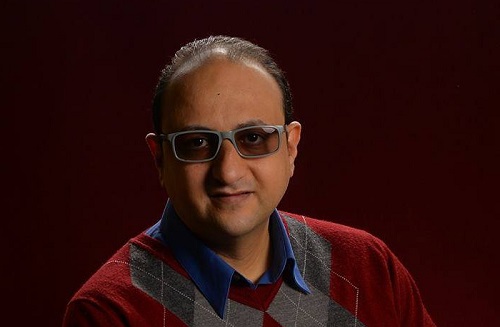علاء خالد
سمعت عن ” أدونيس” في بداية الثمانينيات من بعض الأصدقاء المهتمين بالشعر. كان اسمه، ولغرابته وسهولة نطقه، مشتركا بين العديد من النقاشات المحتدمة التي تخص الشعر، والعلاقة بالتراث الديني والثقافي عند العرب. لم يكن هذا عاديا في ذلك الوقت، أن يثير شاعر هذا الشكل الجديد من النقاشات والخلافات حوله. بالتـأكيد كان كتاب “في الشعر الجاهلي” لطه حسين، ومعاركه حاضرة في لاوعي الثقافة. أيضا كان يتردد في الأفق الثقافي الخلافي، في الستينيات، اسم الشاعر اللبناني سعيد عقل، بوصفه منكرا للقومية العربية، ومؤيدا للخاصية اللبنانية، وجهره بهذا الإنكار، بالإضافة لتأييده للهجوم الإسرائيلي على لبنان عام 1982، ردا على الوجود الفلسطيني هناك. ولكن الخلاف حول أدونيس فتح رقعة جديدة من النقاش، حول “التراث”، وثباته، وليس حول “الهوية”، والذي أدى بدوره لصياغة العقل العربي ورؤيته للعالم من منظور هذا الثبات، بجانب تحريه ورصده للتحولات التي خرجت عن “الثبات، في القرون الأربعة الأولى لنزول الوحي، وهو ماسجله في رسالته “الثابت والمتحول- بحث في الاتباع والإبداع عند العرب” لنيل الدكتوراه من جامعة القديس يوسف ببيروت، عام 1973.
***
شعرت بالرهبة وأنا أقرأ في الكتاب، مثل الرهبة التي شعرت بها، ممزوجة بفرحة، بعدها بسنوات؛ عندما اقتنيت أول نسخة من الإنجيل. ليست فقط الرهبة أو الفرح بالكتاب، ولكن بـ”الآخر” الذي بدأت تكتشفه في نفسك، والذي كان من الصعب اكتشافه إلا بأن تأخذ مسافة من نفسك، عبر نقدها ونقد ثقافتها ومسلماتها، وهذا النقد كان متمثلا في “الثابت والمتحول”. من الأفكار التي ألح عليها ” أدونيس” في كتابه هي جدلية “الأنا – الآخر”، وكيفية إقامة “الآخر” داخل “الأنا”، باعتبارها صيغة من صيغ الحداثة. ربما هذا “الآخر”، بالنسبة لي، كان الجزء الميت، أو غير المرئي، من “الأنا” الذي يحتاج إلى كشف، وإعادة توطين.
***
الكتاب بشكل ما كان يحض على إعادة أخذ مسافة من الجماعة وثقافتها، وهو مالقى هوى في نفسي، في وقت لم أكن أملك فيه الوعي الكافي لأخذ هذه المسافة، من الجماعة، أو من الموروث الداخلي، ذاتيا. كانت كتابات أدونيس تصدِّر لك هذه الإحساس بالنزق المحبب، بانفصالك، بوقوفك في مكان لوحدك بعيدا عن الجماهير.
***
كنت مجندا في ذلك الوقت كضابط إحتياط، أقضي فترة تجنيدي على شاطيء مرسى مطروح، وهو ماأتاح لي مساحة وقت للقراءة والتأمل ومراجعة الأفكار التي كانت تلح على شاب في الرابعة والعشرين. اصطحبت معي كتابه” الثابت والمتحول”، والذي بدوري استعرته من أحد الأصدقاء، حيث وقع عليَّ الدور أخيرا، بعد فترة طويلة من الانتظار، كان الكتاب فيها يتنقل بين أيدي الأصدقاء والمعارف.
فوجئت بسلاسة اللغة، وشعريتها، تلك الشعرية المصحوبة بتصور فلسفي، فالجملة تتقدم بثقة نحو إثبات أو كشف لمعنى أخذ يتكون. تجري الجملة، أو الفقرة، في محتوى يتقدم باستمرار، سواء بالدليل، أو التأمل والحدس الذاتيين، أو بالمقارعة، وفي النهاية بالتفلسف الشخصي الذي يسبك الفقرة. أعتقد هذه الأخيرة جزء من موهبة أدونيس، القدرة على التفلسف الشخصي، وتضمين تفلسفه الفكري داخل مناخ شعري، يجعل للجملة، أو الفقرة، مفاجاة منتظرة دوما، وقدرة على الإدهاش. لفتت نظري طريقته في كتابة الفقرات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة تمتد لصفحات، ليس هناك استخدام للعناوين الجانبية، بل استخدام الرقم كعنوان للفقرة، وهو يوحي باستمرارية مفتوحة في إضافة العديد من الأرقام والفقرات، فالكلام لم ينته، ولن ينتهي.
***
أعتقد أن الجزءين، الفكري والشعري، عند أدونيس، قريبان للغاية، سواء في مقالاته الفكرية، أو في أشعاره. اللغة في ” الثابت والمتحول” تقف على قدم المساواة مع المعنى، وليست شارحة له، وهذه الجدلية النشطة بين اللغة والمعنى، ربما هي إحدى سمات هذا الكتاب. اللغة والمعنى يتكونان كلاحق وليس كسابق، وهنا الجدة في طزاجة التناول للكتاب، وخاصة في مقدمته.
***
” الكتابة ليست إلا النطق وقد سقط الزمان. إنها ظل شاحب للنطق. وهي لاتمثل من الوجود إلا ظله، إنها بتعبير آخر، قناع النطق، أي أنها لاتمثل، لحظة حضورها الكامل، إلا الغياب الكامل” ص-59.*
***
تقريبا في الستينيات، كانت الثقافتان: الفرعونية والماركسية، تبذران اسمائهما وأساطيرها في ثقافتنا وأسماء مواليدنا، فتم ظهور أسماء من قبيل ماركس ولينين وإيزيس وإخناتون وبولجانين، وهذا الأخير كان زميلي في الصف الابتدائي في مدرسة رشدي الابتدائية المشتركة. كان الوعد السياسي والاستبشار الأسطوري بالأسم قرينين إما بفكرة قومية، أو بخصيصة متواجدة في صاحب الأسم القديم.
بالتأكيد استخدامه لاسم ” أدونيس”، وهو إله فينيقي يرمز للانبعاث والإخصاب، داخل زمن راكد، بجانب استخدامه الاسم كلقب؛ سهل له اختراق حاجز الأسماء وسرعة تثبيته في الذاكرة، وتداوله، ومع الوقت أصبح الاسم رمزا مزدوجا، للتحرر والحداثة لفئة، أو للإلحاد والعمالة لفئة أخرى.
***
أتذكر في إحدى جلساتنا في منتصف الثمانينيات تقريبا على مقهى البوابين في محطة الرمل، جلس معنا أحد الشعراء الكبار في الإسكندرية، وهو شاعر كان له حضور في الأوساط الثقافية. تطرق الحديث كالعادة إلى الحداثة الشعرية، وجاءت سيرة “أدونيس”، وبدأ سيل الاتهامات تنهال عليه من طرف هذا الشاعر، تتضمن العمالة وكونه “علويا”، بمعنى ما خارج الصحيح من الدين الإسلامي، وغيرها من الاتهامات. ابن هذا الشاعر ارتبط بجماعة جهادية في السبعينيات، وحكم عليه بالإعدام، وتوسط الشاعر من السلطة السياسية، حتى تم تخفيف الحكم.
***
أعتقد أن جزءا من العداء الموضوعي، وغير الموضوعي، الذي ولدتها ظاهرة “أدونيس” في بعض الأوساط الثقافية المصرية، هو لعبه لدور “المخلص”، وارتباطه بنوع من المعرفة الكلية، التي تنتج ديكتاتورية شعرية وتسيد مفهوم ” النموذج”. بالفعل كرس أدونيس نفسه لدور” المخلص الشعري”، الذي ورث دورا تنويريا، ليس بتعمد شخصي، أو به، بعد أن تضخمت شهرته. ولكن الأهم أنه تصادف لعبه لهذا الدور مع واقع ثقافي/ سياسي لازال مسيسا، يبحث عن “مخلص”، أي كان طبيعة رسالته في ذلك الوقت الميت من الثمانينيات.
أصبح أدونيس يشكل علامة سياسية، ربما أكثر من كونه علامة شعرية، بسبب تناوله لمقدسات ترتبط بالدين والوحي وعلاقة الشعر بالدين. كان من الصعب أن يلعب دكتو لويس عوض هذا الدور بالرغم من تبنيه بعض الآراء الجريئة حول اللغة العربية في كتابه” مقدمة في فقه اللغة العربية” الذي صدر وصودر عام 1981، لأن أدونيس جاء بتشكيلة من الإشكاليات التراثية ترتبط بتتبع السكون في الوحي واللغة والثقافة، وربط هذا بتأخر العقل العربي، وهو مالم يتح لدكتور لويس عوض.
**
هناك نبرة خطاب تحرري في “الثابت والمتحول”، يوجهه للإنسان العربي، خاصة في المقدمة. نبرة منشور سياسي ولكن له أفق رحب يتحرك فيه، وبمفردات وحاجات جديدة لاتراها الثقافة اليسارية آنذاك، وأهمها أماكن جديدة لتقصي”الفردية”. هذه النبرة التحررية جعلت قراءة الرسالة بها هذا التضامن والتماس مع أمر شخصي، وأعتقد أنها جزء من تفاعل وحضور “الثابت والمتحول” في ثقافتنا، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة آنذاك.
***
مع أدونيس تبلور مفهوم “الحداثة” كقطيعة ووصل، في آن، مع التراث. بجانب محاولات جماعة “شعر”، وأيضا كتاب “شعرنا الحديث إلى أين؟” للدكتور غالي شكري. أصبح المصطلح ملموسا ومكان خلاف وتأويل، ومزيحا لمصطلح ” الأصالة والمعاصرة”، الذي كان يبحث عن التجاور بين الماضي والحاضر بدون جدل، عن امتداد زمني بدون قطيعة. أصبح “الشعر” أحد وسائل قياس هذه الحداثة. بالطبع هذا ليس نتاج أدونيس الذاتي، ولكن نتاج ثقافة الغرب منذ القرن السادس عشر وعصور التنوير، ولكنه عاد مع أدونيس وغيره، ووطَّن هذا الإنسان الغربي داخل قراءاته في الثقافة العربية.
***
ربما مامنح أدونيس هذا المكانة أنه كان يمتلك قاموسا لغويا ومنهجا أكثر جراة وتأويلا من منهج دكتور غالي شكرى اليساري الماركسي، الذي كتب ” شعرنا الحديث إلى أين” بحس البيان التحرري، والذي كان في رأيي أحد الجديرين بأن يكون أحد المنظرين للشعر الحديث، وللحداثة الثقافية، ولكنه كان يرى الشعر الحديث انفصالا عن التراث بعكس أدونيس الذي أكد هذا الارتباط عبر الكتابة واللغة واختيار “هامش” التراث كموضوع، للبحث عن تعدده كما في يظهر ” الثابت والمتحول”.
***
ارتبطت “الحداثة”،بشكل عام، بالشعر أكثر من ارتباطها بالرواية، ربما لأن الشعر يصدر عن صوت فردي صريح. وهو ماكان يبحث عنه أدونيس في رسالته “الثابت والمتحول”، أن مقياس الحداثة هو الفردانية المتعددة، مقابل سلطة/ أحادية الجماعة.
في السبعينيات والثمانينيات كان “إنسان الشعر” هو مثال للتمرد والثورة، والذي يتم التوجه له بالخطاب. هو الإنسان الذي كان يبحث عن فرديته في قراءته للتراث الثقافي العربي، فكان الشعر، أكثر من الرواية مثلا، هو الممثل لهذا الإنسان، والحقل الشعري قديما وحديثا هو مكانه. كان الكلام عن الحداثة يخص أكثر الشعر. أذكر ملف مجلة الكرمل الشعري عام 84، الذي أشرف عليه الأستاذ إدوار الخراط، ونشر في مجلة الكرمل الذي كان يرأسها الشاعر محمود درويش عن الظاهرة الشعرية في مصر السبعينيات، والنقاشات والاختلافات والاحتدامات التي قامت حوله ومن أجله، والتعامل معه باعتباره ظاهرة سياسية.
***
في “الثابت والمتحول” هناك مقاربة بين الشعر والقرأن والسنة النبوية، والتفاسير، في التراث العربي المكتوب خلال الأربع عقود الأولى بعد نزول الوحي. يرصد الكتاب التداخل بين الدين والظواهرالثقافية والاجتماعية الأخرى، فالتراث الشعري العربي هو في آن تراث ديني ولغوي والعكس، وكذلك التراث السياسي. فأصبح مفهوم “النص” هو الوسيط الذي يقف بين هذه الاشكال البلاغية والدينية. مصطلح “النص” منح أي كتابة صفتها العلمية، ومنحها أيضا طرق متابعتها وتحليلها كظاهرة وسط سياق. أصبح “للنص” مكانا تاريخيا في اللغة.
***
من الأفكار اللافتة أيضا التي أثرت عليَّ في ذلك الوقت، هو حديثه عن “الزمن المتقطع”، و”الزمن المطلق”. كنا في لحظة تاريخية مطلقة بسبب ركودها وموتها، فكل شيء نهائي وكامل في موته ولايوجد مستقبل بأي شكل كان. بدأت أسمع عن الزمن المتقطع، كأن هناك فجوة لاأراها داخل الحياة يمكن من خلالها رؤية التاريخ بزاوية جديدة، زاوية غير قدرية. تحدث أدونيس عن العلاقة بين الزمن المطلق المقدس( الوحي) والزمن التاريخي الدنيوي. ربما هناك أصداء بنيوية، بفوكو وغيره، وعلاقتها بالزمان المتقطع. ولكن فوكو وغيره من البنيويين لم يدخلوا الثقافة العربية إلا من خلال هذه النصوص المؤسسة كما في “الثابت والمتحول” وأيضا ” تكوين العقل العربي” عند محمد عابد الجابري على سبيل المثال.
***
” الوحي لايُعرف بالزمان، بل الزمان هو الذي يُعرف به، الوحي، بتعبير أفضل، هو قوة الزمان وليس الزمان”. ص-69.
***
تحققت في أدونيس صيغة المبدع المفكر، أو الكاتب الشامل، بشكل عام، لم يظهر هذا الجانب المتفلسف والتحليلي بهذه القوة والدأب في شاعر – هناك بالطبع آخرون كانوا يمتلكون هذا المنحى في عصره مثل الكاتب الكبير عبد الكبير الخطيبي، الذي يكتب الفرنسية- أن يكون مشغولا بالأرق الثقافي لدرجة التخصص، وليس الهوى العام. ويكون النص الشعري هو مكان التأويل السياسي وليس العكس، ولذلك تحركت أراؤه في عدة سياقات عامة نظرا لطبيعة مضمونها العام والخاص في آن، لقد سيَّس أدونيس قضايا الشعر بدون أن يكون خطابيا.
***
مع الوقت، وربما بسبب السياق الثقافي الفارغ، أصبح أدونيس رمزا للحداثة ومعيارا لها، أو المتحدث باسمها في العالم العربي سواء في الشعر أو قضايا ” الأمة” الأخرى. خاصة أنه ظهر وسط مشاريع ثقافية محايثة له لها الحس النقدي للتراث، مثل عابد الجابري والطيب تزيني، وحسن حنفي، وعبدالله العروي. كانت رغبة التغيير أسبق في الثقافة عنها في الشارع، أو بمعنى ما فكرة “النقد” لم تكن تخلصت بعد من الأرث الماركسي الذي كان له ممثلين في الشارع وفي الثقافة، ولكن هذه المشاريع ظلت تدور في سياقات ومدرجات علمية، بالرغم من حساسيتها وأفكارها وأهميتها، بعكس أدونيس الذي ذهب لمساحة أوسع في التلقي والتأثير كون الشعر والإنسان الشعري هو ممثل اللحظة. اتخذ أدونيس طريقا دائريا منح كلامه حصانة، وانتشارا في آن.
بالطبع تواجد أدونيس في لبنان السبعينيات والثمانينيات كان أحد أسباب انتشار أفكاره، بالرغم من حساسية أفكاره الدينية. حماه هذا الاحتراب والصراع بين ذاكرة قومية وأخرى مضادة، ولم يقابل بالرفض كما حدث مع لويس عوض مثلا في كتابه عن فقه اللغة، أو طه حسين قديما في الشعر الجاهلي، بل ومنح خطابه زخمه المطلوب، وامتداده ليكون ممثلا لهذه اللحظة المتناقضة، أو جزءا من مستقبلها المنتظر.
***
ربما الوجه السلبي لظاهرة ” أدونيس”، في كونها معيارا للحداثة، أنها ألغت التعدد في رصد هذه القيمة، على الأقل شعريا، كونها تملك المعيار للكتابة الحداثية، التي أصبح لها مروجون، ومحبون، ومتأثرون، وهو ماجعل الجدل مع ظاهرة أدونيس تأخذ منحى متعصبا، يتضمن العداء والتعاطف معا. بالإضافة لتأييد الأوساط الثقافية الغربية له جعله شخصا إشكاليا، يحمل وجه الحداثة والعمالة معا بالنسبة لجمعات متحفظة أساسا على أي علاقة بالغرب. بشكل عام كان الوسط الثقافي المصري متحفظا تجاه أدونيس باستثناءات قليلة تتمثل في جماعات شعرية كانت تتخذ من فكرة الحداثة أساسا لها في الخطاب الشعري في السبعينيات. ولكن يمكن رصد أن كتابته وخاصة “الثابت والمتحول” صنع مايمكن ان يسمى يسارا شعريا وفكريا، مختلفا جماليا ووجوديا عن اليسار الماركسي المسيطر منذ الستينيات.
***
من أهم الأشياء التي أكد عليها أدونيس في ” الثابت والمتحول” هي تأكيده على مفهوم “الهامش”، ليس الهامش اليساري المعتاد في الثقافة الماركسية، ولكنه الهامش الثقافي. صاحب مشروع للخيال، والذي يأخذ من الإنسان مركزا له. واعتقد أنها نقلة لمفهوم “الهامش” وحضوره في الثقافة. وتقليص دور الهامش اليساري. وأعتقد انها نقطة مهمة أكسبته مساحة جديدة، ظهور يسار شعري جديد، أو “سياسة جديدة للخيال”.ربما للمرة الأولى أن “الأدبي” هو الذي يحاكم “السياسي”، ويضع معايير له وليس العكس.
***
كانت من ضمن أفكار الكتاب المؤثرة بالنسبة لي هو مفهوم “السلطة”، ولعبة القوة في الثقافة. السلطة التي تقف مع الثابت ضد المتحول، ولعبتها في إزاحة نصوص، والإبقاء على نصوص أخرى تقف معها. الجديد أنه قرأ وطبق مفهوم السلطة تاريخيا، عبر التراث القديم. أيضا ارتباط مصطلح الحداثة بالنقصان، الذي هو ضد “الاكتمال”، وهو ماكان يسند فكرتنا عنها. كان “الاكتمال” فكرة محيرة براقة من الخارج، ولكنها مستحيلة التحقق، كونها تضع نموذجا لها من خارجها، وهذا النموذج يحتاج للتعالي على واقعك النفسي والحياتي. أيضا كانت فكرة “النقصان” مغرية، كونها تحمل هامش تسامح وتغاضي عن العيوب والسقوط والذنوب وغيرها. عبر هذا الجدل، دخل مصطلح “الحداثة” بين المقدس والدنيوي، الشخصيين، ببساطة.
***
ربما هناك ابتسار في تلخيص التراث ضمن هذه الثنائية “الثابت والمتحول” أو “الاتباع والابداع”، وهذا الابتسار ساعد في الوصول أحيانا لنتائج حاسمة، تشبه الحكم السياسي أو الأخلاقي، بالرغم من أن الكتاب يحارب أحادية هذا الفكر الأخلاقي. ولكن يظهر التساؤل أيضا، لماذا الكتابات التي تبغي التغيير تقع في الثنائية أو تناقض نفسها، ولكن لاتخونها؟ من أسباب الشهرة الخلافية حول الكتاب هو وضوح المعنى وأحاديته داخله، ولكن مايشفع للكتاب أن هذه الوضوح السياسي، أو الأحادية، وأؤكد، كانا خارجين من جدل حقيقي مع التراث وعلما به وتدقيقا له، لم يجد المناخ المتعدد لقراءته أو تصحيحه.
***
يؤكد في النصوص التي يقف بجانبها في التراث الشعري العربي، على قيمة الفرد ومركزيته إلى جانب علاقة الحب التي تجمع بالله، في النصوص الصوفية، في وحدة خالصة، ليس فيها مركز. الذات هي التي تكشف نفسها في الآخر، وعيها بنفسها هو وعيها بالآخر، فـ”العلاقة بين الأنا والأنت تتم من خلال الحب وليس التشريع”. “الحب وليس التشريع”، أعتقد أنها جملة مفتاحية ضد هذا الزمن.
***
” فالله، وإن كانت له صورة، لاجسم له، أو هو جسم لاجسمي، لأنه ليس تجسيدا كما هو جسم علي أو أحمد تجسيدا لذات علي أو أحمد، وإنما هو جسم ورمز، أي أنه معنى. وهو، لذلك، الغائب أبدا، مع أنه الحاضر أبدا”.ص- 148.
***
ولكن تأثير “ظاهرة أدونيس” أخذت في الخفوت، ربما بداية مع بدايات التسعينيات، بعد حرب العراق، وصولا للألفية الجديدة. فقد تبدل التصور عن الإنسان ومركزيته وذهبت أكثر للآلة والآلية وغياب المركز، ورسوخ ثورة المعلومات. فلم يعد الصراع ولاالسلطة ولاالهامش، ثنائيا كالسابق، بل متعدد الأقطاب، ولم يعد التراث هدفا في حد ذاته يكمن فيه الحل، ولم تعد فردية الإنسان صراعا مع الله أو انتزاعا من الجماعة، بل توسطا وعقدا بين العديد من الأقطاب وليس انحيازا لقطب. بمعنى آخر اختفت ظواهر وأقطاب التنوير التحرري. وإن ظل التنوير هدفا، ولكن ضمن سياقات أخرى، لذا ظل أدونيس له رمزيته، ولكن ليس بالضرورة معبرا عن الحاضر، ولكنه ولاشك جزء من مرجعيات التنوير لهذا الحاضر.
الإسكندرية 8 يونيو – 2020
……………………………………………………………..
• المقتطفات مأخوذة من كتاب ” الثابت والمتحول- بحث في الإبداع والاتباع عند العرب” الجزء الأول – الأصول” على أحمد سعيد. دار الساقي- الطبعة السابعة 1994- بيروت.
*عن أخبار الأدب ـ الأحد 28 يوينو