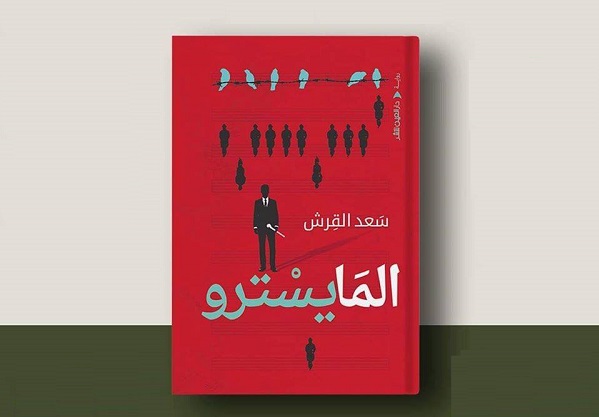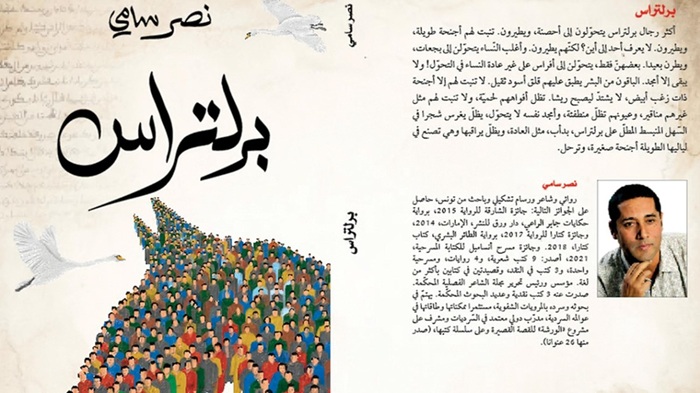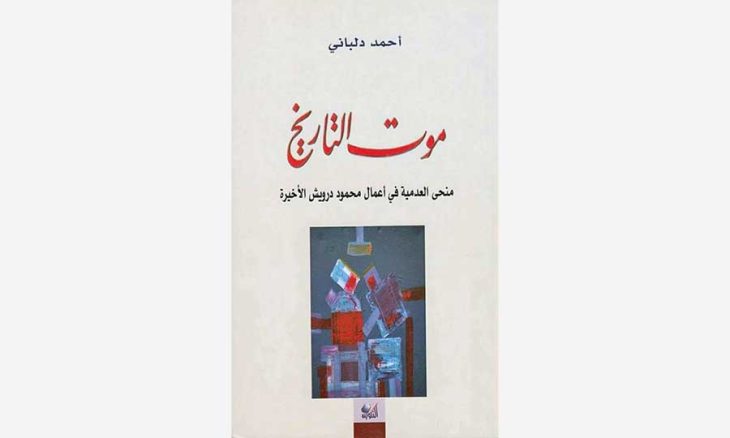فالرواية التي تحكي عن الزرايب والنماذج البشرية التي تقطن اسفل جبل المقطم وتعيش على فرز قمامة القاهرة، لتجعلك تتمتم طوال الوقت يا رب ارحم يا رب ارحم، يا رب ارحم هذا البلد وارحم فقرائه ومهمشيه من هذا السخق المتواصل، والآن بعد الأحداث التي شهدتها مصر بعد 25 يناير لا نستطيع فكاكًا من إعادة فهم النصوص وإعادة فهم جلد الذاتالذي كان يمارسه المجتمع على ذاته، وإعادة فهم ظاهرة الكتابة عن المهمشين والتعبير عن حياتهم أدبيًا وسينمائيًا، فلا شك أن المتابع للأدب وللسينما في العشر سنوات الأخيرة لن يجد صعوبة في رصد تدفق الأعمال التي عبرت عن العشوائيات والمهمشين والبلطجية وأولاد الشوارع، في محاولة لافته للابتعاد قليلًا عن المتن وما يحدث فيه من صخب والذهاب إلى الحافة ورصد التغيرات التي تحدث هناك، ربما في تعبير عكسي حاول أن يلفت انتباهنا ويحذرنا من أن ما استطاع المتن إخفاءه واحتواءه وابتلاعه وسط صخب المدينة وتناقضاتها ظهر جليًا هناك، في الهامش وكأننا نستدل على الزلزال بحركات المصابيح المدلاة من السقف، هذا بالضبط ما حدث، فإن الهزة الأنها كانت تصف القبح بنعومة، وإن لم تتنازل عن إحداث الصدمة المرجوة ولكن في جو بسيط وعذب على مستوى السرد، واستخدام اللغة الذي طعم الكاتب فيها الفصحى البسيطة والعامية القريبة إلى القارئ، وغير الموغلة في المجانية لتكون اللغة مزيجًا سهلًا متدفقًا، يعبر عن ذلك الواقع الخشن بسلالسة رائقة. وعلى ذلك فإن اللغة كانت عاملًا أساسيًا من عوامل نجاح هذه الرواية على عكس ما وقعت فيه بعض الروايات التي تكلمت عن المهمشين بلغة فظة غليظة شديدة الخشونة لوصف واقع أكثر فظاظة مما بنى حئلًا في وجهة ظري بين المتلقي والرواية، لكن كيرياليسون كانت غير ذلك فنجت من هذا الفخ. غير أن هذا المزج بين الفصحى والعامية كان ينحرف في بعض المواضع ليتحدى ذلك لاستخدام منطق العامية في الفصحى أو العكس، وهذه سمة من سمات الكتابة في السنوات الأخيرة كقوله هنا مثلًا “حكمت بالقسوة على قشرتها الخارجية” ويقصد هنا أن من يراها دون التعمق في معرفتها يحكم بأنها قاسية، لكن منطق العامية يحتمل الحديث عن قشرة الإنسان الخارجية، ويحتمل أيضًا أن أقول “حكمت بالقسوة على” بمعنى أني حكمت بأنها قاسية ولم أحكم عليها بالقسوة. لكن هذه الانحرافات المنطقية قليلة ونادرة في الرواية، ولكنها سمة من سمات الكتابات الأخيرة.
وتعتمد الرواية أسلوب التداعي والاسترجاع كأسلوب أساسي للبنية السردية للرواية، فانطلاقًا من الشخصية المركزية “ناجح تيسير عبد الواحد” ووجوده فيما يشبه السجن وتداعي الذكريات لديه ندخل إلى عالم الرواية. ونلحظ هنا أن الرواية تبدأ بإعلان اختفاء “ناجح” ليتسق هذا الاختفاء وعدم الوجود مع كونه مهمشًا وليدخل بنا هانى عبد المريد إلى عوالم المهمشين في منطقة الزرايب، معلنًا منذ البداية أن الرواي الأساسي غير موجود، مختصرًا بذلك موقف المجتمع بأثره منه، والذي يبدأ بموقف الشيخ تيسير نفسه الذي سيحاول محو البطل، ليحيلنا هنا مباشرة إلى الإقصاء الذي يمارسه أفراد المجتمع مع أنفسهم ومع أغيارهم كنموذج للإقصاء الكلي الذي يمارس عليهم.
وبذلك تكون الرواية كلها هى مونولوج داخلي طويل تتداعى فيه الفكار والمشاهد والذكريات، لتضيء لنا وتكشف في مشهديات حياة هذه الذات المعذبة والمنكبة على ذاتها كرد فعل طبيعي للتهميش والإقصاء الذي مورس عليها. فنجده في أحد الفصول يفكر في كتابة سيرة تاريخية لأعضائه التناسلية، كما لو كان يمارس التهميش مع ذاته ويختصرها في علاقته بأعضائه أو علاقة أعضائة بالعالم وسرد تاريخها، وفي ذلك تقزيم وتهميش للذات على أن طرافة الفكرةوسخريتها من الواقع تلف الوجع برداء من الكوميديا السوداء.
والمفارقة أن هذا المهزوم المهمش يدعى “ناجح” في حين أنه مليء بالإحساس بالفشل وبالذنب وبالانسحاق ما بين رؤيته المتشككة المبينة على السؤال أو مراجعة الحقائق، ورؤية أبيه المبنية على اليقين الشافي والحتمية ليكون اسمًا على غير مسمى، وتحفل الرواية بكثير من المفارقاتالتي تكسر أفق التوقع عند المتلقي، فمنذ الوهلة الأولى حينما تطالع العنوان كيرياليسون، وما يستدعيه من تراث ديني وعند مطالعتك لعنوان الفصل الأول “عن ذي القرنين” تتوقع للوهلة الأولى أن الفصل الأول سيكمل هذا الاستدعاء التراثي، ويحدثنا عن ذي القرنين ويأجوج ومأجوج مثلًا، أو أيه إحالة له، لكن تفاجأ أن الكلام هنا عن القوادة، وأن ذا القرنين هنا أقرب إلى التراث الشعبي الذي يصف القواد بذي القرنين، وتكون المفارقة حيث تكتشف أن الراوي متخصص في علوم اللغة، ومع ذلك يعمل حارس عقار ويمرر بنات الهوى للأسياد في الأعلى بمقابل يتقاسمه مع زائرات الهوى. وتتوالى المفارقات والتساؤلات ففي الفصل المعنون بالجهاز التناسلي نجد أن الطلبة ينتظرون على أحر من الجمر أن تدرس لهم إحدى المدرسات هذا الدرس، وبعد طول التمني يدخل الستاذ بكل قسوة ليدرس هذا الدرس الشائك في هذه المرحلة السنية، ويبدأ بهجوم دفاعي في أساسة، لمنع أى هرج يحدث في الفصل، ومثل تلك المفارقات والأفكار، التساؤل عن نوع مصر الجنسي من حيث إنها ذكر أم أنثى وتأثير ذلك على مواقفها السياسية وتعاملها مع الدول الكبرى.
وقد استخدم الكاتب الزمن بطريقة فضفاضة، سمحت له في كثير من الأحيان بالتحرك بحرية في الزمن ذهابًا وإيابًا دون ضع أطر صارمة لذلك، وكان أقرب إلى تقنية التذكر والتداعي، فالإنسان لا تتداعى ذكرياته بشكل تسلسلي ولكن بشكل دلالي، وهذا ما أكسب الرواية -في رأيي- رشاقة في التعامل مع الزمن، وكانت الحرية في استخدامه مبررة بتقنية التداعي ومناسبة لها.
وتتجلى تقنية التداعي في كيفية استدعاء الراوي للشخوص، وخصوصًا في النصف الثاني من الرواية، فشخصيات “فؤاد وجوزيف وأم العفش” على سبيل المثال، جاءت بذلك التداعي من شخصية إلى شخصية.
المكان كان حاضرًا بظلاله، فلم يستغرق الكاتب في وصفه إلا من خلال إشارات كافية في بعض المواضع، وغير مشبعة في مواضع أخرى وربما كان ذلك لانشغال الكاتب بتلك الشخوص والأحداث المثيرة، وربما جاء وصف المكان المسجون فيه ناجح مشبعًا بخلوه من الكائنات، وحوائطه الملساء وبابه والطريقة التي يمرر منها الطعام إلى الداخل والفضلات إلى الخارج بطريقة ليس فيها تعامل مع أحد، لكننا لا نجد ذلك الوصف في الصعيد ولا في العراق. بينما نجده أيضًا مصورًا للمقاهي والبيوت في حي الزرايب بشكل موفق.
وتأتي نهاية الرواية لتلخص لنا الحالة؛ حيث هذا المهمش المسجون يبحث عن الحرية ويسمو على واقعه ليستعير من تراثه ما يعينه على اختراق الواقع فيستعير شخصية سمعان الخراز ويستدعيها ليسمو بمعجزتها في نقل جبل المقطم على واقعه العاجز وأن نقل وإبعاد جبل القهر لو كان ممكنًا والبحث عن الحرية في وسط هذا السجن ممكنًا وربما استدعاء هذه الشخصية كان يلقي بدلالته على إمكانية تحقيق المعجزات على يد رجل مهمش مثل سمعان الخراز، وهناك دلالات أخرى أن التراث الشعبي وذاكرة الأمة لا تعرف التفريق العدائي للأديان ومن ثم يتماهى “ناجح” في النهاية مع شخصية المسيح، ويقرر أن يخترق الواقع ويقدم روحه فداء لشعوره بالحرية وفداء لكشفه وفهمه لدورة وهويته. ويقول بالنص: يقف يستشعر حريته، ما دام السجن سيمنح الحرية للآخرين فهو حر.
أما شابه “ناجح تيسير عب الواحد” سارد الرواية في مشهده الأخير، ما فعله شهداء هذا التهميش في 25يناير.
……………………
*نشر في مجلة الرواية.. قضايا وآفاق- الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد( 7) 2011