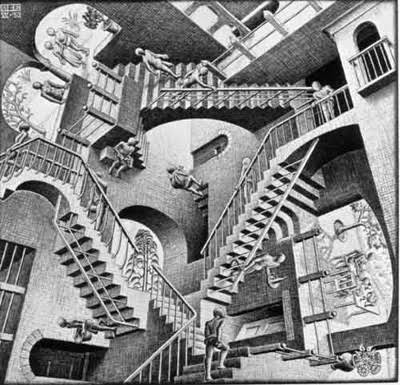صلاح الدين الزربوح*
لعل أبرز ما ميز إنسان العهد الحديث (القرن الثامن عشر والتاسع عشر) افتخاره بتقدم الحركة العلمية وارتباطه الوجودي بها من حيث فعاليتها في السيطرة على الطبيعة باستخراج ما تزخر به من قوانين وقوى منتجة. إذ أن لوي ذراعها إنما أساسه الاعتقاد في سر تحقيق متطلبات الإنسان وحاجياته. وكان مردّ ذلك الافتخار إلى قدرة العقل كأداة أنطولوجية ومعرفية على ربط الأشياء فيما بينها، وفي صياغة القوانين والأحداث. وعلى هذا ظل العقل في أنانيته المستمرة في السيطرة والتسلط، وفي هيمنته المتواصلة على نفوس الناس بدون إفساح المجال للاختلاف والتعدد، بالرغم من دعوى إعادة النظر في تجلياته وفي ماهيته سواء في التاريخ والمعرفة أو في الميتافيزيقا والأنطولوجيا حتى انقلب على ذاته في نزعات لاعقلانية وصور بشعة لا معقولة. وهكذا، فإن الحداثة عند مؤرخي الفكر والثقافة إنما تقترن بنبوغ النظر الفلسفي مع ديكارت فضلا على استقلالية الفرد وحريته. إذ أن هذه الأخيرة دفعت بالإنسان الحديث في كل القرون اللاحقة إلى بناء ثقافة بشرية إنسية بعيدة عن كل ما هو ميتافيزيقي، وكل ما هو متعال. كما أصبحت ثقافة علمية، سواء في الطرائق والمناهج، أو في الأفكار والآراء. وذلك راجع -بالأساس -إلى نقد العلوم الطبيعية القديمة ذات النفس الأرسطي، حيث اضحت تلك العلوم تنظر في موضوعها بما هو موضوع مستقل عن كل ما هو خارجي، أعني أنه إذا كان الاعتقاد عند المتقدمين راسخا في أن هناك علوما تضع المبادئ المشتركة العامة، ومن الضروري بالنسبة للعلوم الأخرى: التعاليم والطبيعة … إلخ أن تأخذ بها دون النظر فيها، بل أن تقبلها كما هي. فإن هذا الاعتقاد في” الأزمنة الحديثة” قد أضحى مهجورا و منبوذا بشدة. في سبيل بناء ثقافة جديدة علمية، ” وضعانية “، المنحى والمضمون. زيادة على أن سمة الإحساس بالزمن كوثيرة أساسية وخطيرة على نفس الإنسان، من أهم سمات الحداثة وتجلياتها، فبعدما كان الإنسان يعيش شرخا شاقا بين ضغط زمن النص المقدس الأصلي وبين قوة الزمن التاريخي المحايث للحياة اليومية للفرد .. فقد كانت الأزمنة الحديثة فرصة مواتية للإنسان الحديث لمفارقة زمن النص وأصليته وقداسته، بل وهيمنته الرمزية والمعنوية، إذ أن قراءة الزمن الخارجي الآني المشار إليه، بزمن مقدس ذي دلالة ميتافزيقية متعالية، هو أمر مخالف للبحث الفلسفي العلمي. وعليه، فإن تلك السمات للحداثة الفردية، العقل واستقلالية الفرد والشعور بالزمن، قد ساهمت في تكريس النقد كمكون أساسي للرؤية الفلسفية منذ ديكارت وكانط وهيجل مرورا بنتشه وصولا إلى دولوز ودريدا وفوكو ولوك فيري .. إلخ مع اختلاف مواقع انشغالاتهم ووجهات نظرهم المتباينة في أغلب الأحيان .. المهم هي سلبياتها، فقدان المرونة مع العالم وتغيراتها بحيث أصبح الإنسان الحديث يعمل على تدمير هذه القرية الإعلامية الصغيرة بكلتا يديه. كما أنه إذا كان الإنسان سيدا على الطبيعة، وأن الطبيعة في خدمة الإنسان. وليس الإنسان في خدمة الطبيعة، فإن الإنسان في الحداثة الأولى أضحى عبدا للآلة والتقنية وذلك بسببه الخفي هو تلك الثقة الخارقة والطائشة في العقل وممكناته، وقد نبه “إيمانويل كانط ” إلى وجوب رسم حدود لهذا العقل وموضوعاته، ولعل ” نقد العقل الخالص” و”نقد العقل العملي ” وفصلهما ألف دلالة ودلالة .
والظاهر أن أطروحة ” ماركيز ” ، ” الإنسان ذو البعد الواحد ” ، تبين مرحلة فقدان الإنسان لتلك المبادرة الذاتية والفردية في النقد والرفض .. فلا معنى لإلغاء السلب ومحوه وإبقاء الإيجاب. بل إن إبقاء السلب في أحضان الإيجاب ضرورة من ضروريات التفكير الفلسفي المعاصر. ومن ثمة كانت التقنية كسمة للعصر الحديث هي المسئولة بشكل مباشر عن تدمير الشعوب والأمم وإلغاء الحوار والتسامح باعتبارها ترويج لثقافة الواحد وفكرة الوحدة بدل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع. كما أنها توجه أحلامنا وآراءنا وتصنع مشاعرنا ومواقفنا. وهذا كما قلنا، نتيجة الإيمان بقدرة العقل ” كأحد موجودات العالم “، وليس كفعالية معرفية وإبداعية. إذن فعصر ما بعد الحداثة باعتباره مضاد لعصر الحداثة في المنحى والتوجه، أو في الموضوع والإشكالية، هو عصر تقويضٍ لكل أشكال الميتافيزيقا الذاتية. لأن هذه الأخيرة تسري في الحياة اليومية والأنماط الثقافية سريان الدم في جسم الإنسان.
لقد قام الفيلسوف الألماني ” هايدغر ” بنقد تجليات الحداثة نقدا جذريا باعتبارها اكتمالا للميتافيزيقا وتجسيدا للذاتية والنزعة الإنسية. إذ أن الحداثة الذاتية منذ ديكارت الذي ينطلق من الذات كتمثل وحضور، وكانط الذي يعتبرها (أي الذات) مصدر قدرتنا التمثلية للأشياء والموضوعات .. وصولا إلى التقنية بما هي اكتمال للميتافيزيقا، وميلاد لعهد جديد في المشهد الثقافي الغربي. كل ذلك، في رأي هايدغر، إنما يكرس الهوية التطابقية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار التوسط والتعارض إلا كعرض ما يفتأ الجدل يقضي عليه في نهاية المطاف. ومن ثم، أضحت “مهمة الفكر “، عند هايدغر، بعد “نهاية الفلسفة ” ي التخلي عن الإشكالات الميتافيزيقية أو على الأقل التخفيف من قوتها ووطأتها حول حقيقة الوجود والذات والهوية والحقيقة… إلخ. وربط الوجود بتاريخه العام كبنية مشتركة لكل العصور التاريخية. وترسيخ الاختلاف كبنية سارية في تاريخ الفلسفة باعتباره تاريخ نسيان الاختلاف بين الوجود والموجود. وأخيرا وليس آخرا، إذا كانت الحداثة ومظاهرها تبدأ بتحرر الإنسان من اللوثة الميتافيزيقية فيه نحو العودة به إلى ذاته ككائن له عقل، ويرد كل الأشياء والموضوعات الماثلة أمامه إلى حكم أعلى ” وهو العقل ” ، فإن ثمن ذلك التحرر والافتخار الطائش بالعقل وقدرته في تغيير الأحداث وصياغة القوانين .. كان له مظهر سلبي يتجسد في مساهمة الإنسان عنوة في إفساد الفضاء الحي الذي يعيش فيه .. ونسي أن الطبيعة هي أحد موجودات العالم كما قال القدماء، ومن ثمة ونتيجة إهماله لها ظهرت أمراض خطيرة _في بيئته وجسده على السواء لا يجد لها الإنسان شفاءً. كما شاركت التقنية_ بإرادة الإنسان_ في إبادة الشعوب والقوميات هنا وهناك، تحت شعار المشروعية الدولية المبررة عقلانيا في المواثيق، والتي تفتقد لكل تبرير وعقلانية في الواقع والتجربة. كما أصبح الإنسان الحديث يشكو من تحول الكماليات إلى ضروريات فضلا على فقدان الأشياء الجميلة الطبيعية _في بيئته وجسده على السواء طبيعتها.
……………………………
* مختبر الإنسان والمجتمع والقيم، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة بن طفيل، القنيطرة