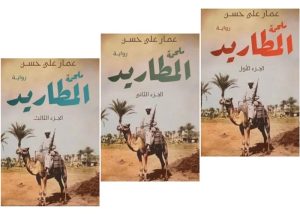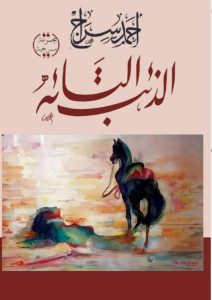لكن هناك أعمالا أدبية تطرح على صعيد التكوين، والبناء، والاحتواء، وعموما اجتراح تجربة فنية في مضمارها، وتبلغ فيها مبلغ التميز والاقتراح، ما يفحم الناقد والقارئ عامة لإيلائها الاعتبار، والتوجه سلفا لرصدها من زاوية اجتهادها في تصور الكتابة،ضمن الجنس الأدبي الذي تنتج فيه، وبالإحتكام إلى الأدوات والخبرة المتوفرة والإمكانات التعبيرية والتصويرية لأدائه، وهي هنا الرواية ومستويات أدائها ومميزاتها، وصولا إلى اختراقاتها، التي ينزع إليها كل عمل قيمته كبيرة ومنزعه منزعه جديد، ومرامه مثير، هو المرصود في رواية:’ الحياة الثانية لقسطنطين كفافيس’ لكاتبها المصري طارق إمام (دار العين،القاهرة،2012، 563 من القطع المتوسط).
2ـ واسمُ هذ المؤلف ليس غُفلا، كما تبين لائحة إصداراته، موزعة بين القصة القصيرة والرواية، بزّ في هذين النوعين بعض أقرانه من جيل الشباب المصري (فهو من مواليد 1977) من حيث تتويجه بعديد جوائز أدبية، نخص بالذكر الجائزة المركزية لوزارة الثقافة لأفضل مجموعة قصصية مرتين عامي 2004 و 2005، وجائزة الدولة التشجيعية عن رواية: ‘هدوء القتلة’ (2009)، التي يبدو أنها حازت انتشارا، قياسا بطبعاتها الأربع، واستحسانها للترجمة. لم نقرأ له من قبل أي نص، وهي مصادفة حسنة أن وقعنا على عمله الجديد، هذا، ينبئ بخبرة، ويشي بمؤهلات بعضُها نامٍ، وبعضُها الآخر، قيد الشحذ والتنضيد، وبينهما نزوع واضح لبلورة حس تجريبي في الكتابة الروائية، متراوح بين خبرة روائية متراكمة في تقاليد السرد الحديث والمستحدث، خاصة، وتضعيفها في سجل مدونة قولية، سرديةـ شعرية، وصفيةـ استبطانية، تعيينية ومجازية، لتوليف نص مُنزاح، بقدر ما يسائل بتجريبيته، يصبح بدوره عرضة للمساءلة والمخاطرة، وهذا امتحان لا مناص منه لكل من يعصى شريعة التقليد ملوحا بـ’إيديولوجيا’ التجديد، فكيف إذا دخل إلى الجنس الأدبي (= الرواية) من باب الشعر وسيرته وعُدّته (كفافي).
3ـ يعمد طارق إمام إلى سيرة الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس (1863ـ 1933 ولد ومات في الإسكندرية)، ليتخذها مهادا وسنادا لكتابة رواية تحمل اسم هذا الشاعر ذي الشهرة الإبداعية والإشكالية. وبذا فالعمل للوهلة الأولى، من خلال الإعلان الصريح لشخصية بطله الواقعية، والعناصر التوثيقية المؤسسة والمصاحبة والقابلة للتحقيق، كعناصر ذاتية، والمنصوص عليها كلاما مدونا كأشعار منشورة وموثقة بدورها في المدونة الشعرية الكاملة والمعلومة للشاعر؛ إن هذا العمل، والحال هذه، يندرج في الإطار الأجناسي للسيرة ( Biographie)، وهي بأبسط تعريف نوعٌ كتابي يُعنى بحياة شخصية ذات تميز معين، وتقتضي معالجتُها الحيادَ ما أمكن، والعمل التحقيقي حول هذه الحياة ، والتأطير التاريخي بخلفياته المعلومة المحيطة بها، فضلا عن توفر عدد من الحوافز القرينة بالإقدام على تشخيص لسيرة بعينها، ذاتية أو ثقافية أو خلقية، الخ.. جدير بالذكر، بعد هذا، أننا مع هذا النوع أمام ضربين: إما سيرةٌ عالِمة، وهي ذات مقتضيات موضوعية، وإما سيرة روائية، من طبيعة تخييلية، أي تتجاوز حضور الشخصية في موضوع حياتها، إلى وضعها كذات قابلة للتأويل، وباستعادتها على صعيد التحويل (=الروائي، مثلا) مع ملاحظة أن المقاربتين يجمع بينهما عنصر السرد كمكون أساس لبنيتهما القولية، وللسارد، حقيقيا أو من ورق، ولمادة ومرجعية مشتركة، هي أحد مصادر قياس درجة الصدق من الخيال، وبالتالي درجة انتساب التلفظ إلى هذا السجل التعبيري أو ذاك.
4ـ من العنوان يتضح أن طارق إمام، اختار السيرة التخييلية الفنية، يزكيها بطبيعة الحال التجنيس المرسوم على الغلاف، وإن جاز ان يكون اتفاقيا لا نصا بالضرورة على النوع، بحكم السوق الأدبي، وهذه قضية أخرى. اختيارٌ مسوّغٌ كذلك بتسمية فرع في العنوان، جاء في صيغة الصفة (الثانية)، من عبارة (الحياة الثانية) وهو في رأينا الحاسم من نية القول، لدى المتلفظ قبل فحص شكله ومحتواه لاحقا، والصفة تتعلق بالموصوف، أي بالشاعر كفافيس، الذي يكون في قراءة(كتابة) تأويل الكاتب قد عاش حياتين. وبما أن الأمر يتعلق بمجال يحضر فيه التأويل فوق البنية الكلية للتخييل فإننا لا نعلم، بالأحرى لا نجزم هل هي صفة حقيقية لازمة بالموصوف أم غير ذلك، وكلما سعينا لاختبار عملها نحويا إلا لزم ربطها بما تدل عليه، انطلاقا من تعريف الجرجاني للوصف الذي يدل على الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر حروفه، أي يدل على الذات بصفة (التعريفات).
5ـ هذه الصفة النحوية هي بوضعها الترتيبي (الثانية) تفيد بوجود أكثر من حياة تقلب فيها كفافيس، ما يفتح الباب واسعا لتطويع العنوان، ومن ثم الكتاب، لتفسيرات شتى، وتصورات ووجوه من الفهم، لنفترض أن أولها قرينٌ، صراحة أو ضمنا، بالمتن السِّيَري كما اقترحه علينا الكاتب. هذا الذي ينبغي أن يكون حرَثَ حياةَ شخصيتِه طولا وعرضا، ونقّبَ، وقام بكل الحفور، لم تفُته شاردةٌ ولا واردة منها، وبعد الغربلة الدقيقة، وهي شبه مستحيلة في هذا النوع من المسعى، مهما بلغت من الشمول( والحقيقة أننا لا نستطيع تقديرها على الوجه المطلوب، لأن المؤلف، هو هنا روائي لا باحث، فلا جُناح عليه، يكتفي بإشارات عامة في نهاية كتابه يسميها ‘إحالات’ (564) والإحالة ليست كذلك تعريفا..) ليصل إلى تخوم العيش الحقيقي، ومنها يتأكد أنه جنح إلى الخيال، إلى:’تحريف وقائع أخرى أو اختراعها في النسيج التخييلي للعمل..'(م.ن 565). وإذ لا يساورنا شكٌ في أن المؤلف ذهب إلى الوقائع في مضانها، وتلمّس أكثر من نسيج للحياة الواقعية لشخصِه السِّيَري، قبل أن يحوّله إلى شخصية روائية تعيش بأداة ‘النسيج التخيلي’ الذي حاكَهُ هو، لا يجد غضاضة من الاعتراف بأن: ‘الفجوات الواسعة في بعض أزمنة الشاعر، فضلا عن الحقائق والتواريخ التي وردت مشوشة أو متناقضة، وبعض المناطق الغائبة، منحتني فرصة ذهبية لإعادة تأويل حياة، حدَّ خلقها وتخمينها، بعد أن بدت لي في كثير من الأحيان كما لو تكن وُجِدت قط.'(م.س). وهذا بيت القصيد، من عبارات تمنينا لو وردت في العتبة لا ذيلا وتكملة، نعني أنها تمثل الوعي الفني النظري للكاتب إثر خوض غمار تجربته، ومحصّلتها، وبعد أن قضى منها وطرا ليُزوِّجناها عملا كاملا، ناضجا، وحمّال أوجه. عمل سِيَري، عالِم وتخييلي معا، لأنه لا يمكن أن يقبل الترتيب إلا إذا بتسانُد طرفيه وتضافرهما، ذا لذاك، وهذا وجه إشكالي من وجوه الكتابة البيوغرافية، بلا صفاء هي، هُجنتها أصلٌ فيها، ومع هذا العمل الفريد شكلا وقيمة يتيح لنا طارق إمام الخوض في مسائل نوعية حقا ليس في الطرْز الذي ارتضى لسرد تاريخ ‘عشيقهّ الأدبي’، بل الرواية كمعشوقة سردية، هي اليوم في قلب حب الأدب المعاصر، يغازلها جماعة من الكتاب العرب يقدمونها لنا بوله طافح.
6 ـ فما هي هذه الحياة؟ وفيم تتشخص؟ وكيف تُشخص؟ ومن هم شخوصها بجوار بطلها؟ وفي الأخير، أي محتوى لرهان هذا العمل، الذي يعلن ضمنا، تارة، وصراحة، تارة أخرى، في غير موضع، وبقصدية ملحة، أن ثمة لعبةً يتواطأ فيها كاتبٌ وساردٌ ومؤلفون وشخصيات، في قلبهم كفافيس: ‘الذي وجد نفسه فجأة قطعة من حياة متوهمة، تعيش في المستقبل من واقعه الفعلي، أنه يجب أن يطور اللعبة[الرواية] بما يمكنه أن يستبق هو المخطوط، أن يصير ما في الرواية التي تنمو أوراقها يوما بعد الآخر، تأريخا لأوهامه.’؟ (30). حقيقية كانت أو أوهاما، فإن الرواية تستهل من نهاية حياة كفافيس بعد أن عاد إلى مسقط رأسه الإسكندرية من أثينا، إثر عملية جراحية على الحنجرة بسبب ورم سرطاني، (1932) فقَدَ معها النطق:’ على سرير ضيّق، انتزع الأطباءُ حنجرته ولم يتمكنوا من إعادتها'(48) وفي أوائل 1933 انتكست صحته فنقل إلى المستشفى اليوناني في الإسكندرية، حيث أمضى الشهور الأخيرة من حياته. نشرع نحن القراء في التعرف على هذه الحياة، على مقاطع ومشاهد مبعثرة، متناثرة، جزئية، ومنتقاة جدا منها عن قصد لتخدم الصور التي يريد الكاتب أن نراها بانورامية ونفاذة عن شخصيته، بؤرة رؤيته؛ اختيار له ما قبل وما بعده. مرةً يرويها سارد عليم، ومرة أخرى، سارد شخصية، وثالثا كفافي الشخصية، أو كفافي الشاعر، فهو ليس واحدا، وطورا واحدة من عديد الشخصيات المحيطية قياسا بالبطل ـ المركز، أو منه إليها. نحتاج نحن القراء، حسب درجة تلقِّينا ومستواه، وصبرنا، أيضا، وهذه قضية/ امتحان بمفرده، أن نلمّ حصيلة أصوات، وشتات مشاهد، وأمشاج صور، وسجلات خطابات، ومدونة شعرية متخللة بين افتتاح الفصول ومطلع الفقرات، أومعانيها مذوّبة في المحلول السردي العام، عليك أنت القارئ أن تكون مُلما بشعر صاحبها، لتُعيدها إلى مصدرها، أو تصل إلى قرينتها، صحيحة أو مفترضة، فما بالك إن جرى الكلام، وهو كثيرا ما يجري هكذا على سبيل الاستعارة لعدم وجود حدود بين التعيين والمجاز ضرورة.
7ـ عن أيّ كفافيس نتعرف من خلال هذه الأفخاخ والحواجز؟ بالأحرى هناك معرفتان، واحدة تكون متحصِّلة لدى قارئ عارف سلفا بقامة الرجل الشعرية، وموقعه في هذه الخريطة، إلى جانب نُتف عن حياته الشخصية، وهو الأقرب إلى التقدير، وهنا إحدى جاذبيات التلقي، وبعض ما يصنع أفق الانتظار، بل إني أذهب إلى القول بأن خالي الذهن من أي معرفة بالشاعر، بمحيط تكوينه بمشاربه المتعددة، الكوسموبوليتاني تحديدا، لن يفوز بكثير، بل قد يخرج محبطا، إن هو امتلك الصبر لمتابعة عمل بحجم ما بين يديه، وخاصة تتشابك وتتدافع شخوصه وتمثيلاته وأهواؤه. وفي المعرفتين، موجبة وسالبة، يقدم لنا الكاتب صورة شخصيته في حال التفسّخ والزوال، بمفارقة مواجهة القمة الشعرية بالانهيار الجسدي. يقدمه لنا، على الخصوص، من بؤرة مركزية هي نزعته المثلية، وهو تبئير يتمكّن ويمتد على سائر أعضاء محيطه، والعلائق الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي يقيمها مع المحيط، في الداخل والخارج، لدرجة أننا إن أردنا أن نستبدل الصفة( الثانية) بغيرها لوجدنا أفضل براديغم(إبدال) لها هو( المثلية). وعلينا، على القارئ في هذه الحالة، ومن غير أن نتهم تلقيه بالسطحية أو التسرع، أو الإحساس بصدمة أخلاقية انطلاقا من عرف ثقافة معينة؛هذا القارئ مدعوٌّ أن يتقبل سلوك الشخصية باعتباره شرط وجود لها، وهويةً ملازمة، سيحرص الكاتب تصريحا وتلميحا، على تعريفها بل وتنظيرها بالحديث عن الأبيقورية مفهوما وتاريخا وتجليات (214) أو بمقولات وعبارات حجاجية وحِكمية:’ إن تدمير الذات، وبالملذات خصوصا،[ل]هو الطريق الأكيد الذي يقود إلى الفن'(237) ؛ وبالدفاع عن المثلية باعتبارها: ‘[ما] يجعلك في الحقيقة قادرا على الإصغاء لنفسك.'(261) لتبلغ ذروتها بوصفها ‘شرارة الشعر’: ‘هذه الشرارة هي الشعر، لستُ روائيا كي أجهد نفسي في تزويج المتناقضات، أنا شاعر، صوت، الشاعر أيها الأصدقاء، هو بالضرورة ذلك المثلي'(م.س). ليس بعد أوضح من بلاغة التماهي هذه قوةً في التبئير النظري لتيمة/ هوية المثلية، لا سيما وقد جاءت في سياق محاضرة لكفافي أمام جماعة ‘الحياة الجديدة’ بأثينا، وهو في الخمسين، حلل فيها اللغة الديموقيطية التي تبناها في شعره، مركزا على’حسية التاريخ’ في قصائده، وعيناه تتحرشان بشابين يصوبان نظراتهما لعينيه في القاعة (!). ولن يكفي القول بأن الهمّ الشعري، الذي لا شك يستبطن النص كله، ويمتد فيه شريانا دافقا، هو البنية العميقة للكلام الأدبي، مما ينبغي أن يُعتدّ به في حياة الشاعر، في تراثه، فالمعوّل على المنظور الروائي، ومقاربات الشخصيات التي تصب في بؤرة مركزية أرادها الكاتب عمدا وبحساسية.
8ـ من هنا التركيز على السلوك المثلي عمليا، في حياة كفافي، فهو دأبه العادي، اليومي، الملتصق بجلده، تُشخِّصُه الرواية في العلاقات التي أقامها مع عديد أفراد، منذ فتوته، وإلى بلوغه أرذل العمر. هم مصريون وأجانب. أفراد متميزون وآخرون عاديون ورَعاع، من الإسكندرية وحيثما حل، وهو قد تنقّل كثيرا، لتبقى هذه محطته الأم. هنا يلتقي حول جسده كل عشاقه، الأقربون والأبعدون، وهو شاعر، لكنه يعرض جسده بضاعة للغواية، ليلبي حاجته وهو يبحث عن نفسه:'(…) يبدو وهو ينحني كأنه يخوض حربا ضد كبريائه، يريد جسدُه فيها أن يخرج منتصرا بأن يمعن في المهانة(…) كان يتمدد في جسده، يتأمل أعمق نقطة في الوجود بتوسيع إسته، كأنه يرى عبره جوهرا مخفيا’ (267) . هذا ما جربه مع توتو(عبد الفتاح) وديمتري، وسائق الترام، والقس تيوفيليس، وفتية يؤجرهم، وعشرات انتهكوا جسده، الذي وهو عرضة للمثلية الصارخة، يتحول إلى نص للكتابة، الحسية، الأبيقورية هي الحبر والقلم الذي يفتقه (193)، . وأخيرا إلى فورستر، الكاتب المعروف، الصديق والمحاور له، تجمع بينهما إلى جانب الانشغال بأحوال الإسكندرية، أن كليهما فقد أباه مبكرا، و: ‘كلاهما فرّط في جسده ـ كنوع من التسامح يصعب أن يصدقه العبيد والساسة على السواءـ في أجساد الرجال'(134). ستُرينا الرواية أن المثلية هي صعيد من بين أصعدة في علاقة الرجلين، اللذين يلتقيان حول قطب الأدب، وقطب مدينة واحدة عشقاها حتى نخاعهما. ولن يفوتها أن تبرز بمناسبة هذه العلاقة، وطورها الأدبي خاصة،الفرق الذي يُقيمه كفافيس ـ من منظور الروائي طبعاـ ، بين المثلية شبه الفطرية، وحتى المبتذلة في حياته اليومية، وبين عالمه الشعري وانشغالاته الوجودية، نصوصا وقيما وأفرادا، وبدون هذا التمييز، كحاجز احتماء من المجتمع الملوث، الذي ما ينفك يكيل له الصاع صاعين، بدون هذا التصعيد الثقافي المتولد سلفا من السِّيَرية الأصلية للشخصية، ما كان للمثلية أن تتبأر، وتنزاح روائيا.
9ـ في هذه الرواية، في هذا الانزياح، أي بالاصطلاح الاختراق الفني، الذي به يتحقق عمل أدبي على نحو مغاير فينزاح عن سواه، يتمثل عالمها بجماعة مجنّسة، ذكورا وإناث، وكما لهذه الرواية، ول’بطلها’ رجال’هاـ ه’ لها نساؤها، يقمن بدور محوري، لا تكميلي، تتواشج به فصولها وفصول حياة البطل نفسه، من النشأة إلى الزوال، الأم، والجيران، والبغي، والمعجبات، والشاعرات: خريكيليا الأم والعقدة، فُتية، البغي المفتتنة به، وهي تعلم أي حاجز بينهما فتتهتّك أكثر، وهي تُعيِّرُه بأنه ‘محض شاذ متأنق'(90) وتنعته بـ’جثمان حيّ'(94)؛ كلوديا تراه ، وهي ذاكرته الشعرية:’ يمصّ دمَ الرجال'(71) ؛ كرستينيا تشرف على مرضه، تحمّمه وتدهنه، وتقوِّم شعره وشخصيته كناقد ومرب عطوف، وهي في هذا الموقف تحمل قناع الكاتب وصوته؛ أيُّ نقد كهذا:’ كان يتعامل مع نفسه كشاعر كلاسيكي، ينتمي لأسلاف عظماء، ويتعالى على الصغائر والصراعات الهامشية، رغم أنه خاض كل الحروب الصغيرة وتشبّع بشتى الابتذالات الممكنة التي أملاها عليه جسده’. شخصيات ومرايا تنعكس عليها تكوينات وأبعاد الأيقونة الروائية، وبواسطتهن، تزداد نتوءاً، تتميز مقارنةً ومفارقةً كي تتجلى العلاقة وتتباعد بوضوح بين الشخصية ومحيطها، والعلاقة هي هذا البحث المسترسل الإشكالي الذي ما يفتأ الكاتب مُمعنا فيه للقبض على هوية من هو سمسار وصحفي، وشاعر(325)، مقتفيا خطاه في عيشه وخلف وطء عشاقه له، ومن خلال استعراض واستكناه قصائده،(338) وبرسم خريطة مدينته، وعبر شبق نسائه وأحزانهن. هم وهنّ جميعا حوله:’ دوائرُ من ماء، متباعدة، غير أن وجهه موزع عليها(…) فأي شخص في كل أزمنة أشباحه يمكن أن يكون هو؟‘(55).
10ـ وإذا كان لكفافي مثلِيتُه، عشقه، شاعريته، رجاله ونساؤه، فإنها نواظم تدور حول الناظم الأكبر، الجامع، مدينة الإسكندرية، الحاضرة الكوسمبوليتانية، التي يدين الأدب الحديث لزمنها بأدباء كبار منهم كفافي أولا، وبالطبع لورنس داريل، صاحب تلك الرباعية الشهيرة: جسدٌ آخر يلتحم بجسد كفافي، ليصنعا جسدَ النص الروائي، وهما ملتحمان رغم تقسيم العمل إلى قسمين، حيث يأتي عنوان المدينة تاليا. وكما أن لا رواية بدون مكان وزمن، كذلك لا تسريدَ وأشكلةَ لشخصية الشاعر الإغريقي السكندري بدون مكانه الأم، به يتشخصن، وفيه مرتعُ أهوائه، ومجلى عبقريته، حيث نما عشب جنونه وهنا ذوت روحه، في صراع وتوتر دائم الاحتداد، بينه وبينها، هي أناه الأعلى وعقدته الثانية بعد أمه خاريكليا. بعبارة أخرى مختصرة، هذه رواية الإسكندرية بامتياز، مرثية لزمن مضى، وفي الآن، تذكّرٌ حزينٌ، دراميٌّ، لزوال الأمكنة، بقدر ما تُحيل على الماضي تنفض غبار النسيان، تأسَى ضمنا على الحاضر بخطاب الإحالة، وهو ينكفئ إلى الوراء، وينعى الغابرين، أيام ‘لا أحد ينام في الإسكندرية’ رواية إبراهيم عبد المجيد المعتبرة، ينضاف إليها اليوم عمل طارق إمام، ليؤكد خصوبة التخييل مصريا في كتابة سرد المكان، وسرد الأدب العربي المعاصر عامة. لم يكن صراع كفافي مع عشاقه، وإنما مع روحه، وهذه من مدينته، كجزء من زمانه وتراثه الهلليني ككل، يخوض معها وضدها حرب مثاقفة ولود، لا يهادنها قط بعد أن أدمنها، فيرسم لها من الصور شتى: ‘الجميع في الإسكندرية يرتدون أقنعة، لا يمكنك أن ترى شخصا يرتدي وجهه الحقيقي’؛ ‘إنها المدينة التي تُجيد الكذب، وتنطق بلغات لا تعرفها لتحفظ بقاءها'(125)؛ ‘شارع ليبسوس[حيث أقام] هذا يلخص الإسكندرية بشكل نموذجي.. فيه مستشفى لآلام الجسد، وماخور للذات، وحانة للنسيان. لم أقصد عندما اخترت هذا البيت ان أتورط في هذه المدينة لهذا الحد، لكن ذلك حدث، ويبدو أن المدينة هي التي فعلت ذلك بقدرتها على صنع القدر.. وقدري بالذات'(205). لا أفْحَمَ من هذه العبارة. ورهانُ الكاتب كان عجْنَ تاريخ الشخصية السِّيَري والوهمي (المصطنع) بتاريخ مدينتها لصنع وجدان وهيئة مشتركة بأداة التخييل، مضطلعا بـ ‘جدول أعمال الرواية’ و’دفتر تحملاتها’ كما يراها هو، بعضها على هدي أسلاف، وبعضه الآخر، الأهم من بنات خياله ونظامه، فأي نظام؟
11ـ لا شك نصل هنا إلى ‘مربط الفرس’ في هذا العمل، نعني معمارَه، طريقةَ بنائه وأدواتها، العمالةَ والموادَ المستخدمة، لنقُل بتبسيط (مُخِلّ)، بِنيته في شكله الكلياني من منطلق تصوره الذي لا ينفصم عن محتواه، الذي هو شكلُه في الآن عينه. وقد كنا أشرنا سالفا إلى تناسله من النوع السِّيَري، وتكييفِه له على وجه السيرة المبدعة لا العالِمة، ما سنقف عنده هنا، وبعجالة، لأن فحصه يتطلب في الحقيقة رسومات وتخطيطات مدققة، دراسة مستقلة بمفردها. لنوجز قائلين في وصف مبسّط بأن هذه الرواية بُنيت في هيئة عمارة من ثلاث طوابق، تولّى الإشراف عليها و(كتابتها) مقاولٌ واحد هو المؤلف، وبتنفيذ ثلاثة مسيرين: الأول، هو السارد العليم، الذي يقدم لنا من أول صفحة السارد الثاني (وهو شخصية في العمل) اسمه ألكسندر سينجوبوليس، عشيق كفافي اليوناني غادر معه السفينة القادمة من اثينا ل:’يكتب عنه رواية، يخبئها عنه في حقيبة، ويضيف إليها كل يوم سطرا، أو بضعة أسطر، فقرة أو فصلا كاملا'(11)، وهو شخص وُجِد بالفعل لا بالاحتمال، وكان بمثابة وريث مسؤول عن الأعمال الأدبية للشاعر لمدة عشر سنوات قبل رحيله (نظير ماكس برود بالنسبة لكافكا، نوعا ما) متكئا على معرفته به، ومستعينا بشعره (112). وما سيكتبه هو النص الذي سيخضع لرقابة، وتنقيح مخطوط لسارد ثالث ليس إلا الشخصية الروائية، مدار العمل والسراد الثلاثة، كفافيس ذاته ، بعلمه: ‘كان ثمة شخص يتلصص على ماضيه'(49) هو ألكسندر الذي يكتب رواية سرية عنه، سيتلصص عليها بدوره، ويسجل عليها ملاحظات:’ إلى أن تشكل ما يصلح لرواية موازية'(13). معلومات أكثر منها استنتاجات، واردة في المتن بقلم المؤلف الواقعي، يضيف إليها إضاءات هي وما سبقها بمثابة دليل سير للقارئ ـ وكم يحتاج من دليل في المتاهات، والتقلبات، والمنعرجات، وتعدد وتداخل الأصوات والأزمنة، ذهابا وإيابا والعكس، إلى ما لا نهاية، فضلا عن كثافة الاستعارت، ما يجعل القراءة شاقة وتحتاج إلى صبر الشغوف، والمثابر، الذي يكابد حتى يقبس من النار المقدسة، إن وجدها في آخر الصعود والنفق، وهذه مسألة أخرى في باب تلقي الكتابة المجددة على نحو من الأنحاءـ . نقول دليل سير وبروتوكول قراءة يتحدد في: ‘حضور الشخصيات من الأحدث للأقدم، بحيث يبدو الزمن وكأنه يعود إلى الخلف بالتقدم في الرواية'(112) وبروتوكولُها مبنيٌّ على ترجيح الخيال على الواقع أقنوما ممثلا في ألكسندر المتخيل يروي عن كفافيس المتخيل(م.س)، وقبله على رجحان مبدأ الشك:’ عندما تبدأ بكتابة شخص[سيرة] تبدأ في التشكك بوجوده، وبعد قليل تكتشف أن لا وجود حقيقيا له خارج أوراقك.'( 54).
12ـ هذا المعمار المتداخل، ذو التناسق الخاص به، والبنية الروائية المركبة، مثلثة السراد، بنقيصة تشابه لغتهم، وغياب تمايزات بلاغية إشارية دالة على تنوع الخطابات، لا تكرارها ، مع اعتبار أن هناك فعلا مستوى مجازيا ترقى إليه اللغة يكثف التعبير شعريا وينسجم مع رؤية حلمية، من قبيل أن: ‘الشتاء يقطن أحشاءه، وصباح في زرقة ملاك ساقط..'(58)، هو معمار تحتويه كتابة بُنيت بداية وختاما وفق استراتيجية ‘التطريس’، أي تدوين طرس على طرس، تعبيرا عن مفهوم التضافر النصي، والتناص أحد وجوهه، والمقصود هنا ما نظّر له جيرار جنيت(1930-) انطلاقا من اللفظ الإغريقي palimps’stos، ونحب أن نحيل للإلمام بالقضية من جوانبها كافة إلى الدراسة القيمة للأكاديمي التونسي أحمد السّماوي ‘التطريس في القصص، إبراهيم درغوتي نموذجا'(صفاقس،2002) تطلعنا على شجرة أنسابه النقدية بدءا من باختين، مرورا بكرستيفا، وإلى جنيت بموازاة مع تراث النقد العربي. ولهذه الاستراتيجية صيغ عمل، (نمطيات التطريس، حسب جنيت) منها التناص، والتضافر، والنصية الموازية، والوصف النصي، والمعارضة، والنصية الناسخة، خاصة، الأقوى اشتغالا في رواية إمام . هذه مجتمعة تحتاج إلى تطبيقات لفصلها عن بعضها، وفحصها سيميائيا ودلاليا، وقد ساعدت الطباعة بالرقن المميز بينها، وهذا لا يكفي، شأن فكرة تمييزها لأن محافل تعدد الأصوات وتنويع طبقات النص، يعوزها ما هو أكثر من العلامات الطباعية، وتنويع بل تكثير وتفكيك الفصول، لتسويغها. وتبقى النمطيات المذكورة في حاجة إلى إضافة أساس وحاسمة، هي النصية الجامعة، (جنيت) وهي ضمنية، وسمة كل نص، وأبرز شكل لها هو في ما ترشد إليه من علاقة للأثر أو بجنس قول ما، وفي ما ترسمه للمتلقي كأفق انتظار(السماوي52). ويبقى عمل إمام مبتورا إن لم يعمد هذا المتلقي، ضمن استرتيجية التطريس التي قلنا إن هذه الرواية تشتغل بإوالياتها، إلى توظيف ذاكرته، وهذه تتأرجح في تلقيها شكا ويقينا، بين استنساخ الواقع، وتبجيل الخيال، ليتجه، لم لا، إلى إعادة كتابة العمل نفسه على طرز مختلف، دعك من تغيير المنظور. أضف إلى هذا البروز القوي للعبة كسر السرد الخطي، وتداخل الأزمنة بإيقاع حدِّي، ونصيةُ التشظية المتقاطعة مع الكتابة الشذرية، والتقاطع بين اللسان الشعري (الوحدة) واللسان النثري (التعدد) بالذات هنا حيث تحدث الحوارية، وتتفاعل النصوص، لهي وغيرها، مما يتعذر الوقوف عليه هنا، لتعدّ من أبرز خصائص المتن الروائي المدروس، الذي وهو يقدم لنا ذخيرة عن حياة كفافيس، واقعية وأدبية ووهمية، تَجسّدَ نصّا فذّا، مُجترحا روائية عربية، تسمو فيها أدبية الكتابة ومناوراتها، مع آليات السرد، قديمة وحديثة، للتعبير عن متعاليات، أعظمها الذات والإبداع والحرية، وبروح مغامرة وجرأة في القول الفني، وككل مغامرة، فلها تبعات.