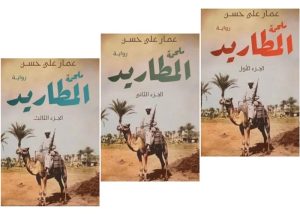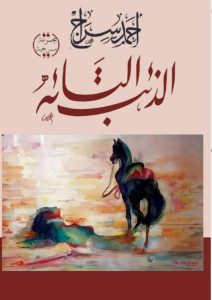وبالرغم من دأب وحيد الطويلة في عناوين نصوصه السردية سواء رواية أو قصة على اختيار عناوين تبدو معنوية رغم دخول بعض المركبات المادية في تكوين بعضها، عناوين من نوعية “باب الليل”، “أحمر خفيف”، “ألعاب الهوى”، “خلف النهاية بقليل”، عناوين تبدو مراوغة بقدر حياديتها، فلا تفصح عن الشخوص ولا الأحداث- فإنّ عنوانًا كـ”حذاء فيلليني”- بماديته الخالصة وتأشيره المشخصن- يفصح عن أطياف غرائبية ستلوح بفضاءات السرد بالرواية باستحضار فيديركو فيلليني المخرج الإيطالي، الذي يُمثِّل علامة بارزة في اتجاه الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، وبالتالي فإنّ استحضار فيلليني في عنوان الرواية قد يشي باعتماد السرد آليات سينمائية في بثِّ حكايته أو قد يسفر عن تبني السرد اتجاه الواقعية الجديدة في الكتابة بما يناظر اتجاه الواقعية الجديدة في الفن السينمائي. أما المضاف في العنوان “حذاء” فهو يستعمل لغة الكاميرا بتضيق الكادر وقصدية اتجاهه Zoom in)) ليكون الـ”حذاء”- منذ البداية- مجازًا يُشكِّل سؤالاً للبحث والاستقصاء عن دوره في الأحداث أو علاقته بشخوص الرواية.
يُهندِس الطويلة في “حذاء فيلليني” فضاءً سرديًّا معقدًا، رغم محدودية أصوات الرواية وشخوص الحكاية عددًا فيما يتمظهر في ثلاث شخصيات رئيسية: الضيحة مُطَاع/ مطيع المعالج النفسي، والجلاد ضابط أمن الدولة الكبير، والزوجة المنتهكة جسديًّا كضحية للجلاد زوجها، يُفرِغ بجسدها شحنات عدوانيته إزاء معتقليه، مع حضور ثلاث شخصيات ثانوية لكنّها تضطلع بدور مهم في الرواية فيما يتمثل في شخصيات: الأب، والجارة رفيقة المعالج النفسي وحبيبته، ومأمون تابع الجلاد الذي كان يومًا فريسةً له فصار عميلاً يصطاد له الفرائس. أما الشخصية الفارقة التي يبدو حضورها مراوحًا بين الشبحية والواقعية مضفيةً على السرد بالرواية أبعادًا غرائبيبة فهي شخصية فيلليني المخرج الإيطالي بحضوراتها المتفاوتة في الرواية بين مستوى طيفي يلوح فيه من بعيد في أفق غيابي كشخصية يتمثلها البطل/ المعالج النفسي/ الضحية، وحضور آخر فانتازي، واقعي بظلال شبحية، إضافة لحضور الشيطان كصوت شبحي يقيم السرد حوارًا بينه ومطاع/ مطيع المعالج النفسي.
الانهمام السياسي
منذ المشهد الأول من الرواية “مشهد ما كان فيلليني ليحبه” تتكشف أبعاد التبئير الأيديولوجي والانهمام السياسي من خلال مسعى السرد لكشف زيف نظام استبدادي- كما يراه السرد في الحالة السورية كنموذج علامي ومثال للاستبداد- من خلال مشهد انتظار جمع كبير- في ترقب واهتياب- مقدم عضو الحزب الحاكم:
جالسين في انتظار القدر، لا صوت واضحًا، بالكاد همهمات واهنة، وسلام بتحريك الأيدي والشفاه فقط.
كأننا أجهزة آلية أو دمى يحركها واحد من الخارج بضغطة واحدة.
كأنه يلعب بنا، بل يلعب بنا فعلاً.
وصل الهر، عضو الحزب الحاكم، يمكن لك أن تستعير عين الشيطان، تحاول أن تختلس نظرة لكنك لن تراه، هو بين رهطه حراسًا وخدمًا ومعاونين، لن تراه لكنك ستحس به، ظله الثقيل يخنق المكان، رائحته الثقيلة أيضًا تتمدد في الهواء، لأصحاب السلطة رائحة لا تخطئها القلوب الواجفة…. كنا في نهاية مؤتمر لشحذ الوعي القومي بين الأمم التي ارتخى وعيها القومي، يحضره رفاق ورفيقات من مشارب الأرض ليكون الشحذ أمميًا، فنحن أمة سامية ذات حضارة خالدة، وعلى الجميع في نهاية مؤتمرات الشحذ هذه أن يحتفل بما يليق بنا، بما أنجزناه وبما حطمناه، ونحن للأمانة كنا على مستوى المسؤولية، لم نقصر، وصوت مندفع من خلفي: وضعنا توصيات كالصواريخ، اتخذنا قرارات كالقنابل، انتصرنا على الأعداء في قلب المؤتمر وسنسحق المؤامرة أينما كانت، ولم ولن نبخل بشيء، كادت حناجرنا تطير من رقابنا في الهواء، وطارت الحروف والكلمات، من قوة النضال ومن سخونة الكلام(1).
فيما يبدو أنّ لسرد وحيد الطويلة في كتابته المشاهد إيقاعًا دراميًّا ونفسيًّا يتبدى في إبراز حركة الشخوص المادية ارتباطًا بأحوالهم النفسية، فقدت بدت الجماعة- في محفل السياسة- عالقة بفرد، ماكثة بانتظاره، كما بدى أن ثبوت الجماعة، جمودها، حركتها المرتعشة كأنّها وقع لحركته، وهو ما يطمس صوت الجماعة ويجعل أفرادها كـ”أجهزة آلية أو دمى يحركها واحد من الخارج بضغطة واحدة” في تجل لفقد الذوات طبيعتهم باستحالتهم كائنات آلية، وخسرانهم إنسانيتهم.
ومن البداية يبدو هجاء الخطاب السردي للشحن الأيديولوجي الزائف الذي تقوم به الأنظمة الاستبدادية للجماهير الذي لا يتجاوز حد الخطابة ومستوى الرطانة إلى فعل ملموس وتضحية حقيقية، وإذا عدنا لما يناهز الخمسة عقود، أي لهزيمة يونيو 1967 واستعدنا قصيدة “هوامش على دفتر النكسة” لنزار قباني لنجد أنّ الصوت النزاري ينعي جهورية الصوت الأيديولوجي الزائف دونما عملٍ حقيقي:
أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمه
والكتب القديمه
أنعي لكم..
كلامنا المثقوب، كالأحذية القديمه..
أنعي لكم.. أنعي لكم
نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمه
(….)
إذا خسرنا الحرب لا غرابه
لأننا ندخلها..
بكل ما يملك الشرقي من مواهب الخطابه
بالعنتريات التي ما قتلت ذبابه
لأننا ندخلها..
بمنطق الطبلة والربابه
السر في مأساتنا
صراخنا أضخم من أصواتنا
وسيفنا أطول من قاماتنا
وكأنّ المأساة التاريخية تتناسخ وتتكرر، وكأنّ الذات الجمعية لم تتحرر بعد من “الفكر الذي قاد إلى الهزيمة”، وكأنّ الخطاب الروائي- عند وحيد الطويلة- يسير بنفس الدرب الذي سار به الخطاب الشعري لدى نزار قباني بمحاولة هدم اللغة القديمة، اللغة الإنشائية الضاجة بالجهر الزائف والنبرة الزاعقة، فيما يتبدى أنّ خطاب الجماعة الواهم أكبر من طاقاتها وقدراتها، وهو ما يتجلى في تبطن كلا الخطابين- الشعري عند نزار قباني والروائي عند وحيد الطويلة- بنبرات سخرية من الذات الجمعية في ظل غيبوبة الوعي الجمعي وتزييفه هربًا من مواجهة الجماعة نكباتها، وكأنّ الذات في كلا الخطابين- الشعري والروائي- تحاول أن تتطهر من خطايا وأخطاء الذات الجمعية من خلال فعل السخرية.
سرد مابعد الفجيعة وكتابة الشهادة
ينبني السرد في رواية “حذاء فيلليني” على حدثين فارقين: الحدث الأول فيما يشبه الخطأ التراجيدي البادي في حيرة مطاع/ مطيع المعالج النفسي المتجلية في تساؤله المعذّب حول سبب الزج به في المعتقل دونما جريمة ارتكبها أو خطأ اقترفه ووقوعه تحت تعذيب الجلاد، والحدث الثاني فيما يُمثِّل ذروة المفارقة الدرامية بلقاء الطبيب النفسي/ الضحية بجلاده/ الضابط في عيادته مريضًا إثر عزله عن الخدمة وإحالته للتقاعد وتردد الطبيب ببين خياري الانتقام من جلاده اقتصاصًا لحقه أو العفو عنه ومعالجته وفق لما تُمليه عليه أخلاقيات مهنته.
يبدو أنّ صوت السرد الأبرز مطاع/ مطيع/ الضحية يمارس اعترافًا بوحيًّا باستعادته تاريخ التعذيب والانتهاك الذي تعرض له أثناء اعتقاله دونما تهمة واضحة:
هل جربت أن تصطك ركبتاك وأنت تقف أمام ضابط أمن الدولة في غرفة خانقة لا ترى منها سوى جدران صماء، كأنها بلا شبابيك، هي فعلا بدون شبابيك في قبوٍ لا تعرف كيف دخلته ولا كيف ستخرج منه، القبو يجعل فكرة العودة للحياة وهمًا، أمنية مستحيلة، ساعتها ستعرف أن الجدران تستطيل فعلاً أمام عينيك بمزيج الخوف، بسمتها الكابي، بألوانها الحائلة الخانقة، تكاد تنطق بأسماء الضحايا، تستطيل حتى تعتقد أنها لن تتوقف كأنها ستصل إلى سابع سماء على تلك الحالة وأنها لن تتركك للسماء كي ترتاح ويرتاحوا، ثم تهبط وتضيق، نعم تضيق تكاد تخنقك وأنت تتمنى لو قدموك للمحاكمة الآن وحكم عليك الآن أيضًا وخرجت تتنفس الفرحة لأنك ذاهب للسجن. (ص49).
تروي الذات فجيعتها وتحكي مأساتها في المعتقل، وشعورها بالموات في “القبو” وفقدانها الأمل- حين اعتقالها- في العودة إلى الحياة، كما يبدو من سرد الذات فجيعتها فإنّ إحساس الذات بالصدمة ينعكس على تمثلها الموضوع/ أشياء العالم، عالم المعتقل، القبو الذي تسبغ عليه من مشاعرها بالخوف والاختناق، والشعور كذلك بتناهي المكان الذي استحال غرائبيًّا في الانغلاق ولا نهائية امتداده في آن، حتى إنّ الجدران “تستطيل حتى تعتقد أنها لن تتوقف كأنها ستصل إلى سابع سماء”، فما الموضوع- لدى الذات في فجيعتها- إلا انعكاس لوعي الذات وتجل لتَمثُّلاتها.
في سرد الفجيعة يبرز استعمال الذات فعل المضارع في حكيها عن أحداث الماضي، وهو ما يكشف عن طغيان ذكرى الفجيعة وزمن الصدمة على وعي الذات في زمنها الآني الذي استحال عالقًا بتاريخ الذات مع فجيعتها.
كما يتبدى- أيضًا- من سرد الذات فجيعتها كضحية إحساسها بشراكتها مع “ضحايا” آخرين تقاسموا معها تاريخ الألم وذكريات الصدمة، حيث “يستخدم مصطلح “فجيعة” في الأدبيات التكنيكية والعلمانية، ليشير إلى القوى أو الآليات التي تتسبب في التشوه النفسي، وليشير في الوقت نفسه إلى الحالة النفسية الناتجة عن ذلك. ففي كتابها المرموق “الفجيعة والشفاء Trauma and Recovery” (1992) تتخذ المعالجة النفسية جوديث هيرمان Judith Herman الخطوة المستبصرة الجدلية، للربط بين ثلاثة أنماط من الفجيعة بالمعنى الأول، وهي: الحرب الحديثة، والعنف الأهلي، والهيمنة الشمولية، سواء مارستها حكومات، أو أفراد أو طوائف دينية. إنّ الأحداث الفجائعية التي تضم عادة “تهديد الحياة، أو السلامة الجسدية، أو صدامًا شخصيًّا- وعن قرب- مع العنف والموت” (هيرمان: 33) ينجم عنها ضحايا يشتركون في أعراض متشابهة”(2)، أي أنّ إحساس الذات بالفجيعة يتضاعف لوجود ضحايا آخرين يشاطرونها ذكرى الألم.
ولذاكرة الفجيعة لدى الذات الواقعة تحت صدمة ما وعي خاص، وعي انتقائي يبدو عالقًا أكثر بخبرة الألم والانتهاك:
أنا في الحقيقة لا أتذكر شيئًا سوى التعذيب وأشياء أخرى قليلة.
انمحت ذاكرتي تمامًا. بيضاء. وكل ما أريده هو استعادتها، أحيانًا يخيل لي أنني يجب ألا أستعيدها، ولكن ما بقي منها يتراءى أمام عيني طول الوقت قططًا سوداء، أسأل نفسي: ألم تكن هناك قطط بيضاء، ألم تمسني امرأة، لم لا أتذكر قصة حب واحدة؟ كمريض بالزهايمر يرى كل الوجوه وينساها.
لا أعرف هل فقدت ذاكرتي فعلاً أم أن هناك من تواطأ عليَّ لأمحو كل شيء، أم تواطأت أنا بفعل القهر لأنسى كل شيء وأكرس روحي لشيء واحد؟ (ص22).
تجيد الصياغة السردية لدى وحيد الطويلة تشييد بناء نفسيٍّ للحكاية وشخوصها، فتدع أصوات السرد يمارسون البوح بفجيعتهم، بتمثلاتهم النفسية وتهاويماتهم، فيبرز السرد ذو الطابع النفسي الآثار التدميرية للفجيعة على الذات وخصوصًا الذاكرة، إذ يساكن الشخصية شعور بانمحاء ذاكراتها، الذاكرة مخزن الزمن وحافظة تاريخ الذات. وكما هو بادٍ في ذلك المقطع من كثافة أدوات الاستفهام والنفي حالة الاهتزاز النفسي والارتباك الشعوري جراء إحساس الذات بفقدها تاريخها مما يعني تشوهها النفسي جراء الصدمة الناجمة عن تعرضها للقمع والانتهاك في المعتقل، إذ يتعرض الشخص الضحية- بأثر الصدمة إلى “تشوه ناتج عن عقدة ما بعد الفجيعة” Traumatic stress Disorder (ptsd)-Complex Post. ويتميز هذا المرض بتبلّد الضحية، وانعزالها وانسحابها، وتشوشها في العلاقات الحميمة، والانزعاج الدائم، وإيذاء الذات، والميل إلى الانتحار، وتبدد الشخصية، والهلوسة، وفقدان الذاكرة واستعادة الخبرات السيئة”(3)، وقد تبدى هذا في علاقة المعالج النفسي/ الضحية بالآخرين وبجارته، إذ يقول عن جلاده:
هذا الرجل حطَّم ما بيني وبين العالم، هشَّم ما بيني وبين طعم أصابع جارتنا. (ص58).
الصدمة تعزل الذات عن العالم، وعن آخرها الذي تحب، تُفقِد الذات رغبتها في الأشياء وتصيبها بنوع من الكفِّ الشعوري يفضي بها إلى “عزلة” نفسية وانسحاب وجودي. كما تتسم لغة الطويلة في خطابه السردي بإيقاع سيكولوجي كما هو متبدٍ في “عنف اللغة” تعبيرًا عن مكبوتات الشخصية ودواخلها اللاشعورية، وهو ما يقويّ من شعرية لغة السرد في كتابة وحيد الطويلة.
كسر الإيهام السردي
فيما يبدو أنّ الذات الساردة من فرط إحساسها بمأساوية الواقع وجهامة العالم الذي تنقله عبر الرواية فإنّها تعمل من حين لآخر على كسر الواقع الدرامي الذي يبثّه السرد رُبَما تخفيفًا لثقل هذا الواقع الذي يُصدِّره التخييل السردي، فيخاطب السارد قارئه قائلاً:
القبو مكان آخر غير السجن، جحيم آخر، القبو مكان تحت القبر، مكان الحساب على الأرض… جهة اليمين تؤدي فقط إلى النار واليسار تؤدي إلى الجحيم.
هل جربت ذلك عزيزي القارئ؟ عزيزتي القارئة أنا أعفيك من هذا المشهد، فأنا رجل أحب النساء ولا أتخيل مجرد وجودهن في هذا المأزق رغم أنه يحدث كل يوم.
هل جربت أن تنظر في كل الاتجاهات فلا تجد إلا اتجاهًا واحدًا وسهمًا واحدًا؟
هل جربت طعم أن تجد جلادك الآن بين يديك، يدخل مريضًا لعيادتك وهو لا يعرف أنك تعرفه؟ (ص ص49-50).
بينما ينطلق السارد في وصف عذابات القبو وهول وحشته وما يبثّه في النفس من فجيعة كبرى وهلع فادح وانكسار عميق يُلِّم بالذات ويجتاحها في معتقلها حيث القبو منتهك الذوات ومدار التعذيب، ومع توالي مبثوثات الخطاب السردي الواصفة اضطراب الذات في منتهكها التعذيبي بتفاقم مأساوية حالها يقطع صوت السارد البث الحكائي مخاطبًا القارئ، بل إنّه يعني بالتوجُّه بحديثه للقارئ الرجل دونما القارئة إشفاقًا على قرائه من الإناث لهول ما يحكيه وبشاعة الواقع. فالسارد بمخاطبته القارئ إنَما يُوقِف حركة التخييل السردي الإيهامية التي تحاول أن تُوهِم بالواقع.
والكاتب بجَعلِه ساردَه يخاطب المتلقي، القارئ، إنّما يُحدِث تبادلية في الأدوار التي تؤسس الحديث، حيث إنّ “الأحجار الأساسية التي ينبني منها الحديث ليست الكلمات أو الجمل، بل “الأدوار” أو “الانتقالات”، وأن الأدوار التي يلعبها المتكلم أو المستمع يُنظَر إليها باعتبار أنّهما “شريكان” يكمل أحدُهما الآخر، وأن النشاط نفسه لا يحدده ما أُنتج في النهاية (أي محتوى الكلام)، بل تصوُّر المشاركين لما يحدث”(4)، فالمتكلم/ السارد يضع نفسه موضع المستمع/ القارئ، حتى إنّه يُجمِّد سرده ويُوقِف حكايته ويُعطِّل حديثه كي يختبر خبرة قارئه من الرجال بفجائع الانتهاك القمعي في المعتقل، فيُعفي قارئه من الإناث من وطأة التَّمثُّل النفسي لهذه التجربة الأليمة.
فيقول السارد مُطيع/ مُطاع:
أنا لا أحكي عن التعذيب، فمائة رواية كتبها كتّاب من مختلف بقاع العالم لم تشف غليل أحد ولا جعلت السلطة تتوقف عن التعذيب، ولا جعلت الجمهور الغبي يقف ضد التعذيب، أكثر ما كان يغيظني في الأفلام الأجنبية التاريخية تحديدًا أن البطل يدافع عن الرعاع، عن كرامتهم، ويصرخ بصوته بدل أصواتهم، وحين يقدمونه للمقصلة يقفون في وجل يأكل حشاهم، لكنهم يصفقون حين يصعد إلى المقصلة وحين تقطع رأسه كأنهم قضوا على الطاغية… ثم يعودون إلى بطل آخر يقصف أمامهم، يتصايحون كأنهم يتفرجون على مباراة للديكة، وهكذا كأنهم بدون ذاكرة سوى ذاكرة البعوض. (ص ص42-43).
يبرز الصوت السارد في ثنايا حديثه عن التعذيب المُمَارَس وعيه- بما يبثّه للقارئ- بأنّ ما يُكتَب من روايات عن الاستبداد والقمع والتعذيب لا يغيير موقف السلطات الديكتاتورية من أيديولوجيتها القمعية ولا يدفعها للتخلي عن خيار التعذيب، ولا يكتفي السارد بإدانة السلطات المستبدة وإنّما يدين المقموعين أو الجماعة لتخليهم عمن يدافع عنهم.
وإفصاح السارد الذي يُقدِّم نفسه ككاتب لهذه الحكاية كرواية عن وعيه بأنّ كتابة رواية- كغيرها من الروايات التي تدين القمع والاستبداد- لم يغيير لا في موقف السلطات الديكتاتورية ولا حتى المقموعين كجماعة حري بها أن تتضامن مع المدافع عنها حينما يقع تحت مقصلة الطغيان إنّما يعمل على أن يُبطل أثر الإيهام بالواقع لدى الذات المتلقية، القارئ، وكذلك فإنّ قيام السارد/ الكاتب بموازة استعارية بين فن الرواية ككتابة تتناول القمع وفن السينما الذي تتناول أفلامه تاريخ القمع إنّما يستلهم تاريخًا مكرورًا للقمع وسلوكًا متناسخًا للمقموعين مستخلصًا الدرس من التاريخ الذي يٌقدِّمه الفن السينمائي. وكأنّ السارد- في الآن ذاته- يستثير القارئ ويستنهضه كي لا يقع مجددًا في نفس الفخّ الذي وقع به أسلافه من الذي يقرأون كتابة منددة بالقمع والاستبداد ولا يتخذون موقفًا قويًّا في وجه القمع حين يقع من يدافع عنهم فريسة في مهلكة، وكأنّ السارد/ الكاتب يعمد- هنا- إلى كسر الإيهام السردي لكي ينبِّه القارئ المتلقي بألا يكون سلبيًّا كغيره من القراء الذي لم تغييرهم الكتابة ضد القمعية، بل يُحرض السارد/ الكاتب قارئَه على ترك السلبية في مواجهة القمع.
ولما يقوم به الصوت السارد/ الكاتب- من حين لآخر- عبر السرد- بتنبيه القارئ بأنَّ ما يتابعه هو رواية غير غرض، فيقول السارد:
جارتنا، أخاف أن أشي باسمها في الرواية. (ص65).
تُمثِّل هذه الإشارة- التي لا تخلو من فعل تهكمي وروح سخرية- بأنّ الخطاب الذي نحن في حضوره هو رواية- كسرًا آخر للإيهام يقوم به السارد، وكأنّ السارد/ الكاتب يردّ على بعض ما يتوقعه من أسئلة قد يُطْلِقها القُراء من نوعية: ما اسم شخوص الرواية؟ ولماذا لمْ يذكر السارد/ الكاتب أسماء شخوص روايته؟
عمومًا، ما يبثّه السارد/ الكاتب من إشارات في ثنايا حكيه بأنّ خطابه هذا هو رواية أو بمخاطبته قارئه هو عملية مقصودة لكسر الإيهام السردي وإيقاف الإيهام بالواقع الذي قد يُصدِّقه القارئ عبر الخطاب الروائي يناظر كسر الإيهام في المسرح أو كسر الحاجز الرابع بين الممثل في المسرح/ السارد، والجمهور تلك التقنية البريختية التي تُمثِّل إحدى وسائل “التغريب” في المسرح البريختي، وهو ما يمنع الجمهور/ المتلقي من التماهي التام مع الأحداث، ذلك التماهي الذي كانت الدراما الكلاسيكية الأرسطية تنشد حدوثه من أجل إحداث “التطهير” لدى المتلقي/ الجمهور. وكأنّ كاتبنا بجعله سارده يكسر الإيهام التخييلي لسرده إنّما يُشفق على متلقيه وقارئه من التماهي مع الواقع الذي يصيغه التخييل السردي بمأساويته وكابوسيته وفجائعه وأهواله.
لعبة الضمائر
لئن كانت الضمائر بمثابة ركائز أساسية للسرد ومن خلالها تتموقع أصوات الحكاية في لوحة السرد، وعبر تلك الضمائر تتمركز الذوات في معاينة العالم، موضوع الحكاية. وكذلك عبر التفاتات الذوات بين الضمائر تنجلي لنا أحوال الذوات وتحولاتهم النفسية والوجودية. وفي رواية حذاء فيلليني تتنوع ضمائر السرد وتتراوح أصواته بين الضمائر الثلاثة (المتكلم- المخاطب- الغائب) وإن كان لضمير المخاطب حضور لافت في هذه الرواية:
سرد المخاطب
لما كان ضمير المخاطب، الضمير الثاني السردي، هو الأقل حضورًا في السرد الروائي، فإنّ استخدامه البارز في حذاء فيلليني يجعلنا إزاء سرد مغاير، كذلك يكون المخاطب فيه متنوعًا ومتغيرًا في المضمر المحال إليه وفقًا لحالات الخطاب السردي ومقاصده وما يقيمه من حوارية، فيقول السارد في مقطع الرواية الأول، المشهد الأول، “مشهد ما كان فيلليني ليحبه”:
انتظر قليلاً، عفوًا انتظري قليلاً، كان يجب أن أوجه النداء إليكِ أولاً، فأنتِ الأولى بالتقديم كما تقول قواعد اللياقة، أنتِ الأولى كما تقول قواعد العشق، وأنا رجل يمكن أن تصفينه دائمًا بأنه عاشق قديم، القدم هنا لا يعني أنني قضيت وطري من الدنيا أو تداعت أسنان الغرام عندي كما قد يفهم البعض، إنما تعني أنني أوغلت وما زلت، تفاصيله تسكن ملامحي وأصابعي تنطق بالوعود.
النساء هنَّ من سيسمعنني ولو بأفئدة مكسورة، أما الرجال فقلوبهم مهشَّمة وما تبقى منها تحول إلى حجر. (ص ص9-10).
يكون المخاطب- هنا- هو المتلقي، “القارئ، في كسر للإيهام، ولكنّ السارد يفصل هذا المخاطب/ القارئ/ المتلقي ويفرقه جنسيًّا مفضلاً مخاطبة المؤنث، مراعاةً لقواعد اللياقة، “الإتيكيت”، ولخبرة الذات المتلفظة من خلال السرد باعتبارها تمتلك تاريخًا في العشق واختبارها قلوب النساء وتوقعها باستجابتهن لحكايتها. وإذا كان السارد في خطاب سابق يتوجّه بحديثه للقارئ الرجل دونما المؤنث- في حديثه عن الممارسات التعذيبية بالقبو- إشفاقًا على الأنثى من بشاعة المشهد الذي يحكيه وقسوته، فإنّه على العكس- هنا- يُقدٍّم الأنثى ويُفصِّلها على الرجل- لكون النساء رغم انكسار قلوبهن أكثر استعدادًا لسماع حكاية عن الاستبداد من الرجال الذين صارت قلوبهم حجرًا، لذا “يُمكن القول إنَّ المتكلمين والمستعمين يتعاونون على إنتاج الكلام، لا لأنَّ المتكلمين واعون بهوية الجمهور فقط، بل أيضًا لأنّهم واعون بتطور رد فعل هذا الجمهور إزاء الكلام، وبطبيعة الحال، فإنّ الكُتّاب، في حالة التواصل المكتوب، يجب أيضًا أن يكون لهم جمهور في أذهانهم (أونج Ong 177، 1982)”(5)، فتؤسس كتابة وحيد الطويلة السردية تفاعلاً واعيًا بين النص ومتلقيه، فيقول السارد/ مطاع/ مطيع:
لا بد من قتله، لا يجب أن أنتظر أحدًا أو مذاقًا آخر سوى مذاق دمه، لا يحكِينّ أحد لي منكم عن الطبيب والرحمة والملائكة، وقسَم أبقراط، لو تعذب أبقراط نفسه لتنصل من قسَمه بعد أول صفعة، الصفعات هنا آتية من الجحيم وبيد ملائكتها الذي يعتقد هو أنه واحد منهم، لو شاهد أبقراط الأجساد وهي تتحول إلى جيفة حية ثم ميتة لحنث بقسَمه واقتلع أسنانه وأقسم قسمًا جديدًا ألا يجلس من أية امرأة مجلس امرأته، ألا يمد قطرة دواء لأحد أو يكتب وصفة لمريض، أن يكشط بسيف حاد كلمتي العطف والرحمة من قاموسه.
أنا نسيت الرحمة، لم أفعلها عامدًا ولا بخاطري. (ص43).
كما يتبدى من هذا المقطع فإنَّ تفاعل السارد/ الكاتب مع الجمهور/ المتلقي/ القارئ يتجاوز مجرد توجيه السارد/ الكاتب حديثًا إلى القارئ/ المستمع إنّما يتوقع السارد/ الكاتب ردّ فعل المتلقي/ القارئ كأنّه يسمع صوت القارئ ويحدس بمسلكه إزاء ما يقوله السارد وما ينتوي عمله، ليدخل السارد في جدال افتراضي مع القارئ/ المستمع ما يرفع درامية السرد ليس بحركة أحداثه فحسب بل بحركة الحوار بين صوت النص السردي وصوت القارئ الافتراضي بما يُسهم في مضاعفة التوتر الدرامي للسرد، حيث يبدو “المتكلِّمون في رأي محللي المحادثة، ليسوا مهيمنين يفرضون ما يريدون قوله على مستمعين سلبيين، بل “إنّ المستمعين مشاركون فاعلون في عملية صناعة الدور في الحديث، ويمكن لفعلهم أو عدم فعلهم، أن يؤدي إلى تعديلات جوهرية في الجملة التي يكون المتكلم بصدد إنتاجها” (جودوين وهيرتيج 293)”(6)، وإنّ لمراعاة الكاتب/ السارد ردّ فعل المتلقي/ القارئ/ المستمع دورًا في خلق إيقاع لكتابة السرد يبدو أكثر حيوية ونبضًا بترددات السارد/ الكاتب استجابةً لردود أفعال القارئ الافتراضي.
ويدفع صوت السارد ردّ الصوت الافتراضي لمتلقيه ومستمعيه بتفكيره الانتقامي إزاء جلاده بمراعاة أخلاقيات المهنة التاريخية بدءًا من قسم “أبقراط”، في مراوحة بين صوت السارد وصوت “القارئ الافتراضي الضد”. ولكن هل يكون صوت المستمعين/ المتلقين المغاير والمضاد لصوت الذات الساردة هو صوت “الذات الضد”؟ هل تضع “الذات- الضد” للسارد/ الكاتب/ المتحدث نفسها موضع القارئ/ المستمع؟ أو أنّ صوت “الذات الضد” هو الذي يستدعي أصوات المتلقين/ المستمعين في توجههم المعارض للذات؟ وكأنّ صوت القارئ الافتراضي- في معارضته الذات في تفكيرها الانتقامي- هو صوت “الذات الضد” الذي يتبدى من حين لآخر- على امتداد السرد- في هيئة جماعة القراء الافتراضيين- تشكيلاً لجماعة ضغط على الذات ليكون صوت القارئ الافتراضي في معارضته الذات الساردة بمثابة صوت ردع أو صوت الضمير الأخلاقي للذات الذي يكبح جماحها في شهوتها الانتقامية.
وإذا كان جاكوبسون يدفع بأنّ ضمير المتكلم لا سيما في المضارع أكثر ارتباطًا بالغنائية، في حين أنّ ضمير الغائب خصوصًا في الماضي يتعلق بالمحلمية، أما ضمير المتكلِّم فيرتبط بالوظيفة العاطفية والدور الإفهامي أو الإعلامي(7)، لكن قد يكون ضمير المخاطب، ضمير “الأنت” قاصدًا الذات الساردة نفسها “الأنا”، وليس آخر:
لاحظت أنّه لا ينظر ناحيتنا، اقتربت منه على مهل، ممددًا في رقدته ووجهه ملويٌّ بعنف ناحية اليسار، مددت يدي مدفوعًا بأسى وافر أتحسس وجهه ورأسه بلطف وأنا أحاول أن أمازحه، لم تكن ملوية فقط، بل راسخة في مكانها الجديد، مستقرة فيه كأن كلاب الجحيم هاجمته فجأة وهو نائم يحلم بالجحيم، كتمثال شمع في متحف جارته مارلين مونرو فالتوى عنقه من شدة النظر إليها وبقي هناك… انحنيت أمام بشاعة المنظر.
حتى لو كنت تملك قلبًا باردًا ككل الأطباء، يجب أن تنحني بأسف شديد أمام رقبة محنيَّة عكس اتجاه الحياة، القصة ليست في التعاطف وإن تعاطفت، القصة فيما تفاجئك به الحياة وهي تلعب بقسوة في مصائر البشر. (ص25).
بعد أن يستعمل السارد ضمير المتكلم في وصف الحدث في الماضي (استقبال المعالج النفسي جلاده، ضابط الأمن، في عيادته وهو في حالة متردية) ينتقل- في التفاتة إشارية- إلى سرد بالمخاطب (أنت) عن الذات (أنا) في حديث تأملي يوقف الوصف الدرامي أو بالأحرى ينتقل من دراما الخارج إلى دراما الداخل النفسي، وبينما تسرد الذات عن نفسها بالمتكلم جاءت الجمل فعلية والأفعال في الماضي بما يناسب (الوصف)، في حين أن في سرد الذات عن نفسها بالمخاطب تنوعت الجمل بين فعليه في زمن المضارعة واسمية بما يناسب (النصح والإرشاد).
هذا وتتكرر- في غير موضع- لعبة الالتفات الضمائري التي يمارسها السارد بالانتقال من المتكلم إلى المخاطب في حديث الذات عن نفسها، فيقول السارد:
أحكي عن تعذيبي وحدي، أنا الآن فرد عنّين الروح، وهو أيضًا فرد برتبة جلاد، أو جلاد برتبة فرد، اشف غليلك وعقِّم جراحك، جراح روحك التي لم تندمل يومًا، هذا هو سبب علاقتك الخاصة بفيلليني التي لا يعرفها أحد، وبجملته التي عرفت طعمها الآن: لا شيء أصدق من حلم. حلمت أن تقابله لتقتص منه، وجاءك على تروللي برقبة ملتوية معوجة، جاهزًا للذبح كما لم يحدث في أفلام فيلليني نفسها.
أنت الآن تملك أن تدفع برودة الموت بخطىً بطيئة إلى قلبه ليلفظ أمام عينيك آخر أنفاسه، كما كدت تلفظ آخر أنفاسك بين يديه رعبًا، لا تتأخر ولا تفكر كثيرًا، يجب أن تأخذ ثأرك منه وبسرعة، لا بد أن تكون حاسمًا خوفًا من أية مفاجأة. (ص44).
في انتقال الصوت السارد من ضمير المتكلم في حديث الذات عن نفسها ومع نفسها إلى ضمير المخاطب نكون وكأننا إزاء ذاتين، يمثلان- بالطبع- ذاتًا منشطرة، منقسمة على نفسها، ذاتٌ ترزح تحت نير الذكرى، مثخنة بطعنات ماضيها، منكسرة بفعل القمع وأثر التعذيب الذي مُورِس ضدها، وذاتٌ أخرى تحاول التعافي من فجيعتها ولملة حطامها وجمع شظاياها. وفيما بعد الصدمة تتأرجح الذات بين محاولة نسيان ماضيها والرغبة في الانتقام، فقد مثَّل ضمير المتكلم (الأنا)- هنا- الذات المنكسرة، عنينة الروح، أما ضمير المخاطب (الأنت) فيُمثل الذات التي صارت في موقع قوة إزاء جلادها الذي ألقت به الأقدار بين يديها ويمكنها الانتقام منه.
إنّ هذا الحوار التي تجريه الذات مع نفسها ضروري وشرط أولي لكي تتعافى من فجيعتها، لتدخل فيما يُعرَف بدائرة “الشهادة للذات” حيث “تنطوي هذه الدائرة على مقدرة شخصية مفردة على تحمل الشهادة لنفسها حول تجربة ما. وحين تؤدي أحداث عنيفة إلى فجيعة نفسية تتحطم هذه الدائرة. إنّ التعافي من الفجيعة يتضمن جوانب متكاملة من التجربة كانت قد ضاعت، وهذه العملية تبدو وكأنّما تتطلب بالضرورة شخصًا آخر (الدائرة الثانية). ومن المحتمل أن تكون الذات، وكأنّ عليها في لحظة ما من عملية الشهادة، أن تعيد التجربة إلى تكاملها، عبر مراجعة مع الذات لما حدث (الدائرة الأولى)”(8)، أي أنّ الذات- في محاولتها التعافي- تُجرِّد من نفسها ذاتًا أخرى تحاورها للخروج من صدمتها الفجائعية.
وفي لعبة الالتفات الضمائري قد يكون الانتقال من المفرد إلى الجمع كما يبدو في أحد المقاطع:
عذبه إذًا ولا تتأخر، لا تُجلسنا أيامًا لتقص علينا حكايتك، غيرك يريد أن ينتهي منه وربما منك، اخترع له وسيلة لم تُخترع من قبل، لا تنسَ أن آلات التعذيب لا يخترعها الضباط وإنما يخترعها علماء وأطباء خونة مثلنا، وأن كل السموم هي من بنات أفكار الطيبين ليتعذَّب بها طيبون مثلهم. (ص55).
تبدو الذات- هنا- في التفاتها وانشطارها الضمائري متوزعة بين ضميري المخاطب “الأنت” في تحريض الذات أناها على الانتقام من جلادها، وضمير المتكلم الجمعي “النحن” في التعبير عن تململ الذات الجمعية من تأخر الانتقام من الضابط، الجلاد، اقتصاصًا من الذات، وكأنّ الذات تجرد من نفسها شخصًا آخر “الأنت” ليتقتص لها من جلادها، كما أنّها تتماهى مع الذات الجمعية “النحن” وكأنّها تمثِّلها، الأمر نفسه الذي يُفصح السارد عنه:
أعرف أنني ألعب بالضمائر وأتحدث بكل ضمائر المخاطب والغائب لأنني أوقن وأبصم أن تعذيب واحد يعني أننا عذبنا جميعًا، وأن تغيير الضمائر إنما يشير إلى أننا صوت واحد. (ص161).
فالصوت السارد باعترافه بممارسته لعبة الضمائر والتنقّل بينها على تنوع مستوياتها إنّما ليؤكد على كون الذات المفردة صوت أو قناع يرمز للجميع وينوب عنه، فهي ذات “مفرد بصيغة الجمع”، تنوب على الآخر من الذين وقعوا تحت استباحة انتهاكية.
تجديد الواقعية الجديدة والحضور الطيفي
إذا كان حضور فيلليني بالرواية من عنوانها وفي متن حكايتها يضعنا أمام تيار مدرسة الواقعية الجديدة الذي قدمته السينما الإيطالية في خمسينات القرن العشرين الذي كان معنيًّا بتقديم سينما تتناول الواقع- دون إبهار أو تحسين- بمأساويته، بكل ما فيه من تشوه وقبح وما تضج به الذوات من معاناة إنسانية، وكذلك تيار الواقعية الجديدة الذي بزغ في الأدب العالمي والعربي بعد الحرب العالمية الثانية طاويًّا بظهوره الحقبة الرومانسية في الفن والكتابة بتوجهه أكثر نحو تناول الواقع بما فيه من صراعات وجودية.
تبدو رواية حذاء فيلليني بتقديمها الواقع الانتهاكي والتجاوز القمعي واختيارها القبو مكانًا استرجاعيًّا تراوحه الذات ويلح على ذاكرتها ماضيها الأليم فيه- أقرب لتيار الواقعية الجديدة، لا سيما مع اعتماد الكاتب على الوصف الدقيق ومَشهَدة سرده، لكنّ تدجين السرد بحضور طيفي ومستوى شبحي يبرق في فضاءات السرد كما في حضور الشيطان وحضور فيلليني يجدد نوعًا ما من تلك الواقعية الجديدة بمزاوجة الواقعي بما هو “غريب” بعد أن “أصبح مفهوم “الطيفية” Spectrality الذي استمده دريدا من فرويد، والذي استمده- بدوره- من شيلنغ وشتيرنر وينتش، أصبح أحد أهم أشكال المجاز في الثقافة والخطاب المعاصرين”(9)، ومن أبرز هذه الحضورات الطيفية بالرواية حضور الشيطان وحضور فيلليني المخرج الإيطالي الشهير وإقامة الذات حوارًا مع كلٍّ منهما، وهو ما يدخل بالسرد في أفق طيفي، مفارق للواقع، فيدور هذا الحوار بين الذات والشيطان:
– أنا أنت يا مطيع.
– لكنني لست أنا.
– أنا الشيطان يا مطيع.
.. تعال واشرب معي يا رجل، لماذا تأخرت على غير عادتك، وماذا حدث في عيد الميلاد؟ هل كنت هناك؟
لا أعرف يا مطيع، هل جئت في الوقت الخطأ أم لا؟ هل كان يجب أن آتي إليك وأنت مستيقظ بكامل حواسك حتى تتذكر كل كلمة سأقولها لك، خفت عليك أن تتخيلني شيطانًا، أم أنني جئت في الوقت المناسب كي لا تتذكرني جيدًا، وتعتقد أنك كنت تخرف أو وقعت في كابوس أو حلم، لقد ظللت نصف ساعة على الباب أفكر في أحد الحلين، ووجدت رأفة بك أن أدخل إليك في هذا الوقت.
.. أنت لا تجيء إلا في الوقت الخطأ دائمًا، حين احتجتك ذهبت إلى غيري ووقفت ضدي.
الوقت الخطأ أفضل لي ولك، يناسب شهوتي ويوافق حالك، أنت دخلت من الأساس في النفق الخطأ دون إرادة منك ولا ذنب.
.. لا حاجة لي بك الآن، ما حدث حدث، والقبر المزخرف لا يفيد الميت.
اسمعني جيدًا، أنا مشغول وليس عندي وقت للمزاح، جئت من أجلك، أنت لن تعيش مرتين، وأنا سأعيش أبد الدهر، عليك أن تتخلَّص من كوابيسك، من الجلاد، لا تقتله، قتله سوف يريحه هو، لكنه سيترك لك ألمًا مضاعفًا، لن تنجو بفعلتك وسيصير هو شهيدًا برأس كبيرة تحتاج مقدارًا أكبر من الجبس، ستٌزيد عدد التماثيل واحدًا، والشوارع والمدارس أصبحت مكتظة، ألا ترى الطريق بين حمص ودمشق، يخرجون عليك من الجبلين على الجانبين بغتة كآلهة الجحيم، أنت تحتاج إلى المستقبل لا إلى الماضي، أعرف أنك لن تستطيع أن تخطو خطوة واحدة إلى الأمام إلا بعد أن تقتص لروحك قبل بدنك، لكنك يجب أن تنتهي من هذه المسألة بسرعة حتى لا تدور في فلكها طوال العمر، هم بدؤوا الفيلم لكنك أنت من يجب أن يضع النهاية. (ص ص109-110).
تبدو الذات في لقائها بالشيطان وحوارها معه في حال تهويمي، في مفترق رجراج بين الواقع والوهم، اليقظة والغفو، الوعي والهذيان. وتبدو مساحة الجمل الحوارية للشيطان أكبر من تلك التي للذات/ مطيع رُبما نتيجة ارتباك الذات التي تبدو مُباغتة، ومُدهَشة من الموقف.
وإذا كان هذا الحوار يُجسِّد حالة عنيفة من التردد البالغ والحيرة المتمادية تنتاب الذات في خيارها بمواجهة جلادها وكيفية اقتصاصها منه، فإنّ هذا الحضور الشبحي للشيطان لا يجعلنا نستدعي- فحسب- ذلك الحضور الطيفي للشيطان في تاريخ الكتابة؛ كالشيطان في مسرحية فاوست لجوته الذي أسلم روحه للشيطان، وإنّما يبدو هذا الشيطان في تمظهره الشبحي والغريب كقرين ظلي للذات، أو بالأحرى يُمثِّل صوت الانتقام والتدمير في الذات، وكأنّ الحضور الشبحي هو مراودة طيفية للذات باعتبار أنَّ “الأدب وبالمعنى الحديث، يتعلق، في جوهره، بالتحديد والتجسيد لتلك الأشكال الخاصة من مساءلة الذات واستكشافها، عبر النصوص واللغة . والأدب هو أيضًا الميدان الخاص بالغرابة بامتياز؛ لأنّه يشتمل- دائمًا- على ذلك الجانب الخفي منه، على الجانب الخاص بالآخر، وقد يكون هذا الآخر هو الذات نفسها كما تنعكس على نفسها وتتأملها، ويكون هذا الآخر مختفيًا، هناك داخل النص، ويحضر من خلاله وعبره، في أردية وأقنعة رمزية، يحضر كطيف أو شبح. هكذا تتعلق الطيفية- إلى حد كبير- بالماضي الذي يجيء في الحاضر، وبالآخر الذي يحضر من خلال الذات”(10)، وكأنّ هذا الشيطان هو تمظهر شبحي للذات المفككة، المتشظية، صوت آخر مراود للذات.
وإضافةً لحضور الشيطان يحضر فيلليني في تمظهر شبحي آخر للطيفية، فيدخل في حوار آخر مع الذات:
.. هل تريدني أنت أيضًا أن أعذبه؟ أنا أريد أن أرتاح بأية وسيلة.
– لا. أريدك أن تفعل العكس، لا تجعل نوازعك الفطرية تأكلك، أريدك أن تتركه وزوجته إلى حال سبيلهما، اعتذر بأية طريقة، يمكن لك أن تغلق عيادتك لشهر وتكتب عليها أي شيء من وحي اللحظة، قل إنك ستسافر وستعود بعد عام، أنا كنت أرتب المشهد الجديد أثناء الاستراحة، لم أكن أكتب شيئًا من أساسه، الفكرة العامة كانت فقط في رأسي وأخترع مشهدًا بمشهد، كنت أصغي أحيانًا لحركة الممثلين والمساعدين أثناء التصوير وأخلق المشهد الجديد على ضوء ما حدث في التو واللحظة، الناس لا يستطيعون أن يتخيلوا ما يحدث خلف الكاميرا، إنه أحيانًا أكثر درامية مما أمامها.
.. لكنني حلمت أن أجده ووجدته.
– كل حياتك قامت على جملتي: لا شيء أصدق من حلم، وتحقق الحلم، دعه إذًا وتقدم لحياتك، اهزمهم بأن تصنع حياة أخرى مدهشة، لن يهزمهم قتلهم، إذا سقط منهم واحد تشققت الأرض عن عشرة، كل ما فعلوه بك يريدون شيئًا واحدًا: أن يجردوك من أحلامك، اتركه إذًا ونم واحلم حلمًا جيدًا.
.. لكنني تغيرت، لم أعد أتذكر شيئًا سواك، سوى جارتي وأبي وحلم غائم.
– احلم بمطاع، اجذبه بقوة من ماضيك، وإذا كان من الواجب أن تقتل أحدًا فاقتل مطيعًا، الشيء الذي يجب أن تعشقه وتحرص عليه أن ترى صورتك في المرآة، ترى مطاعًا في مطيع، عليك أن تتخلص من الأدران وتعطي لحياتك قبلة جديدة، ودعك من الحلم الغائم، الأحلام تقاوم التفسير الواضح. (ص ص116-117).
يحضر فيلليني كشبح متجسد بعد أن ظلَّ حاضرًا على امتداد الحكاية كظلٍّ يلوح في خلفية مشاهدها، إذ يتماهى صوت الحكاية الرئيسي وبطلها مطاع/ مطيع معه حدّ التوحد به، حتى أنّه كان يُشار عليه في مدينته بفيلليني: “الذي يلبس حذاء فيلليني أو مجنون فيلليني” (ص161). وهو ما يُمثِّل عملية خرق للزمن وكسر لحواجزه كحاجز الموت، إذ من المعروف أن فيلليني قد توفي في عام 1991، لذا تكون الطيفية أو الشبحية أو “المراودة هي عملية عابرة للأجيال، إنّها تأخذ شكل “السر” الذي ينتقل داخل عائلة ما، أو مجتمع ما، أو ذات ما، من دون أن يقر له قرار؛ وذلك لأنّه يرتبط، بـ”سر ما”، بـ”ذنب ما”، أو “خجل ما”، أو “كارثة ما”، أمر مكبوت ما، أو شيء نحاول الهروب منه وتحاشيه عند مستوى الوعي على نحو ما، أمر ما كان نتيجة مترتبة على “صدمة ما” لم يتم الشفاء منها أو من تأثيراتها. ولأنّ هذا السرّ يظل خفيًا، لم يتم البوح به، لم يتم التحرر أو الخلاص منه، فإنّه يظلُّ موجودًا داخل الذات الفردية أو الجماعية، يظلُّ يُشكِّل في داخلها ما يسميه إبراهام وتوروك، شبحًا ما، طيفًا ما، A Phantom، شكلاً أو تشكيلاً لا شعوريا، لم يُصبح قط شعوريا إلا من خلال أشكال رمزية”(11). غير أنّ حضور فيلليني- هنا- يبدو لدفع صاحبه المتوحد به للخروج مع عوالق ماضيه والتسامي عن فكرة الانتقام من جلاده.
وإذا كان الشيطان يرى في صاحبنا “مطيع”، الذات المنسوخة المستلبة بعد انكسارها واكتوائها بنيران القمع والانتهاك، فإنّ فيلليني- على العكس تمامًا- يراه “مطاع” أو بالأحرى يدعوه لاستعادة “مطاع” والحلم به والتخلُّص من “مطيع” ونفي شبحه بآثاره السلبية على الذات، أي يدعوه إلى استعادة الذات في أصلها قبل التعرُّض لمحنة المعتقل والتشوُّه النفسي.
وإذا جاز لنا أن نعتبر فيلليني بحضوره الطيفي هو تمظهر آخر للذات كقرين شبحي لها ليمثِّل صوت التسامي داخلها- فإنّه يُمثِّل- إزاء الشيطان- طيفًا مضادًا، وكأنّه يحقق نوعًا من “التعادلية” أو التوازن بين قوى النفس الانتقامية والمتسامية، قوى الشر والخير في داخل الذات. وهو ما يحفظ- بدوره- التوازن الدرامي للشخصية والسرد معًا.
وكأنّ حضور هذه الأصوات المختلفة من القُراء الافتراضيين وأشباح كالشيطان وفيلليني بمثابة تمثيلات لما أسميناه- سابقًا- “الذات- الضد” التي تُمثِّل ظلاً شبحيًا للذات في تردداتها وتذبذباتها، توتراتها وتقلباتها، تحولاتها وانقلاباتها.
الهوامش
1- وحيد الطويلة، حذاء فيلليني، (إيطاليا، ميلانو، منشورات المتوسط، الطبعة الأولى 2016)، ص ص9-10.
2- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، ترجمة: خيري دومة، (المركز القومي للترجمة، مصر، عدد 2781، الطبعة الأولى 2016)، ص210.
3- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، مرجع سابق، ص ص210- 211.
4- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، مرجع سابق، ص44.
5- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، مرجع سابق، ص ص54-55.
6- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، مرجع سابق، ص46.
7- صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، (مصر، الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان، 1996)، ص ص74-75
8- آيرين كاكانديز، المتحدثون (الأدب وانفجار الحديث)، مرجع سابق، ص228.
9- شاكر عبد الحميد، الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب، (الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 384، يناير)، ص79.
10- شاكر عبد الحميد، الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب، مرجع سابق، ص79.
11- شاكر عبد الحميد، الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب، مرجع سابق، ص80.