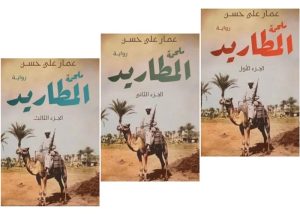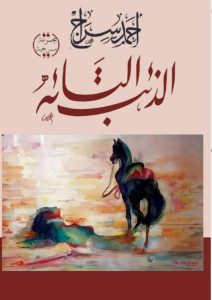طارق إمام
بداهةً، تتقدم الذاتُ الإنسانيةُ في الوجود سعياً وراء المعرفة، غير أن الذات، أو الذوات، في كتاب هدى عمران الشعري “كأنها مغفرة”، تناضل بكل قوتها، بحثاً عن الجهل.
ربما هو قلبٌ عنيف لمغزى الوجود الإنساني، غير أنه يحيل لحقيقةٍ أخرى: تولدُ الذواتُ شعرياً عارفة، وهي، إذ تتجرد من تلك القشرة، أو الصدفة، فإنما تقترب من جوهر غايتها: أن تستبدل بالموت الاختفاء، أو التبخر، أن يبتلعها العالمُ في ثقبٍ أسود في السديم، عوض أن يواريها مقبرةً تحت الأرض.
ثلاث دوائر متماسة، تُشكل أفق الكتاب الشعري الصادر مؤخراً عن دار صفصافة بالقاهرة؛ ثلاث دوائر/ حركات، يمكنُ بجهدٍ تجريدي، ردّها إلى ثلاث مرجعيات يستند إليها النص في الاشتباك مع الشعري والنفاذ إليه: الميثولوجي، الإيديولوجي، الذاتي.
ربما هذا الملمح الفارق هو أول ما يلفت في هذه التجربة، فثمة تململ من احتكار طريقةٍ بعينها تمسك بآلية إنتاج القصيدة، وبالمقابل، فعلى اختلاف الآفاق الثلاثة، ينسجم جسدُ الكتاب دلالياً، إذ يختبر مداليل بعينها، تسدر وتُلح على أفقه: الحرية، الحب، الفردانية.
تُصّدِّر هدى كتابها بجملةٍ نظريةٍ لعبد الفتاح كيليطو: إن الخلقَ الشعري، كخلق العالم، لا يقوم إلا على أساسٍ سديمي”. إنه موقفٌ يتجاوز الاجتزاء، فهو في مجمله موقفٌ نقدي. دأب الشعراء على تصدير كتبهم بمقاطع من نصوص تخييلية، لكن هنا، الفعل النقدي هو مفتاح الدخول إلى الفعل الشعري، في تذويبٍ أوَّلي لثنائية الشعري/ النقدي أو التخييلي/ النظري. عبارة كيليطو تحيل لهامش كبير حتى أنه يكاد يبتلع الصفحة، بقراءته، نكتشفُ أنه ليس توضيحاً لعبارة التصدير أو تعقيباً عليها من قِبل الشاعرة، بل “مانيفستو” شعري، أو هكذا رأيته، يستبق التجربة الشعرية بتدشينٍ معرفي لماهية الشعر، في هذه التجربة على الأقل. أما العنصر الثالث اللافت، ولا زلنا عند التصدير، فأن مرجعية المانيفستو ليست شاعراً حداثياً أو بعد حداثي، إنما “أبو نواس”، العباسي، المارق، الذي يلتقطه المانيفستو في درس الاستظهار المحو. من الألف قصيدة التي حفظها أبونواس ثم نسيها، تمسك هدى بالنسيان والمحو كشرطٍ للشعر. غير أنها تمسك بتعريفين آخرين لا يقلان أهمية: “الشعر هو رحلة الشك للوصول إلى يقين”، و” الشعر هو جرح الذات وجرح الآخر”.
القوانين الثلاثة ستختبر نفسها دون كلل في لحم القصائد، لنواجه تجربةً شعريةً تبدأ من النسيان لتشييد الذاكرة، تنطلق من الشك لترسيخ اليقين، وتجرح ذاتها والغير بالنصل نفسه، حتى تستحيل التفرقة بين دم الأنا ودماء الآخرين.
هويّات متحوّلة
مع النص الأول “سيرة عائلية”، تخوض الذاتُ الشاعرةُ مباشرةً في الميثولوجي. ثمة قصة تأسيس سلالة، (أقول “قصة” عن عمد)، ذاهبةٌ بكل قوتها لتخييلٍ وحشي، لا يخفت فيه العجائبي والخارق، ويتسيد الميتافيزيقي مركزه بلا وجل، بحيث نخوض في أرض الأسطورة الثقيلة، من خلال أهم ما تتيحه بوصفها مرويةً استعارية، ويعجز عنه النص الكنائي: التحوّل.
فكرة التحوّل هي في ظني ما يمنح الخيال قدرته على الإرعاب، ذلك أن أمان الواقع يتحقق بالأساس من استحالة تبدّل الهويات، فلا أمل في تحوِّل إنسان إلى حيوان، أو طائرٍ إلى شجرة. أمانُ الواقع هو الماهية الإنسانية غير القابلة لفقدان مظهرها الفيزيقي، حتى لو تجردت بالكامل من جوهرها الأخلاقي، أو استعارت من الموجودات صفاتها في منحى رمزي. الأسطورة تحل محل الواقع لتخلق وجوداً بديلاً يحتفظ من الواقع (والتاريخ) بعصب تصوراته الثقافية. في سبيل ذلك تقلب الأسطورة الطاولة على مبدأ المحاكاة: تُحوِّل المعنوي المجرد إلى متجسد محسوس، والاستعاري في المعنى إلى حرفي في الواقع (واقعها)، وهذا ما تقاربه الدائرة الشعرية الأولى بنصوصها الثلاثة: “سيرة عائلية”، “سِحر الحب”، و”ضربٌ مبرح”.
لعل أهم مفارقة في هذه الحركة الشعرية الأولى هي قدرتها، عبر الاتكاء على دال جمعي كالعائلة، على تشييد فردانية شرسة، فكل ذاتٍ تُميت المجموع، وللمفارقة، تطمح في أن تتحول هي إلى صانعةٍ لمجموع جديد. كأن السؤال الأساسي هو نبذ السلطة الموروثة لإنتاج سلطة جديدة.
الفرد هنا هو ذاته الجماعة، سواءً بوصفه بقايا السَلَف أو شرارة الخَلَف، وفي هذا نقضٌ عنيف لثنائيةٍ أخرى دأبت على التفرقة بين جناحين عملاقين من الشعرية العربية: موقع الفرد من الجماعة؛ كصوت لها، أو كصوت في مواجهتها.
ثمة ملحوظة لافتة للغاية بالنسبة لي في القصيدة الأولى، إذ تتأسس من أفق “الصحراء” وليس “المدينة”: “الناجي الوحيد من الوباء، آتياً من قلب الصحراء على حصانٍ أسود غطيس”. أفق البداوة وأداته هما حاضنة القسم الأول انطلاقاً من سطره الأول. أسطورة البداوة (القائمة على الجماعة) تفتت نفسها هنا بنجاةٍ فردية من وباءٍ اقتلع الجماعة، وتنتج شعرياً لغةً مراوحةً بين الإعتام والشف، كما تتناص مع مقاطع نابعة من أصوات أخرى كالحلاج. إنه “النسيان من أجل التدوين”. قصيدةُ النثر هنا لا تدير ظهرها لمسرح القصيدة العمودية الأثير ومعجمه، بل تشتبك معه مباشرةً، بل ومع أغراضه المرعية من رثاء، لغزَل، لوقوف على الأطلال. بدورها، تُراوح اللغةُ الشعرية بين نسقين مندمجين، من إيهامٍ بلغة أكثر عراقة، على مستوى الدوال ونمط تشكيلها، إلى لغة التداول المتخففة بلاغياً والإحالية في رد الشعري إلى مرجعيةٍ مألوفة.
المقاطع تتنوع بين رجلٍ وامرأة، والأفق الدائم تغيير العالم، (هو نفسه أفق شعرية ما قبل الحداثة). وحيث ينهض تأسيس صورة الرجل والمرأة التي ستنسحب على الكتاب كله: فالرجل يؤمن بالتوحد مع المحبوب “باستئناسه وهضمه وبلعه ووضعه على مائدة قرباناً للحب”، فيما المرأة “تؤمن بفردانية المحبوب”. من أجل ذلك، يرتبط دال “القربان” بالرجل، فالذات الجامعة، التي تذيب ذواتاً في داخلها (وتهضمها) كي تجدد هويتها، هي بحاجة دائمة لتقديم ثمن، قوامه الدم: “في ليلة من الليالي لم يَقدر على إعادة تشكيل جسده مرةً أخرى، سال وتحوّل إلى نهرٍ من الجنون”.
بجرأةٍ شديدة، تشيد الذاتُ الشاعرة نصوص هذه الحركة الأولى كسرديات، فلن يغيب الحكي، ولن ينهض سطرٌ شعري واحد بمعزل عن المروية التي تبدو كأرضٍ راسخة يرفرف فوقها الشعرُ كراية في مهب الريح. حتى الشكل الطباعي لهذا القسم الأول، يهيمن عليه الاتصال السردي للسطور، ليُحكم الإيهام. وإذا ما أضفنا غياب ضمير المتكلم، إلا من المقطع الأخير، فسنتوهم في أحوالٍ كثيرة أننا لسنا بصدد ذاتٍ شاعرة، بل سارد عليم.
غير أن هذا الاختبار الشجاع، والراديكالي، للشعر كابنٍ للمرويات، لا يخذل المتلقي في الوصول، كل مرة، إلى القصيدة المنشودة. إنها “الهوية” مجدداً وهي تختبر صلابتها في هوياتٍ أخرى، لتُصعّب من اختبار الشعري.
بناياتٌ كأعشابٍ راكدة
مع الحركة الثانية، يطل الإيديولوجي برأسه. كيف لا، وعنوان القسم الثاني “كانت الثورةُ عمري”؟
الضمير الاول الذي أنهى الحركة الأولى، كضيفٍ خجول، يمسك بالذات المتكلمة لتهيمن على مقدرات الحركة الثانية، بعد أن أسَّس لوجهة نظر شكلانيةٍ/ دلالية معاً في اعتماد علامة الترقيم (/) فاصلاً بين العبارات، بوصفها “علامة اندماج للمعنى”، لكن الأهم أن هذه العلامة تفعل ذلك “في لحظةٍ زمنية واحدة”. إنه سؤال الزمن في كيفية تحققه شعرياً كزمن سائل تنتفي فيه الحوائط الثلاث: ماضٍ، حاضر، مستقبل، لنصير أمام نصٍ متحقق بالكامل ليس فقط في لحظة إنتاجه، بل في زمن تلقيه، وهو ما سيجعل هذه العلامة مهيمنة في قصائد القسم الثاني. حتى على مستوى النص الواحد، ستشهد القصيدة اختلاطات زمنية واضحة، يجسدها موقف الذات الشاعرة من الأمومة، دون ترتيب، بين نظرتها لطفلها، ثم تأمله في رحمها، فلا نعود قادرين على الإمساك بتراتبية أطوار الأمومة داخل النص الواحد، ويمكن لهذا القانون أن ينسحب على مجمل التجربة.
تذهب الدائرة الشعرية الثانية إلى المدينة، وإلى الذات المنبتة عن العائلة، فكأنها تفكك بنفسها الدائرة الأسبق، أو تمنحها “التحوّل” الميتافيزيقي إلى هوية مختلفة. ثمة أيضاً اقتراب أكبر من حساسية قصيدة النثر التداولية، وأفقها في الانفتاح على الواقع بتخييلٍ ذاتي، لكن قصيدة هدى تغرد خارج سرب قصيدة التسعينيات من خلال اشتباكها الصريح مع الاجتماعي والسياسي عبر مقاربة اللحظة الثورية. المدهش، أن القسم الثاني بدوره يستند إلى تجارب “قبل حداثية” على مستوى الاستدعاءات الشعرية، بتناصات مع شاعر الأطلال إبراهيم ناجي، وبعناوين تحيل إلى أغراض القصيدة العمودية: “بكاء على الأطلال”، “رثاء”.
هنا، تؤسس الذات نفسها كحضور، بالضمير الأول. كذلك ينسحب الميثولوجي لصالح مرجعية الواقع، انطلاقاً من القصيدة الأولى، التي لا يحتاج عنوانها إلى شرح: “2011”، ومن بعدها الثانية “2 فبراير 2012”. تغادر الذاتُ الشاعرة الطريقة التي أنتجت بها نصوص القس السابق، يتبدل الضمير المهيمن، والشكل الطباعي، لكنها لا تغادر السؤال المركزي: موقع الفرد من العالم.
غابةٌ من الخطايا
الجسد: إنه المكان الذي تتحرك فيه قصائد الدائرة الثالثة “المشي وحيداً”، ولنلحظ أن الشاعرة لم تقل “وحيدة”، رغم هيمنة الذات الأنثوية على أغلب القصائد. ثمة ذلك التوق إلى تخليص الجسد من لافتته المسبقة، الوصول إلى كائن لا هو أنثى ولا هو ذكر، يراوح بين تعريفاته لنفسه، وصولاً إلى اقتراح مقبول لكلمة “إنسان”.
الجسد هنا في حالة مشي، أي أنه متحرك، إجبارياً للأمام، حاضرٌ يتحول بلا هوادة إلى مستقبل. لكن الجسد، فيما يمشي، لا تكف الذاتُ التي تقطنه عن التذكر، في آليةٍ ذاهبة، بالعكس بالضبط، إلى الخلف. نحن إذن أمام حركتين متناقضتين، تمتزج فيهما الأزمنة كلها، مثلما يمتزج الحسي بالمجرد.
الأحلام، النوم، المخدرات، الحمى، الخدر: دوالٌ متكررة، تحيل جميعها لوعيٍ يطفو فوق الواقع، مستمداً مادته من وقائعه، لكن بتشكيلٍ جديد يذهب إلى واقعٍ موازٍ هذه المرة وليس أسطورةٍ مُفارقة كالحركة الأولى. ما يبقى في الحالتين هو المسافة المحسوبة لقراءة الواقع دون التورط في نقله كنائياً، فطموح هذا المشروع الشعري في تقديري هو تحويل المعيش إلى استعارة كاملة.
على جانب آخر، تنهض معانٍ مجردة، تحاول الذات الشاعرة تعريفها كما لو أنها تؤسس لمعجمٍ شعري: الحب، العنف، الانحطاط، الشقاء، الشر، وغيرها من دوال، فبقدر ما تدمجها الذاتُ الشاعرة في القوام الشعري، بقدر ما تعزلها لتعيد تعريفها: “يومان كاملان بهوس البحث عن كلمة الانحطاط، بالاحتفاء بها، بالوقوف إلى جانبها، بمؤازرتها ضد كل المديوكر الكليشيه الاعتياديين، وفجأة رأيتها جليةً أمامي، متجسدة، ساطعةً حتى العمى..”/ “الشقاء هو: لو أن عقل الإنسان ملايين الغابات، ففي عقلي وضع الرب متاهةً ليعذبني”/ “الجهل جمل يتخيل نفسه حصاناً، يمشي متباهياً بين الناس بذيل ليس له”.
سنلحظ أن اللغة بدورها تنحو في هذا الجانب لجفافٍ نظري، كأنها تنبذ الوقوع في أي فخٍ للعاطفية، رغم أن الفخ مفتوحٌ في كل لحظة. تفعل اللغة ذلك فضلاً عن مواصلة الالتحام بمعجم شعري سالف، على غرار: “قلت نادني”، “بحثتُ في وحدتي عن نديمٍ فوجدتني، وشربتُ الكأس بعد الكأس”. تذهب اللغة إلى غابة من الإحالات، باتت شفرات ثقافية أكثر منها مفردات متاحة لإعادة التعبئة، بغية إعادة تدويرها في نسق لغةٍ هجينية بين تراثي /عصري، بلاغي / متقشف، عاطفي غنائي/ محايد موضوعي، استبطاني داخلي/ مشهدي خارجي. هذا القوام الثقيل، الذي يستحيل فصل مكوناته في شكله النهائي، هو قوام اللغة الشعرية لهدى عمران، والذي يمنحها، في تقديري، فرادةً متوهجة.
ينتهي المشيُ بتذكر العالم، باستحضاره، لكن هذا ليس كل شيء. العالمُ، في السطر الأخير، يبتلع الذات، فيُخفي أثرها. ثمة فارقٌ هائل بين أن تكون ميتاً ومفقوداً، فارقٌ تترجمه إمكانية العثور على جسد، أو تحول جسد إلى جثمان، أو جثمان إلى حفنة من العظام، وبين انتفاء هذه الإمكانية.
الوجود في الشعر يبتلعنا، أهو توق أم رعبٌ أسود؟ الوجود لا يوارينا ثراه، حين تكون اليابسة هي القصيدة، الوجود، في النهاية، يُخفينا في لا نهائيته؛ كأنه العقاب، أو كأنها المغفرة.