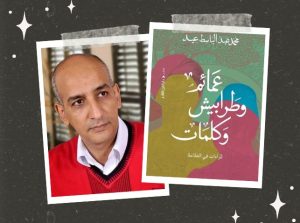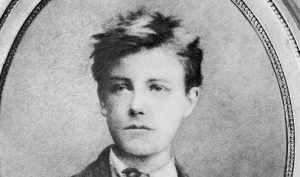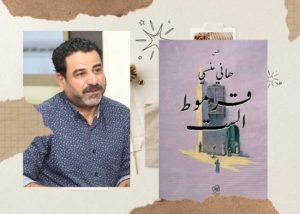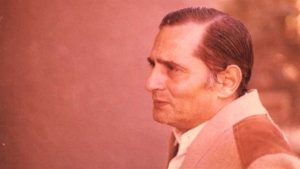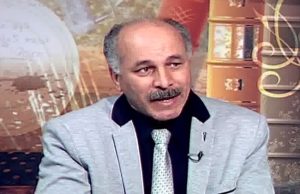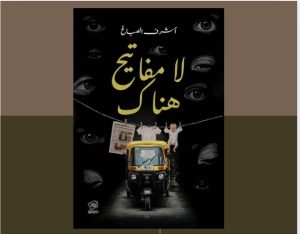د.محمد زيدان
ظواهر فنية جديدة:
أصبح الشعر الجديد في مصر والوطن العربي بعيدًا كل البعد عن المسارات الكبرى التي حدثت إبان الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وبدأ يرسخ لظواهر فنية ولغوية وفلسفية على أيدي شعراء من جيل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من نفس القرن، وهذه الظواهر في رأيي أنها بدت كأساس من الأسس التعويضية لفقدان القواعد العروضية لهذا الشعر، وبدأ كل شاعر يختط لنفسه ما شاء من هذه الظواهر معتمدًا على خطين هامين من قواعد الإبداع في الفنون؛ وهما: الدراما والسرد، لأنه؛ وبلا شك، يمثل هذان الخطان روح النصوص الجديدة من إبداع الشعر الجديد، وداخل هذين الخطين، بدت ملامح الظواهر في بلورة اتجاه كل شاعر، وسمير درويش من الشعراء الذين أصَّلوا لأنفسهم إبداعيًّا في الشعر بأعمال مثلت روح العصر بصفة عامة، وروح المرحلة الشعرية بصفة خاصة، ومن ثم جاءت نصوصه الجديدة ممثلة في ديوان “كأعمدة الصواري” لتعبر عن أهم الظواهر الفنية التي سادت إبداع الجيل الجديد من كتاب “قصيدة النثر”.
فلم يعد الشعر كما كان في عهوده الأولى يبحث عن جوهر الأشياء، ويتعمق هذا الجوهر، وإنما أصبح يبحث عن الظاهر المادي للأشياء، ومن ثم؛ فإنه يتعمق هذا الظاهر من حيث هو أساس مادي، ومن حيث هو دلالة على كيان آخر مادي أيضًا، لا لأن هذا الظاهر يكتسب أهمية ما تفوق الجوهر، ولكن لأن هذا الظاهر في عصر العولمة الراهن تسوده الفوضى، وإرادة الشاعر أكثر بصيرة في محاولة تكوين منظومة إنسانية تعتمد على هذا الظاهر في إعادة صياغة الشكل العام لحركة الحياة، وكأي حركة تنبع من النفس يبدأ الشاعر رحلة بحثه من الذات، ومما يحيط بها من ملموسات وفضاءات وحواس.
ويمكن الولوج إلى عالم الشاعر من خلال عدة افتراضات نراها أكثر كثافة في النصوص، وبتضامها يمكن -أيضًا- أن تعطي صورة لهذه المنظومة الظاهراتية المبثوثة في الديوان.
وصف الثوابت:
الشاعر “سمير درويش” يعطي في نصوصه صورًا شعرية كلية تميل إلى وصف الثوابت في المادة السردية التي تكوِّن الأداة الأساسية في الميل نحو الظاهرة السردية في الشعر الحديث، وهذه الصورة الشعرية باعتمادها على الوصف تطرح حركة درامية غير مكتملة عن قصد من الشاعر، لأن الحركة الدرامية الكاملة تغلق أمام النصوص آفاقا كبيرة من توليد الدلالة العامة والخاصة في النصوص. فنراه يركز على وصف ثوابت الجسد، ولكنها ثوابت تطرح من خلال الإضافات المعنوية التي تكتسبها من السياق السردي جوهر الذات، أو جوهر الجسد من خلال الظاهر المادي، وكأن الشاعر ينتقل بعين الكاميرا من خلال صوره الشعرية المتعددة الدلالات، حتى إنه يصرح بزاوية النظر هذه من خلال التعبير الشعري.
هذا سهيلُ
ينظرُ بريبَةٍ لعينِ الكاميرَا.
يبكي بحُرْقَةٍ.
يرشفُ ماءَ الحياةِ بنهَمٍ.
ينامُ مُتَوَحِّدًا بالغيبِ.
فجربى أن تسأليني عن سهيلَ
البعيدِ..
البعيدِ،
الذي يتربعُ
-وحيدًا-
على عرشِ قلبي(1).
وهذه الصور تمثل للشاعر مدركات حسية سابقة في الذهن، وكل خبرة حسية يتداخل في ائتلافها خبرات فكرية ونفسية وخيالية، فكل خبرة من هذه متى قامت في المستوى الحسيِّ، فهي تكون قابلة لأن تولِّد صورة كلية للخبرة التي تمثلها، وبالتالي: فهي دال لها(2)، والشاعر في النص يزاوج بين الخبرة الحسية التي يمثلها الرمز، وبين الخبرة الفكرية والشعورية الممثلة في قوله: ماء الحياةِ، ينامُ مُتَوَحِّدًا بالغيبِ، وكأنه يقدم صورة جديدة للرمز تمثل خبرة قابلة للانتقال.
وَالشاعر في هذا النص الطويل الذي يكرث معظمه لوصف لقاء بين محبوبين يطرح من خلاله وجهة نظره التي تجره للتعبير عن قضايا الإنسان، إذ يكرر لازمة سردية تتمثل في “سهيل” الغائب، فيميل الافتراض إلى أن “سهيل” هذا هو “ذات الشاعر” وإنما اللقاء المادي في النص لقاء غيبي، والبحث عن “سهيل” يمثل بحثًا عن ذاته، ولجوءه إلى وصف الظاهر المادي الثابت يُعْطي بدلالاته قشرة خارجية، وينفذ إلى الجوهر من خلال الصفات المادية لسهيل، وكأنه يريد أن يدمج الذوات في بعضها: “يرشفُ ماءَ الحياةِ بنهَمٍ- ينامُ مُتَوَحِّدًا بالغيبِ”، فالنص تجسيد لتضام الظاهر والباطن في النص، الظاهر المتمثل في اللقاء، والباطن المتمثل في البحث عن الذات. لكن الشاعر لا يظل على هذا الحال في الوصف، فبعد أن ملأ النص بوصف الثابت من خلال إضافاته، بدأ يصف الثابت ويظل مكتفيًا بهذا الوصف، وذلك لأنه يعطي فرصة لحركة السرد أن تعبر عن نفسها بنفسها.
ففي نص بعنوان “1987” يشير إلى:
حذاء رياضي
ساقان نحيلتان
فجسم ضامر
شعر مائل للصفرة
تيارات تتأهب
الجورب الأبيض القصير
النهدين البارزين(3).
ويعقب ذلك بوصف الوجه الذي يُغطُيه الزّغب، المغسول بماء العذريّة، الذي يبدو جامدًا، كرسي في الكافيتريا، الفتى الأسمر، الذراع النحيلة، كم سترة متسخ، الحارة القصيرة.
فالذي يميل بشعريّة “سمير درويش” ليطرح هذا الكم من وصف الظاهر، يعود إلى الطرح السابق حول العصر المنطلق نحو فوضى الظاهر، بل أقول إن الظاهر -والشاعر هنا ابن عصره- السلاح الوحيد الذي يملكه الفقراء للتعبير عن الكينونات الجبارة الخارقة التي تحرك الكون المادي الآن، لذلك فإن الشاعر ينطلق من التعبير عن هذا الظاهر وكأنه كل شيء، ثم يدخل إلى وصف ظاهر يتلقي بجوهر ما سواء كان جوهرًا ذاتيًّا خاصًّا، أو كان جوهرًا إنسانيًّا عامًا، ومن ثم يركز من خلال اللغة على إشاراته المتصلة برصد الظاهر:
ذلك فرح طفولي لا يرصده إلاها:
عين واحدة لآلة التصوير.
..
آلة التصوير تصدر صوتًا خاصًّا
..
هناك خلف نافذة بعيدة
لا يرصده إلاها
حينما تنظر بعين قلقة في
عين الباب(4).
فكلمات مثل “يرصده- عين- آلة التصوير- نافذة- تنظر- بعين- عين الباب” تغطي بدلالاتها على حركة الدراما في النص من خلال حركة الذات لمزيد من الترقب، والنظر، والبحث الدائب عن شيء ما، يمكن رصده، لأن عملية الرصد لا تتم إلا في الظاهر، بل إن الشاعر في كل نصوصه يحاول أن يرصد شيئًا ما، بدأها بملامح في المحبوبة، ثم حاول رصد ذاته، بل حاول البحث عنها، ثم حاول رصد الرموز من خلال التركيز عليها، والتفاصيل الصغيرة طريقة من طرق هذا الرصد.
والشاعر يلجأ في عناوين نصوصه إلى طريقة تشبه إلى حد كبير، تقرير الظاهر، وكأنه ينطلق من العنوان في دلالته كبداية لحركة البحث، فنراه يضع “التذوق، النظر، السمع، اللمس، الشم” ثم ينتقل بين النصوص بلا فواصل، وكأنه في نص واحد “وهو كذلك بالفعل” وبداية من عنوان الديوان “كأعمدة الصواري” الذي يمثل تشبيها يفتقد ركنه الأول الأساس في إعطاء المعنى، ودلالة ذلك مبثوثة في النصوص، إذ إن البحث والنظر مطروح في العنوان الذي يمثل بدوره صورة شعرية بصرية.
فأي شيء “كأعمدة الصواري”؟
فإتاحة الشاعر للمسكوت عنه في النص تميل به إلى الخطِّ الفَلْسَفيِّ في التعبير، من خلال ما يطرحه الظاهر المادي، في مقابل ما يتضمنه المضمر، سواء كان هذا المضمر معنًى، أو كان تصورًا.
الرمز الظاهر:
إن خبرة الشاعر الجمالية جعلته يدرك أن العلاقات الداخلية في النص ضرورة من ضروريات وجوده كأساس مادي لغوي، وضرورة من ضرورات صيرورته كأساس معنوي يطرح رؤيةً وفكرًا يميزانه عن النصوص السائدة، ولذلك لجأ الشاعر “سمير درويش” إلى الاحتفاء بتقنية الرمز المادي الظاهر، وجاء هذا الاحتفاء معبرًا عن روح المعنى، ومفردات الدلالة من جهة، ومعبرًا عن أسلوبه في عدد من التقنيات:
أولًا: الشاعر اختار عددًا من الرموز المسماة، وإن كانت تسمية الرمز تفقده بعض إيحاءاته، إلا أن استخدام الشاعر له في صورة درامية أكسبت النصوص موسيقاها الخاصة، والتي تنبع من وجود الاسم، والفضاء الذي يلمه الشاعر حول الاسم، والمفردات التي يضمها هذا الفضاء.
ولنأخذ الرمز “سهيل” لنجد أن استخدامه غطى مساحة كبيرة في النصوص لسببين:
1- الغموض الذي يلف الرمز ولو بشكل نسبي من خلال دمج الذوات.
2- الطاقة المعنوية التي يطرحها.
وكذلك لا يكتفي الشاعر بكونه رمزًا، ولكنه استقطب له دلالات سردية تتصل بالإحساس البصري، والسمعي، والإدراكي، فيجعل من هذه المساحات محطات تكثيف درامي ذات مغزى.
الغرفةُ ذاتُ الشُّبَّاكِ المُغْلَقِ
ساحةُ صراعٍ
لذلكَ امْتَلأَ الجوُّ
برائحةِ الخصامِ
وارتفعَ الشَّريطُ الطُّوليُّ الأوسطُ
من المَرْتبةِ، وعليهِ
استسلَمَ جسدُ سهيلَ
للنُّعَاسْ(5).
فالتعبير المباشر عن حالة الاستسلام من خلال الرمز جزء من الدلالة العامة للرمز في ظاهره المادي “الجسد” كدال على حالة الخوف التي تلازم الرمز، ويلازم الرمز النص، ثم يلتفت الشاعر إلى ذاته، ثم يعطيه بعدًا آخر عندما يضيف له وجهًا آخر لحالة الاستسلام من خلال وصف ظاهري يتمثل في البكاء:
عندما يبكي سهيل
تعبث يداي في قواريره
..
وعندما يضحك
أتقافز حوله كبهلوان بين
حاجياته المتناثرة
وعندما يستحم تتبلل أحذيتي
ووصف الظاهر المتناقض له مدلوله النفسي في النص، بما يشيع عن حالة عدم الاتزان للرمز حكاية عنه، ثم وصف حالة الاندماج بين الذات “السارد” في قوله: يستحم تتبلل أحذيتي.
ويعمد الشاعر إلى وصف حالة الرمز الظاهرة ليكسب أبعاد النص الحركية حرية في فضاءات الحركة حول الرمز، فالاستسلام بالنعاس جره إلى الاستسلام بالبكاء والضحك، ثم يكثف الشاعر في أزمة الرمز ليجعل الاستسلام بالبكاء لقهر الرمز:
يبكي سهيلُ ليأكلَ
يبكي ليشربَ
لينامَ
ليلعبَ
..
أضمُّ سهيلَ بينَ ساعديَّ
أُقَبِّلُ شفتيْهِ
وجنتيْهِ
وكفيْهِ المُنَمْنَمَتينِ،
فيضحكُ ضحكةً رَائقةً، يهتزُّ لها
جسدُهُ الصغيرُ
ويعلَكُ خنصرِي بينَ فكَّيْهِ.
سهيلُ..
الذي قاطَعَ نورسَيْهَا
أيضًا(6).
وهنا يعطي الشاعر للرمز مزيدًا من البوح ليجعل من “سهيل” صغيرًا بالوصف الظاهري الذي اتبعه، فأكسبه بذلك بساطة في مقابل الغموض الذي اكتنفه في نصوص أخرى، وربما -وهو الأرجح في رأيي- أن الشاعر حوَّر كثيرًا في استخدام الرمز الظاهر، وأضاف له صفات معنويّة وجسدية تجعل منه بعدًا هامًّا من أبعاد الإدراك الكلي للنص.
وأحيانًا يجعل من النص حالة تقابل حالة الاستسلام السابقة، حين يجعله مستيقظًا، وبوعي، وبنظر وإدراك، ولكن في إطار نفس حالة الاستسلام:
مثلِي..
ينظرُ سهيلُ للكاميرا بوعْيٍ
يفتحُ عينيْهِ على اتساعِهِما
ويرفعُ حاجبيْهِ.
ومثلُهَا يبكي..
وإذا ابتعد الشاعر عن موتيفة الرمز “سهيل” نجده أيضًا يحتفي بالرموز الجزئية الظاهرة احتفاء الكاميرا باللقطات التي تتبعها، وكأن البحث عن هذه الجزيئات الظاهرة يمثل همًّا أساسيًّا في النص، يصلح لاعتبار ذلك ظاهرة ملفتة للنظر في الديوان، ويمكن بإحصاء هذه الأوصاف الظاهرة، والبحث عن دلالاتها، ومقارنتها بإحصاء الأوصاف المعنوية التي تتصل بالمدركات غير الظاهرية، أن نخرج بنتائج هامة في كشف هذه الظاهرة الجلية في الشعر الحديث، فأصبح الظاهر الآن معادلًا آخر من معادلات الوجود الإنساني في حد ذاته:
الحقائبُ المصنوعةُ من
قماشٍ رخيصٍ، تتدلى من أكفِّ
العيالِ، أو ترزحُ على أكتافهم.
بينما وحده..
وحده تمامًا،
يكبحُ محاولاتٍ مستميتةً
لانفراطِ كراريسِهِ العاريةِ على
صمتِ الترابْ.
..
بجلبابِهِ الذي لا يستخدمُهُ للنومِ..
يقفُ في منتصفِ الطابورِ الصباحيِّ
يتلُو أشعارًا حماسيَّةً،
وفي قاعاتِ الدرسِ
يختلسُ النظرَ لوجهِهَا الأبيضِ
أو يراقبُهَا وهي تتنقَّلُ بخفةٍ بين زميلاتِهَا(6).
والرموز التي يسوقها الشاعر ليجعل من السياق حدثًا سرديًّا واحدًا يعتمد فيه على استخدام لغة المنولوج والذي يراوحه بين الداخل “المنولوج الداخلي” والخارج “المنولوج الخارجي” مستخدمًا نفس التقنية السابقة في وضع الظاهر المادي موضع الأساس في النص الشعري، فهو في النص السابق يحتفي بوصف الظاهر الموضوعي من ذاكرة المنولوج الخارجي “الحقائب- أكف العيال- أكتافهم- كراريسه العارية” وهي مفردات تدل على موقف من الذاكرة يعمله الشاعر بلغة “الهو” قاصدًا به في الأغلب “الأنا”، فهو “الشاعر” يسخِّر ذاكرته ويوزع عليها أحداثًا سرديةً صغيرة، وهذا بدوره يجعل من النصوص في الديوان نصًّا واحدًا، وكأنه يصنع ما يسميه “يوري لوتمان” بالكل المركب، وهو يتحدث عن النظرية البنائية في الشعر(8). ويواصل الشاعر “سمير درويش” تعبيره عن مكونات الظاهرة المادية حينما يستخدم نفس الأسلوب الوصفي في رسم صورة كلية أخرى لموقف من الذاكرة الكلية للنص “الجلباب- الطابور الصباحي- الأشعار الحماسية- زميلاتها”، وهكذا يزاوج الشاعر بين الموتيفات السردية التي تمثل مكونًا سرديًّا واحدًا مثل حديثه عن “سهيل”، وبين الرموز الجزئية التي تمثل صورًا شعرية كلية تعبر عن موقف سردي خالص، يعطي للنّص أبعادًا إيقاعية تضاهي الإيقاعات الوزنية، ولأن إيقاع الصورة الشعرية، وإيقاع الصور السردية ومكوناتها لها من المعطيات الشعرية ما يؤهل النص الذي يتداخل معها لإيقاع مؤثر.
أما التساؤل الذي طرحته الدراسة عن الشكل البنائي للعنوان “كأعمدة الصواري”، فإن الإجابة عليه تسهم بقدر كبير في فك رموز عديدة في الديوان، فالسبَّابة التي ترتفع إجلالًا لمشهد الموت هي التي يصفها الشاعر بأنها “كأعمدة الصواري”، وهذا الاختيار ينحاز بالديوان في مجمل الصورة التي يواجه بها الشاعر الحياة، باعتبار أن حالة الموت سارية في خلفية النصوص، سواء كان موتًا مشهودًا كما يشير إليه الشاعر مباشرة في قوله:
كان الجسدُ ملفوفًا بقماشٍ أبيضَ، الرجالُ انقسمُوا، بعضُهُم نزَلَ من الفتحةِ الضيِّقَةِ إلى العتْمَةِ، وبعضُهُم أخرجَهُ من المستطيلِ الخشبيِّ، أناسٌ بجلابيبَ باهظةِ الثمنِ يقبِّلُونَ القماشَ، وآخرونَ يُتَمْتِمُونَ بأدْعِيَةٍ ويرفعُونَ سباباتِهِمْ (كأعمدةِ الصوارِي)(9)
فالشاعر يغلف الديوان بغلالة رقيقة يصنعها العنوان، والحاسة الشعورية التي يبثها، وسواء كان المقصود الموت الحال في الأحياء، أو كان في الرموز التي يسوقها من الذاكرة، أو في الرموز المادية التي يصفها من الواقع، والشاعر بهذا يضيف إلى إيقاع الحياة في النَّص إيقاع الموت المختفي وراء الظاهر المادي الحيِّ، وهذه إحدى المسافات الفلسفية المضمنة في النصوص. وتحقق للشاعر مزج رؤيته المتوازية مع المركب الحسِّي، بل أصبح ذلك المركب الحسِّي جزءًا من رؤية الشاعر، وأصبح التعامل مع جوهر النص من خلال ظاهره(10).
الهوامش:
1- سمير درويش: كأعمدة الصواري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط1، سنة 2002، ص 24.
2- نعيم علوية: نحو الصوت ونحو المعنى، المركز الثقافي العربي، ط1، سنة 1992، ص55.
3- الديوان، ص27.
4- الديوان، ص38.
5- الديوان، ص45.
6- الديوان، ص47 – 51.
7- الديوان، ص94 – 98.
8- يوري لوتمان: تحليل النص الشعري -بنية القصيدة- ترجمة: د.محمد فتوح أحمد، دار المعارف، ط1، سنة 1995، ص43.
9- الديوان، ص79.
10ـ نقلت هذه الفكرة من حديث الدكتور مدحت الجيار عن توازي علاقات الشاعر مع جوهر التراث في كتابه: الشاعر والتراث في طبعته الأولى، دار النديم بالقاهرة، سنة 1995، ص227.