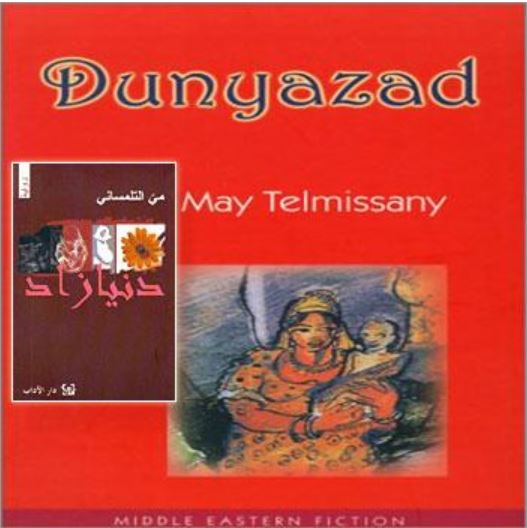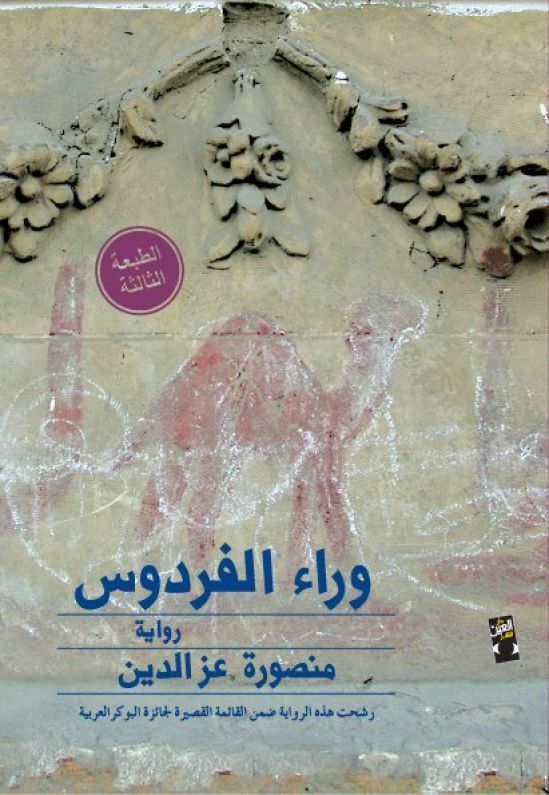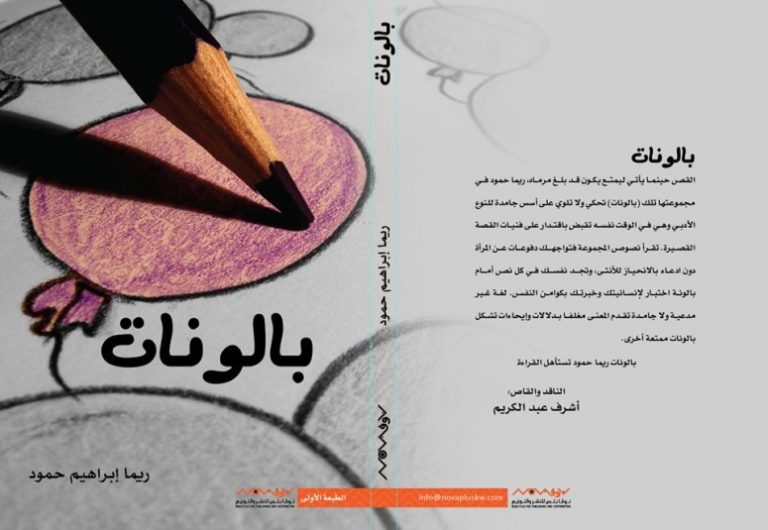حسن غريب أحمد
الأديبة الشابة (مي التلمساني) التي قدمت لنا هذه الرواية الجديدة (دنيا زاد) وبالطبع هي ليست العمل الأول لها ولكنها قدمت لنا من قبل “نحت متكرر”. وإذا أردنا أن نقترب من عالم (مي التلمساني) .. نستطيع القول أن (مي) إلى جانب أن لها هذه التجارب الروائية .. تشتغل بالدراسة والنقد وذات قلم في الكتابة أعتقد إنها من الأقلام الشابة الواعدة لآن. (مي) تنتمي لأسرة ذات علاقة وشيجة بالفن وهي أسرة التلمساني وخاصة بفن السينما وهو قريب جداً من فن الرواية والإبداع و “دنيا زاد” هي رواية كما يتضح من العنوان تحاول أن تقطف الأسطورة القديمة والشهيرة في (ألف ليلة وليلة) من أول تسمية العمل ذاتها .. فتلعب بالاسم هذه اللعبة المزدوجة للمخلوق الروائي الذي سنكتشف فيما بعد عندما نمضي في قراءة العمل أنه مخلوق مهدد بالفناء لا يبيقيه على قيد الحياة سوى الكتابة وسوى تسجيل مولده المجهض.
تتميز رواية “دنيا زاد” بأنها رواية حداثية وإن كانت بسيطة وعفوية في الوقت ذاته .. وأبرز مظاهر هذه الحداثة … أن الأصوات فيها متعددة والانتقالات فيها كثيرة فالراوي يمكن بأن يكون ضمير الراوي الكاتب نفسه لكنه لا يستأثر ولا يحتكر عملية السرد بل تدخل الشخصيات أيضا هذا المجال لتتحدث سنجد مثلا أنه في بداية الرواية تعطي صوت الرواية لزوجها الذي لا تسميه وإن كانت تصفه فيحكي نفس الأحداث التي سبق للراوية أن حكتها لكن من منظوره الخاص وبوجهة نظر أخرى ..
وهذا هو مظهر من مظاهر الفن – اللعب – الحداثة – الجميل في السرد .. لا تكون مجرد حكاية عادية – وأيضا نستمع إلى صوت آخر هو صوت إحدى صديقات الراوية واسمها “نورا” ونعرف أن هذه الأسماء ليست من محض التخيل لكنها قريبة أيضا في الحياة الواقعية .. وتسرد على لسانها حلماً سوداوياً شفيفاً … ونلاحظ أن الراوية في معظم أجزاء الرواية قد تحرص على تقديم هذه الأصوات المتعددة والأصوات تتراوح بانتظام مع ضمير الأنثى .. ضمير المتحدثة لكي تخفف عن روحها صقل التجربة التي تبهظ مشاعرها وترهف وجدانها .
وعندما نقترب من موضوع الراوية فهى تقدم فيها تجربة ولادة شاقة ومهيضة لوليدة توفيت على حسب عبارة الرواية – نتيجة انفصال تام في المشيمة كما جاء في تقرير الطبيب … لكنها لا تعرف ذلك للتو – أقصد الراوية (انتظروا عليها يومين حتى تقوى على تحمل النبأ كانت تعتزم تسميتها (دنيا زاد) على طريقة الأمهات المثقفات في اختياراتهن المسببة بالبواعث الأدبية) وتنحفر هذه التجربة بعمق في ذاكرة المتلقي لصعوبة تكوينها لأن المتلقي يبذل جهداً حقيقياً لمتابعة الانتقالات الحادة لأصوات الرواية وبمساعدة نمط توزيع السطور على الصفحات .. وهي في البداية تلعب لعبة الكتابة ، طريقة كتابة السطور على الصفحات تساعد في هذا … لكن النمط الكلي المعتاد تشغيله الرواية الملتبسة بالصوت الأول وفجأة نجد أن هذا الصوت ينقطع وتتشكل السطور بهامش أبيض عريض إيذاناً بدخول صوت آخر .
أقسام الرواية
وقد قسمت الأديبة الرواية إلى عدة فصول .. يستقر الفصل الأول على التراوح بين الزوجين حيث لا تكتفي الرواية بتقديم عالم الأنثى بكامل تفاصيله ولون حساسيته – كما أشرنا – بل تضع قناع الرجل أيضا لتختبر طريقة تلقية للأحداث ونوعية ممارسته فيها .. وحينئذ تبرز لنا المفارقات الطريفة بين حساسية الرجل من ناحية وحساسية المرأة من ناحية أخرى كيف يخفي عنها – مثلا – طرفاً من الحقيقة حفاظاً عليها … في هذه اللحظة ندرك أننا أمام مشروع كاتبه له أبعاد نصية متعددة فهي كاتبة امرأة لا تكتفي باسترداد حقها في وصف عالمها الأنثوي الحميم وتحديد طبيعة حساسيتها الجمالية بالكون مما يتطلب تسمية الأشياء بلغتها الخاصة بل تطمح إلى أبعد من ذلك .. تمد وعيها ليستوعب الرجل أيضاً بمعنى أنها تحاول أن تتمثل عالم الرجل – تعيره كلماتها .
أدب (مي التلمساني) النسائي
ربما هذه الملحوظة تنقلنا إلى أن حكاية حساسية المرأة الأدبية حالياً من أن يسمى إبداعها بأدب نسائي أو أدب أنثوى .. أصبحت هناك حساسية .. لكن مثل هذه الرواية التي تعبر عن أدق أحاسيس المرآة والتي لا يستطيع أن يصفها أى إنسان آخر أو أى رجل.. أحاسيس امرأة حملت ثم أجهضت .. هذا إحساس له خصوصية شديدة جداً وهذا ما يدفعني أن أتساءل لماذا لا نعترف بأن هناك أدب نسائي أو أنثوي ؟؟
فهي تريد بطبيعة الحال أن تقدم هذه التجربة البالغة الخصوصية والحميمية من منظور المرأة مما لا يستطيع أن يكتبه الرجل ويريد أيضا أن يقوم بدور تقديم وجه الحياة الآخر المكتمل منظور الرجل ..
لأن الرجل طالما كتب باسم المرأة فمن حق المرأة أيضاً وهي تكتب أن تتمثل الحياة بشطريها بكامل أبعادها وتمارس وتجرب وتتقن صناعة متخيلها في تمثيل ردود فعل الرجل على تجربتها الخاصة وهي أيضاً من هذه الوجهة أصدق شاهداً من الرجل نفسه .. لأن الرجل لا يصف بدقة وموضوعية رد فعله .. لكن من يخاطبه .. من يلمح وجهه ؟
بناء الوعى المزدوج
على أى حال سنجد هنا أن هذه الطريقة تسمح ببروز الظلال بين التصورات والصور تصبح ثنائية الصوت رجل أو امرأة هي الطريقة لكشف هذا التماس والتقاطع بين العالمين ويتعين على القارئ لكي يتلقى ويستوعب هذه التجربة أن يبني وعياً مزدوجاً مجسداً لكل من الموقفين .. وهنا سنجد أن الكتابة تكتسب كثافة خاصة وتكتسب عمقاً واضحاً لأنه كلما تعددت الأصوات أصبحت اللعبة أكثر تركيباً وتشويقاً وثراء .. خاصة أن الراوي العليم بكل شيء قديم يختفي ويصبح أمام مجموعة من الأصوات تقوم بتوزيع الأدوار والتمهيد للانتقالات .
وتصنع الكاتبة هكذا طرفا من إشاراتها المتميزة لتفادي الخلط والارتباك فهي أحيانا – مثلا – تأخذ طابع مسرحي .. مشهد تقول فيه الكاتبة (الحلم – كأنها تقدم حلماً – اليوم أتمت دنيا زاد ثلاث أسابيع – هذا لو كانت قد عاشت – سأنير شمعة وأحملها إلى قبرها الساكن في ركن من أركان الغرفة – هذا شيء رمزي نربط به – أفتح باب القبر وأتسلل إلى حيث الجسد الجاثي أضع الشمعة إلى جواره وأبكي مرة واحدة ) نلاحظ هنا أنه حلم كابوس والكوابيس يتضح فيها أن المقابر تنتقل إلى البيوت والبيوت تذهب إلى المقابر (في طقوس حب سرية أراها تطبع على جبيني قبلة حارة كحرارة القبر المغلق) أيضا في الحلم الأحياء يموتون والأموات يتحركون وهكذا ..
الفقد الموجع لمكونات الذات
لكن تظل صورة دنيا زاد وتردادها العميق في وجدان الصوت الأول .. وجدان الراوية الكاتبة .. هي التي تبرز إيقاع الرواية ومدى انتظامها حول محور أساسى لأن الشعور الجوهري الذي يستخلصه القارئ من العمل هكذا هو الفقد الموجع لجزء من مكونات الذات .. بل ليظل هذا الشعور المعيار الذي يتحكم في انتقاء الأحداث والتركيز عليها .. فبقية المشاهد والتجارب تكتسب درجة التحامها مع النسيج الروائي العام بمدى ارتباطها بهذا الشعور الذي يمكن أن نسميه “الحبل السري للراوية” مع أنه انقطع بيولوجياً في الحمل إلا أنه موصول في الكتابة .
وبطبيعة الحال الكتابة لها وسائل متعددة ماكرة وذكية لتترك هذا الانطباع بالصدق ولا شك أن الرواية فيها جزء كبير من الصدق .
لكننى أود أن أشير إلى التقنية التي اتخذتها الكاتبة لكي تحقق لنا بقوة هذا الانطباع بأنها تقدم تجربة صادقة .. هي تقنية غريبة جداً .. فهي في الدرجة الأولى نوع من الوعي بعملية الكتابة ذاتها .. فهي تسلط ضوءا شديد جداً وتصف بدقه بالغة ومتناهية عملية الكتابة .. بل ميزاتها وملمحها الأساسي أن هنا الكتابة فيها وعي شديد بذاتها الأمر الذي يجعلها مفعمة بلون خاص من الشعرية يتمثل – كما أشبهه في التنفس أمام المرآة – بمعنى أن أمامنا في الكتابة العادية التقليدية نجد الحياة ونجد الصورة التي يمكن أن نقول أنها انعكاساً لها في مرآة الأدب .. لكن ما تفعله الكاتبة في هذه الراوية كأنها تقف أمام المرآة – التي يجب أنها تعكس صورتها .. لكنها تتنفس بصدق بالغ وحرارة شديدة جداً .. الأمر الذي يجعل كتابتها مثل الرذاذ الذي يغطي سطح المرآة فلا نرى صورة التجربة بقدر ما نرى حرارة الكتابة ذاتها حرارة الكتابة وهي تكاد تغطي على التجربة ذاتها .. تصبح العملية الإبداعية هي الأصل ومن المعروف أن الإبداع اقترن في دراسات علم النفس ودراسات علم الجمال ودراسات كثيرة مفادها بأن الإبداع عملية ولادة .
القضية الرمزية في الرواية
هنا سنجد أن الإبداع مزدوج ولادة حقيقية وولادة كتابية من هنا سنجد أن طبيعة تجربة الرواية ذاتها تعطي فرصة مواتية لتوهج الموقف هذا الموقف المعكوس حيث يتحد طوق التخليق طوق الولادة البيولوجية مع شوق الكتابة والتعبير عن هذه التجربة ويصبح الموت في الرحم وهذه هي القضية الرمزية في الرواية صورة للإخفاق في الإبداع ..
لأن الإجهاض كذلك كما أن الخلق عملية مزدوجة الإجهاض هنا يصبح كأنها وهي تكتب تخشى الإخفاق في الكتابة مما يجسد الإخفاق في الولادة . فهى يحكمها هذا الخوف . تبدأ المشكلة عندما تصبح هذه الفكرة فكرة الخوف من الفشل في الكتابة هاجساً محبباً لاستراتيجية الكتابة ذاتها . يصبح الأمر أيضاً فيه شيء من الصبح .. ونتوقف عند بعض المقاطع أو بعض المواقف التي توقفت أمامها كثيراً وأدهشتنى في هذه الرواية … فمثلاً من المقاطع التي بها توتر شعري شديد جداً عندما تقول :
( أكتب عن الانتظار عن رهبة وجود كائن آخر ينمو هناك وسط شعيرات دموية أليفة تحتضن بقايا الحيوانات الأليفة التي تشبهنا أو أكتب عن ذاكرة خائبة تحتفظ بوجه أزرق فوق صفحة سماء زرقاء تقوم مقام الجنة ، الآن أو أكتب عن قهر الخوف بخوف آخر كأن تخاف على ملابسك من الأتساخ وسط حشد هائل من المتأنقين عديمي الفائدة أو أن تخاف على صورتك في التلفزيون حين تسألك المذيعة ماذا كنت تقصد بعنوان “نحت متكرر”؟ ثم تطالع صحف كل يوم خوفاً من أن ينسوا ذكر اسمك في الصفحة الأدبية فتتصل بإحدى الصديقات لتطمئن على صحة أولادها وعلى أنها شاهدتك على الشاشة ذلك المساء) .
اختزال المشاهد السينمائية
هنا نلاحظ إلى نوع من السيناريو و (مي التلمساني) بالطبع من عائلة سينمائية وخير من يتقن صناعة السيناريو لأن السيناريو كأن الكتابة تصبح هي البديل لفعل الحياة من ممارسة تصبح هي الهدف تختزل مشاهد الحياة في حروف الكتابة وبقدر ما تلتصق الحروف بالواقع الحرفي تضيق رقعة المتخيل وتهبط السماء .. لأن المشكلة إذا اشتد وعينا بظاهرة لا نمارسها بطريقة تلقائية وعفوية مثلاً .. أبسط الظواهر التنفس لو انتبهنا إلى كيفية تنفسنا سيرتبك تنفسنا .. الخطوة ونحن نسير لو انتبهنا لكيفية سيرنا سنتعثر ونقع ..
فأشياء كثيرة جداً تتم بطريقة عفوية وتسليط الضوء الشديد عليها يربكها ..
وأرى أن هذا يرجع لكون الأدبية (مي التلمساني) تمتلك الوعي النقدى كناقدة وهذا بالإمكان أن يربكها كثيراً .. أعتقد أنه سبباً من الأسباب الجوهرية الوعى الفكري بالعمل الإبداعي و ليست ممارسته بالطريقة التلقائية البسيطة هذا يشبهها من ناحية أخرى طبيبة نساء وولادة عندما تقوم بتجربة الولادة على الورق .. ومع أننا نلاحظ ضيق مساحة المتخيل هنا إلا أن المدى يظل واسعاً وفسيحاً للمبدعة الكاتبة (مي التلمساني) أن تزاوج بمهارة بين قدرتها الروائية وقدرتها النقدية لكي ننتظر منها أعمالاً واعدة في خريطة المبدعات الشابات في أدبنا العربي.