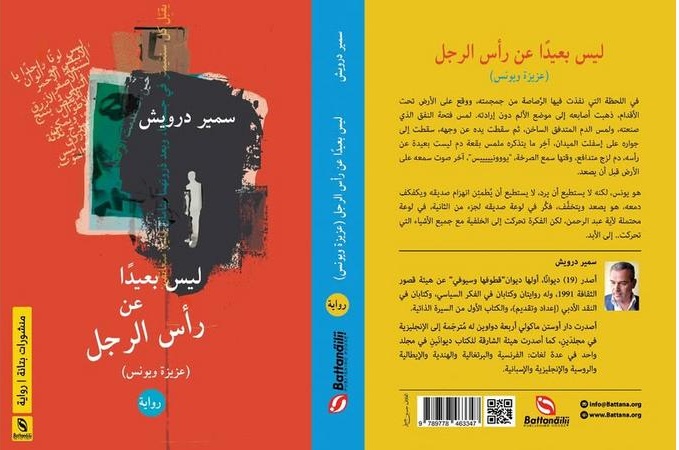سمير درويش
رغم أن المشهد -إذا التقطت له صورة علوية- يبدو عشوائيًّا، بدائيًّا، مثل حروب القرن السادس، حيث يتقاتل الناس بالسيوف والعِصِيِّ والكرابيج من على ظهر أحصنة وجمال وبِغال، فإن الرصاصة التي اخترقت عينه اليسرى، ونفذت من رأسه، بميْلٍ إلى أسفل؛ وكادت أن تصيب آخرين خلفه، كانت دقيقة واحترافية (قدَّر المتخصصون -بعد ذلك- أنها جاءت من فوق أحد المباني العالية، من بندقية قناص مدرَّب).
وجهه تشوَّه بالكامل في لحظة، لحظة مرَّت عليه كأنها دهر، بطيئة وقاسية، يرى الناس خلالها من أسفل إلى أعلى، مجرد مساحات لونية مختلظة متراكبة متناغمة، كخبطات فرشاة عريضة على فضاء قماش الكانافاس، تتماوج كموج البحر. والأصوات التي كانت عالية منذ قليل أصبحت خافتة، وعميقة، وممطوطة، واسمه يتردد متناغمًا كأنما من قاع بئر:
– يووونيييييس!
لا يزال يذكر أنه هو يونس، هذا اسمه، لكنه لا يدرك السبب الذي غيَّر الميدان فجأة، ونقله من واقع مؤلم وصراخ وعراك وإصابات ودم، إلى مشهد فانتازي من حلم مزعج، رأى خلاله كل مشاهد حياته تمرُّ، مشهدًا وراء مشهد، تمر بالبطيء: عزيزة، عرَّاف المدينة، الحماران، الغجرية، الطريق إلى المدينة، الكلية، الموديلز، وئام سلطان، الدكتورة سميحة النجار، نيويورك وآليكس ومليكة عمراني، القصر وزهرة الخشخاش، نجوان سيف الدين وآية عبد الرحمن.. قبل أن تظلم الدنيا تمامًا.
قبل ثوانٍ كان واقفًا جنب سور الصينية، مواجهًا شارعي طلعت حرب والتحرير، يصد مع الجموع هجوم الأحصنة والجمال والبِغال التي اقتحمت الميدان، لطرد المتظاهرين منه بالقوة، كاد جمل مندفع يدهسه، لكنه نجح في تفاديه، والوقوف على قدميه مرة أخرى، والعراك في هذا المشهد الأسطوري، كأنه مشهد في فيلم قديم، أبيض وأسود، عن تاريخ الإسلام أو عن الغزوات الصليبية.
مَنْ الذي فكَّرَ في هذا؟
مَن الشيطان الذي جاءته هذه الفكرة؟ وكيف استطاع أن يجمع كل هؤلاء في وقت قصير؟
هل هذه هجمة مدفوعة الأجر أم مجانيَّة، مجاملة من الهجانة لكبيرهم الذي يطلقهم على السائحين عند أهرامات الجيزة؛ أم مقاولة دبرها سمسار ما؟
أسئلة كثيرة متداخلة تدور في رأسه، لكن هذا ليس وقت التفكير، لا توجد مساحة له أصلًا، هو يدور في عجلة رهيبة من الصراع بالأيدي والأرجل، يتحرك وسط الجموع وبقانونهم، يحس بسخونة دم ينزف على جانبي وجهه، لا يجد فرصة لاختبار إن كان دمًا بالفعل أم بعص التهابات نتيجة الكر والفر والاصطدام بالآخرين وضربات عشوائية من هنا وهناك، من الأعداء الراكبين، أم من الأصدقاء الراسخين على الإسفلت، في محاولاتهم المستميتة للنجاة أولًا، ثم لدحر الهجوم.
الجو بارد والسماء ملبدة بالغيوم السوداء التي تنذر بالمطر، وهو يرتدي ملابس ثقيلة: سويتر أزرق بكبوت من الفيبر المضاد للماء، اشتراه من محل ملابس جاهزة في شارع استانواي في أستوريا بنيويورك اسمه بورتابيلا Portabella، بين 30 و31 أفينيو Ave، يديره شُبَّانٌ جزائريون يعرفونه من كثرة تردده عليهم، ويقدمون له خصمًا باعتباره زبونًا، وحول رقبته كوفية صوفية كاروهات، أحمر في أسود، اشتراها من محل في 26 يوليو بالزمالك، يملكه نادر سيف الدين، يلفها بإحكام. كاد يختنق أكثر من مرة والجميع يشدونه منها. الجميع.
– يووونيييييس..
الصوت يتردد في رأسه كأنه ماء بئر تشكَّل دواماتٍ إثر إلقاء حجر فيه، يعرف هذا الصوت، يميزه من بين كل الأصوات الصاخبة العنيفة في الميدان. من يا ترى؟ نعم، صوت يسري الصبَّاحي، صديقه، الفنان التشكيلي، يقابله هنا يوميًّا منذ بداية التظاهرات بعد غياب ثلاثين عامًا.
يونس يسكن قريبًا من الميدان، في شارع محمد محمود، لذلك لم يجد صعوبة في التواجد، لكن يسري دخل مع الجماعة التي أتت من ناهيا مرورًا بجامعة الدول ثم كوبري 15 مايو، والكورنيش من أمام ماسبيرو، ونجحوا في اقتحام الميدان من عدة مداخل.
في اليوم الأول ظلَّا معًا حتى منتصف الليل، وغادرا، كلٌّ إلى بيته، وبعد ساعة أو ساعتين كان يسمع ويرى -من مكانه- الهجوم الأمني لإجلاء المعتصمين.
في اليومين التاليين كانا يلتقيان في المقاهي المتعددة بالشوارع المتفرعة من الميدان، وفي يوم الجمعة التقيا معًا أيضًا، أُنهكا تمامًا حتى ما بعد العصر، ثم أصبح الميدان مفتوحًا ومتاحًا.
“هل أموت الآن؟
أحسُّ أن ثقبًا هائلًا يمر برأسي”..
السؤال الكبير الذي يفصل بين عالمين يدور في رأسه، بينما الحشود تدهس جسده المنهك والمُنتهك، جسده الذي يغادر بحيث لا يكون منتميًا إلى هذا المشهد الأخير الذي يراه.
يرى بياضًا يزحف ببطء ويلوِّن الناس والفراغ والأرض والسماء، يرى جسده ريشة خفيفة يحملها الهواء، تتراقص بخفة، تعبُرُ حُجُبًا وموانع وتفاصيل وحكايات، تدخل في البياض المترامي.. اللانهائي.
يذكر فيلم الجمال الأمريكي American Beauty، حين عَرَضَ (وس بنتلي Wes Bentley) لحبيبته فيلمًا صوره بكاميرته، كان يهوى التصوير، الفيلم لكيس بلاستيك يتلاعب به الهواء على الرصيف وسط أوراق الشجر الساقطة الحمراء، يصاحبه شريط بصوته:
“كان أحد تلك الأيام، قبل سقوط الثلوج بدقيقة، وكانت هناك كهرباء في الهواء، يمكنك سماعها تقريبًا، صحيح؟ وكان هذا الكيس يرقص معي، كأنه طفل صغير يرجوني أن ألعب معه، طوال 15 دقيقة. في ذلك اليوم أدركت أن هناك حياة كاملة وراء الأشياء، وأن هناك قوة خير ساحقة أرادتني أن أعرف أن ما من سبب يدعو للخوف، أبدًا”.
كأن هذا الكيس هو جسده الآن!
فكَّر مرة أن يرسم لوحة بيضاء، ضحك بصوتٍ عالٍ رغم أنه كان وحده، ضحك وضحك، فقد تذكر تمثيلية تليفزيونية رآها منذ زمن، بطلها فنانٌ تشكيليٌّ سيرياليٌّ، علَّق في معرضه إطارًا خشبيًّا فارغًا كتب تحته اسم اللوحة: “الجراد”، وعندما يسأله الزوار: أين اللوحة؟ يقول: أكلها الجراد! وعلق لوحة أخرى سوداء تمامًا، وكتب تحتها اسم “القافلة في الليل”، وعندما يسألونه عن القافلة، يقول إن الصحراء مظلمة في الليل ولا يمكن رؤيتها.
لكن فكرة اللوحة البيضاء أعجبته رغم ذلك، ظل يقلِّبها في رأسه حتى رسمها. الأبيض ليس لونًا واحدًا يا مليكة، الأبيض هو ألوان الطيف السبعة: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والنيلي والأزرق والبنفسجي، الأبيض ينتج عن اختلاط الأطوال الموجية للضوء، ويمكن الحصول عليه بمزج ثلاثة ألوان: الأحمر والأزرق والأخضر، فالأبيض ليس لونًا أصلًا لأنه لون الموت.
وحده في الصالة التي حوَّلها إلى مرسم، في الاستديو الذي استأجره عند تقاطع الكريزنت Crescent مع 24 أفينيو Ave، يضع لوحة بيضاء على الحامل، يضحك أيضًا من الخاطر الذي أتاه، أنه سيرسم لوحة بيضاء على قماش أبيض!
هو في النهاية يرسم هذا البرزخ الذي يعيش داخله الآن، حين يتخفف الإنسان من كل مشاكله، من كل ماضيه وحاضره ومستقبله، من كل الأفكار الكبيرة والصغيرة التي يجاهد ليضعها على مائدة الفعل، يتحرَّر من كل ذلك ويعلو نحو البياض.
– يووونيييييس..
يتذكر كل الأطباء الذين زارهم ليحاصر تضخم عضلة القلب، ميل الدم للتجلط في الشرايين والأوردة، الأدوية التي كان عليه أن يتناولها يوميًّا ليتفادى الموت! يتذكر الأميال التي يمشيها يوميًّا ليحافظ على لياقته، والندوب التي تتركها الأحذية الضيقة على أصابع قدميه.
يرى نفسه وهو يراقب الأطفال في الثانية والثالثة وهم يلهون دون حساب للمسافات، ودون اعتبار للخطر، يتذكر ابتساماتهم ويعرف أنه لن يكون لديه طفلٌ يومًا، شيء ما أقوى منه كان يقول إنه لن يستطيع أن يكون مسؤولًا، أبًا مسؤولًا عن حياة آخرين، يلوم نفسه إذا أخفقوا، أو أخفق هو، وسارت الأمور عكس الاتجاه الذي يتمنَّاه، يحب ابتسامات الأطفال، ويخاف أن يتسبب في شقاء طفل يأتي به إلى الدنيا رغمًا عنه، ولا يستطيع أن يوفر له ما يريد.
يتذكر أجساد البنات والسيدات اللاتي جلسن أمامه، بكامل ملابسهن أو متخففين من بعضها، كي يحولهن إلى صور، تلك الأجساد تكون متحفزة ومتعجِّلة لترى نفسها في عينيه، تراها منفصلة عن ذاتها، ليس كما تظنها هي بل كما يراها هو ويتوقعها..
كثيرات يرى الإحباط على وجوههن، لوقت قد يطول وقد يقصر، حين يسمح لهن بالحركة والإطلال على اللوحة، الإحباط الناتج عن عدم وجود أجسادهن أصلًا، لا كما يرينها ولا كما يتطلعن إلى رؤيتها في عينيه، فقط لطشات بفرشاة عريضة، لطشات ملونة متراكبة، طبقات وطبقات من الألوان الصامتة، الخشنة، لا ينكرن أنهن يشعرن بملامحهن، يشعرن بها دون أن يريْنَها.
كل لوحاته وكل نسائه وكل الطائرات التي ركبها، والغرف التي نام فيها، والطلاب الذين درَّس لهم، وأساتذة علم الجمال الذين حفظ نظرياتهم ومقولاتهم، كل الدوائر والإدارات الحكومية التي تعامل معها، كل الأوراق التي قدَّمها لكل تلك الجهات، كل ذلك يحيط به الآن ويصعد معه، يتحول تدريجيًّا إلى نتف على جذع الريشة، التي تكونت من ألوان كثيرة، ثم ابيضَّت بالتدريج.
في اللحظة التي نفذت فيها الرصاصة من جمجمته، ووقع على الأرض تحت الأقدام، ذهبت أصابعه إلى موضع الألم دون إرادته. لمس فتحة النفق الذي صنعته، ولمس الدم المتدفق الساخن، ثم سقطت يده عن وجهه، سقطت إلى جواره على إسفلت الميدان، آخر ما يتذكره ملمس بقعة دم ليست بعيدة عن رأسه، دم لزج متدافع، وقتها سمع الصرخة، “يووونيييييس”، آخر صوت سمعه على الأرض قبل أن يصعد.
هو يونس لكنه لا يستطيع أن يرد، لا يستطيع أن يُطمئِن انهزام صديقه ويكفكف دمعه، هو يصعد ويتخفَّف، فكَّر في لوعة صديقه لجزء من الثانية، في لوعة محتملة لآية عبد الرحمن، لكن الفكرة تحركت إلى الخلفية مع جميع الأشياء التي تحركت.. للأبد.
حين اصطدمت الرصاصة بوجهه واخترقت جمجمته، شعر بالبرد الشديد يخترق الملابس الثقيلة التي يرتديها، برد قارس عاصف شنيع لم يجربه من قبل، رغم أنه عاش ولعب وتنطط في درجة حرارة تحت الصفر بثماني عشرة درجة، كان يتجمد حرفيًّا، لكنه الآن يشعر ببرد مختلف، يحول جسده إلى لوح ثلج أو لوح خشب، لا فرق.. لحظة فقط كأنها عمر طويل، ثم انقشع البرد من جسمه كما تنقشع الهموم في حضرة جسد فائر محب.
لحظة توازي عمرًا، خاطفة بمقاييس من يحيطونه ويعرفون أن الرصاصة نفذت من جمجمته، طويلة جدًّا بمقاييس الزمن الجديد الذي يدخله الآن.
تذكَّر فيلمًا أمريكيًّا -أيضًا- لا يذكر اسمه الآن، يصوِّر الناس في الآخرة، بعد موتهم. كل شيء ظهر أبيض: الملابس والأحذية والجدران والإسفلت والمصاعد وأدوات المائدة والنباتات والأسانسيرات، يبدو أنه سيصبح ضيفًا عليهم الآن، سيكون بطلًا من أبطال الفيلم.
– يووونيييييس..
مليكة لم تنادِه باسم يونس أبدًا، كانت تقول له: مستر، ثم حين باتا صديقين أصبحت تقول: يويو، تضحك لأنه يحمل اسمًا دينيًّا رغم أنه لا يمارس أية طقوس دينية، لا يتكلم في الدين، يكتفي بالمتابعة حين يتناقش زملاؤها حول إشكالياته، وإن طُلب منه رأيًا يقول إنه لا يعرف.. فقط!
وعد مليكة أن يدعوها لمصر، تقضِّي معه شهرًا يأخذها خلاله إلى كل الأماكن التي لم يرها هو نفسه: الساحل الشمالي، القرى السياحية على شاطئ البحر الأحمر، الواحات، سانت كاترين وجنوب سيناء، لا يعرف ماذا يوجد في هذه المناطق، لم يحاول أن يعرف، لم يسمع قصصًا من أصدقائه ولم يتصفح الكتيبات الدعائية، حتى من باب الفضول.
هو ليس فضوليًّا، لا يسمع ما لا يهمه سماعه.. صديقات كثيرات عرضن عليه أن يذهب معهن في جولات سياحية ضمن جروبات في كل تلك الأماكن، خصوصًا في الواحات وفي سيناء، يحكين قصصًا عن تجاربهن هناك: التكلفة والمسافة وشكل البيوت وواجهاتها، المعابد التي تعالج الأمراض، المساجد والكنائس والأديرة، شساعة الصحراء وأبراج الحمام والقلاع، أنواع الأطعمة وإمكانية التخييم في الفضاء.. راقب الحكايات بعينيه لكنه لم يسمعها.
وعد مليكة أن يأخذها لهذه الأماكن كي يكتشفها معها، رغم أنها ارتبطت بشاب آخر بعد رحيله فإنها تحمست، قالت إنها ستأتي وحدها، دون صديقها الجديد، ربما كي تستعيد ذكرياتهما معًا، وربما كي تعبِّر له عن امتنانها لأنه فكَّ عقدة خوفها من الرجال، كان رجلها الأول، لكن الأهم أنها تحتاج بالفعل أن ترى شيئًا مختلفًا يجدد نشاطها، وأن ترسم ما تراه.
كانا سيلتقيان بعد تسعة أيام فقط، لكنه يصعد الآن ويرى مليكة على باب البناية التي فيها الاستديو، ظلت به وحيدة عدة سنوات بعد رحيله، ثم انتقل صديقها الجديد ليعيش به معها، ينام معها على سريره نفسه، الذي طالما ناما عليه! رفضت أن تنتقل إلى شقته الأوسع، لأنها ارتبطت بالاستديو تريد أن تستكمل حياتها فيه، قبل أن تعده بأن تتركه له عند عودته..
يراها الآن ترتدي ملابس ثقيلة سوداء، الوقت مبكرٌ في نيويورك، وقت خروجها للعمل، يراها بألوانها بوضوح، قبل أن تتحول إلى الأبيض العميق.