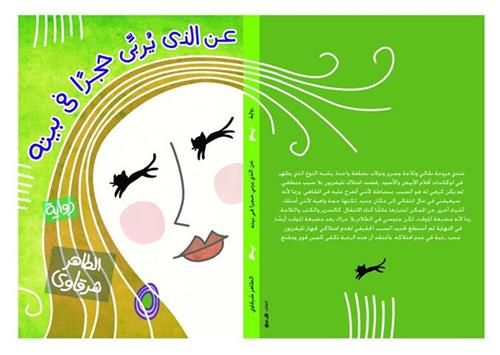لا أحلم مثل بقية الناس، وإن شئتم الدقة فأحلامي قليلة جدًّا، معظمها كوابيس لا أستطيع حكيها، من كثرة غموضها وتداخلها مع بعض، تشبه مجموعة من الخيوط المنعقدة لا أعرف أولها من آخرها، مما يجعلني أعيش يومًا من المزاج السيئ، الذي يصعب عليّ التخلص منه، بالإضافة إلى الشعور بإرهاق وآلام شديدة في كل أجزاء جسمي، وكأني قمت بنقل حجارة جبل وحدى، لدرجة تجعلني راقدًا في السرير إلى ما بعد الظهر، دون رغبة حقيقية في النهوض أو فعل أي شيء، كنت مع نفسي أصفها ساخرًا بأنها: “أعراض إنفلونزا الأحلام”، أما باقي أحلامي فكانت قصيرة جدًّا، أشوفها دائمًا بالأبيض والأسود، أنتظر قدومها بشغف رغم مجيئها على فترات متباعدة.
كانت تمتلئ بالحياة وتشع سحرًا غامضًا، عرفتها منذ اللحظة الأولى التي وقع بصري عليها، قلت لنفسي: إنها هي. فكانت هي.
قالت:
– اسمي في الأوراق الرسمية: “سرين”، ـ هكذا ـ بدون حرف الياء بعد السين، أخطأ موظف السجل المدني عندما أملاه أبى الاسم، ولم يهتم بتصحيحه فيما بعد قائلاً: “كلها أسماء”، بينما رددت أمي: “حتى يأخذ العين التي فلقت الحجر”. أنا وحيدة أبوي، جئت على كبر، وبعد أن يئسا لسنوات، كنت فرحتهما التي انتظراها بشوق. عمومًا لا أحد يعرف حكاية الحرف الناقص سوى أسرتي وزميلاتي في الدراسة. وظل الأقارب والجيران ينادونني بأسماء الدلع، مرة: “سمسم” ومرة “سنسن” وأحيانا “سوسو”، وعندما اكتشفوا أنني كبرت قليلاً، نادوني بـ “سيرين”.
حكت:
– ضايقني اسمي أيام زمان، عندما كانت زميلاتي في الفصل يضحكن عليه وهن ينطقنه بدون حرف الياء مع تشديد الراء.. سهرت كثيرًا أفكر، وبكيت مرارًا، في السر وفى العلن، وكثيرًا ما صرخت أمام أبوي في البيت: “أكره اسمي” معقبة في عتاب: “أنتما السبب”، وكنت ألوم أمي على انفراد: “أنا ابنتكما الوحيدة، لماذا أخطأتما في اسمي”، لكن تذمري الدائم لم يصلح الأمر. عندما أنفرد مع نفسي في حجرتي، كنت أحلم باسم يخلو من الأخطاء الإملائية، حتى لو كان اسمًا “دقة قديمة”، المهم اسم لا يثير غمز البنات وضحكهن الشرير.
روت:
– كرهت الذهاب إلى المدرسة، وأصررت بشكل حازم على تغيير اسمي، كنت حائرة بين عشرات الأسماء، كل الأسماء الجميلة للبنات كانت في يدي، كل يوم اختار اسمًا ثم أغيره في اليوم التالي.
قالت:
– الآن أعشق اسمي جدًّا.. أعشقه حتى لو كان بدون حرف الياء بعد السين..
أتت خصيصًا من مدينتها القريبة لمقابلتي، شافتني كثيرًا في حلم لا يفارقها، وخاطر واثق من نفسه أخبرها أنني موجود قريبًا منها لدرجة لا تتخيلها.. هي عكسي تمامًا في موضوع الأحلام، تقريبًا كل فترة نومها تعيشها في أحلام متواصلة، لتستيقظ بعدها وهى غارقة في دموع غزيرة، أو تصحو على جسد مسكون بالسعادة، فتنطلق في غناء عذب يملأ حجرات البيت.
تنبعث الموسيقى من أماكن غامضة، أما البنات فكن يتحركن بخفة على الأرصفة وهن يمسكن في أيديهن ببالونات.. مدينة صغيرة تفوح برائحة الأنوثة، وشوارع نظيفة ولامعة، وجوه ضاحكة دومًا، وأسماك صغيرة تملأ السماء فوقنا، ورائحة خفيفة لليود تفوح في المكان، وكأن هناك بحرًا قريبًا منا.
ضحكنا.. مشينا.. عدونا.. جلسنا.. تكلمنا.. غادرنا.. صمتنا.. تثاءبنا.. ابتسمنا.. غنينا.. حلمنا..
“أنا خبيرة في الأحلام” هكذا قالت “سيرين”، وهى تحكى لى أن سيدات العائلة والجيران والمعارف، كن يحكين لها أحلامهن، فقط حكى الحلم ولا شيء آخر، لا يطلبن تفسيرًا أو تأويلاً، إن تكلمت “سيرين” فخير وبركة وإن لم تفعل فقد أخرجن ما يكتم على صدورهن، كن مؤمنات بأن البنت التي عاشرت الأحلام، والتي تعرف ما لا يعرفه أحد، هي الوحيدة التي ستفهم وتنصت بلا ملل أو تذمر، أو حتى دون إعطاء تفسيرات لا معنى لها مثل الأخريات، واللاتي كن يقلنها من أجل بث الاطمئنان في قلوبهن القلقة، هذا اليقين الذي يقبع بالداخل، يجعلهن يمارسن طقوس الاعتراف بكل حب، قبل أن يشعرن بأنهن خفيفات وفرحات بشكل لم يجربنه من قبل كثيرًا. يأتين خصيصًا إلى البيت بحجة الزيارة والحرص على صلة الرحم، ثم ينفردن بها فى حجرتها، يتأكدن أولاً من وجود الأم في المطبخ ومن إغلاق الباب، قبل أن يبدأن في سرد أحلامهن دون نسيان ولو تفصيلة صغيرة، ثم يقتربن من أذنها ويهمسن: “إنه سر” ويرحلن، لكنهن يعدن ثانية بعد أيام أو أسابيع، ويكررن نفس الموضوع..
قالت “سيرين” إنها تقريبًا تحلم بكل شيء يحدث في حياتها..
– تخيل كل شيء أفعله أو يحدث من حولي شفته من قبل في الحلم.. في الأول كنت أنزعج بشدة وأرفض الخروج من البيت، قلت إنها لعنة أصابتني.. بعد ذلك علَّمت نفسي كيف أتحكم في أحلامي، الأمر سهل: أفكر في الشيء الذي أود أن أحلم به، وببساطة يتحقق ذلك.. أختار أحلامًا على مزاجي، بدلاً من أن تأتى الأحلام وأنا وحظي.. أتعرف كنت أفكر في ولد أحلم به، ولد أعشقه مثل بقية البنات، كن يحكين لي ويستشرنني في بعض الأمور، هذا الوميض الذي يظهر في عيونهن وهن يحكين كان يثير غيرتي، كنت أرى البهجة تسكن أجسادهن، فكرت مع نفسى: أريد أن أجرب طعم الحب.. فشفتك في حلمي، قلت لروحي: ربما صدفة، لكنك سكنت أحلامي لأسابيع تالية.
البنت التي زارتني في حلمي والتي بدورها شافتني في أحلامها، حكت عن أحد تلك الأحلام: كنت مستلقية على الحشائش في حديقة صغيرة، تحديدًا تحت إحدى أشجار “البوانسيانا”، وفى مواجهتي مقعد خشبي وحيد، يبدو قديمًا وعجوزًا بشكل يثير الشفقة، لم يكن هناك أحد من الخلق في الحديقة، وكأنها خلقت من أجلنا نحن، رأسي في حجرك، سكبت الكثير من الدموع، لا أعرف لماذا، فنبت عود قمح يحمل سبع سنبلات ذات طعم مر، لم تقترب منها الطيور، ثم مسدت على رأسي بيدك، فبكيت مرة ثانية، لا أعرف لماذا، نزلت دموع غزيرة، فنما بجواري عود قمح، يحمل سبع سنبلات طيبة الطعم، أقبلت عليها الطيور بنهم.
تمتلك روحًا حلوة، وحضورًا أجبرني على الوقوع في غرامها إلى الأبد.. قالت: “شفتك في الحلم وجئتك في الحلم.. بُص، إنه القدر”.. قلت: “أنا مسكين، أحلامي قليلة”.
ابتسمت وهى تقول: “سأطرق الباب ثلاث مرات، فقط ثلاث مرات، عندها أفتحه على مصراعيه”..
ضحكنا.. مشينا.. جلسنا.. تكلمنا.. صمتنا.. تثاءبنا.. ابتسمنا.. غنينا.. افترقنا..
الفراق هو اللقطة الوحيدة غير الواضحة في المشهد، يكتنفها بعض الغموض والضباب..
هل رافقتها إلى محطة المترو؟ أم أوقفت لها سيارة أجرة؟
هل بقينا معًا حتى أول شعاع من النور؟ أم فتحَتْ مظلتها وصعدت إلى السماء وسط تصفيق المارة.
البارحة طرقت “سيرين” الباب ثلاث مرات.
فقط ثلاث مرات..
وكانت سعيدة وهى تنعم بالبهجة على كل شيء بلا حساب، وتحمل في يديها أربعة أصص من الصبار.