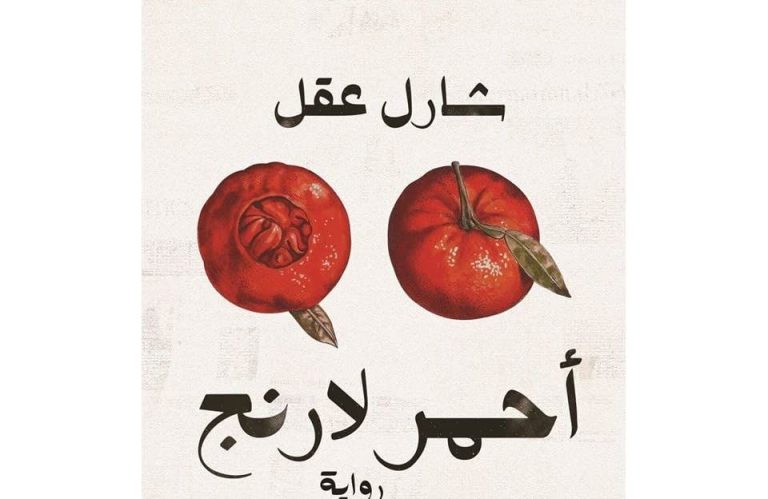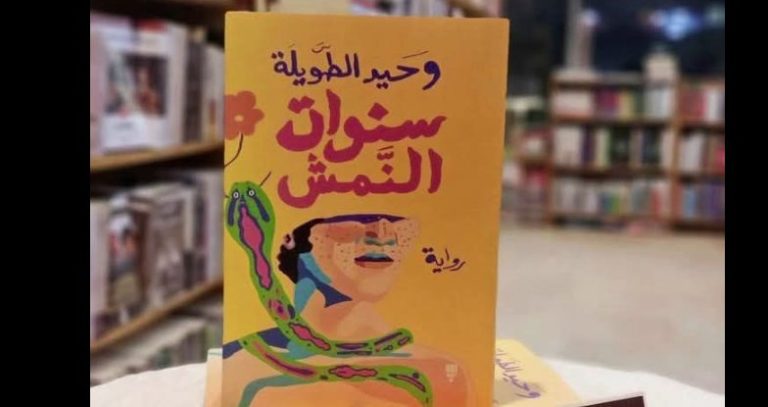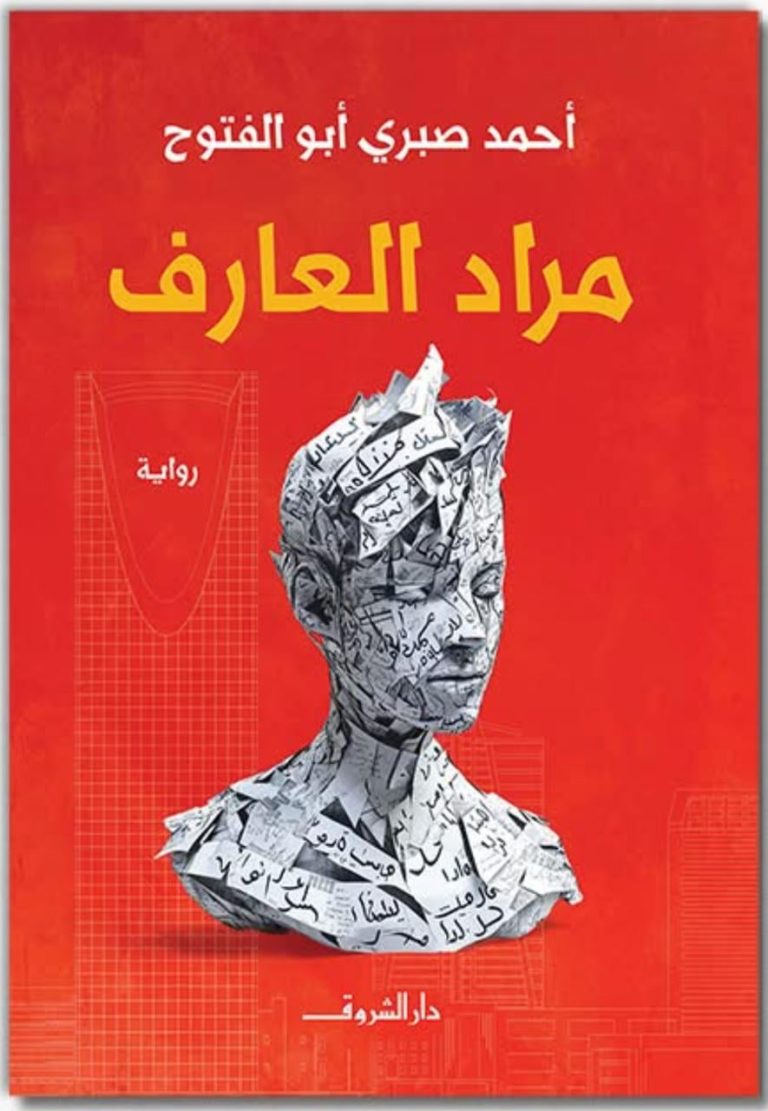نور الهدى سعودي
تعود ذكرى فاطمة المرنيسي كلما مر وقت يكفي لالتقاط معناها من جديد؛ تعود لا كتاريخ يبتعد، بل كسؤال يتقدم إلى الواجهة: كيف يتحول الحلم من رغبة داخلية إلى جناح يفتح ممرا لم يكن مرئيا؟ وكيف يمكن للكتابة، في لحظة ما، أن تتجاوز حدود التعبير الفردي لتصبح شكلا من أشكال التحرر المشترك؟
لم تأت المرنيسي من زمن يسمح للنساء بالتفكير خارج الحدود المرسومة، ولا من سياق يمنحهن الحق في إعادة قراءة التاريخ. جاءت من بيت فاسي تقليدي، من حريم تتقاسم نساؤه الأحلام والقيود معا، ومن طفولة كانت تصطدم فيها الرغبة في الاتساع بجدران مرئية وأخرى أشد صلابة لأنها غير مرئية. لكنها لم تتعامل مع الجدران بوصفها نهاية القصة. أمسكت بالسؤال كما يمسك الطفل بخيط طائرته الورقية، وظلت تتابع أثره: لماذا؟ من قرر؟ وما الذي يجعل الحدود تستمر؟
تلك الأسئلة لم تكن مجرد فضول طفولي، بل البذرة الأولى لمشروع سيمتد عقودا، مشروعٍ يختبر الطريقة التي تُبنى بها الحدود: كيف تتحول من أفكار إلى ممارسات، ومن ممارسات إلى بنى قابلة لإعادة إنتاج نفسها. المرنيسي لم تعش داخل الأسئلة فقط، بل حولتها إلى أدوات بحث، إلى كتابة تفتح مجالاً للنظر من زوايا لا يمنحها السرد التقليدي. وهنا يتضح مسارها الخاص: لم تكن تحكي لتؤرشف حياتها، بل لأن القصة الشخصية تكشف بنية اجتماعية وثقافية أوسع.
وسرّ قوة نساء على أجنحة الحلم أنه ليس مجرد سيرة ذاتية، بل جغرافيا حسية للحرية. المرنيسي لم تتناول الحريم كحيّز مغلق، بل كفكرة تستقر في الوعي قبل أن تستقر في المكان. كتبت عن نساء حملن أحلامهن داخل الحدود، وعن اللحظة التي لا يعود فيها الحلم مجرد مهرب، بل يتحول إلى طاقة تعيد تنظيم الوعي، وتفتح مجالا جديدا للمشاركة في العالم. في ذلك النص، يصبح الحريم استعارة لما يضيق حركة الروح ويستدعي طرقا مبتكرة للعبور.
وما يجعل الكتاب لافتا أنه يقدم الحريم كفضاء متعدد الطبقات؛ ليس صورة نمطية، بل نسيجا تتجاور فيه الرعاية والسلطة، الانتماء والاختناق، والألفة والقلق. وفيه تتعلم الفتاة الصغيرة أن الحرية لا تُلتقط دفعة واحدة، بل تُبنى عبر اختبارات صغيرة تتراكم. وأن الحلم ليس امتيازا، بل قدرة على إبقاء الداخل يقظا حين يضيق الخارج. ومن يتخلى عن تلك اليقظة، يتخلى عن إمكانية الحركة.
لهذا يصبح العنوان نفسه موقفاً معرفيا : نساء على أجنحة الحلم. ليست النساء هنا مجرد حالمات، بل صاحبات أجنحة، والجناح ليس صورة شاعرية بقدر ما هو وسيلة انتقال، آلية للتحرك فوق ما يستعصي تغييره. ما لا يمكن هدمه بمواجهة مباشرة، يمكن تجاوزه بارتفاع مختلف. وهذا جوهر رؤيتها: الحرية ليست انفصالاً عن الواقع، بل إعادة نظر في موقعنا داخله.
وعلى نحو مواز، تدرك المرنيسي أن السرد وحده لا يكفي. لذلك تعود إلى التراث الإسلامي، إلى طبقاته المطمورة، بحثا عن أسماء نسائية استبعدتها الروايات اللاحقة. لم تكن استعادتها تلك مجرد زخرفة للنص، بل تذكيرا بأن حضور المرأة في المجال العام ليس استثناء معاصرا. كانت تذهب إلى النصوص كما لو أنها تفتّش عن احتمالات أغلقت مبكرا، وتعيد فتحها دون ادعاء امتلاك الحقيقة. كان منهجها يقوم على الإصغاء: إصغاء لما قيل، ولما مُنع أن يُقال، وللمساحة الرمادية بين الاثنين. وهذا ما منح قراءتها بعدا تركيبيا نادرا، لأنها لم تكن تسعى إلى انتصار خطاب على آخر، بل إلى كشف ما تراكم فوق المعنى حتى حجبه.
المرنيسي تتحرك داخل منطقة حساسة، ومع ذلك لم تقارب التراث بوصفه خصما، ولا بوصفه يقينا. تعاملت معه بقرابة واعية: انتماء يسمح بالاقتراب، وحرية تمنع الوقوع في أسر الخطاب الواحد. لم تكن هويتها موقعا ثابتا، بل أفقا يتوسع مع أدواتها وأسئلتها. القراءة عندها كانت مساحة تفاوض بين الماضي والحاضر، لا صراعا بينهما.
في قلب هذا المشروع، تقف اللغة. كانت المرنيسي تعرف أن اللغة ليست مجرد وعاء، بل زاوية رؤية. من يمتلك القدرة على التسمية يمتلك القدرة على إعادة ترتيب العالم. لذلك كتبت بلغتين، لا لتقسيم خطابها، بل لتوسيع مجال القراءة. كانت الفرنسية نافذتها على العالم، وكانت العربية نافذتها على التراث، وبينهما مساحة تُعاد فيها صياغة الأسئلة بشكل يسمح لها بالحركة. وأحيانا كانت تنتقل بين اللغتين كما ينتقل المسافر بين مدينتين يفصل بينهما جسر، لا لأنهما متعارضتان، بل لأن كل واحدة منهما تمنح منظورا إضافيا لفهم السؤال نفسه.
ومع انتشار كتبها عالميا، ظلت مرتبطة بسياقها الأول. لم تتعالَ على جذورها، ولم تنحبس فيها. أدركت أن العالم شبكة مترابطة، وأن الأسئلة التي تواجه النساء في المغرب تتقاطع بشكل أو بآخر مع أسئلة تُطرح في أماكن بعيدة. الحريم، كما تقدّمه، ليس حكرا على ثقافة بعينها، بل شكل من أشكال تنظيم السلطة حين تُفرَض على الجسد والمعنى. وكانت ترى أن التجارب المتباعدة تتقاطع في نقطة واحدة: الرغبة في توسيع مجال العيش، وفي إيجاد لغة تُنصت لما يحدث تحت السطح، لا لما يُعلن عنه فقط. لذلك شكل حضورها في السياق العالمي إضافة لا مجرد امتداد، لأنها كانت تذهب إلى الأسئلة الكبرى من بوابة التفاصيل الصغيرة.
وفقا لهذا امتد صدى كتبها إلى قرّاء من ثقافات متباينة؛ فالكتابة عندها تنطلق من تجربة محددة لكنها تصاغ بأسئلة تتجاوز حدود المكان والهوية. أسئلة يجد الإنسان فيها ما يعيد التفكير في موقعه: كيف نتحرر من الحدود التي نرثها؟ كيف نبني هوية لا تتحول إلى سجن؟ وكيف يمكن للتراث أن يكون مساحة للفهم والحوار بدل أن يتحول إلى قيد يعطل إمكاناتنا؟
وربما الأهم في مشروعها أنه يقدم اقتراحاً للعيش. لم تكن غايتها نقد الجدران فحسب، بل تخيل ما يمكن أن يوجد وراءها. الحرية لديها حضور القدرة على إعادة تعريف الذات، على الاختيار، على صياغة موقع الشخص في العالم. لم تكن المرأة موضوعاً في نصها، بل فاعلة فيه.
ومع كل قراءة جديدة للمرنيسي، يتضح لنا أن ما تركته ليس فكراً منجزاً، بل طريقة في النظر. طريقة لا تجعل السؤال سلاحاً، ولا تعتبره زينة بل تمرينا على إعادة ترتيب الضوء على الأشياء. لهذا يبدو السؤال اليوم، في ذكرى رحيلها، موجهاً إلينا: هل يمكن للحلم أن يصير جناحا فعليا ؟ لعل الإجابة لا تُبحث عنها في نص محدد، بل في تلك المسافة التي فتحتها المرنيسي بين ما هو قائم وما يمكن أن يكون. مسافة تجعل الطيران ممكناً، ولو ببطء.
في غياب المرنيسي، لا تزال أسئلة تعيد تشكيل الوعي حاضرة، ونصوصاً تفتح الأبواب المغلقة، وشجاعة تذكر كل من يقرأها بأن الحدود ليست نهائية. تركت فكرة بسيطة وعميقة في آن: أن الحلم ليس رفاهية، بل ضرورة. وأن الجناح لا يُمنح، بل يُصنع. وأن المعرفة، حين تقترن بالموقف، تصبح قوة تغيير حقيقية.
في ذكرى رحيلها، لا يعود السؤال عن المرنيسي وحدها، بل عن الفكرة التي حملتها: هل يمكن أن يصبح الحلم جناحا فعليا؟ الإجابة تكمن في طبيعة ما تركته. في طريقة التفكير، منهجا في طرح الأسئلة، شجاعة في مواجهة المسلمات. تركت للنساء، إرثاً من الجرأة الفكرية التي لا تخاف من أن تعيد النظر في كل شيء.