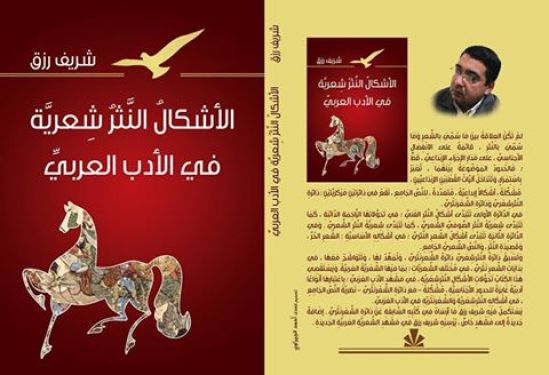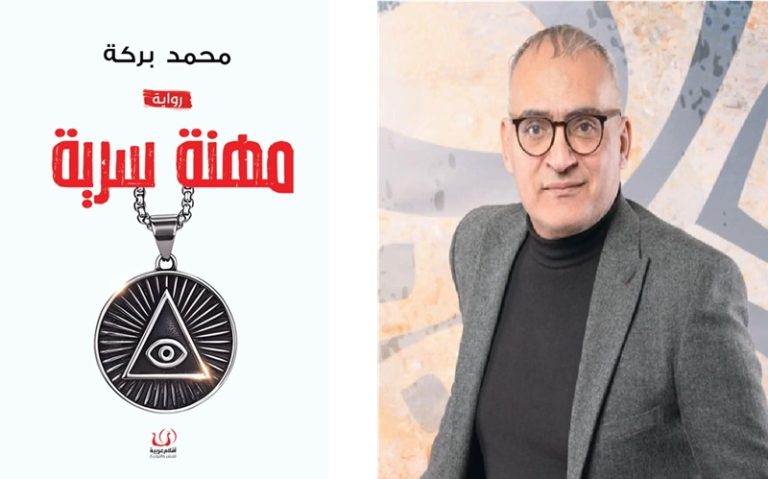رشيد برقان
لحسن باكور وجه من الوجوه السردية المعاصرة التي تداوم على الإنتاج والإبداع بوثيرة محترمة وبعيدا عن الأضواء والقفزات الإعلامية. راكم على الصعيد السردي لحد الان روايتين (“البرزخ”، و”شريط متعرج من الضوء”) وثلاث مجاميع قصصية (“رجل الكراسي”، و”الرقصة الأخيرة”، و”الزرافة تظهر في غابة الاسمنت”) نال بها جميعا جوائز بالعالم العربي، حيث نالت مجموعته “رجل الكراسي” جائزة الشارقة للإبداع الأدبي سنة 2008، كما أحرزت مجموعته “الرقصة الأخيرة” جائزة دبي الثقافية لسنة 2015.
وتكتسي الكتابة في العالم السردي للحسن باكور طابعا خاصا لا من حيث المواضيع والوضعيات التي يؤثرها منفردة منعزلة، ولا من حيث طريقة الاشتغال على السرد الذي يقترب من تصوير الكاميرا الشفافة التي تنبع من لغة صافية مهووسة بنقل لحظات هاربة.
وبغية الانفتاح على هذا العالم المتميز تقترح هذه الورقة الاقتراب من المجموعتين القصصيتين “رجل الكراسي” و”الرقصة الأخيرة”، واضعة نصب عينيها الظفر بالخاصيات التي تشكل من العالم السردي للحسن باكور عالما متفردا.
تضع المجموعتان نفسيهما في وضع متقارب من حيث الحجم، وبشكل تصاعدي ينمّ عن تطور التجربة، ف”رجل الكراسي”[1] تنتظم في ثلاث وستين صفحة من القطع المتوسط، وتضم تسع قصص. أما “الرقصة الأخيرة”[2] فتمتد على مساحة سبع وعشرين ومئة صفحة وبها تسع قصص. ولعل في تزايد الصفحات وبقاء عدد القصص على ما هو عليه ما ينبؤ بتطور في التجربة وتمرّس أكثر بالكتابة، وفتح لمغاليقها على الصعيد السردي.
بصدد الموضوعات:
يلفت انتباه المتتبع للمجموعتين أن الموضوعات الأثيرة لدى لحسن باكور هي الوضعيات الإنسانية المتفردة، والتفاصيل الحياتية الفردانية، والتي اعتدنا على عدم الوقوف عندها على اعتبار أنها أحداث مبتذلة، فمن التيه في “المطاردة”، إلى الانتظار في “امرأة جميلة تنتظر”، والوحدة في “أنثى محتملة”، مرورا “بالإحراج في “نظارات سوداء”، ووصولا إلى الموت التي قاربها من خلال قصتين هما “عصافير الروح” و”شيخوخة”. ويبدو أن قلق الذات وانفصامها والموت هما التيمتان الغالبتان على المجموعة حيث يخترقان قصص المجموعة، ويتم تناولهما غالبا من خلال العجيب والعوالم غير المألوفة.
تيمة الموت:
شكلت الموت دائما معضلة للإنسان حار في فهمها، ولم يستطع تقبلها. لهذا عمل دوما على مراوغتها خصوصا فكرة الحتمية فيها، وعدم إمكانية التعرف على تفاصيلها. وسارد المجموعة ينظر إلى الموت باعتبارها النهاية ونقطة اللاعودة. وهي تأتي بدون معاناة، وبدون أن يكون مرحبا بها أيضا؛ يقول: «تمددا على ظهرهما متقاربين، ثم استوى على جنبه الأيسر، واستوت على جنبها الأيمن .. تنهدت وأرخت أعصابها .. طافت فوق عينيها إغفاءة عذبة سرعان ما استسلمت لها، وبالكاد كان يسمع صوت تنفسها الخافت .. تنهد هو أيضا .. ثنى ركبتيه اليابستين وأدناهما من صدره .. بلل غصة ناشفة كانت تجرح حلقه .. رقصت أمام عينيه غلالة بيضاء شفيفة، وتلألأت في مقلتيه عبرتان حائرتان ما لبثتا أن طفرتا وانسكبتا على الخدين النائيتين.
وكان هناك صمت .. صمت ثقيل له صدى خفيف هامس ينضج برتابة قاسية .. وكان هناك حزن.»[3] وكما نلاحظ هناك استسلام مطلق للموت وبدون مقاومة.
وفي “عصافير الروح” يعبّر عن الموت لمغادرة العلامات الحيوية للجسد، والتي يراها السارد عصافير، ويبقى الجسد خرابا. يقول:
«الوقت يمر
يخنق أنفاس العانس ذعرٌ متنامٍ
صدرها المفتوح يزداد وحشة ويوشك أن يغدو مغارة مهجورة.
الليل يزحف في الخارج، والعصافير (كانت بيضاء اللون) بدأت تفقد أشكالها رويدا، وما لبثت أن ذابت وسط السماء السوداء الخالية من أي نجمة»[4]
وفكرة الموت طرحت بإلحاح في الشعرية الحديثة، وهي تندرج ضمن تيمة كبرى هي السوداوية؛ فضغط الواقع، وكبح الآمال التي تعرضت ولاتزال تتعرض له الفئات المجتمعية العريضة جعل جذوة الأمل تخبو، وأصبحت الآمال إحباطا. لهذا لا بدع أن تتركز نظرة المبدعين على مظاهر الموت والأفول، المتجلية في شخصية معزولة، والتركيز على الشيخوخة والعنوسة والوحدة، وكل الوضعيات الإنسانية غير المنتجة.
وتتميز مقاربة السارد للموت هنا عن المقاربات المتداولة بنوع من التقبل الاستسلامي، فالشخصيات المهددة بالموت لم تبذل مجهودا لتراوغ قدرها. والعالم المحيط بها، إن وجد، لا يفعل شيئا للتصدي والمقاومة، بل حتى بعد الفجيعة المرافق أصلا للموت لا تجد له أثرا. ومن المعبر في هذا الصدد ألّا تجد في القصتين أي أحداث بعد الموت.
وتتكرر كلمة الموت أيضا في المجموعة الثانية “الرقصة الأخيرة”، ويتكرر التركيز على حتمية الموت، وعدم قدرة الشخوص على الفعل أو التصرف حيالها؛ يقول في قصة الحادثة التي تركّز على لحظة دهس السيارة للشخصية الرئيسية: «لم يعد ثمة وقت لأدنى مناورة. لو أراد فقط أن يشيح بوجهه بعيدا حتى لا يعذبه هول الصدمة، أن يطبق جفنيه في استسلام يساعده على امتصاص قليل من قوة الضربة، لو أراد أن يتنحى قليلا، أو يستدير نحو هذه الجهة أو تلك، لتأتي الضربة في موضع يراه أقل قابلية للألم .. لو أراد مجرد ذلك، فإن الأوان قاد فات!»[5]. وفعلا فكرة فوات الأوان هي التي تكرس نفسها أيضا في القصة التي تحمل على عاتقها اسم المجموعة “الرقصة الأخيرة “. حيث تحكى قصة رجل أخذت الموت زوجته بمجرد زواجه منها، وبقي حبيس الذكرى والحنين. مما يشي بقدرة الموت على توقيف المسارات، ويؤكد عدم قدرة الشخصيات على تجاوز الشرخ الذي تحدثه في حياتهم.
قلق الذات وانفصامها
تعيش الشخصيات الرئيسية حالة من القلق، وانعدام المصالحة مع الواقع تصل درجة الخصام مع الذات والانفصال عنها. ففي “المطاردة” تقوم الشخصية بملاحقة شخص تعرف ملامحه جيدا، ولكنها لا تستطيع مواجهته. وفي الأخير تكتشف أنها كانت تطارد ذاتها بدون أن تتجرأ على مواجهتها، وبدون أن تتأكد من أن المعطيات المحيطة تقول إن الشخصية تلاحق ذاتها. يقول: «سرت نحو الغرفة ببطء .. انتابني خوف بارد وعرتني رعشة، كما حدث عندما اقتربت منه في الشارع، على الرغم من أن هذه اللحظة هي التي انتظرتها منذ البداية .. حاولت أن أسترد تماسكي .. لقد أصبحت الآن أمام الغرفة .. أمامها تماما، إلى درجة أني أستطيع أن ألمس الباب بحركة بسيطة .. رفعت يدي بتردد ورهبة ودفعتها إلى الأمام .. وضعتها على أكرة الباب الباردة ثم جمدت في مكاني .. بعد هنيهة أدرت الأكرة ودفعت الباب الذي انفتح بمهل وأصدر أزيزا وافق هوى غريبا في داخلي .. دفعت جسدي إلى الداخل، وانفرش على وجهي مشروع ابتسامة بلهاء ولكنني ــــــــــــ و يا لهول ما حدث! ـــــــــــــ لم أجد أحدا في الداخل. »[6]
وفي “حدث في مقهى شعبي” تصل درجة انفصال الشخصية عن ذاتها أنه يدخل في طقس الفسخ بحيث يقوم بفسخ كل الوجوه المصطنعة التي علت وجهه، وعندما يتعرف على وجهه القديم يقرر إعادة الاندماج في الجماعة، يقول: «وأنا أستدير لأخرج مغادرا المقهى، واجهتني صورتي المنعكسة في مرآة دون إطار، معلقة على الجدار قرب مدخل المقهى. في البداية فاجئني الوجه الذي بدا لي غريبا، باهت الملامح تفوح منه رائحة “الغمولة” والرطوبة، لكني لما أمعنت التحديق فيه، بدأت ذاكرتي تنتعش شيئا فشيئا، فعرفت بأن ذلك الوجه لم يكن سوى وجهي الذي توارى، لفترة طويلة، خلف الوجوه/ الأقنعة التي تخلصت منها لتوي؛ وجهي الذي استعدته أخيرا، وكنت قد أوشكت أن أفقده إلى الأبد .. ولم ألبث أن بدأت استأنس به وبملامحه التي بدت لي طبيعية أليفة وناطقة بالحياة.»[7] وليس غريبا هنا أن تحدث المصالحة مع الذات وسط مقهى شعبي حيث الألفة وقدرة الذات على إيجاد ذاتها، بدل مقهى الأصدقاء الضاج بالنميمة.
وإذا كانت شخصية هذه القصة قد استطاعت التصالح مع ذاتها، فإن “رجل الكراسي” لم يستطع ذلك، ولكنه ظل يحمل ثقل الكرسي العملاق الرابض فوق ظهره[8].
وتبدو وضعية القلق المزمن للشخصيات طافحة في “الحادثة”؛ فكل الشخصيات قلقة تترقب وقوع شيء لا تعلمه بالتحديد، كما أنها مشغولة بدرجة كبيرة بما يحسّه الآخرون، وما يمكن أن يفكروا فيه؛ “فالحادثة” تحكي عن أب تعرض لحادثة سير، وبقي مستمرا في انشغالاته رغم أنه معلق بين الموت والحياة، إذ تنتظره جلسة محاسبة ابنه، وهو خائف من انزعاج زوجته وابنته إثر الانتظار أو بعد تلقيهم خبر موته، والشيء نفسه يذكر بالنسبة لكل أفراد العائلة.
هيمنة الأشياء و الحيوانات على الإنسان :
يتبوأ الحيوان موقعا أكثر أهمية من الإنسان في مجموعة “رجل الكراسي”، ففي قصة “الرجل والكلب” يستثمر السارد الوصف والعلاقات التقابلية ليعطينا صورة عن “الكلب الضخم النقي” والرجل الذي “يشيع جسده النحيف وسط جلباب أبيض رث”، والمكلف بإمتاع الكلب على حساب مظهره وهيأته، ذلك أن الكلب يبدو مبخترا أنيقا في حين أن الرجل تبقى “هيأته زرية”، ويصل التقابل قمته حينما تصدم العربة الكلب ويموت ولا يقتنع الرجل بأنه كلب، ولكنه يتحوّل هو إلى كلب. وفي قصة “رجل الكراسي” بدأ الرجل بائع الكراسي يصرّ على وجود الكرسي الوهمي الذي يحمله حتى اقتنع السارد بوجوده، واقتنع بحكايته المأساوية، وأصبح يتخوف من أن ينتابه المصير نفسه، يقول: «تقدم بخطوه الوئيد المرتعش وسط الزحام. كان فوق ظهره المقوس كرسي عملاق يجلس فوقه، جنبا إلى جنب، كائنان هلاميان لا ملامح لهما ولا شكل. أحدهما أبيض والآخر أسود .. كان الشيخ يتحرك بوهن، ويجاهد للحفاظ على توازنه وتوازن الكرسي فوق كتفيه. غمرني دوار الدهشة، وتهيأ لي أن هذيان الرجل جعلني أرى شيئا غريبا لم يكن موجودا قط، لكنني أمعنت النظر وأيقنت أن بصري لم يخدعني. لقد كان الشيخ يحمل ذلك الكرسي بالفعل. كالتماعة ضوء خاطفة، لكن متوهجة حادة التوهج، قفز الى ذهني ما قاله لي، في لقائنا الأول، عن الكرسي الذي ينوء بحمله، وأدركت إشاراته الغامضة المستمرة إلى ظهره كانت تتخلل حديثه إليّ.»[9] والفكرة نفسها نجدها في “الرجل ذو الربلة العجفاء” حيث هيمنة الريح.
العجيب والغريب:
لكي تصبح الحقيقة فاقعة تحتاج إلى دفعة من خيال، فالحقيقة والواقع كما هو لا طراءة فيها ولا فجاءة، وتكاد، لفرط حقيقتها وواقعيتها، تبدو عادية مبتذلة. لهذا يلجأ السارد لحظة اشتداد الأزمة إلى العجيب للانفلات من أسر الواقع ومحدوديته، ولإعطاء الوضع العام شحنة جديدة مفارقة للمألوف، ومعبّرة بشكل أكثر قوة عن وضعيات مقلقة، فالتعبير عن الانفصام جعل الشخصية تطارد نفسها، وللتعبير عن مخاصمة الذات لنفسها وحاجتها إلى المصالحة اعتبر الشخصية حاملة لعدة أوجه /أقنعة بمجرد أن وعتها طفقت تنزعهاـ ولم تسترح حتى أزالتها كلها، واستعادت وجهها الأول. ولترسيخ فكرة الهمّ الضاغط على الشخوص، وإيمانهم بعدم إمكانية التخلص منه جعل السارد “رجل الكراسي” الشخصية تحمل كرسيا أينما حلت وارتحلت وكأنه قدرها المحتوم.
والشيء نفسه نجده عندما ينتاب الشخصيات الخوف، أو فوبيا الأماكن المغلقة، حيت صوّر السارد الخوف على هيئة شخصية تطارد الشخصية الرئيسية، وتتربص بها كلما دخلت المصعد. ولم تستطع التخلص منها إلا عندما قهرت خوفها[10].
وتركيز الكتابة عند لحسن باكور على الذات وانفصامها، وعلى العجيب والاختيارات المفارقة للحقيقة، يدرج عالمه السردي ضمن اللحظة الحديثة في مسار القصة العربية التي بدأت تهرب من ضجيج الأيديولوجيا وتركز على الذات، وتبحث عن طرق جديدة لقول الأشياء. وهي لحظة تتقاطع مع لحظة تاريخية عامة أساسها الإحباط، وأفول الإرادة الحرّة في الفعل داخل المجتمع، بحكم ما ترتّب عن سنوات الرصاص من إحباط وانكفاء على الذات، وإصرار الدوائر المسؤولة على المحافظة على وضع بات بائدا وتقليدا متفسخا.
إن الهروب من الواقع واللجوء إلى الخيال يعدّ، والحالة هذه، استجابة لمطلب مزدوج؛ حيث تجد الذات متنفسا لها عبر التخفّف من ثقل الواقع ومعانقة حلم أو طيف خيال، وهذا مطلب أصبح ضروريا لاستمرار العيش. كما يجد القارئ فضاء يتماهى معه ويفرغ من الضغط الذي سبق له أن وقع تحت براثنه.
شخصيات تهوى المراقبة :
تتميز القصة، من ضمن ما تتميز به، وجود شخصية رئيسية، وغالبا ما تكون هي السارد، ولعل في هذا ما يسمح بقراءتها وفق تقاطعاتها والمسارات الموحّدة للشخصيات؛ فأغلب الشخصيات تعيش لحظة التردد، وعدم القدرة على الفعل والمواجهة. وحتى عندما تدخل في مواجهة، فإنها لا تواجه إلا نفسها كما نجد ذلك “حدث في مقهى شعبي”[11]. وعندما تطارد فإنها لا تطارد إلا نفسها. إنها شخصيات تحيا دائما في صراعات داخلية مع ذاتها لا تتجاوز الاحتمال والهواجس الداخلية؛
إن العالم الخارجي قد أرخى سدوله على مجموع الشخصيات، وتركها تتآكل داخليا لا تستطيع مواجهة العالم، ولا ترى المشكل إلا داخلها؛ فرجل الكراسي لاهمّ له إلا تحمل عبء الكرسي الوهمي الذي لا ينفصل عنه. والشاب في “حدث في مقهى شعبي” آثر الانعزال عن الجماعة، وشرع في فسخ الوجوه التي كان يحملها. وحتى عندما لا تواجه الشخصيات ذاتها، فإنها تكتفي بمراقبة العالم من أعلى وبدون تدخل أو مواجهة، حيث تكفيها فقط هواجسها واستيهاماتها لخلق ارتياحها الداخلي، ففي قصة “شجرة النارنج”[12] بقي السارد/الكاتب العمومي يراقب النزاع بين الزوجين، وعندما رقّ لحالهما وآلمه أن يفترقا شرع في نسج الحلول والاحتمالات الإيجابية في مخيلته فقط، واستراح عندما انصرم وقت عمل المحكمة على أساس أن الوقت كفيل بدفعهما للتراجع عن قراراتهما الجنونية.
إن شخصيات قصص لحسن باكور تبقى دائما مأخوذة بقوة خفية هي التي تحرّكها ولا تملك، والحالة هذه إلا الانصياع. وغالبا ما يكون هذا الانصياع لمشيئة شيء وليس شخصا، ففي “الجذبة”[13] كانت الضربات على الطبل ورنات الهجهوج هي من يتحكم بالجموع. وفي “الرجل ذو الربلة العجفاء”[14] وحدها الريح هي المتحكمة في مصير الرجل؛ يقول: « .. وحيدا كان الرجل يمشي في العراء الممتد بلا نهاية. بجسده النحيف الذي تحف به الريح وينقض عليه الغبار، يبدو مثل شبح انبثق من الفراغ الهائل. تصفعه الريح من خلف، فيلتصق جلبابه الفضفاض بجسده، ويلتف طرفه الأسفل بأعلى الساق كاشفا عن ربلة عجفاء مكرمشة. بعمامة يلفّها حول رأسه ووجهه يتقي هجمات الغبار الذي تتحول ذراته إلى إبر حادة اللسع ..”[15].
و الشخصيات إذا لم تكن مترددة مراقبة، نجدها على مشارف الموت أو تعيش أرذل العمر، فلا تبادر إلى الفعل، ولكنها تعيش مأساتها المتجسدة حنينا أو ترقبا مميتا؛ يقول السارد في “شيخوخة”: « تمددا على ظهريهما متقاربين، ثم استوى على جنبه الأيسر، و استوت على جنبها الأيمن.. تنهدت وأرخت أعصابها.. طافت فوق عينيها إغفاءة عذبة سرعان ما استسلمت لها، وبالكاد كان يسمع صوت تنفسها الخافت.. تنهد هو أيضا.. ثنى ركبتيه اليابستين وأدناهما من صدره.. بلّل غصة ناشفة كانت تجرح حلقه.. رقصت أمام عينيه غلالة بيضاء شفيفة، وتلألأت في مقلتيه عبرتان حائرتان ما لبثتا أن طفرتا وانسكبتا على الخدين الناتئين.
و كان هناك صمت.. صمت ثقيل له صدى حفيف هامس ينضح برتابة قاسية.. وكان هناك حزن.»[16]
اللغة :
تبدو اللغة التي يصوغ بها لحسن باكور عوالمه السردية وكأنها لغة صافية ذات اتجاه واحد يبعد اللهجات واللغات المجتمعية، وتسعى هذه اللغة جاهدة إلى فرض صوتها على الأصوات الأخرى، ( انظر الفرق بين الصوت و ) خصوصا حينما تتلبّس لبوس العربية الفصيحة، وتنحو نحو لغة شعرية متميزة، يقول:« لم تخدش خشونة الأصوات بعدُ بكارة الصباح إلا قليلا، فكانت الأغنية تصله كما لو يترنم بها مذياعه، بل أكثر صفاء وشجنا، كأن النغمات تتهادى وتميد إذ تعبر المسافة الفاصلة بين المقهى في الأسفل وبين شقته في الطابق الثاني، متسلقة نبات اللبلاب إلى أن تبلغ الشرفة، لتنداح ناعمة إلى حيث يقف الآن وقد دهمته تلك الرغبة الجارفة..»[17]
ولغة بمثل هذه المواصفات تنمو وسط حوار داخلي مباشر؛ فأغلب القصص مروية على يد السارد العليم الذي يدخل في أعماق الشخصية لدرجة تجعله يعرف ما تفكر فيه. وحين يفصح لنا عن دواخله يورده على شكل أسلوب مباشر محدّد بواسطة علامات الترقيم. يقول: «ارتعشت قدماه فاضطربت الصينية في يده، وتفادى سقوطها في آخر لحظة. ابتسم بسخرية: “انتبه يا رجل! أنت الآن شيخ تقف بساقيك المرتعشتين وسط صالة بيتك، ولست ذلك الشاب المتفجر عافية الذي رقص في باحة دار ذلك العرس القديم”.. ثم انخفض كمن سرقته غفوة»[18].
وقد يتدخل السارد ليتكلم باسم الشخصية، ويورد عبارات يتنازعها التعليق وحوار الشخصية دون أن يستطيع أحدهما أن ينتصر؛ يقول: «لم يلبث الرجل البدين أن تخلّف عن الموكب. أزال سترته الجلدية ورماها جانبا، ثم رفع من وتيرة سيره وهو يعرج بشكل واضح، بسبب حصاة تسربت إلى داخل حذائه، (كأن هذه البدانة اللعينة لا تكفي!) وما فتئت تخزه على نحو مؤلم. تمنى لو يستطيع التوقف لإزالتها..»[19].
عين الكاميرا
من الخاصيات المميزة لتجربة لحسن باكور القصصية هيمنة الوصف ودقته. وكأن السارد يحمل على كتفه كاميرا يرى من خلالها تفاصيل العالم، يقول: «في ظل الجدار العالي تقف امرأة وحيدة .. كانت تنتظر شيئا أو أحدا ما.
لكنها ـــــــ أيضا ـــــــ كانت جميلة .. جميلة جدا وفاتنة!
وأنا كنت أرنو إليها من هناك، يتلبّسني الخوف والترقب، وأنتظر أن تنهار وتتهاوى في أي لحظة!
كانت توشك أن تستند بظهرها إلى الجدار.. إلى جانبها على الأرض حقيبة يدوية سوداء، وفي يدها اليسرى جريدة مطوية بعناية.. بين فترة وأخرى تتعب إحدى قدميها فتتحرك لتنقل ثقل جسدها إلى القدم الأخرى، دون أن تعكس هيئتها وملامحها الهادئة شيئا آخر غير انتظار ما.»[20]
ولحسن باكور يعتمد الوصف لأغراض متعددة أهمها تقديم الشخصيات؛ فالمقطع، المذكور آنفا، يُنْقَلُ بعين السارد الذي يعاين الشخصية ويروي لنا تفاصيلها.
و لا تقدم الشخصية، دائما، هكذا معزولة، ولكنها قد توصف داخل مشهد عام أو إطار؛ يقول: «يكون المساء في أوله، و الشوارع مصطخبة بضجيج المارة وزعيق السيارات المارقة التي تعشى الأبصار بأضوائها المتوهجة .. يلوح فجأة في مقدمة الشارع، يخبط الأرض بنعليه الضخمتين، ويدفع جذعه بارتجاج عنيف إلى الأمام، حتى ليوشك أن يكبّ على وجهه. يسبح جسده النحيف وسط جلباب أبيض رثّ، ويمسك في يده، بانفعال واضطراب، طرف سلسلة تنتهي بطوق جلدي يلتف حول رقبة كلب ضخم نقي، يمشي على أطراف قوائمه باختيال.. »[21]
كما يستعمل الوصف لتحديد الطابع العام، ووضع المتلقي وسط الحالة النفسية، مثلما يمكن أن نجد ذلك في قصة “عصافير الروح” حيث نجد في الأخير تقريرا وصفيا لموت العجوز، ولعصافير روحها التي بقيت تائهة، ثم وصف العجوز الخادمة مرتعشة الأطراف وهي على وشك الإغماء[22].
السارد
لا يعتمد لحسن باكور على سارد واحد، للتواصل مع المتلقي، لكنه يتجاوب مع ساردين متعددين، وهكذا يمكن أن نرصد من أنواع الساردين:
- سارد ذي رؤية من خلف[23]، وسارد مشارك في الحدث[24]. وخارج هاتين الوضعيتين العاديتين نجد تنوعا في وضعية السارد؛ ففي قصة “نظارات سوداء”[25] يعطي السارد الإطار العام للحكي، ثم بعد ذلك يسلم دفّة الحكي لصديقه الذي يحكي ما وقع له، ولا يستلم السرد منه إلا ليعلن عن نهاية القصة. فيصبح لدينا ما يسمى في السرديات القصة المؤطّرة والقصة المؤطّرة. وفي هذه القصة استثمار للسرود العربية القديمة خصوصا كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة.
وفي “الحادثة”[26] يقوم السارد بتوزيع الأدوار بين الشخصيات التي تحكي عن نفسها ودواخلها بخصوص الحادثة، مما يمكن من تقديم رؤية بانورامية عن الحدث في كليته.
والسارد العليم حين يحضر يهيمن على كل تفاصيل النص، ويكشف على كل دواخل الشخصية حتى التي تزال مجرد هواجس؛ يقول: «استغراق الشابين في حديثهما الهامس منح الأربعيني فرصة تأملهما كما يحب، دون أن يخامره الشعور بكونه فضوليا أو متطفلا. “لابد أنهما عاشقان”، قال الرجل لنفسه.»[27]
ولكن في بعض الأحيان يلتزم السارد بدور المراقب عن بعد ليقدم لنا سردا موضوعيا يتميز بتبئير خارجي[28]؛ نجد هذا في قصة “شجرة النارنج” حيث تتكون القصة من مقطعين أولهما فيه وصف ورصد لزوجين يتشاجران تحت ظل شجرة قرب محكمة الأسرة، وقد نقل لنا هذا المشهد كاتب عمومي كما رآه دون أن يضيف شيئا على ما رآه.
خاتمة:
عالم لحسن باكور السردي عالم سوداوي تفصح فيه الذات المعطوبة عن هواجسها التي لم يُسمح لها أن تتجاوز الذات، فبقيت تأكل نفسها ببطء وأناة حزنُها عميق وأساها مترسخ. وخلال رحلتها هذه تتسلح بعين دقيقة المراقبة تجيد التقاط التفاصيل وتبرع في رصد فجيعتها التي أصبحت خارج الذات داخل العالم المحيط. ولأن الذات، كل ذات تحتاج للمقاومة لكي تعيش التجأت الذوات عي هذا العالم إلى الحلم والعالم العجيب لتعمق فجيعتها أو لتقول ذاتها بشكل أكثر رحابة وأشد عمقا.
…………………..
[1]ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، مطبعة وليلي، مراكش، الطبعة الثانية، 2010.
[2]ـ لحسن باكور، الرقصة الاخيرة، سلسلة كنانيش مراكش، الطبعة الاولى، 2016.
[3] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 57.
[4] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 18، 19.
[5] ـ لحسن باكور، الرقصة الأخيرة، ص: 40.
[6] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 11.
[7] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 44.
[8] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 53.
[9] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 52.
[10] ـ لحسن باكور، الرقصة الأخيرة، ص: 7.
[11] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 34.
[12] ـ لحسن باكور، الرقصة الأخيرة، ص: 103.
[13] ـ لحسن باكور، الرقصة الأخيرة، ص: 69.
[14] ـ لحسن بكور، الرقصة الأخيرة، ص: 81.
[15] ـ لحسن بكور، الرقصة الأخيرة، ص:81، 82.
[16] ـ لحسن باكور، الرقصة الأخيرة، ص: 57، 58.
[17] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 57، 58.
[18] ـ لحسن بكور، الرقصة الأخيرة، ص: 62.
[19] ـ لحسن بكور، الرقصة الأخيرة، ص: 36.
[20] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 13.
[21] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 21.
[22] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 19.
[23] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 12.
[24] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 34.
[25] ـ لحسن باكور، رجل الكراسي، ص: 28.
[26] ـ لحسن بكور، الرقصة الأخيرة، ص: 39.
[27] ـ لحسن باكور، القصة الأخيرة، ص: 27.
[28] ـ انظر قاموس السرديات، ص:26.