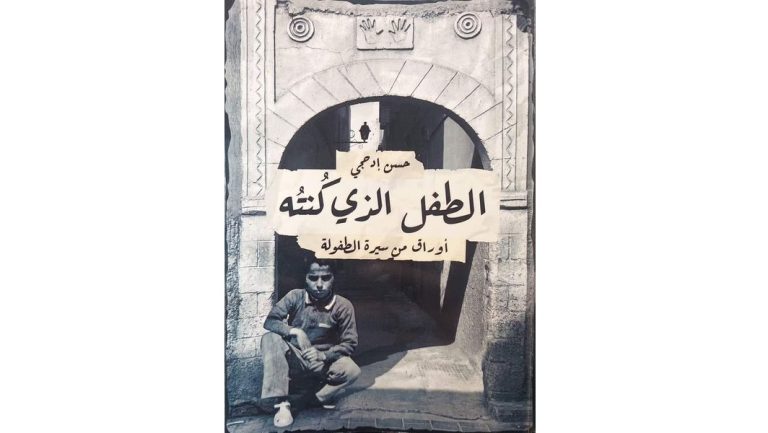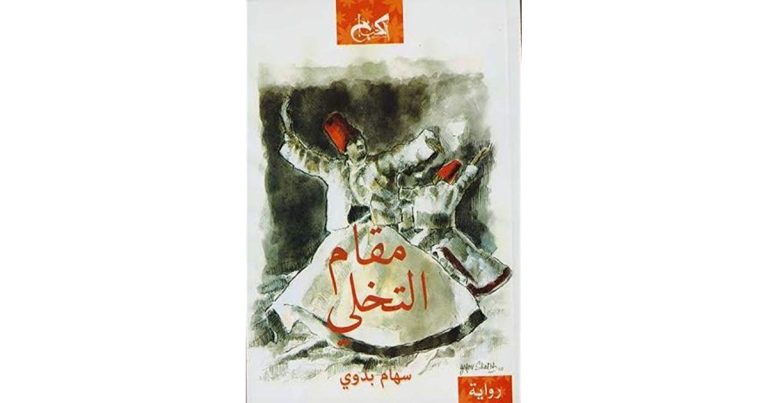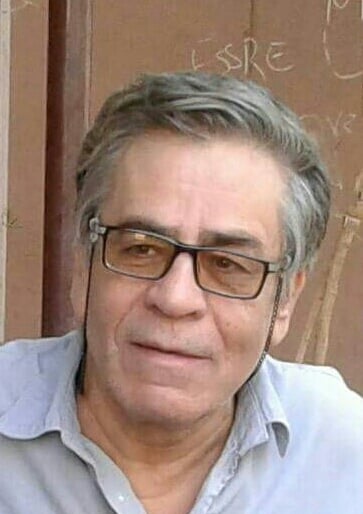كان يمكن أن يخلص قارئ “عن الذي يربي حجرا في بيته” من قراءته لها وقد اطمأن إلى أن هذا الزمان الذي نعيش و”الطاهر شرقاوي” فيه لا يزال قادرا على إنتاج شخصية روائية كراوي هذه الرواية الذي يفكر في تغيير مسكنه وينتقل إلى مسكن جديد ميزته الأساسية أنه يمكن النظر منه إلى القمر. والذي يستلقي في حديقة بالليل فيرى على القمر فتاة تشير إليه. والذي يقابل في أحلامه فتاة، وتقابله في أحلامها نفس الفتاة، ويشرعان في الاتصال بأحدهما الآخر في غير عالم الأحلام مستخدمين موبايلات عادية كالتي بين أيدينا جميعا.
شيء يبعث على الطمأنينة أن نرى هذا الزمان يفرز شخصا يكلمه الحجر، والنمر المرسوم على عباءة امرأة، وتستجيب الكلاب لطلبه المهذب بالسماح له بالمرور بينها في أمان (شيء مطمئن في حد ذاته أن ينتج زماننا شخصا مهذبا)، وتستعير الجان كتبه وتردها بعد أن تقرأها (وهي مغرمة غراما خاصا بأعمال أمل دنقل الكاملة!!).
شيء يدعو إلى الطمأنينة طبعا، ولكننا نعيش في زمن أقل ما يوصف به ـ وعن جدارة ـ هو أنه باعث على القلق.
***
لا نعرف اسما للراوي في هذا الكتاب. هو يقدم لنا نفسه بوصفه كاتبا ورساما متخصصا ـ حتى الآن ـ في القصص المصورة، ومقتني لوحات، وكتبا، وحجارة، إلى جانب تفاصيل عديدة أخرى. ولكنه لا يجد داعيا لأن يكون له اسم. ربما لأنه حصل على ميزة أن يكون صاحب الحق الوحيد في هذه الرواية أن يقول “أنا”.
يلاحظ ميلان كونديرا في مقال له ضمن كتابه الأحدث “لقاء” أن أغلب أبطال الرويات العظمى ليس لهم أبناء. وقد خطرت لكونديرا هذه الملاحظة وهو يقرأ “مائة عام من العزلة”، حيث الكولونيل بالفعل ليس له أبناء.ولكن له اسما، هو أورليانو بوينديا، ورتبة عسكرية، وسيرة حياة طويلة عريضة، ومدهشة.
كونديرا يلاحظ أن عقم أبطال الروايات العظيمة عن إنجاب الأبناء يكشف في “الرواية” (الرواية الأوربية طبعا فكونديرا واضح جدا في هذه المسألة) عن انحياز للفرد، وإعلاء له، وإيمان بأنه وحده هكذا، جدير بالبقاء، جدير بأن يكون مبتدأ حكاية ومنتهاها، جدير في ذاته بخلود من نوع ما، غير الخلود الرمزي الذي توفره له الطبيعة إن تهيأ له امتداد بيولوجي.
هذا إذن هو اقتراح “الرواية” في مقابل اقتراح “الطبيعة” بحسب ما يلاحظ كونديرا. والحق أن أولى روايات الدنيا، روبنسن كروزو، تقول مثل هذا، بل ترينا إياه بأعيننا، على مدار صفحات الرواية كلها، ترينا مقدرة الفرد على الاستقلال عن كل من في العالم من أفراد موجودين فعلا، ناهيكم عن أفراد محتملين.
فهل الرواية التي يتكلم عنها كونديرا هي التي كتبها الطاهر شرقاوي؟ أهي الرواية المنحازة فلسفيا للفرد في مقابل المجتمع بسلطة ما استقر لديه من مفاهيم ومعايير؟ ألأن الشخصية الرئيسية هنا هي لشاب منعزل عن المجتمع مكتف بتأملاته وبمراقبة العالم، ونفسه، وجسمه وقطرة العرق التي تتفجر من تحت ثديه وتهبط حتى تختفي “في منطقة السرة” (يا له من تعبير)، وذاكرته، وأحلامه، تكون هذه هي الرواية التي يتكلم عنها كونديرا؟
***
“عن الذي يربي حجرا في بيته” هي العمل الروائي الثاني للطاهر شرقاوي، بعد “فانيليا”، وبعد عدد جدير بالإعجاب من المجاميع القصصية التي نشرت جميعا خلال العقد الماضي. وكان “جمال الغيطاني” ـ فيما أذكر ـ قد قال في حق فانيليا ما معناه أنها رواية “جديدة” بحق، ومن جملة الأسباب التي دعته إلى تقليد الرواية وسام الجدة هذا هو أن بطليها بغير أسماء، بل يشار إليهما دائما بضمير الغائب هو وهي ـ إن صحت ذاكرتي.
حسن، ها هي ذي رواية أخرى لا نعرف لراويها وشخصيتها الرئيسية اسما، ولا لأي من شخصياتها (إن جاز وصف عابري الرواية وعابراتها بالشخصيات أصلا)، اللهم إلا الحبيبة (أو الأنثى وحسب)، فكل من الشخصيات التي تظهر عرضا في الرواية يشار إليها بـ س، س الجارة، وس الجارة الأخرى، وس البائع في الطريق، وس مصاص الدماء، وس الصديق، وس النادل. وكأن “الآخر” في نظر الراوي هو مجردنمط يتكرر دون أي تمايز أو اختلاف يستوجب تسميته باسم، أو حتى منحه رمزا مستقلا، وكأن الآخر (ولا أقول “الآخرين”) متعدد ولكن في غير تنوع. هكذا إذن يحكم الراوي على كل من يحيطون به بالنفي إلى أقصى أطراف دائرة انتباهه. وهكذا يعمد إلى تجهيلهم، دون أن يمنحنا فرصة لإحسان الظن به، وافتراض أنه يجهل مواطن تفرد هذه الشخصيات، ولا يفطن إلى ما بين أحدهم والآخر من تمايزات، فالراوي يرى بوضوح، أن هذه الجارة بالذات ترتدي عباءة يركب ظهرها نمر، ويعرف عنها بعض الحكايات، بل إنه يعرف أن زوجها الميت يظهر في شقتها متجولا بملابسه الداخلية باحثا عما لا يعرفه أحد (بشكل شخصي أعتقد أنه في الغالب يبحث عن بقية ثيابه)، ويرى أن من البشر من يستحقون وصف “مصاص الدماء” ويعرف عنسماتهم الكثير، ولكنه حينما يأتي وقت الكتابة، أو البوح، أو إعلامنا بالعالم كما يراه، فإن الجميع يصبحون لديه سواء: كلهم يجري تقليصهمإلى س.
وذلك ما يمكن اعتباره عدواناعلى الآخر ـ وإن يكن غير معلن الأسباب.
***
المصادفة وحدها جعلتني خلال الأيام التي قرأت فيها الرواية مشغولا بمصطلح Misanthropy، أو مشغولا بترجمته العربية بالأحرى. كنت أترجم عرضا نقديا كتبه الشاعر الأمريكي “آدم كيرش” عن كتاب موضوعه مركزية كراهية اليهود في الثقافة الغربية. وانشغلت وبعض الأصدقاء على الفيسبوك فيما إذا كانت “البِرَّاوية” هي الكلمة المثلى لترجمة المصطلح. ويبدو أننا أجمعنا على صلاحية الكلامة لولا عاميتها.
فهل يصلح هذا المصطلح في توصيف حال الشخصية الرئيسية في هذه الرواية، الشخصية التي لا أجد أدنى غضاضة في الإشارة إليها ـ ولو من قبيل التسهيل في الكتابة إن لم يكن من قبيل رد العدوان بمثله ـ بـ س؟
يرد في ويكبديا أن الـ Misanthropyهي كراهية البشر وعدم الثقة فيهم وازدراؤهم. ويرد في مقال آدم كيرش أن هذه تهمة ألصقت باليهود، إذ أشيع عنهم أنهم يتخذون هذا الموقف من كل من عداهم، أي الأغيار بحسب المصطلح اليهودي.
***
أصلب ما يمكن أن تستند إليه فكرة البراوية أو النفور من البشر هذه هي تركيبة مصاص الدماء الذي يقدمه لنا الراوي، لا بوصفه شخصا، بل بوصفه نمطا، وظيفة، نوعا من البشر، ولكنني عن نفسي لم أستطع أن أجد في مصاصي دماء الرواية ما يبرر تسميتهم هذه. إن كل ما يفعلونه هو أنهم يستعينون بالراوي أو بغيره على كسر وحدتهم، يصطاده الواحد منهم من الشارع، ويسوقه إلى المقهى، وهنالك يكلمه. مصاصو الدماء في الرواية لا يمصون دماء ضحاياهم، بل يمنحونهم من حكاياتهم، ولعل جريمتهم هي أنهم يعتدون على أوقات غيرهم، ولعل خطيئتهم التي جعلتهم يستحقون هذه التسمية هي أنهم يخدشون وحدة شخص كالراوي يقدس الوحدة، يقدس ذاته. مصاصو الدماء في هذه الرواية بشر عاديون يمكن القول إنهم لا يجدون في وحشة المدينة(وربنا يسامحني) من يأنسون إليه فيقتحمون الآخرين طلبا لحقهم الإنساني (والمجتمعي بالمناسبة) في الائتناس. مشكلتهم التي حولتهم إلى مصاصي دماء في نظر الراوي هي أنهم ليس لديهم من الخيال مثل ما لديه هو.
ولكنه سند غير صلب بالقدر الكافي ذلك الذي يستند إليه توجيه الاتهام للراوي بالبراوية، أو النفور من البشر. فنحن نجد لدى الراوي ـ برغم نفوره من خادشي وحدته ـ أصدقاء، ومنهم من دخل بيته وكتب فيه شعرا، بل إن الراوي نفسه يحرص على هذه الصداقات، إلى حد أنه يكتم عن أصدقائه بعض أحواله (فلا يحكي مثلا لأحد ـ غيرنا ـ أن فتاة أشارت له من على القمر، أو أن جانا تشاكسه وتخفي عنه أقلامه).
فهل لهذا التناقض ما يفسره؟ الحق أن هناك إجابة لسؤال التناقض هذا ولو أنني لا أعرف إن كانت الرواية تقترحها فعلا: وهي أن س لا يكره البشرـ
برغم عدوانه عليهم بالتقليص إلى س أو بوصفه فقراء الخيال منهم بمصاصي الدماء ـ إلا أنه لا يكرههم بقدر ما يفضل عليهم نفسه، لا يتعالي على الوجود معهم، ولكنه يحب أن يكون مع نفسه أكثر. وهو في موضع ما من الرواية كان يطل من شباك مسجد على ما اعتبره “الجنة”، ولكنه زهد في الجنة بمجرد أن سمع خطوات قادمة.
تلك إجابة كافية لي، لا كشخص، بل كنوع من القراء. الراوي يحب نفسه أكثر مما يحب الآخرين، ويحب أن يبقى معها أطول وقت ممكن، خاصة وأن كل ما يريد أن يقوله لها هي تعرفه، ومن ثم لا ترهقه وتستنفد طاقته.
نوع القراء هذا يتقبل منذ عقود تحول جريجوري سامسا إلى حشرة. انظروا منذ كم عقد من الزمن ونحن نقرأ “التحول” ونتحاكى بها، برغم أن أحدا لا يمكن أن يقطع بكيف ولماذا تحول هذا الإنسان إلى حشرة. استعرضت الرواية ـ أو هي عرضت لما كان من أمر حياة جريجوري قبل التحول، واستعرضت حياته الجديدة بهدوء: طعامه الجديد، ونشاطه الجسدي الجديد، والتغير الذي طرأ على رؤية أهله له، وعلى الأهل أنفسهم من جراء تحوله. بدون أن تمنحنا السبب الذي أدى إلى هذا المصير لجريجوري. إنه ليس مرضا حتى.
بل إن هناك من يصل إلى حد رفض أي “تأويل”لهذا التحول أو اعتباره رمزا لأي شيء. فهذا التحول هو ببساطة دليل على أن هناك قانونا آخر،لا نعرفه، هو الذي يسري على ذلك العالم المسمى بـ “التحول” لكافكا.
لكن، برغم حجر يتكلم، لا يبدو أن هذه الرواية مكتوبة لهذا النوع من القراء
***
أريدج أن أرجع إلى الرواية التي تكلم عنها كونديرا.
هل تحترم رواية الطاهر شرقاوي هذه فرادة راويها، وخياره،وإيثاره العزلة دونما مبرر سهل، دون أن تكون لديه مثلا مآخذ ـ معلنة ـ على المجتمع وبنيته وسلطاته ووعيه؟ هل استوعبت الرواية أن يكون هناك شخص كهذا؟
لقد تعاملت الرواية مع نزوع الراوي إلى العزلة بمثل الريبة التي يتعامل بها مجتمع يريد ـ إلى درجة الفيسبوك ـ أن لا يترك أحدا وشأنه، وأن لا تغيب عنه فكرة تخطر لفرد من أفراده، أم أقول استيتس. لم تتقبل الرواية عزلة الراوي، فقدمت نفسها بوصفها تقريرا عن طبيعة هذه الحالةوأسبابها.
***
مرة كتب تشارلز سيميك وصفة لصنع قصيدة حديثة من قصيدة كلاسيكية، فقال ما معناه:
احذف مناجاة ربة الشعر في المطلع، والحكمة والدرس المستفاد من الخاتمة، تبق بين يديك قصيدة حديثة.
وبدوري أستطيع أن أتخيل المحذوف من “عن الذي يربي حجرا في بيته”. الفصلين الأول والأخير. الفصل الأول الذي يقتنع فيه الراوي بأن يحكي للطبيب النفسي كل شيء، والفصل الأخير الذي يشخص فيه الطبيب حالة مريضه.
نعم، بقدر ما تمتلئ الرواية بما يؤكد تميز الراوي عن بقية الناس في الرواية وفي العالم الواقعي، بقدر ما تضع بين أيدينا بإصرار أدلة متتابعة على أنه باختزال مجرد شخص مريض، بحاجة إلى طبيب نفسي ـ كما تقول له سيرين صراحة.
ما الذي سوف يبقى الآن بعدما انتهى الراوي، وقام من على الشيزلونج؟ لم يبق إلا أن يقول له الطبيب في فصل أخير محذوف بدوره:
ـ أتعرف يا س لماذا لم يظهر اسم أو رقم على شاشة موبايلك عندما اتصلت بك سيرين؟ لأنه لا وجود لسيرين يا س. سيرين هي أنت يا س، هي الشخصية التي اخترعتها في أحلامك لأنك مريض بالشيزوفرنيا يا س ولا بد من علاجك. الحجر لا يتكلم يا س، والستارة لا ترقص. ولكن أنت مصاب بالهلاوس السمعية البصرية يا س. والجان ـ اللهم احفظنا ـ لا وجود لهم أصلا يا س. والطيور في السماء لا هي سعيدة ولا هي تعيسة، هي تعيش وحسب. والقاتل المأجور سوف يدخل السجن ثم النار. وأقلامك لا تختفي لدى الجان ثم تظهر في غير أماكنها ولكن لك ذاكرة من التريكو يا س.
أو هكذا أتصور
***
وتبقى “عن الذي يربي حجرا في بيته” رواية جميلة،مكتوبة بمهارة، وبلغة سلسلة أصبحت علامة شرقاوي التجارية، وتبقى أيضا أقدر على الاننتماء إلى عالمنا هذا من راويها البراوي الصامت في البرية.