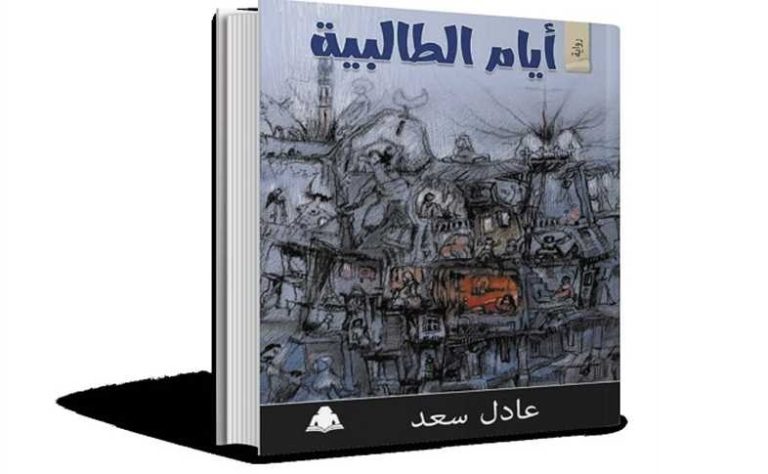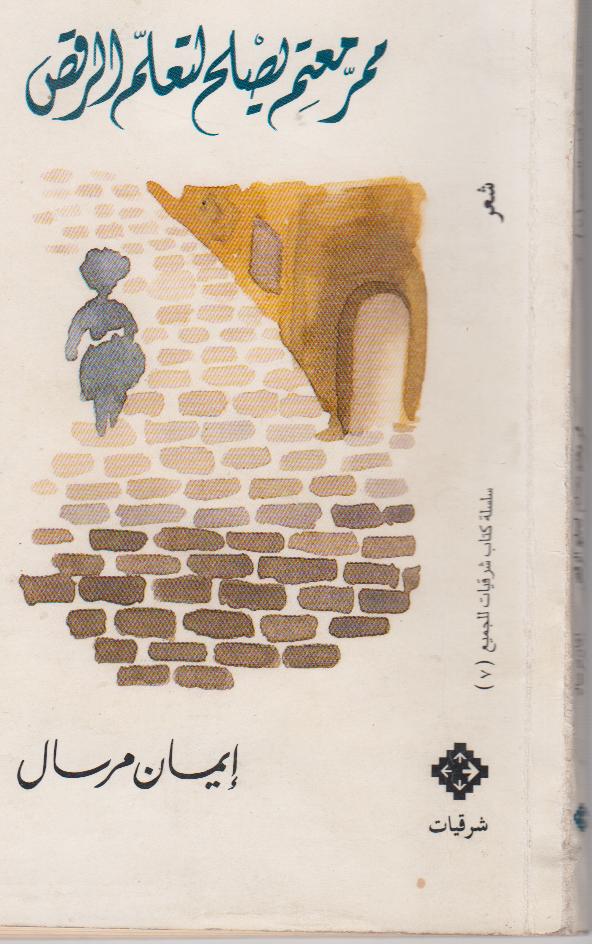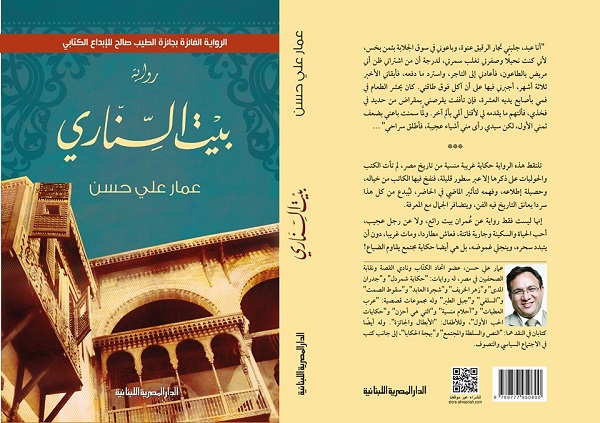د.شهد هشام الشنديدي
في المجموعةِ القصصيةِ (يجري في ملابسهِ كالضِّلِّيل) يُدهشكَ عالمُهَا القصصي ويربِكُكَ أحيانًا، فتبدو مضطربًا قلقًا مع القراءةِ الأولى؛ ثم لا تلبث أن تنفتح لك مغاليقَ النص، ويبدأ في التَكَشُّف شيئًا فشيئًا مع قليل من التدبر وإعادة القراءة، فكلُ قصةٍ في المجموعة تأخذك في رحلةٍ عميقةٍ، تدهشك بجمالِ أسلوبها وعمقِ لغتها، وتفتحُ آفاقًا جديدة للخيال؛ فيستكمل القارئ أحداثَها الظاهرةَ والباطنة، بعد أن يكشفَ الكثير من هذا المعمار القصصي الغرائبي، ويبقى ما خفي من أحداث ودلالات أعظمَ مما ظهر منها.
ولكلِ قصةٍ سراديبٌ متشعبةٌ يسيرُ معها القارئ: فمنهم من يُحيطُ بها، ومنهم مَن لا يدرك أبعادها، والقارئ لقصص حسين عبد الرحيم لابد أن يكون يقظًا منتبهًا وهو يسبر أغوار عالمه السردي حتى يتسنَّى له الحصول على المتعة السردية التي يبغيها، فكل جملة سردية تفتح باب التأويلات على مصراعيه؛ وتنشطر معه الدلالات المتباينة؛ لذا حين يُقدِمُ القارئ على قراءة مثل تلك النصوص يجد نفسه مصطدمًا بخطاب سرديٍّ من نوع خاص، وهذا الخطاب ربما يحتاج أن يُقْرَأ غير مرَّةٍ، وكل قراءة في الحقيقة تُعطيكَ دلالةً جديدةً وفق بناء قصصي قوامه الرئيس الإدهاش والتجريب مع الاعتماد على الحلم وتداعي الصور وتواليها على ذاكرة المبدع بأسلوب غرائبي عجيب.
وقد سُطِّر ذلك في ظهر الغلاف حين قيل: “يُفاجئنا الكاتب ببناء تجريبي مدهش، مع لغة رصينة يُطوعها في قوالبَ مختلفة، ما بين السيرة والحلم والتَّخييل، وبالولوجِ في بداية إحدى القصص، نجد أنفسنا تائهين في دهاليزيها السردية، مستمتعين بالتفاصيل، مشدوهين من تفرعات أفكارها التي لا تنتهي.”
-جاء عنوانُ المجموعةِ يحملُ هذا الإبهام “يجري في ملابسِه كالضِّلِّيلِ” فهو تعبير مجازي ينفتح على عدة تساؤلات تباغت القارئ وتجعله في حيرةٍ من أمره؛ خاصةً بعد أن جاء بالفعل (يجري) وأهمل تعيين الفاعل متعمدًا؛ فدفع مَن يقرأ العنوان أن يتساءل متعجبًا عن الفاعل المراد بسؤال مفاده: “من هذا الذي يجري في ملابسه كالضليل؟! ثم مَن الضليل هذا الذي يشبهه؟! وما أشكاله؟! ولماذا وصفه بهذا الوصف؟! وهل هو شيء يجري داخل ملابسه؟! أم هو تعبير يعني تعدد الصور التي يظهر بها؟!
أسئلة كثيرة لن تجد إجاباتها واضحة وأنت تقرأ عتبة العنوان، فتدخل لقراءة النص وليس بجعبتكَ غير عدة تساؤلات تخلق عند القارئ فضولًا من نوع خاص يدفعه إلى مزيد من التَّأنِّي قبل التَّأتِّي لهذا العالم القصصي الغريب.
وفي الحقيقة نجح المبدع- من وجهة نظري- في اللَّعب مع القارئ تلك اللُّعبة الذَّكية؛ فلم يعطهِ مفاتيحَ نصوصهِ في العتبةِ الأولى وإنَّما دفعه دفعًا للولوج إلى النصوص علَّه يحصل على مرادهِ بين صفحات المجموعة، وكأنَّه يوجه إليه رسالة مفادها: اتركْ لخيالك العنان واسبَحْ بين أحداث كل قصة على حدة، وستجد ما يَسُرُّك.
وأضاف لغموضِ العنوان غموضًا آخر، في الصفحة الافتتاحية للكتابِ حيث قال: “الرجلُ الذي خاصم أهل الأرض بمداومة النظر إليهم صامتًا، حدثني قبل الفجر عن صعوده إلى السماء كل مساءٍ، من فوق سطح المنزل القديم الذي تهدَّم، فأحيا ظلال رؤيتي لأشباح الماضي”[المجموعة: ص5].
فذكره للصُّعودِ إلى السماء، وسطح المنزل القديم المُتَهدِّم، وأشباح الماضي، تفتحُ آفاقَ الخيالِ على مصراعيه؛ لتجهزَ ذهن القارئ للولوج إلى هذا الإبداع.
-اعتاد الكُتَّاب أن يعنونوا مجموعاتهم القصصية بعنوان أبرز قصة في المجموعة، لكننا لا نجد عنوان المجموعة بين عناوين القصص، غير أن الكاتب استخدم ألفاظه في قصة (خمسة وستون عامًا) حين قال: “كنتُ أذاكر على ضوء لمبةٍ شبه معتمةٍ، قبل أن نعود إلى بلادنا التي لم تَعُدْ، لأنَّ أبي جعلني أمضي عمري كله وحدي، أجري في ملابسي، مرة في بنطلون وأخرى في جلباب، كالضليل مقطوع الطرف، يخبئ وجهه من عفاريت العتمة، وحبيبات مراهقات يلطمهن الهوى ووجع البعاد وقت الغروب، فتتبدد أحلامهن بالأمومة.”[المجموعة: ص21]
وهو في النَّصِ السابقِ وفي القصة الثالثة من المجموعة يُعلن عن النص الذي استقى منه اسم مجموعته، والذي يكشف كثيرًا عن تلك التساؤلات التي طُرِحتْ مُسْبقًا؛ ويدفعنا إلى قراءة هذا النص غير مرة؛ لربما نُمْسِك بِطَرْفٍ رفيعٍ من الخيط الذي يربط بين قصص المجموعة كلها.
وحين نقرأ هذه القصة نجد تناصًا واضحًا وجليًّا بين شخصية الضليل المشار إليه في المجموعة وبين امرئ القيس الملقب أيضًا بالملك الضليل، وهو ما يجعلنا نعطي عدة تفاسير منها: أن الكاتب ربما استخدم هذا التناص للتشابه بين الشخصيتين، فصاحب قصة (خمسة وستون عامًا) نشأ في بيئةٍ بائسةٍ، فأبوه أفقده الذاكرة دون أن يقصد عندما دفعه ببوز حذائِهِ في رأسهِ ليسابق الأيام، وامرؤ القيس طردَهُ أبوه وأقسم ألَّا يقيم معه من شدة سُكْره، فَهَامَ في الأرض حتى بلغه نبأ مقتل أبيه، فهب ليثأر له، وقال مقولته الشهيرة: “ضيَّعنِي صغيرًا وحمَّلنِي دَمَه كبيرًا”.
فالشخصيتان يجمعهما العنف الأبوي، وكلاهما تائهٌ في دروبِ الحياة ولهما سقطاتٌ وغدراتٌ، ومن هنا اشتركا في لقب الضليل، والضليل ليس مقتصرًا على صاحب الخمسة وستين عامًا فحسب، إنما نراه سمتًا في كثيرٍ من شخوصِ القصص؛ وبذلك نكون قد أمسكنا بطرف الخيط أو ربما بذلك اعتقدنا.
–أما عن تصميم الغِلافِ فحمل أيضًا الغموض، فهو في صورةِ رجلٍ مُقَسَّمٌ لنصفين: أقدامه على الأرضِ، ونصفه العلوي يحلِّقُ في السماء بعد أن فرد أجنحته القوية، مستخدمًا من الألوان: اللون الأسود في رسمِ الرجل، فهو لون يدل على الغموض، والتمرد، والجاذبية، والعمق، والتحدي، وفي الوقت ذاته يرمز إلى الاكتئاب والموت والشر، وهو بذلك يؤكد لنا أن فكرة الغلاف توافقت مع الفقرة السردية السابقة، وألمحت بطرفٍ خفيٍّ إلى عنوان المجموعة القصصية.
واللون الأحمر في كتابة العنوان ورسم الجناحين؛ حيث يعتبر اللون الأحمر لونًا قويًّا مع دلالات إيجابية وسلبية. على الجانب الإيجابي، يمثل القوة والعاطفة والثقة، لكن يمكن أن يكون سلبيًا؛ حيث يمثل الغضب أو الحذر أو الخطر.
- جاءت المجموعة في تسع وثلاثين قصةً مُقَسَّمةً إلى ثلاثة أقسامٍ: القسم الأول: بعنوان “النارُ التى أشعلَت الحواسَّ” ويحوي ثماني قصصٍ.
القسم الثاني: بعنوان “سِفْر الأحلام والتوهمات” ويحوي خمس عشرة قصةً.
القسم الثالث: “الركض فوق الجسور” ويحوي ست عشرة قصةً.
وعناوين الأقسام تبدو لمَن يقرأها ملغِّزة، تنفتح على العديد من التـأويلات، وتتخذ من المجاز تُكأةً لها، فضلًا عن الإشارة إلى الأحلام والتَّوهمات، وجميعها كفيلةٌ بإثارةِ ذهن القارئ حتى دون الدخول إلى تلك الأقسام وتفاصيلها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، (واحد بورسعيد – الأرض الواطئة – رجْرجة – نصف ثمرة جوافة – ظلال الأرواح – ريميني – نداء الليل)، كما جاءت العناوين معبِّرةً عن فحوى كل قصة، ومفتاحًا لعالمها.
-ظهرت التجربة الذاتية الحياتية المعاشة للكاتب حسين عبد الرحيم في بعض القصص بصورةٍ جليَّةٍ واضحةٍ، لا يمكن أن ينكرها قارئٌ لأعماله؛ ففي معظم القصص نجده حاضرًا بذاته وباسمه، ويتمثل ذلك في قصة (عمر الحمزاوي)؛ إذ ذكر الكاتب اسمه أثناء حضور عرضٍ لفيلمِ (الشحاذ)، للمخرج السينمائي حسام الدين مصطفى، وقصة نجيب محفوظ، في إحدى صالات السينما؛ حيث قدمه المؤلف للمخرج قائلًا: “قال المؤلف: اللي حضرتك متعرفوش يا حسام بيه إن حسين عبد الرحيم بورسعيدي، ودارس سيناريو، وجه النهاردة عشان يتعرف عليك، ياريت نبدأ بحسين.” [المجموعة: ص28]، وكأن الكاتب يحكي موقفًا حقيقيًّا حصل معه.
ويذكر الجد الكبير عبد الرحيم في قصة (محطة) أثناء استدعائه للماضي – حيث قام بناء القصص عليه -، يقول: “حقول الفواكه ورائحة المانجو وبريق العنب النباتي المبدور فوق طريق إسفلتي، ليل مظلم في بلاد بعيدة، أمي وأبي، عبد الرحيم الكبير، القابع في الزمن البعيد، يشمُّ رائحة الشواء ويأكل اللحم الطازج…. طفولة وصبا ورجولة وشيخوخة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يناير 1973، طير جريح يحلق في سماء رمادية قاتمة يبحث عن وادٍ غير ذي زرع.” [المجموعة: ص137]، وكأنه في حالة حسرة وندم على ما مضى.
وفي قصة (خمسة وستون عامًا) يحكي عن معناته هو وأشقائه قائلًا: “عُمْرٌ حقيقيٌّ عشتُهُ، أنا وأشقَّاء طالتهم نفس السموم المُهلِكَة، عندما بدأ أبي الهالك فرض سطوة الغشم على عالمنا، كان فقيرًا عفيًّا، ذات يومٍ، أفقدني الذاكرة دون أن يقصد، دعاني إلى الاندفاع لأسابق الأيام، عندما دفعني ببوز حذائه في رأسي، وُلِدَتْ أشباحٌ تخاف ظلِّي، وجهامة شقيقي الأكبر الطائش، وقت أن كنت طفلًا يحلم بأن يغِّير العالم، أن ينير عمودًا واحدًا في بلاد الهجرة.” [المجموعة: ص21]؛ وربما دفع ذلك القارئ أن يتساءل بينَه وبينَ ذاتهِ هل ما كُتِبَ في النصوص السابقة يتعلق بفن السيرة الذاتية للكاتب أو بعضًا منها؟ أم هي حيلة سردية أخرى من حيل الكاتب يمارسها مع القارئ رغم إمداده بهذا الكم من المعلومات التي تبدو حقيقية واقعية؟
– أضفى الكاتب كذلك الواقعية على بعض قصصه، فذكر شخصيات فنية كثيرة مثل: المخرج السينيمائي حسام الدين مصطفى الذي لقبه بصَاصَا كنوع من الألفة والحميمية بينهما، وتماهى معه قائلًا:” كان الفارس الهمام بالنسبة لشخص مثلي محب للسينما” [المجموعة: ص 25]، وذكر نجيب محفوظ وحوار متخيل معه، “قُلي يا نجيب بيه، ما الفارق بين النيل والبحر؟ كتبتَ عن الإسكندرية في “ميرامار” و”الشخاذ” و”السمان والخريف” وشهد النيل وكبائنه ثرثراتك مع الرفاق.
–قُلي إنت يا عبد الرحيم، البحر دنيا تانية يا عم نجيب.
النيل محفوظ، وأنا مولود في بحر بورسعيد.
نجد هنا تأثرًا واضحًا بنجيب محفوظ حتى إنه سمى قصة (عمر الحمزاوي) على اسم الشخصية في رواية الشحاذ، بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك؛ حيث نجده في قصة (دائرة الرحلة) يقول على لسان البطل: “أنا ظل عمر الحمزاوي، سئمت الحياة، الخريف في غمامة أنا، وُلدت شقيًّا بلا ذنب، عيني كليلة، رمدي يطول.” [المجموعة: ص 87]
كما ذكر يوسف شاهين (جو)، والمطرب عبد العزيز محمود، والكاتب الفرنسي ميلان كونديرا، الموسيقار المشهور فاجنر، والكاتب الروائي والمخرج الأمريكي بول أوستر، والممثلة الأمريكية ميريل استريب، ورواية صخرة طانيوس للكاتب اللبناني أمين معلوف وجعلها عنوانًا لقصة بالمجموعة، ورواية (كل الأسماء) لجوزيه ساراماجو، مسرح العبث لبيكيت.
وذِكر هذه الشخصيات والأعمال الروائية يكعس ولع وشغف مبدعنا بالسينما خاصة والفن عامة، ودليلًا على ثقافته المتشعبة؛ وهو في توظيفه لتلك الشخصيات لا يقف عند وصفها الخارجي أو سماتها، وإنما يتعمق فيها ويحاورها ويجاوبها؛ فتبدو حية من روح ودم، نسمع كلامها، ووقع أقدامها، في المتن القصصي بعد أن يَبْعثها من مرقدها؛ مما يضفي جمالًا وحيوية على السرد، ويخفف من حدته على القارئ.
-يمكن اعتبار قصص (يجري في ملابسه كالضِّلِّيِل) قصصًا سيكولوجية؛ إذ تصور مشاعر أبطالها وتجاربهم، وتعكس أفكارهم الداخلية، وتصل إلى أعماق النفس البشرية فتتحدث عن أشياء خفيَّة فيها، فعلى سبيل المثال قصة (الأرض الواطئة)، رسم فيها مبدعنا لوحةً فنيَّةً رائعةً بطلها الألم الذي يبدو طافحًا وأكثر بروزًا في هذه القصة، وهو يؤنسنهُ ويشخِّصهُ – وهي سمة مميزة في البناء السردي للقصص- فيجعله زائرًا ثقيلًا غشيمًا جهولًا، “ينخر في عظمه منذ شهور تخطت الثلاثين، صار للوخز مجاري وقنوات ما بين عضلات الساقين، من الخلف ومن الأمام، في سمَّانته اليسرى فاليمنى، تتمدد الآلآم، تتناوش منذ أكثر عامين، هي الآن تسكن أيضًا فتحتي الأنف، بات هناك مجرى يستقبل العدم، غير العوادم السامة يستنشق رائحة الدم المتخثر التي زادت في أيامه الأخيرة، بعد نزوله للأرض” [المجموعة: ص 41].
فهو يجعل من الآلام كائنًا يتمدد ويناوش جسمه النَّحيل متعدد القنوات والألم ومجاريه، فهذه الفقرة تنحت بدقة علامات الألم التي بدت على البطل من أسفل قدميه حتى أعلى رأسه؛ كما اعتمد الكاتب في (الأرض الواطئة) بصورةٍ رئيسيةٍ على فكرة الهذيان، أي أنَّه ينقل إحساسه بالواقع تحت هذا التأثير فتبدو كثيرًا من صوره، وكأنَّها تتوالى دون رابط، فهي تحكي قصة شخص اعتدى مع صديق له يُدعى أحمد لاشين على شخصٍ يُدعى أحمد زغيم بعد أن يتفقا معًا على قتله أو تعريته أمام الشَّبِّيحة وتجار الحشيش، وقد اتصل أحمد لاشين هذا بالبطل ليتأكد من أقواله التي أدلى بها أمام مكتب مكافحة المخدرات فور عودته من القاهرة، تستمر الحكاية لتؤكد معاناة البطل، وترسم لوحةً فنيَّةً بطلها الهذيان التي يعيشها تحت تأثير ما تعرض له من ضربات وجروح وآلام التي رأى أن الوسيلة الوحيدة للتعافي من آثارها هو تعاطي البروفين والترامادول وكؤؤس الجون ووكر؛ مما يجعله يدخل في حالة من الهذيان أو الهلاوس، وكأنَّه مريضٌ يقبع تحت تأثير مُخَدِّر العمليات مما يجعله يرى في المرآة صورته وكأنَّها استُنسِخت فصارت أشباحًا كثيرة تشبهه، وتلك الحالة تجعل الذاكرة تدخل صراعًا شرسًا فيتذكر أخاه الأصغر والأكبر من الأصغر، ثم يخطئ تحت هذا التأثير من حصر عدد إخوته وأخواته أهم ثلاثة أم ستة أم عشرة.
وهذا الهذيان والألم نجدهما كذلك في قصة (واحد بورسعيد)؛ حيث تحكي قصة شخص يقوم فزعًا على صراخ ألم، ووجع متكرر في الظهر والأجناب يكاد يفتك بالكلى، وتفح أدخنة سوداء تطوف في هالات من رماد تخترق حواسه فيشمها وتحيله عنوة إلى أزمنة وأحداث بعيدة ويجتر ما حصل له في محطات عمره الفائت، وقصة (الميت) بطلها يضحك ثم يبكي ولكنه يضحك إلى حد الهذيان.
-اعتمد الكاتب في عددٍ من قصص المجموعة على تقنية الحُلْم، وهو يقدمه كتقنية سردية أولاها اهتمامًا كبيرًا، وقد تجلَّى ذلك حين عقد قِسمًا كاملًا من أقسامه الثلاثة احتفاء بتلك التقنية، وهو القسم الثاني من المجموعة الذي سمَّاه: (سِفْر الأحلام والتوهمات)، ونلاحظ هنا دقة استخدامه للفظة التوهم بدلًا من الوهم؛ إذ الفرق كبير بين التوهم والوهم، فالوهم يعني الخيال وهو ظاهرة طبيعية عادية، أما التوهم فيعني التخيل ويكون من نسيج الإنسان وصنعه، وهو ما يتناسب وطبيعة قصص هذا القسم.
وفي تلك التقنية يصير الحُلْم نصًّا مهمًّا يُكْمِل نسيج الرؤية السردية، ويكشف بعضًا من تجارب الأبطال داخل بنية الخطاب القصصي؛ إذ يأتي في هيئة “جمل متسلسلة تعرض سلسلة متوالية من السلوكيات والإحساسات والأفكار الملموسة.. هو متتالية مصبوغة باللذة أو بالانزعاج أو بنسبة متغيرة منهما معًا” [التحليل النفسي والأدب، جان بلمان نويل، ترجمة حسن المودن: 24].
وتقنية الحُلم تُشكِّل لُغزًا تثير به انتباه المتلقي لتسير القصة في تفسيرها بعرض تفصيلات الموضوع إلى أن تؤدي الغرض الذي ذُكِر في أولها، وعند ذلك يشعر المتتبع أن الحلقة قد استدرات، وأن الموضوع قد بلغ غايته، فينفك لغز الرؤيا وينكشف للفاعلين والمتلقين أيضًا، ويتمثل ذلك في عددٍ من القصص؛ مثل قصة (الروح) فيقول في بداية القصة: “ورأيتني أستعيد ذكرى لقائنا الأول في نشوة، متمرغًا في فراش مخملي يطير بي بعيدًا عن سكني، أنادي ظلها، أهاتف زميلاتها في العمل كلَّ حين، وتختلط عليَّ الأصوات، تذوب حواسي وأنا أستمع إلى من شاركوها الحديث عني.” [المجموعة: ص 57]
ويُحَدِّث نفسه وحيدًا هل يختارها هي أم توأم روحِها، فصديقتها منذ عرفها وصورتها لم تزل في روحه، ويقول مستدركًا: “لا، ليست صورتها، بل روحها.” [المجموعة: ص58]
وحلم بحبيبة روحه مارينا عندما سمع أنها مريضة، فقال لصديقتها وهو يسألها عن حالها: “نعم حلمت بذلك، رأيتها ملفوفة في ثوب أبيض في سرير أبيض وقد اخترقت رائحة البنج فتحتي أنفي وأنا أتقلب في فراش من حديد”. [المجموعة: ص58]، وهو حلم له تفسيره ودلالته.
وفي قصة (الساحلي) تستمر أجواء الحلم لتسيطر على المتن القصصي فنجد بطل القصة وهو صبي يهرب من عمِّه بعد وفاة أبيه بسبعة أيام، أتى من شمال البلاد ليهرب إلى صخب الشرق وقد “رأى نفسه في حُلمٍ تكرر مرات ستة، رأى أنه يطوف بسفينةٍ تتجه نحو المكسيك، يغفو ويتقلَّب في الفراش، ثم يبكي من جديد كلما تذكر مأساة الأب الذي فرمت عجلات قطار الجنوب جسده النحيل، الذي كان أشبه بهيكل عظمي”. [المجموعة: ص61]، وكأنَّه يحاول الهروب من واقعهِ ومأساتهِ التي يعيشها بعد هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة أقرب الناس إليه؛ لذا يكون ملاذه الوحيد هنا هو الحلم الذي يحاول من خلاله تخفيف حدة الألم ووقعه عليه؛ والكاتب في لجوئه لتقنية الحلم يكشف بواطن الشخصيات ويعرِّيها، كما يستعين بها كنوع من رفض الأنماط التقليدية في حل بعض المشاكل أو عرضها.
فاعتماد الكاتب على تقنية الحُلم أضاء جوانب كثيرة من الممكن أن تظل طي الكتمان لولا الاتكاء على هذا الملمح الذهبي؛ إذ ساعد الكاتب على كشف كثير من خوالج أبطال بعض القصص وأسرارهم فصارت تلك الأسرار مسطورة على ورق بعد إبراز محتويات اللاوعي المكبوتة لتبدو واضحةً وضوح الشمس معتمدًا في ذلك على الصورة الحلمية، وهي تلك الصورة التي تتخذ من الحلم مُنْطَلَقًا لها وتغيب فيها المنطقية عن الزمان والمكان، وتبقى لغتها “لغة مصورة تعتمد على التشخيص والتجسيد وتراسل مدركات الحواس” [العناصر التراثية في الرواية العربية في مصر، مرادعبد الرحمن مبروك:ص165]
-طعَّم مبدعنا سرده في بعض القصص بالأسطورة والعجائبية، ففي قصة (الساحلي) بطلها دائمًا ما يتملكه إحساس بأنه عاش من الأعوام ثلاثمائة ويزيد، وأن نهايته القتل، دائمًا هو على سفر، وحتى وإن لم يفارق فراشه أو مقعده، وقريب من هذا المعنى قوله في قصة (نصف ثمرة جوافة): “يحصى سنواته، لم يحتفل بذكرى ميلاده رغم انفلات كل هذه العقود، لم يزل متأرجحًا في دائرة الرحلة، ثلاثمئة عام مع هواجسه، مع نفسه، وحيدًا يعيد تأويل الزمن، يحصى سنوات عمره المنقضية، وهو المنتبه إلى قرن من الزمان لم يطوه النسيان”. [المجموعة: ص 82]، ويقول في قصة (الميت): “تحسه عائشًا منذ خمسمئة عام، أو أنه قادم من أزمنة ثلجية وقت حروب الخليقة البدائية في الكهوف، دائم الإهمال في مظهره، رغم وسامته وثرائه النسبي، فإن ما يحيرني حقًا هو مشهد وداعنا”. [المجموعة: ص74].
وهذا يحيلنا إلى نظرية القرين وتناسخ الأرواح والتي ذكرها الكاتب في قصة (طويلُ الليل) و”أن كلًّا منا يحتفظ بأكثر من آخر بداخله يشبهه في أشياء، ويختلف معه في أشياء أخرى” [المجموعة: ص94]، وقصة (ظلال الأرواح) فبطل القصة كاتب سيناريو، وكتب فيلمًا بعنوان الظلال، وقبله فيلم بعنوان الأرواح “يعالج ماهية القرين، وكيف تنتقل الروح لتسكن جسدًا آخر في مكان وزمن مجهولين“. [المجموعة: ص106]، ويرجعنا الكاتب هنا بالزمن للوراء لزمن العصر الذهبي زمن الأندلس، عندما يسأل البطل (سراج) حبيبته عن مدريد، وتسأله عن طليطلة، وكأن سراج عاش بروحه في زمن غير زمنه ومكان غير مكانه فتنبهه حبيبته قائلة في عصرنا الحالي: “إنت مخاوي باين عليك يا سراج، إلحق نفسك قبل ما واحد فيكم يقتل التاني”. [المجموعة: ص109]، فبطل كاتبنا في القصة تماهى مع بطل فيلمه الأرواح، ومن يقرأ القصة ينتابه الشعور بأن الكاتب هو نفسه بطل القصة.
وبطل قصة (ليالٍ عشر) “كثيرًا ما يظن أنه خُلق من زمن بعيد وعاش في عصورٍ شتى، بدليل أن رأى تلك الوجوه التي يقابل أصحابها في أسفاره من مدينة إلى أخرى، من قارة إلى أخرى“.[المجموعة: ص18]، وكأنه يسافر عبر الزمن، ومن يقرأ العنوان يُخَيَّل إليه أنه يتناص مع قوله تعالى (والفجر، وليالٍ عشر)، ولكن القصة بعيدة كل البعد عن هذا المعنى، فبطلها له “ليالٍ عشر يحاول النوم ليتوقف عند سنواته الأخيرة التي انقضت في لمح البصر، وكأن أحدًا آخر غيره هو من كان يتلبَّس جسده وعقله، أما روحه وحواسه، فهما تخصَّانه” [المجموعة: ص17]
ونلاحظ هنا دقة الكاتب وبراعته في وصفه لبطله في بداية القصة؛ إذ يقول: “هو ليس بفاقد الذاكرة، ولا ضد مشيئة الرب، كل ما يهمه وقت خروجه، كان رأسه ذلك الذي تساقط الشعر منه حتى تعرى نصفه أو كاد”.[المجموعة: ص17]، فيقدِّم وصفًا بارعًا صادقًا لسرقة العمر، فالبطل في كامل وعيهِ وإدراكِهِ، ولكنه في حالة حسرة على عمره الذي انقضى.
-كذلك نجد السارد في مواطنَ عدة في القصص وكأنَّه على اتصال بعالمِ الجن، فعلى سبيل المثال في قصة (الجانب الآخر.. ضباب) يقول: “عاودت الإنصات إلى تلك الهمهمات التي تسري في أذنيَّ من زمن مبهم. طغى صوت امرأة، تجسَّدتْ في صورة بهيَّة.”[المجموعة: ص 100]، ويقول في قصة (خمسة وستون عامًا): “تأخذني مركب إلى شاطئ آخر قريب، يتحدثون عن جنيات البحر، وقروش فضية وريالات تطفو على السطح ليلًا.” [المجموعة: ص22]، وتلك العوالم العجيبة التي اعتمدها الكاتب في بنية خطابه القصصي أمدته بطاقاتٍ إيحائيةٍ كثيرة أثرت عالمه السردي وأغنته، وأمتعت القارئ وجعلته يشارك أبطال القصص تلك العوالم الغريبة ويتنقل بين منعطفاتها.
-وإذا ما تطرقنا إلى أسلوب الكاتب في سرده للقصص نجد أنه اعتمد على العديد من تقنيات الكتابة الإبداعية، كاستخدامه بكثرة للمنولوج (حديث الشخصية مع نفسِها) حيث أظهر هذا الحديث أفكارَها ومشاعرَها، فعلى سبيل المثال يقول في قصة (زينب): “أقول في نفسي، هل أطلَّت في عيني الزرقاوين الزائغتين دومًا في صمت وحيرة، لم تسكن الطلَّات ولا خمد الشرر إلا مع رؤيتها في شرفتها، خلف النافذة، قرب البلكونة.” [المجموعة: ص 174]، وغيرها الكثير.
– تميَّز أسلوب المبدع بكثرة استخدام الاستفهام بحرفيةٍ عاليةٍ؛ فهو يطرح أسئلة وجودية تجعل القارئ يفكر بعمق؛ لأن السؤال لمس شيئًا عنده، يقول في قصة (الذكريات): “أين أبي؟ أين عمري؟ أين البحار؟ أين نفسي؟” [المجموعة: ص 148]
وفي قصة (أول العرب): يقول الراوي متسائلًا: “من أنا؟! وما كل هذا الركام من الغضب والجنون والصمت والطيبة والشفافية والفجور؟ والنار المستعرة تعتليني فأكبح جماح نفسي وهواي، .. من أين جئت؟ أقولها لنفسي .. لا مجيب، تتعدد أهوائي، شياطيني السبعة، نفسي اللوَّامة. شيطانٌ أنت أم ملاك؟ مَن أبي؟ مَن الصومالي الحبشي؟ مَن جاء بي إلى هذا المكان ومّن هؤلاء؟” [المجموعة: ص 183-184]، وتساؤله في قصة (عمر الحمزاوي): “ماذا فعل بك الوجود؟ وماذا فعلتَ أنت في الوجود؟ وهل أنت موجود بالفعل؟” [المجموعة: ص 30].
ففي النصوص السابقة حديث نفسي يثير سيلًا جارفًا من الأسئلة الفلسفية الوجودية التي تتعلق ببقاء الذات وفنائِها ومصيرها، مما يوحي بأنَّ الراوي أو البطل في حالة من الحيرة والقلق الدائم الذي لا ينتهي، فيأتي باستفهاماتٍ كثيرةٍ دون أن ينتظر في كثيرٍ منها جوابًا يخرجُه من حيرتِه تلك، ونكتشف من خلالها طريقة تفكير السارد، وما الذي يشغله، ويؤرق عليه حياته.
-استخدم الثنائيات الضدية بصورةٍ واضحةٍ مُلْفِتةٍ داخل قصص المجموعة، وهو ما يتناسب مع غموض القصص كون تلك الظاهرة تعبر عن حالات نفسية وأحاسيس غامضة مبهمة تتعالق فيها الصور وتنتظم فيها المفردات؛ لتكوين صورة توضح الموقف العام، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد عددًا من الثنائيات الضدية؛ مثل: (النور والعتمة، الأبيض مع الأسود، المنتمي واللامنتمي، الحياة والموت، العدم والوجود، الواقع والخيال، الحلم والحقيقة، السماء والأرض، الغياب والحضور،… إلخ)، وهذه الثنائيات الضدية تساهم في تفجير دلالات متعددة مما يضفي على القصص نوعًا من التوازن يحسه القارئ ويتلذذ بوقعه.
-ومن أهم مميزات سرد الكاتب في مجموعته القصصية، الإيجاز ويعني السرعة والكثافة في الحدث، في موضوع القصة، وخير مثال على ذلك قصة (شفيع)؛ إذ يقول في بدايتها: “رنة الموبايل نبَّهتني إلى فحوى المكالمة.” [المجموعة: ص39]، جملة موجزة مختصرة، ثم يأتي بعدها قوله: “حسين إنت فين؟ تعالَ ضروري، الأستاذ شفيع تعب فجأة، لازم تيجي المستشفى، إنت نوبتجي الليلة.” [المجموعة: ص39]، وهي من القصص الجيدة في المجموعة؛ حيث توافرت فيها وحدة الزمان والمكان والحدث، وعدد الجمل، ومن الممكن اعتبارها من القصص القصيرة جدًّا.
-كذلك نجد القصص زاخرة بالاسترجاع الزمني (Flash Back)، وربما يرجع ذلك إلى أن السرد يقوم في الأساس على استدعاء الماضي وذكرياته بحلوها ومرها، وكل ما فيها من هواجس وآلام وأحلام، التي وصفها الكاتب في مفتتح المجموعة بأشباح الماضي، وأذكر هنا مثالًا على ذلك شعرت فيه بمدى صدق مشاعر الكاتب فيه؛ حيث وصفه وصفًا دقيقًا معبِّرًا للغاية، وكأنه موقف حقيقي حصل بالفعل، في قصة (الإرث)، يقول: “ليتها تصرخ مثلما تهبُّ زاعقة في جسدي، مرات ومرات، في كل وقت وحين، ليلًا ونهارًا، يهيمن الشك على يقين متبلد ورخو، في صورة حراشف مدبَّبة، وقواقع من صدف بأسنة من نار تتأجَّج في صدري، وضمير كان يستعيدها غصبًا للتفاوض والمراودة، عن تقصيري غير المقصود في تركها مشتعلة وهي الصبية الملاكة في طفولتي الخصبة البازعة للتو، في دروب طلخا، وحلقات الذكر وقباب البازات، والكوَّاء النجس الملعون” [المجموعة: ص150]؛ إذ تعرضت فتاة للاعتداء الجنسي من قِبل كوّاء ملعون، فيشعر بتأنيب الضمير، بل يعذبه ليل نهار، يجلد ذاته لعدم تمكنه من إنقاذها؛ لأنه كان صغير السِّن، فمر على الحادثة أربعين سنة، إلا أنها حاضرة في ذهنه لا تغيب، ويتمنى لو تنهض من رقدتها فهي الميتة الحية في ذاكرته، ليتها تفصح عن جرحها القديم، ليتها تحاسبه.
– وبما أن كاتبنا سينمائي، فنجد تأثر أسلوبه الواضح بتقنيات السينما كالمشهد، والسيناريو، وغيرها، ويتمثل ذلك جليًّا في قصة (عمر الحمزاوي)، فحرص الكاتب فيها على إيراد تفاصيل الحدث كاملة وتمثيلها أمام القارئ من خلال الكلمات، وكأنها تحدث الآن لحظة بلحظة، فيقول: “طالت جلستي صامتًا ولأكثر من ساعتين، كان حسام صاصا قد دخل العرض من البداية، وتعمدت أن أحدق في وجهه عندما سمعت صرير الأبواب الخلفية، وظهر سكرتير الجمعية بصحبة أحمد عبد الوهاب الذي نادى بصوتٍ خفيض: اتفضل يا أستاذ حسام. التفتُ إلى الخلف أرقب المشهد وأتأكد من ملامحه التي لم أرها من قبل إلا من خلال صفحات الفن وأخباره”.[المجموعة: ص26]، وصفًا دقيقًا لمشهد حضور المخرج حسام الدين مصطفى عرض فيلمه الشحاذ، وكأن القارئ يراه رؤيا العين.
– وظف الكاتب الموروث الديني في المتن القصصي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوله في (نصف ثمرة جوافة): “يكلم الناس في المهد صبيًّا، وكهلًا” [المجموعة: ص81]، تناص مع قوله تعالى في سورة آل عمران: {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ} آية 46.
– أما عن عنصري الزمان والمكان داخل القصص، فقد أولاهما الكاتب عناية خاصة؛ فاعتنى بذكر الزمان في كثير من القصص وحرص تحديده تحديدًا دقيقًا؛ بذكره بعض تواريخ الأحداث التي يعرضها في المتن القصصي، على سبيل المثال لا الحصر قال في قصة (صخرة طانيوس): “قلت وقد غامت عيوني رغمًا عني: نعم، أنا قدمت إلى هنا مع بدء خريف العام السابع والسبعين“[المجموعة: ص103]، وفي قصة (الروح) يقول: “مع أول لقاء في خريف العام 2000“[لبمجموعة: ص58]، ونلاحظ هنا أن الكاتب يتنقل بالأزمنة ما بين الماضي التليد والحاضر غير البعيد.
وسعى في كثير من قصصه كذلك إلى تحديد الأماكن وذكر أوصافها فنجد ذكرًا لبورسعيد منشأه، وسوهاج، والمنيا، والإسكندرية، والهرم، وغيرها، وكان البحر شاهدًا على العديد من المواقف في أكثر من قصة فقد احتل مكانة كبيرة عند الكاتب، ولعل هذا يرجع إلى نشأته الساحلية.
– نلاحظ في كثير من قصص المجموعة دقة استخدام المفردة، وطريقة توظيفها في بنية الخطاب القصصي، فتعطي مزيدًا من الطاقات الإيحائية والدلالات الفنية؛ والأمثلة كثيرة جدًّا في الحقيقة، فيكفينا أن نعطي مثالًا واحدًا يؤكد ذلك وهو الاستخدام الدقيق للفعل (ينخر) في قصة (خمسة وستون عامًا) تلك القصة التي تنحت صورةً بطلها الألم الذي يطغى على الذات الساردة ويتمكن منها، فيقول: “ينخر في عظمه منذ شهور تخطت الثلاثين”[المجموعة: ص41]، فاستخدامه للفعل (ينخر) جاء موفقًا جدًا؛ إذ يعني في اللغة العربية: (تَفَتَّتَ) فيقال: نخر الشيء: تفتَّت وبلَى وقلَّ تماسكُ أجزائه من القِدم، ويقال نخر السوس الخشب، يعني فتَّتَه، ويدل استخدام الكاتب لهذا الفعل مع الألم على عبقريته في توظيفه أو توظيف دلالاته المعبَّرة عن جو القصة كلها، وربما صارت هذه الكلمة أهم كلمة في النص؛ إذ اختصرت العديد من الجمل والتراكيب وعبَّرت بصدقٍ عن معاناة الذات الساردة وأوجاعها.
-كما تميزت لغته بالشاعرية، والمجاز، خاصةً عند وصفه للمرأة، فيقول: “امرأة من نار ونور“،[المجموعة: ص100] وقوله عن ماريا: “أيتها المرأة التي تصبغ ملامحها كل نساء الكون، أتفرس في ملامحها، فتتزاحم في ذاكرتي صور للجميلات في الرحلة الأرضية، مَن صاحبتهن الروحُ في رحلتي في الحياة، تتشابه الملامح إلا من وقعها على خلجات نفسي” [المجموعة: ص57] .
– وفي جل القصص نرى اللغة رصينة مناسبة للذوق العام غير بعض المواضع القليلة مثل ما ورد في قصة (أماديوس).
– وفي النهاية، وبعد قراءةِ هذا العملِ القصصي المنفتحِ على عوالمَ عديدة، يمكنني القول: إن الكاتبَ حسين عبد الرحيم أتقنَ فنونَ اللغةِ وغاصَ في مشاربِها، وقدَّمَ عملًا جديرًا بالقراءةِ والدراسة.