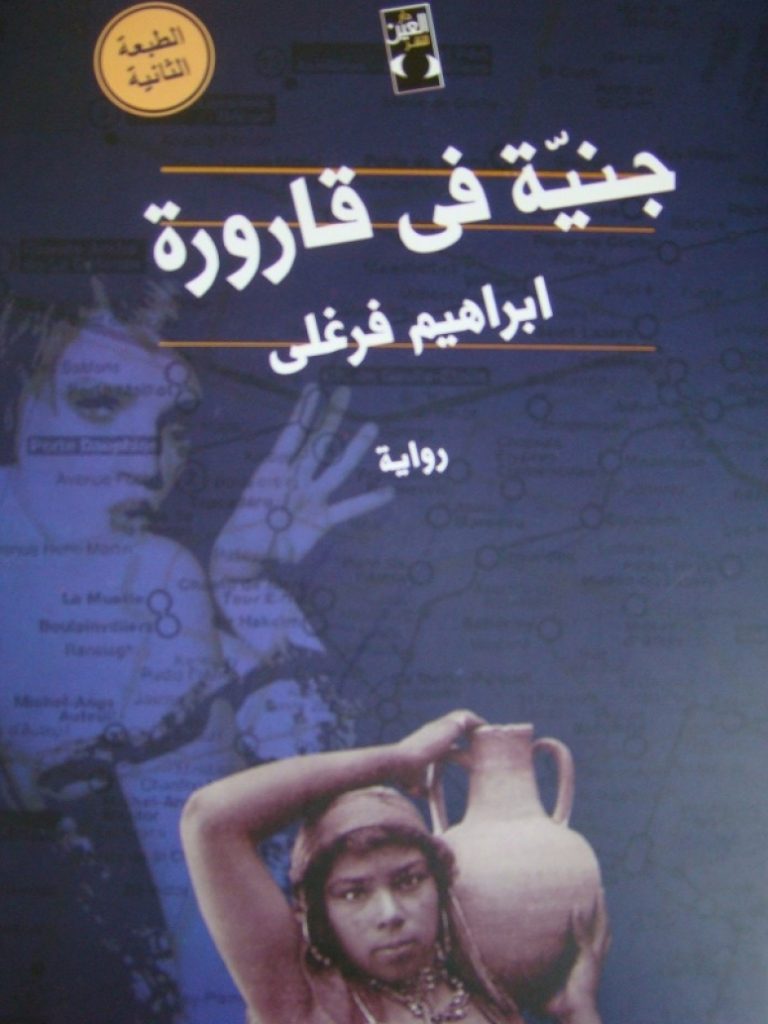محمد المسعودي
يلقي صمت مهيب ثقله على البيت الصغير المحاط بسياج كثيف من الظلمة، ويرسل البحر آهاته من بعيد، فتخترق جدار السكون. بين يدي رواية “المساكين” لديستويفسكي أتملى سطورها وأعايش شخصياتها على ضوء “لمبة”. وفي الغرفة المجاورة تغط جدتي في أحلامها العجوز، تتوق لرؤية مصباح كهربي يتدلى من السقف ليضئ البيت الصغير بحجرتيه وممره المربع، ولطالما حدثتني وحدثت خالي في الموضوع وكنا نعدها بأن ندخل إلى بيتها الصغير سلكا يمتد من المقهى إلى مسكنها في أقرب وقت. ولأمر ما لم يف خالي محمد بوعوده، أما أنا فقد كان لكسلي دخل كبير في تماطلي. كنت أقضي الأيام وأنا موزع بين قراءة أعمال الروائيين العالميين وبين حلم كتابة رواية، أسهر الليل في ضوء “اللمبة”، أتيه في عوالم قصية، وأحلم بالكتابة عن عوالمي الأليفة بطنجة: سيدي بوقنادل، وللارقية، وحجرة سبع بنات، وحجرة سيدي حمو، وحجرة السبع، وغرسة الغول.. أسترجع مشهد إشعال الشمع عند مدخل كهف “للاجميلة”، والعذارى قد رفعن تنوراتهن ليلجن الشاطئ لحظة الجزر وصولا إلى الكهف البحري، وهن يتصايحن أثناء رش الماء على وجوه بعضهن، أو وهن يغتسلن بماء البحر البارد، والأمهات المتطلعات إلى تزويج بناتهن تدغدغن الأثداء الريانة أو تُسهمن في تبليل بناتهن بماء البحر. حركة وصياح تطرز الصباح الباكر، والنساء تحسبن الشاطئ خاليا إلا منهن، ولكن عين الرقيب الفتي ترنو من بين الأشجار إلى حركاتهن وعريهن المحتشم.
أحلم بنسج كلمات تقطر شاعرية، وتطفح بحلاوة الحكي عن أحاسيس فتى حالم بالكتابة والعشق والمغامرة. أتذكر وأحلم، وأحلم وأتذكر. وعند استواء الشمس وخلو الشاطئ من النساء أنحدر نازلا من أعلى الهضبة نحو الكهف لأجمع الشموع ونقود النذور، أو أظهر للنساء قبل ذهابهن حينما ألمح إحداهن تحمل ديكا أسود، فأقوم بذبحه، ثم أمرغ قدمي العذراء بدمه، وأحمله، بعدها، إلى نتوء داخل الكهف. وحينما تغيب النسوة أضعه في كيس بلاستيكي وأحمله إلى “با تهامي” في كوخه الصغير ب”غرسة غنَّام”، أما الشموع والدراهم فآخذها لنفسي، ثم أنطلق بحثا عن عبد العزيز وأحمد وشلة الرفاق لنعيش لحظات متعة وهيمان في خيالات أفلام تعرضها “كازار” أو “كابيطول” أو “فوكس”. وبعدها أعود إلى بيت جدتي لأواصل أحلامي وتهويماتي، ولأغرق في كتبي وأخربش أشعاري، ودائما يتردد الوعد على شفتي:
-سأدخل سلك كهرباء ينير البيت يا جدتي، سأفعل قريبا..
مضت الأيام دون أن أفعل. طلقت التردد على أماكني الأليفة، وتخليت عن كثير من أحلامي العذبة. انتقلت إلى تطوان لمتابعة دراستي الجامعية. وفي أحد الأيام عدت، لأجد جدتي المريضة في شبه غيبوبة. كان جميع أفراد أسرتي وخالتي وخالي يحيطون بها، ولما استرجعت الجدة بعض وعيها واطمأن الزائرون عليها، وبعدما أرخى الظلام أمواجه الثقيلة على حجرتي البيت الصغير ذهب الجميع إلى حال سبيلهم ما عدا خالتي التي انزوت في الحجرة الأخرى. بقيت إلى جانب جدتي قليلا، ثم غادرت البيت فجأة نحو “باب طياطرو” حيث اشتريت سلكا كهربائيا طويلا ومصباحا من “دروغري إبراهيم السوسي”. عدت إلى البيت وبأدوات طلبتها من البقال “سي عبد القادر” استطعت وصل السلك بكهرباء مقهى خالي: مقهى الدالية، وجعلت المصباح في حجرة جدتي بعدما أدخلته من نافذة تطل على غرسة البيت الخلفية.
في حوالي منتصف الليل أفاقت جدتي من نومها، ونادت علي: طلبت مني أن أسقيها ماء. أسندتها إلى صدري ريثما شربت، ثم وضعت رأسها على المخدة. وحينما رفعت بصرها نحو المصباح الكهربي أشرق في عينيها وميض غريب، وأخلدت ثانية إلى نومها. من شدة الإرهاق نمت جالسا إلى جوارها ورأسي مسند إلى “المطربة” التي كنت أستند إليها ورائي، بينما كانت خالتي تنام في الحجرة الأخرى. في الصباح استيقظت فزعا على نداءات الخالة المتكررة، لأرى جدتي قد أسلمت الروح إلى بارئها، وشبه ابتسامة تعلو شفتيها، بينما كانت عيناها معلقتان بالمصباح الذي نسيتُه مضاء طيلة الليلة. أمرتني الخالة بالاسراع في إخبار والدي. هبطت “عقبة الخروبة” أجري إلى موقف الحافلات بالسوق دبرا. أخذت الحافلة رقم 15 التي سارت بي إلى بيتنا بحومة “البوغاز/الموظفين” حيث أبلغت الخبر إلى والدي، حتى نذهب جميعا إلى بيت الجدة قصد إعدادها للدفن، وقد شرقت روحي بحزن لا يحد، وأنا أردد:
-رحمك الله يا جدتي! لم يدخل نور الكهرباء بيتك إلا لحظة احتضارك وانطفاء نورك.. ما أغرب الحياة!
ثم أجهشت في بكاء داخلي مرير ما يزال يجعلني أنتفض كلما عادت بي الذاكرة إلى ليلة وفاة الجدة.