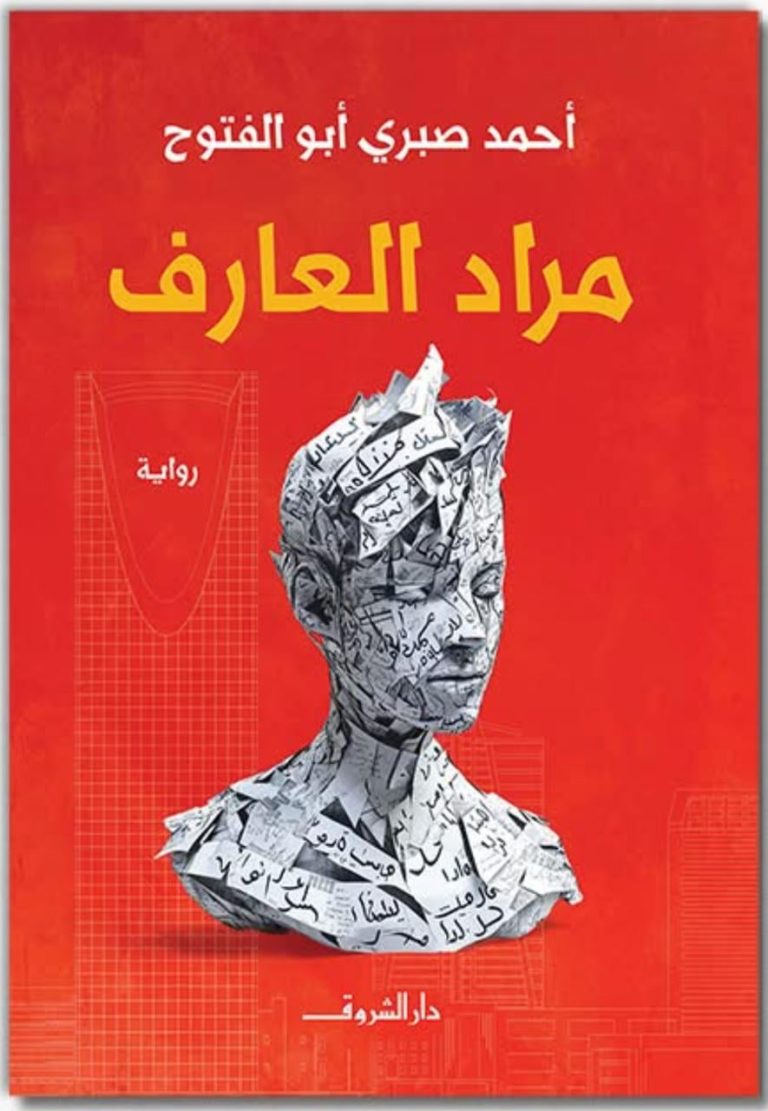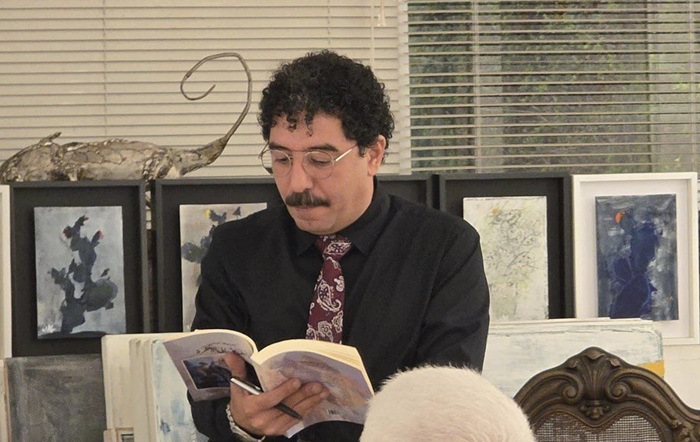ممدوح فرّاج النّابي
في أحد الحوارات التي أجرتها “أليف شفق” Elif Şafak (1971-…) الكاتبة التركيّة لمجلة «باريس ريفيو» سُئلتْ: «هل في رواية “قواعد العشق الأربعون” (Aşk 2009)، أيّة ثيمات تخصُّ تاريخَك الشّخصي؟» لم تجب شفق عن السؤال الموجّه إليها، بل قدمتْ إجابة مائعة- نوعًا ما – بعيدة عن السؤال – المباشر – فذكرت ما تمثّله كتابة الرواية لها من أنّها رحلة جوانيّة، ثمّ ضربت مثالاً بعلاقتها بالتصُّوف. لم تيأس المحاوِرة فسألتها مرة ثانيّة – ولكن – صراحة: «ثمّة شعور بأنَّ الروائيين يَميلون دومًا إلى إسقاط بعض أوجه شخصياتهم على الشخصيات الروائيّة التي يخلقونها.
ـ هل مثّلت إيلا مقطعًا زمنيا ما في حياتك؟» [ملحوظة: إيلا: هي بطلة رواية قواعد العشق الأربعون]
لم تجد شفق مناصًا – حيال الإلحاح – فأجابتْ: «لا تحصل الأمور هكذا، كتابة الرواية بالنسبة لي ليست بالضرورة كتابة عني وعن جوانب من تاريخي الشّخصي، وأقول بكلّ صَراحة لستُ بتلك المولَعة بتاريخي، بل الحقّ أنّني أَجد لذةً كبيرةً في أن أتصوّر نفسي وقد استحلتُ شخصية أخرى. عندما أكتب رواية ما أتوقف عن التفكير بكينونتي الذاتية وأرى نفسي تُسافر وتحلّ في نفوس أشخاص آخرين، وهذا التقمُّص مسألة أساسيّة في فن الحكي القصصيّ، وإن هذه التجربة الوجوديّة هي ما يُبهجني أكثر مِن الحكي عن نفسي، وهذا هو السّبب في عدم اعتبار أعمالي رواية سيرة ذاتية“
- لقاء بالمصادفة
لا شك أنّ ما ذكرته أليف شفق صحيحًا – على الأقل – من الناحية النظرية، فتجربة حياتها أفردت لها مساحة كبيرة في مذكراتها «حليب أسود» (Siyah Süt 2007)، لكن مَن يقرأ نصوص أليف على تعدُّدها يكتشف أنها لم تتحدّث عن تجربتها الشخصيّة، بقدر ما تحدثت عن كسر تقاليد المجتمع الذي ما زالت آثارها عالقة في اسمها الذي يرفض الانتساب إلى الذكورة / أو البطريركية، ومن ثم صارت تنتصر لذاتها عبر شخصياتها المتعدّدة. وهذا ما تحقّق في علاقتها بزوجها الصحفي أيوب جان.
هي أليف شفق الكاتبة التركيّة المولودة في 25 أكتوبر 1971 في ستراسبورغ (صاحبة قواعد العشق الأربعون وشرف وقصر النمل ولقيطة إسطنول وحليب أسود، وبنات حواء الثلاث، وصولاً إلى “10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب) وهو أيوب جان صحفي يعمل في صحيفة راديكال التركية، من مواليد عام 1973 بمدينة أَضنة التركية، دَرَسَ الاتصالات في جامعة إسطنبول، ثم أكمل دراسته العليا في جامعة هارفارد لدراسات الشرق الأوسط، أوّل عمل له كان في صحيفة الزمان وهي تتبع جماعة حركة.
جمَعتْ بينهما الصّدفة – أولاً- في لقاء بعد عودة طارئة لشفق إلى إسطنبول بعد انتهاء فصل دراسي لها في أمريكا، كانت الزيارة مُحدَّدة الوقت وأيضا الأعمال، حيث توقيع عقود روايتها الجديدة، وحضور حفلات التوقيع، كانت الزيارة هذه المرّة مختلِفة منذ أن استقبلتها المدينة بحركة زيادة تتّسم بها المدينة في شهور الصيف، ما إن هبطت الطائرة بها في مطار أتاتورك (القديم)، حتى داهمها دوار السّفر، لكنها أجرتْ اتصالاً هاتفيًا بصديقة لها، عبّرت لها عن سعادتها بوصولها، وعلى الفور تمّ دعوتها للقاء في إحدى حانات المدينة القديمة للاحتفاء بوصولها.
لم تكن عادة شفق أن تشرب إلّا كنوع من استعادة صفاء الذهن. تحت ضعط الصّداع ذهبت أليف وهناك التقتْ صديقتها إلى جانب بعض الأصدقاء الآخرين، لم تكن في حاجة إلى التعارف فجميعهم على معرفة مُسبقة، ماعدا شابًا بِشَعْرٍ داكن ومتموِّج وابتسامة خافتة، قدّم نفسه باسم أيوب جان.
- النظرة الأولى
طيلة الجلسة التي امتدت لساعات الصّباح الأولى لاحظتْ شفق أنها أعارته اهتمامًا كبيرًا، كانت في أوّل الأمر تنظر له بحذر، ثمّ تحوّل الحذر إلى فضول. أَقرت شفق فيما بعد أنه «كان يُجسِّد لها كل ما هربت منه طيلة حياتها، الصّبر الصّافي، التوازن المحض، العقلانية المتزنة، التناغم الأنيق، الهدوء الشّفاف. إنه صياد سمك بالفطرة، على حدّ تعبيرها».
منذ أوّل جلسة قالتْ: «لم أكن أُعجب به، بل كنت أسقط في حبّه كليّا». حاولتْ أن تُخفي مشاعرها التي بدأت تقفز من داخلها، إلى الطاولة، جاهدتْ وأسرفت في الشراب، إلى أن جاء الخلاص من أحد الجالسين، بغيةً لكسر مَلل الجلسة، فاقترَح أن يقول كلّ واحدٍ منهم أجمل اقتباس عن الحبّ، بدأ الجميع بعبارات عن شكسبير وعن ألبرت أينشتاين، ومارك توين. كانت كل عبارة تُستقبل بحفاوة وتصفيق حادّ من قبل الجميع وعبارات ثناء من قبيل: (برافوووو، مرة أخرى، أحسنت…) في حين أن أليف كانت عيناها على عينَي أيوب اللتيْن كانتا تُشعان بريقًا، وجاء الدور عليها.
صمت الجميع في انتظار عبارة شفق عن الحبِّ. صمتت، ثم نطقت: «هل وقعتَ مرة في الحبّ؟ إنّه مريع، أليس كذلك؟ يجعلك هشّا تمامًا، يفتح صدرك، ثمّ يفتح قلبك، وهذا يعني أن أحدهم يستطيع أن يدلف هناك ويعبث بك. يا للحماقة!»
لم يُبدِ أحد من الجالسين جوابًا بعد انتهائها، كان الكلُّ مُندهشا. قام البعض بالسُّعال مُدعيّن أن هناك شيئًا عالقًا في حلوقهم، وبعضهم تصنّع ابتسامة فاترة، لكن لم يرفع أحدهم نَخبًا كما حدث مع عبارات السّابقين. قطعتْ أليف شفق صمتهم وَحَيْرتهم قائلة: «هذا اقتباس من “نيل غايمان“» لكن ظلّ الصّمت – الذي تطاول، وتحوّل شيئًا فشيئًا إلى صمت كثيف كضباب الصَّباح، صَمت كثيف وراسخ؛ كما وصفه فيركور في “صمت البحر”- عالقًا ومهيمنًا بل صانعًا مسافة – فاصلة – هلامية بين الجميع، فأسرعت – قاطعة حبل الصمت الممدود قائلة: «ساندمان، ستاردست، مقبرة الكتب، هل تذكرون؟». ظل الصمت الكثيف الراسخ هو المسيطر على الوجوه والمكان معًا.
أكملت الاقتباس بلا مبالاة.
ـ «تصنع درعًا كاملاً كي لا يستطيع أحد أن يَجرحك، وبغتة يأتي شخص أخرق، لا يختلف عن أي أحمق آخر، يأتي ويتجوّل في حياتك كما يشاء…. يا للغباء!»
ران المكانَ صمتٌ لا يقطعه إلا أصوات الكؤوس عندما تُغادر الفم فارغة وتصطدم بالمائدة أو أصوات النُّدُل الذين يوزِّعون أنظارهم في اتجاه الطاولات وكذلك كلمات Evet( أي نعم). شعرتْ أليف وقتها بأنها أفسدت نشوة الخمر التي شربها الجميع، لكن وبينما تفكّر في لوم نفسها، جاءها المدد من أيوب، ذلك الصحفي الذي تعرفت عليه لأول مرة في الجلسة، عبْر نظرة امتنان، وهزة من رأسه.
انتهت الليلة، وغادر كل شيء منها ما عدا صورة أيوب جان ودعمه المعنوي الذي جاءها في وقت كانت في أشد الاحتياج إليه. الغريب أنه استطاع أن يقدمه بلا كلام أو تصفيق أو حتى رفع نخبه تحيةً، فقط مجرد نظرة امتنان وهزة رأس، كانتا كفيلتيْن أن يغيرا قناعات أليف في أمور كثيرة من بينها الحب والزّواج.
- إغواءات الحُبّ
في إحدى المرات تساءلت أليف شفق تعليقًا على نموذج بطلة رواية الأديبة التركية خالدة أديب أديفار (Halide Edib Adıvar) (1884- 1964) “المهرج وابنته” (Palyaço ve O’nun kızı) (1935)، وخالدة واحدة من الرعيل الأول من الأديبات التي دافعت عن تساوي الجنسين وعملت على تطوير حيوات النساء، ولها رواية مشهورة بعنوان “اقتلوا الفاجرة” (Vurun Kahpeye) (1926) وهي رواية مبكّرة تصوّر موقف رجال الدين المتكلّس من عمل المرأة، وبمعنى أدق نظرتهم للمرأة بصفة عامة. فالمُعلِّمة “عالية” فتاة متنوّرة تقدميّة، قادمة من إسطنبول إلى إحدى القرى، بعد أن أقنعت المسؤولين في وزارة التعليم الوطنية بنقلها إلى القرية؛ كي تزيل الجهل عن الطلاب، وتغرس في نفوسهم حبّ العِلْم وَحُبّ الوطنِ.
وبينما تُمارِسُ المعلِّمَة دورها، تختلط بالرّجال وتحث الطلاب على العمل، وتذهب إلى المدرسة بكل حرية، إلا أن هذه الوضعية أو الهيئة – غير المألوفة للمرأة – تُثير النفوس ضدها، لأنها تكسر – بهذا الفعل – التقاليد التي نشأت عليه القرية. فيؤلّب عليها فتّاح أفندي وهو رجل مُتعصّب، نقيض – فكرًا وَخُلقًا – لعمر أفندي وهو رجل دين سمح، تقيم عالية في بيته هو وزوجته، فيُنْزلانها مَنزلة ابنتهما الرّاحلة.
أما فتّاح أفندي فيؤلّب صدور الناس ضدّها بدعوى أنها تنشر الزُّعر بينهم، بل يصفها بأنّها زانيّة وفاجرة وتغوي الرِّجال، وبينما الّصراع (السياسي) مُحتَدِم بين الثوّار والمُحتل الأجنبي، فإن صراعًا آخر – فكريًّا – مُحْتدمًا بين رجال الدين المتشدّدين بقيادة فتّاح أفندي ورجال الدين المعتدلين، وينتهي الأمر بالتحريض على قتلها بدعوى أنها أقامت علاقة مع رجل يدعى “طوسون”، فيلقى نداءه صداه، فيهجم الناس، مدفوعين بتحريض رجل الدين – المتشدّد– على المدرسة، ويتمُّ إلقاء القبض على عالية، ويقتادونها إلى خارج القرية، وهم ينهالون عليها بالحجارة، وصوت فتّاح أفندي يجأر “اقتلوا العاهرة”.
خلقتْ خالدة أديب بهذه التمثّلات للمرأة – التقدميّة / المتعلمة / الثورية / المناضلة / التنويرية / المتمردة – التي ظهرت في أعمالها في وقت مبكّر؛ صورة مغايرة للمرأة التركيّة فجعلت بطلة روايتها “المهرج وابنته” تغيّر ثيابها لترتدي بيجامة نوم ثمّ تذهب إلى السرير حيث ينتظر زوجها.
كان نموذج “رابية” بطلة الرواية نموذجًا جديدًا على المجتمع التركيّ المُحافظ، مثلها مثل “عالية“، بل هي نموذج يُضاهي “نورا” بطلة “هنري إبسن” التي صفقت الباب في مسرحية “بيت الدميّة” وكانت رمزًا لبداية جديدة، وثورة على هذه الذكورية، والأهم إعلانًا لميلاد جيل من النساء قادر على أن يقول “لا” دون خوف، وأن تخرج من إطار اللُّعبة / الدُّميّة التي وضعها فيها الرجل بعقليته الذكورية. هنا “رابية” صفقت التقاليد البالية بالمثل غير مبالية بأية أنساقٍ.
كانت شفق تتساءل: «هل سيأتي اليوم لكي ترتدي ملابس تُبرز الصّدر، أو تنانير قصيرة أو حتى تُطلي شفتيها بلون الأحمر؟». لم تكن تتوقّع أن تساؤلاتها هذه ستتحقّق ذات ليلة وبفضل أيوب نفسه. في ذات ليلة اتصلت بأيوب لكي يَلحق بها في مطعم لتناول الأسماك على البوسفور. كان المطعم مُميَّزًا، لكن كلّ ما كانت عليه أليف أكثر تميّزًا أيضًا، فقبَل الموعد ذهبت إلى محل تصفيف شعر، وصبغت شفتيها باللون الأحمر القاني، ثم ارتدت فستانًا أسود عاري الصّدر وضيقًا جدًّا، وحذاءً ذا كعبٍ عالٍ. كانت سبقتْ أيوب في الذهاب.
وعندما حان الموعد اختفتْ في الحمّام، حتى رأتْ أيوب يدخل، ولمَّا جلس على المائدة المحجوزة من قبل خرجت. ولكنها ألقت بنظرة أخيرة في مرآة الحمّام على شكلها. أَنْكرت ما فعلت. لكنها كانت تستجيب لإغواء جديد تركت نفسها له. نادت على النادل ليأخذ بيدها حيث يجلس أيوب. كانت علامات الخجل بادية عليها، جلستْ وطلبتْ من أيوب – في حياء – ألّا ينظر لها، بل سألته أن يستدعي النادل ليحضر لها غطاء مائدة تغطي بها صدرها. أدرك أيوب ما اعترى شفق من تغيّر. فطلب منها:
ـ “أن تأخذ نفَسًا عميقًا من الداخل، وتسترخي على المقعد”.
استجابتْ شفق وبدأتْ تَشعرُ بتحسّن، على عكس ما كانت عليه قبل جلوسها.
كانت أوّل مرة يخفق قلبها بسرعة يوم أن ألقى اقتباسه في لعبة التسليّة في ليلة اللّقاء الأوّل حيث قال:
ـ «عندما تحاول اصطياد الحبّ، قامِر بقلبك، لا بعقلك»
وكان اقتباسه من مارك توين.
كان باديًا على اقتباسه رمي الصّياد، وهو ما أشعر الجميع بنشوة فابتسموا له، وحيّوه برفع الأنخاب احتفاء باقتباسه.
بعد مرور عام بالتمام على لقاء الحانة، كانت شفق وأيوب جالسيْن في السُّوق الكبير (Büyük Pazar)
وأثناء التجوّل، سألها أيوب، وسط الضّجة الصّاخِبة من البازار قائلاً:
ـ حبيبتي، كنتُ أتساءل، أما زلتِ ضدّ الزواج؟!
قالت: طبعًا لا أزال.
ثم أردفتْ:
ـ “نظريًّا على الأقل!”
قال لها في حيرة: “ما الذي تعنيه بالضبط “نظريا” هذه؟”
حاولت أليف الشّرح، لكنها أُسْقطت في الفخ الذي كانتْ تهرب منه، كانت توَدّ أن تقدّم إجابة فلسفيّة، تهرب بها من الإجابة، فإذا بها تقول له صراحة:
ـ “لستُ ضدّ أن نتزوج أنا وأنت، على سبيل المثال”.
هكذا نطقتْ بها أليف، طلبتْ الزواج مِن أيوب جان، في مشهد لا يُصدّق، فما كان منه إلا أن ضَحِكَ، ثمّ تظاهر بالجدّ وقال لها:
ـ “أظن أنكِ للتو قُمْتِ بأكثر طلب عكسي للزواج استقبله رجل من امرأة عبر التاريخ؟”
نظرتْ إليه: وقالتْ: أقلتُ هذا حقًا؟
قال: تستطيعين بالطبع أن تتراجعي عن ذلك.
وأكمل “لكنني لن أتراجع أنا”.
قالت: “لقد قلتُ ما كنت أشعُرُ به حقا“
ـ “أريد أن أسألك أن تتزوجني!”
- ثورة على التقاليد
إصرار شفق على أن تخالف عادات المجتمع الإسلامي لم يكن من قبيل التمرد عليها، بقدر ما هو تأثُّر بثقافة مغايرة كانت تبحث – من خلالها – عن تأكيد هويتها، التي سُلبت منها منذ طلاق أبويها، وهي طفلة صغيرة، وهو ما جعلها ترفض الانتساب لعائلة أب ذكوري لم يهتم بها. تأثير حادثة الطفولة كانت سببًا لأن تجد في كتابات خالدة أديب أديفار، النموذج على التمرد على هذه التقاليد. بل سعت إلى تطبيقه دون أن تشعر. فمشهد الفستان عاري الصدر والملابس الملتصقة وهي ذاهبة لموعد جان خير دليل على أنها امتثلت تمامًا للأفكار بل وطبقتها.
لكن أخطر هذه الأفكار أنها انعكست دومًا على كل أعمالها، بل إنها جعلت واحدة من أهم رواياتها والتي تسببت لها في مشكلة كادت أن توقع بها رهينة الحبس، ألا وهي «لقيطة إسطنبول» (2006)، حسب الترجمة العربية، لكنها بالتركيّة كان عنوانها (Baba ve Piç) أي «ولد غير شرعي» أو«ابن زنا» في تغريب لهوية الأب، وكان العنوان العربي أكثر تعبيرًا عن التيمة التي طرحتها أليف.
لم يكن الهجوم الذي تعرضت له أليف بسبب حديثها عن مشكلة الأرمن داخل الرواية، بقدر ما أنها جعلت بطلتها “زليخة” التي تمتلك صالون حلاقة، أُمّا للطفلة بانو ولكن بلا أب شرعي، وهو ما جعل عائلة قزانجي تنتقدها بشدة. كانت أليف تريد أن تُرسِّخ لمفهوم العشق حتى وإنْ كان بلا مواثيق مقابل رفضها القطعي لما اعتبرته خيانة بعقد زواج ثم التنصل عن الواجبات.
فالخيانة لديها تُسلب الآخر كلّ حقّ يُهيّأ له أنه يمتلكه. فحرمان البنت “بانو” من اسم أبيها بمثابة عقاب لهذا الأب الذي تخلّى عن الأم وقت احتياجها. على كل المستويات لا يمكن فهم حكاية “لقيطة إسطنبول” خارج سياق تجربة أليف ذاتها، فنموذج الأم التي وفرَّت لها سُبل التحرُّر من كل قيود البطريركية، تتحوّل إلى النقيض تمامًا، فتحوّل قائد البيت إلى شخصية عنيدة وفي أحيان قامعة، وهو ما ظهر في ملامح وجوه الفتيات فدائما نظراتهن زائغة وحذرة منقادة بشعور رهيب من أنها يجب أن تكون أكثر صرامة.
حكاية الابنة اللقيطة تمررها في أعمال أخرى ففي روايتها “قصر الحلوى” (Kâğıt Helva) (2010) التي ترجمها محمد درويش عن دار الآداب في عام 2016، ترجع لها من جديد، فالقصر الذي أخذت الرواية عنوانه شيّده مهاجر روسي بافيل بافلوفيتش أنتيبوف، لزوجته أغريبينا فيودروفنا أنتيبوفا، بعدما لازا (الزوجان) وآلاف من الروس بإسطنبول هربًا بعد الثورة البلشفية، وعملا في أعمال دنيئة بعدما ضَاع ما لديهما مِن أموال، وما إنْ فَقَدَا طفلتهما قبل أن يحتفلا بعامها الأوّل، حتى هاجرا إلى فرنسا بعيدًا عن شُرور إسطنبول، وهناك استاءت حالة الزوجة فأدخلها في دار للرعاية، وقد ارتبط هو الآخر بفتاة تصغره بعقود، وحصل منها على طفلة غير شرعيّة، لكن بعد فترة من الزمن تَطْلُبُ منه أن يعيدها إلى إسطنبول مرّة ثانية ويعودان معا ويبني لها قصر (بونبون)، وهو يحمل الاسم الذي كانت تريده لابنتها، ويأتي كتعويض لها عن الظلم الذي لحقها منه، ثم يؤل فيما بعد إلى فاليري جيرمين الابنة غير الشرعيّة لبافيل من زوجته الفرنسية الشّابة عام 1972.
في الرواية ثمة شيئان تعود بهما شفق إلى ماضيها بشكل غير مباشر، حكاية الفَقد، وحكاية التكريم الذي افتقدته؛ فالأب يُكِّرم ابنته بقصر. وهو ما عملت عكسه شفق حيث جرّدت الأب من شَرف الانتساب إليه، وكرمت الأم، في عقاب عكسي على ما فعل.
كان زواج أليف وجان بعد صدور روايتها الأولى «الصوفي»، لكن تأثير هذا الزواج أقصد ما قبله من عشق وهيام، جعلها تقلع عن عهدها بعدم الزواج وهو ما عرّضها لحملة انتقادات من جمهورها، صار مَلمحًا لكل أعمالها، فروايتها الشهيرة بالعربية «قواعد العشق الأربعون»، والتي ترجمها إلى العربية، خالد الجبيلي عن دار طوي عام 2012. جعلت من بطلة الرواية «إيلّا روبنشتاين» عاشقة على الرغم من أنها زوجة وأمّ لثلاثة أطفال، لكنها كانت تعيشُ حياة نَضَبَ فيها الحبُّ مع زوجها ديفيد في مدينة نورثامبتون ببوسطن، مِن جَرَّاء كثرة خياناته، ينتابها السَّأم من كلِّ شيء حتى المطبخ الذي تجد فيه عشقها.
بعد أن تأتيها وظيفة جديدة كمحرِّرة أدبيّة في دار نشر، وما أن تصلها أوّل رسالة من عزيز حتى يحدث التحوُّل في حياة الزوجة، وهو التحوّل الذي يشبه تحوّل بطلة باولو كويلو “الزانية” ليندا التي كانت في العقد الثالث من عمرها، وزوجة لرجل ثري وأم لولدين، لكن في لحظة جفاف الحب؛ تبحث كنوعٍ من المغامرة أو التشويق إلى التجديد بكسر حدة ورتابة هذه الحياة وتغيير نمطيتها، فتلتقي مُصادفة بحبيبها القديم في المدرسة “جاكوب كونيش“، وقد صار سياسيًّا ومرشحًا لمجلس الولايات. فتجدّد الماضي القديم الذي لم يتجاوز القُبْلَةَ بينهما، إلى علاقة حَميمة، تصل إلى نَزق الجنون أثناء مُمارستهما في مكتبه. الغريب أن البطلتين عادتا عن طيشهما، احترامًا للأسرة، وهذا تأكيد على قيمة العائلة الذي احتفت بها أليف في أعمالها خاصة رواية “إسكندر” (İskender) (2011) وترجمت إلى العربية بعنوان “شرف” “وأنا معلمي” (Ustam ve Ben) (2013) التي ترجمت إلى العربية بـ”الفتي المتيم والمعلِّم”، ثمّة حكاية حبّ بين جيهان القادم مع الفيل والأميرة مهرماه رغم الفارق الطّبقي. لكنه العشق الذي لا يعترف بتقاليد أو حتى فوارق طبقية.
لا توجد مناسبة إلا وَتُدَلِّل فيها أليف على عشقها لأيوب، وهو ما جعلها تُكْثر من شكره في نهاية كل أعمالها، ومن هذا ما وَرَدَ في نهاية رواية (إسكندر) شرف: «وإلى أيوب، الزوج والحبيب وجوهر الصبر والحكمة». قدمت أليف الجواب عن لماذا هذا العشق المجنون لزوجها دون أن يسألها أحد.
هكذا ورد في حوارها مع مجلة باريسريفيو: «فقد تحدَّرت أُسرتي من جذور عائلية تخضع لنظام بطريركي نموذجي كان هو السائد في تركيا لسنوات طويلة، ونشأتُ أنا تحت رعاية أُمّ تدير أمور العائلة بمفردها وقضيت كثيرًا من الأوقات مُحاطة بالنّساء: الجدّة، العمّات، الجيران، ولم يكن ثمّة أب في البيت لذا كانت لي معرفة مُبكرة بكل الخبرة الثمينة التي تخترنها النساء في حيواتهن. فكنّ متصلبات وقامعات لبناتهن بغرض حمايتهن من التأثيرات المؤذية للمجتمع البطريركي».
في الخلاصة عوّضَت أليف فقدان الأب بعشقها لجان، وعندما طلبت يده في السوق الكبير، لم يكن خروجًا عن النسق الاجتماعي بقدر ما كان تمردًا على الصفة البطريركيّة التي إذا أرادتَ شيئًا تطلبُه، وهو ما ترجمته بطلات روايتها “بنات حواء الثلاث” (Havva’nın Üç Kızı) (2016) “ناز بيري نابلنت أوغلو”، التركية التي نشأت في جو ليبرالي، و”منى” المصرية الأمريكية الجنسيّة القادمة من واقع منقسم على ذاته، فالأب متحرّر والأم متدينة، والثالثة “شيرين” الإيرانيّة التي عاشت في أسرة عانت من المنافي بسبب حكم الملالي. فبحثن الثلاثة عن الحرية بمفهوم ذاتي – بعيدًا عن الوصايا الأبويّة أو الأعراف والأنساق المهيمنة – وصل إلى حدّ إنكار إحداهن الإله (شيرين الإيرانية) ليصلوا إلى اليقين – والتعرف على الذّات – عبر الدرس وأستاذ الفلسفة “أزور“. أليف شفق واحدة من الأديبات التي تعترف أنّها دائما مرتحلة لكنها مُحبّة لعائلتها وتبذل قصارى جهدها للتواصل معها.
العجيب أن هذا الارتحال وعدم الاستقرار انعكس على شخصيات بطلاتها جميعًا، فهن في حالة ارتحال دائم، تطاردهن الأعراف والنواميس، ولكن تبقى المدينة إسطنبول هي الملاذ والملجأ، وأيضًا هي الذاكرة التي تستوعب الماضي. إسطنبول – التي تعتبرها “مدينة أنثى” كما في عبرت في إهداء روايتها الأخيرة- في معظم أعمالها حاضرة، حاضرة بميراثها القديم وتقاليدها، وأيضًا بثوريتها ضدّ الفاشية وضد الحريات، حاضرة باحتوائها شخصياتها الفارات بعارهن من بؤر مكانية مختلفة، حتى ولو كان صرن هامشًا، المهم هي الحاضنة والملاذ، مثلما هي الملاذ لأليف نفسها، التي ارتحلت – وما زالت ترتحل – إلى بقاع العالم بحكم وظيفة أمها، أو بحكم عملها الآن، لكن دومًا تجد وقتًا لتعود إليها. فهي “المدينة التي اشتهاها الجميع وأرادوا ترويضها” وفقًا لكتاب “فيليب مانسيلا“. وإن كانت المدينة التي تستقر فيها ليست تلك المدينة تريد وزارة السياحة أن يراها الأجانب، إن المدينة الخليفة. مدينة الهامش والمهمشين.
صورة المدينة (الكوزومبالتيّة) الحاوية (والصّاهرة) للهامش والأقليات والمنبوذات اجتماعيًّا، في نسيجها، تبلوّرت بصورة واضحة في مرويتها الجديدة “10 دقائق و38 ثانية في هذا العالم الغريب” (On Dakika Otuz Sekiz Saniye) (2020)، حيث شخصياتها السّت (خمس نساء؛ نالان (وهي متحوّلة عن رجل عثمان، فرّ يوم زفافه، واستطاع أنْ يتحوّل إلى نالان، ليحققَ ذاته)، وجميلة الصوماليّة، زينب اللبنانية، حميراء التركيّة، ورجل “سنان ابن قريتها”) مغتربات أو منفيات (إراديًّا أو بفعل وقيم ذكورية) تجمعهن المدينة – رغم تنافر مكوّنها الإثني والديني والاجتماعي والسياسي والثقافي- تحت دثارها حتى ولو أنشأوا مجتمعًا صغيرًا كبديل عن المجتمع الكبير الطّارد لهن، يمتثلن لقوانينه بأنْ يلوذَ أحدهما بالآخر ويتبادلون – فيما بينهم – الحبّ والوفاء في السّراء والضراء وفي الحياة والموت.
تقدّم أليف شفق شخصيات نسائيّة – في معظم نتاجها الرّوائي – تنحدر من منابت متنوّعة؛ اجتماعيًّا ودينيًّا وقوميًّا وجنسيًّا (نالان المتحوِّلة عن ذكر عثمان، وهناك المثليّة كما في رواية “بنات حواء الثلاث“). تقع هذه الشخصيات بكل توجهاتها الفكريّة والطبقيّة وتحيزاتها خارج الدائرة النمطيّة / الاستهلاكيّة. فهن نساء وقعَ عليهن فعل / قهر المجتمع / الذكورة تحديدًا وتحَمّلهن عِبء وَضَراوة هذا المجتمع وأنساقه المهيمنة سواء ذكوريّة أو دينيّة أو حتى عرفيّة، ولم تَحُلْ هذه العراقيل – المُصْطنعة – التي وضعها الرجل / المجتمع، رغبة في استلاب ذات المرأة، دون أن تحقّق مآربها ومقاصدها أيا كانت النتيحة.
العجيب أنّ المرأة – بكافة تمثيلاتها الحاضرة في أعمال شفق؛ مومس، صاحبة صالون حلاقة، ربة منزل، كاتبة، عاشقة، طالبة، ثورية، والطفلة (المتمردة على اسمها الطويل في البنت التي لا تحب اسمها) وغيرها- عند شفق تقع ضحية ليست لذكورية أسيرة أيديولوجيّة دينيّة وفقط، وإنما ذكورية أسيرة أيديولوجيات متعدّدة؛ دينيّة وسياسيّة، واجتماعيّة (سُلطة العرف). وبصفة عامة المرأة – عند أليف شفق- ضحيّة للظلم الاجتماعيّ والتمييز الدينيّ والجندريّ والعنصريّ، وأيضًا القهر السّياسيّ، وكأنّ كافة الظروف تكاتفت (أو تكالبت) ضدّها لتعيق حركتها ليس في التحرّر وإنما في العيش الآمن – على الأقل – والحياة الطبيعيّة. فعلى سبيل المثال ليليّ بطلة روايتها الأخيرة (عشر دقائق وثمانية وثلاثون ثانية في هذا العالم الغريب) كانت ضحيّة لليسار فزوجها الدكتور المناضل اليساريّ والمتمرد على الأعراف الاجتماعيّة، يموت في مظاهرة ضدّ السُّلطة، وبموته تعود مرّة ثانية إلى عالم الضّياع الذي انتشلها منه من قبل. وهو ما يشير بمعنى خفي إلى تناقضات وتحيزات الإيديولوجيا الذكورية في آن معًا.
ومن ثمّ كانت هذه الشخصيات – على اختلاف هوياتها، وانتماءاتها؛ محليًّا: ماردين (حميراء)، وقرى كردية (بمبى وجميلة في رواية شرف) … وغيرها، وإقليميًّا؛ مصر (مني)، لبنان (ليلى)، الصومال (زينب)، إيران (شيري)- وأيضًا بما حملته من تشوهات نفسيّة أو جسديّة (فإسكندر طبرق –بطل رواية شرف – يطعن – غسلاً للعار – بمبى طبرق طعنات قاتلة، وليلي على سبيل المثال، عمّها يُعتدي عليها جنسيًّا، وعندما تحمل من فعلته، ترفض الأسرة ادّعاها بل تُجْبرها على الزواج من ابن عمّها الذي يصغرها سنًا، وعندما تصل إلى إسطنبول تتفاقم أزمتها بأن يعتدي عليها أحد الزبائن المختلين عقليّا فيُلقي عليها بحمض الكبريتيك).
وكأن هذه الشخصيات جميعها – بما وقع عليها من ظلم – بمثابة المَحك أو الاختبار المفصلي الذي تكشف به أو تعرّي تحيزات الرّجل / المجتمع الذكوريّة، ضدّ المرأة، أو بمعنى أصح تُعرّي خطابات الذكورة – الفضفاضة وغير المُجدية- عن مناصرتها لقضايا المرأة، ودعمها للجنوسة والتغيير الجنسيّ، وكافة الشّعارات التي ترفعها النّسويات. وهي – في الوقت ذاته – تثأر – بهذا – لذاتها التي عانتْ من هذه الذكوريّة، وما زالت تُعاني من صِراع الأيديولوجيات بكافة توجهاتها، لمواقفها المُتعلّقة بقضايا المرأة والجنس والعدالة الاجتماعيّة والحريّة السّياسيّة والديموقراطيّة، وهو ما جعلها دائمًا في خانة المستهدَفة أي في مَرمى نيران الاتّهام والتخوين والعمالة.