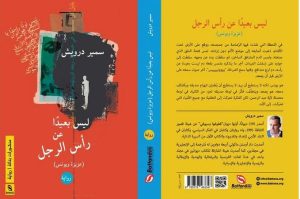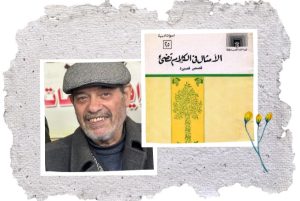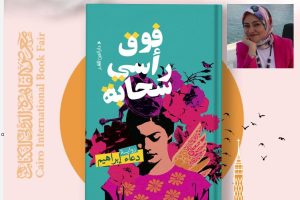د. شهيرة لاشين
يؤلمني أحيانًا أن ثمة أشياء قد تفوتنا ببساطة، إما لضيق الوقت أو لجهلنا بوجودها أصلًا، فتمضي الحياة من دون أن نختبر لذتها. لذلك أشعر بالامتنان أنني التقيت وتعرّفت على الروائي النيجيري تشنوا أتشيبي من خلال رواية “أشياء تتداعى”، ودرتُ حوله وحولها كالدرويش؛ أتوقف عند بعض المقاطع فأعيد قراءتها مرارًا في المواصلات، في المكتب، في البلكونة ساعة العصاري، أردد جملًا بعينها كما لو كانت أغنية حلوة فوق سطح البيت بجوار برج الحمام وقت الغروب، في غرفة النوم، وحتى في المطبخ وأنا أراقب نضج الطعام فوق البوتاجاز. وخلال قراءتها أظلّل عبارات كثيرة كي أستعيدها في لحظات لا أقوى فيها على الكلام أو القراءة أو الكتابة.
أشعر بسعادة أنني انتهيت منها، وليس أمامي الآن سوى الكتابة عنها كي أركنها بضمير مرتاح على الرفوف الخلفية من ذاكرتي.
خلف هذا الانجذاب الذي حدث معي والاندماج التلقائي مع الشخصيات والأحداث والفضاء المكاني للرواية، يكمن أسلوب أتشيبي نفسه ووضوح رؤيته وعرضه للفكرة، مما انعكس على قوة الحبكة والشكل الفني للرواية، التي أظهرتها الترجمة البديعة للمترجم عبد السلام إبراهيم، والذي أوضح في تقديمه للرواية أن أتشيبي كان مهتمًا بتصوير المؤسسات الاجتماعية المعقّدة والمتقدمة والتراث الفني لثقافة الإيبو، قبل احتكاكها بالأوروبيين. وكان استخدامه للغة الإنجليزية ذا مغزى سياسي، لكي يردّ على التصوير الاستعماري السابق لأفريقيا، على العكس من الكتّاب الأفارقة الذين جاءوا من بعده، واختاروا أن ينعشوا اللغات الأصلية كشكل من أشكال مقاومة الثقافة الاستعمارية. لكن أتشيبي أراد أن يحقق القوة الثقافية باللغة الإنجليزية، ومن خلالها.
كما يبين كيف أن أتشيبي قادر على اختزال الأمثال والحكايات الشعبية والأساطير المكوّنة للتراث والتقاليد النيجيرية التي تداولتها قبائل الإيبو على مدار الزمن، ووصف جودتها بالأبدية، مثل جدة السماء والغابات والأنهار.
وبذلك فقد نجح الكاتب في أن يكتب تاريخًا آخر؛ تاريخًا يُرى من زاوية المجتمع الأفريقي نفسه، متخذًا خطًا سرديًا واضحًا ومتدرجًا، مسندًا إلى راوٍ عليم يوازن بين القرب من تفاصيل القرية وعاداتها، والابتعاد لرسم المشهد التاريخي الأوسع. وبهذا أعاد صياغة الحكاية الجماعية بلغة تحتفظ بأصالتها ونكهتها المحلية، وتظل في الوقت نفسه قادرة على الوصول إلى الجميع، لتغدو شهادة على مجتمع بأكمله في لحظة تحوّل مصيرية.
تُعَدّ رواية “أشياء تتداعى(1958)” لتشنوا أتشيبي– طبعة هيئة قصور الثقافة المصرية (2014) بترجمة عبد السلام إبراهيم – حجر الأساس في الأدب الأفريقي الحديث، ويعتبره البعض الأب الحقيقي للرواية الأفريقية الناطقة باللغة الإنجليزية، رغم أنه لم يكتب سوى خمس روايات طوال حياته.
وقد استلهم عنوان هذه الرواية من قصيدة وليم بتلر ييتس “العودة الثانية” حيث يرد السطر الشهير: “الأشياء تتداعى، والمركز يفقد السيطرة”، ويتحدث الشاعر في القصيدة عن المجتمع عندما يكون خارج السيطرة فيؤدي ذلك إلى الفوضى والسقوط، كما ينتقد الحضارة الأوروبية وما سببته من شقاء للإنسان وخراب للأرض. هذا الاقتباس يلخّص مسار الرواية، حيث ينفرط نسيج مجتمع (الإيبو) تحت ضغط قوتين متشابكتين متمثلة في الاستعمار البريطاني المتقدّم من الخارج من ناحية، والتصدّعات الداخلية التي أخذت تنخر بنية المجتمع من الداخل من ناحية أخرى.
في قلب هذه العاصفة يقف أوكونكو، الشخصية المحورية داخل العمل، ليجسّد نموذجًا نفسيًا مركّبًا؛ رجل يبني هويته على القوة الجسدية والانتصارات، لكنه في العمق مسكون برعب دفين من أن يشبه والده أونوكا، الرجل الكسول الفقير الذي ارتبط في مخيلته بالعار. هذا الرعب من الضعف، أكثر من رغبته في القوة، هو الذي يحرك أفعاله. إننا أمام شخصية تعويضية تقسو على الآخرين كي تطمئن داخليًا إلى أنها ليست صورة مكررة من الأب، وهذا كان أول الأشياء التي تداعت أو سقطت في الرواية؛ فقد أسقط الابن صورة الأب وسعى إلى صنع صورة بديلة. ويمكن النظر إلى ذلك في ضوء عقدة أوديب؛ فهو لا يسعى إلى قتل الأب كي يحتل مكانه، بل يسعى إلى نفي الأب من داخله إلى الأبد.
“مات أونوكا مثقلًا بالديون، لم يكن قد حصل على لقب واحد؛ فما العجب إذن في أن يخجل ابنه أوكونكو منه؟ ولحسن الحظ، فقد كان هؤلاء القوم يحكمون على الشخص نفسه، ولا يُؤخذ المرء بجريرة أفعال أبيه. لقد خُلق أوكونكو ليقوم بأفعال عظيمة. كان لا يزال شابًّا حين حقق شهرة كبيرة بصفته المصارع الأعظم في القرى التسع. كان مزارعًا موسرًا، ولديه مزرعتان مليئتان باليام، وتزوّج لتوّه زوجته الثالثة. وقد تُوِّج كل ذلك بحصوله على لقبين، وأظهر بسالة فائقة في حربين مع قبيلتين” (ص 66).
صورة أونُوكا، الأب الكسول الفقير، تتحول هنا إلى ظلّ نفسي يطارده باستمرار. كل فعل قوة، كل قسوة، كل رغبة في التسلط، ليست إلا محاولات للتبرؤ من هذا الأب. غير أن المفارقة تكمن في أن هذا “النفي المهووس” لا يؤدي إلى التحرر منه، بل إلى إعادة إنتاجه بصورة أكثر قسوة وتدميرًا. نحن أمام شخصية مسكونة بـ”فوبيا الضعف”، تجعلها سجينة صورة رجولة متصلبة، غير قادرة على التوازن.
هذا القلق النفسي يتجسد في لحظة قتل إيكيميفونا، والذي بقتله يتداعى شيء آخر في حياة البطل؛ إذ كان الصبي أقرب إلى ابنٍ له، ومع ذلك فضّل أوكونكو أن يطعنه بيده على أن يُتَّهم بالضعف. “ما إن سحب الرجل الذي تنحنح سيفه ورفعه، حتى أشاح أوكونكو بوجهه بعيدًا، سمع الضربة. سمع صرخة إيكيميفونا: أبي لقد قتلوني! وهو يركض نحوه. وهو دائخ بفعل الخوف، رفع أوكونكو سيفه وقطع رأسه. كان خائفًا من أن يظن الآخرون أنه ليّن العريكة” (ص 126). هنا يتحول الخوف من “نظرة الآخر” إلى قوة مدمرة، تعكس آلية دفاعية مرضية، والتضحية بالأقرب للحفاظ على صورة الرجولة الصلبة. ورغم أن صديقه المقرّب حذره من أن يشارك في قتله: “الفتي يدعوك أبًا فلا تشارك في قتله”، لم يستمع له. فيما بعد سيترك موته جرحًا نفسيًا يلاحقه حتى النهاية، كاشفًا هشاشة تلك الصلابة الظاهرية.
لم يكن موت الصبي ذا تأثير قوي على أوكونكو فقط، بل على ابنه نوويي أيضًا، الذي كان يتعامل معه كأخ له وتعلّم على يديه العديد من أمور الحياة في السنوات الثلاث التي قضاها في دارهم، حتى ينظر شيوخ أوموفيا في أمره، فقد كان قد قُدِّم من قبل والده لهم كفدية أو تعويض للقبيلة عن قتله امرأة منها. “كان يبدو كشقيق أكبر لنوويي، ومنذ البداية بدا كأنه أضرم نارًا جديدة في كيان الفتى الأصغر. جعله يشعر بأنه راشد، ولم يعودا يمضيان الأمسيات في كوخ أمه أثناء طهوها للطعام، لكنهما الآن يجلسان مع أوكونكو في كوخه، أو يشاهدانه وهو يعتصر نخلته لإعداد نبيذ المساء” (ص 116).
وحين عاد أبوه في تلك الليلة عرف نوويي أن إيكيميفونا قد قُتل، وقد حدث أن تداعى بداخله هو الآخر أشياء كانت ذات قيمة أو ربما ليست لها أهمية تُذكر، لكنها انهارت بقوة جرفت معها كل معنى مزيف للإنسانية. تداعٍ جعله غير قادر على البكاء، وشعر بأنه عاجز تمامًا، وبنفس قوة المرة الأولى التي شعر فيها بانهيار ما في داخله، وكان عائدًا مع مجموعة من الأطفال بسلال من اليام من حقل بعيد عبر الينبوع، وسمع أصوات طفلين رُضَّع موضوعين في قدرين فخاريين وهما يبكيان في الغابة الكثيفة التي تُسمى “غابة الشر”، وكانوا يُلقون فيها الأطفال التوائم أحياء، وتُلقى فيها أجساد المرضى قبل موتهم وأصحاب الجرائم بعد الموت لتتعفن جثثهم دون دفن. كان الطفلان هما أخويه التوأم، ماتا هناك وحيدين دون ذنب، مثلهما مثل إيكيميفونا الذي حوسب على جريمة لم يرتكبها.
لاحقًا، تؤدي حادثة عرضية في جنازة أحد الأعيان ـ إطلاق رصاصة بالخطأ تودي بحياة شاب ـ إلى نفي أوكونكو وعائلته سبع سنوات من قريته إلى قرية أهل أمه: “حالما أشرق النهار، تجمهر حشد كبير من حي إيزيودو أمام مجمع أوكونكو، يرتدون زي الحرب. أشعلوا النيران في أكواخه، وهدموا أسواره الحمراء، وقتلوا حيواناته ودمروا مخزنه. كانوا ينفذون عدل إلهة الأرض، وكانوا مجرد رسل من لدنها. لم يكونوا يُكنّون في قلوبهم كراهية لأوكونكو، فقد كان صديقه الحميم أوبيريكا من بينهم. كانوا فقط يطهّرون الأرض التي دنسها أوكونكو بدماء ابن من أبناء القبيلة” (ص 199).
ورغم حزن أوبيريكا الشديد بسبب الكارثة التي ألمّت بصديقه، وأنه يُعاقَب بهذا الشكل على جريمة ارتكبها من دون قصد، إلا أنه خلص إلى أنه لا بد من إنزال العقاب به، لأن القبيلة إن لم تعاقبه فسيحل غضب الإلهة عليها بأسرها، لا عليه وحده. وفي المنفى، سنجد أن أوكونكو يحاول إعادة بناء حياته، لكن شعور العار لا يفارقه، كما أن الناس الذين عاش بينهم في المنفى لا يشبهون أهل قريته الأقوياء الشجعان، هؤلاء مسالمون لا يحبون الحرب ولا سيرتها، فعمل على أن تنقضي أيامه فيها بفارغ الصبر، وأنه لن يزوّج أيًّا من بناته أو أبنائه منهم، فهم في نظره أناس جبناء. ومع وصول المبشّرين المسيحيين إلى بلده تفاقم إحساسه بالخزي والانكسار.
مجتمع الإيبو الذي ترسمه الرواية يبدو للوهلة الأولى متماسكًا: أعراف، محاكم شعبية، طقوس دينية، تقسيم واضح للأدوار. لكن أتشيبي يعري ذلك كله ويبرع في كشف التشققات الداخلية من تفاوت طبقي، وتهميش المنبوذين، والعنف الموجّه ضد النساء، والسلطة المطلقة للشيوخ. هذه الفجوات كانت التربة الخصبة التي مهّدت لنجاح المبشرين في جذب “المهمشين” ومن فقدوا مكانتهم داخل النظام التقليدي إلى مشروعهم الديني. ومن خلال بناء الكنيسة والمدرسة في غابة الشر التي تركوها لهم باعتبار أن من يسكنها ستصيبه اللعنة وتنتقم منه الآلهة العظيمة، وهو ما لم يحدث، عزّز المبشرون أكثر الانقسام الداخلي في مجتمع الإيبو. والأكثر إيلامًا بالنسبة لأوكونكو أن ابنه انضم إلى المسيحية، فجسد هذا الانقسام في أقرب دوائره. ثم جاء المستعمرون البريطانيون الذين، منذ لحظة وجودهم الأولى على الأرض، تحوّلوا تلقائيًا إلى خصم عنيد للقبائل، عدو لا تملك أي قوة لمواجهته، فكانت الخاتمة انهيارًا وتداعيًا حتميًا لهذا العالم.
عاد أوكونكو إلى قريته بعد سبع سنوات من المنفى، يحمل في داخله رغبة عارمة في استعادة مكانته وهيبته بين أهله. لكنه ما إن وطئت قدماه أوموفيا حتى اصطدم بواقع جديد متمثلًا في سلطة تقليدية تراجعت أمام نفوذ بريطاني يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية. ما جعله في لحظة غضب ويأس، أن يقتل رسولًا بريطانيًا أثناء اجتماع عام، منتظرًا أن ينهض رجال قريته خلفه ويقاتلوا دفاعًا عن كرامتهم، كما السابق وكما كان يحدث في حروبهم ومعاركهم القديمة، غير أنّ صمتهُم وتراجعهم فضح وحدته القاتلة. عندها أدرك أن ما كان يتوهّمه من شجاعة في أهله قد تبخر، وأنّ مرض الجبن والرضا بالذل استبدّ بالجميع، فاختار الانتحار على أن يضع عنقه تحت حذاء المستعمر.
المفارقة هنا قاسية؛ فالرجل الذي أمضى حياته هاربًا من مصير أبيه الضعيف انتهى إلى المصير ذاته. لم تُدفن جثته بين أبناء قبيلته، بل ألقيت في غابة الشر على أيدي الغرباء، كما تقتضي أعراف الإيبو التي ترى في الانتحار عارًا وإهانة لربة الأرض.
“يقول أحد رجال القبيلة: “إنه يخالف عاداتنا. فقتل المرء لنفسه مكروه. إنه إهانة لربة الأرض، والرجل الذي يرتكبها لا يدفنه بنو قبيلته، فجثمانه يعتبر شرًا، والغرباء وحدهم هم من يستطيعون لمسه. لذلك طلبنا من رجالك أن ينزلوه، لأنكم غرباء”. سأل الحاكم: “هل ستدفنونه كأي رجل آخر؟”
نحن لا نستطيع دفنه الغرباء فقط هم من يستطيعون ذلك، سوف ندفع لرجالك مقابل الدفن. وعندما يُدفن سنقوم بواجبنا نحوه. سوف نقدم القرابين لكي نظهر الأرض المدنسة”. التفت أوبيريكا، الذي كان محدقا في جسد صديقه المتدلي على نحو ثابت، فجأة نحو الحاكم، وقال بغضب: “كان هذا الرجل من أعظم الرجال في أوموفيا. دفعتموه لكي يقتل نفسه، والآن سوف يُدفن مثل أي كلب..” لم يستطع قول المزيد تلعثم فاختنقت الكلمات في حلقه”. (ص 293)
النهاية تأتي عبر عدسة الإداري البريطاني الذي يسخر من موت أوكونكو، ويراه ليس سوى فصل في كتاب سيقوم بتأليفه بعنوان: “قمع ثورة القبائل البدائية في حوض النيجر السفلى”. وربما لن يكون فصلًا كاملًا، بل فقرة مقتضبة عن رجل قتل حارسًا ثم شنق نفسه، إذ لابد للمرء أن يكون صارمًا في حذف بعض التفاصيل. هنا يكشف أتشيبي بمهارة عن مفارقة مأساوية، وهي مصير رجل كان رمزًا للقوة والصلابة يُختزل في حكاية أو جملة باردة، كما لو كان حدثًا تافهًا في أرشيف السلطة الاستعمارية، في انعكاس ساخر لتحقير الثقافة المحلية بأسرها.
هكذا نجح أتشيبي في تعرية آلية الاستعمار، ولم يقف عند حدود نقد الاستعمار وحده، بل تجاوزه إلى نقد المجتمع التقليدي نفسه. فأوكونكو ابن ثقافته بقدر ما هو ضحيتها؛ والثقافة التي مجّدت القوة وأقصت الضعفاء، كانت هي نفسها التي مهدت لانكسارها أمام سلطة أكثر عنفًا وتنظيمًا. إن مأساة أوكونكو تكشف مأساة الرجولة الصلبة القائمة على الخوف، كما تكشف هشاشة مجتمع بدا متماسكًا، لكنه كان ينطوي على قابلية الانقسام.