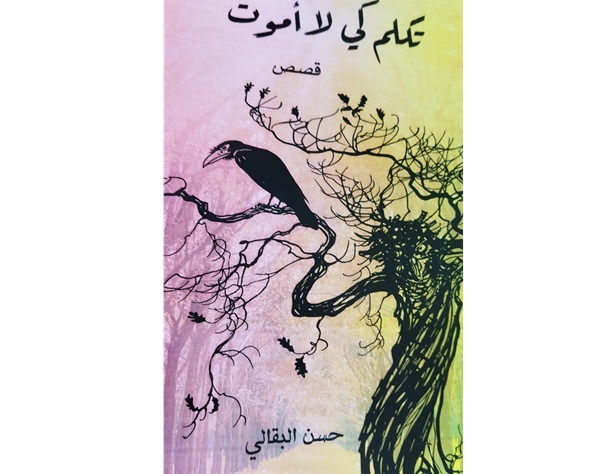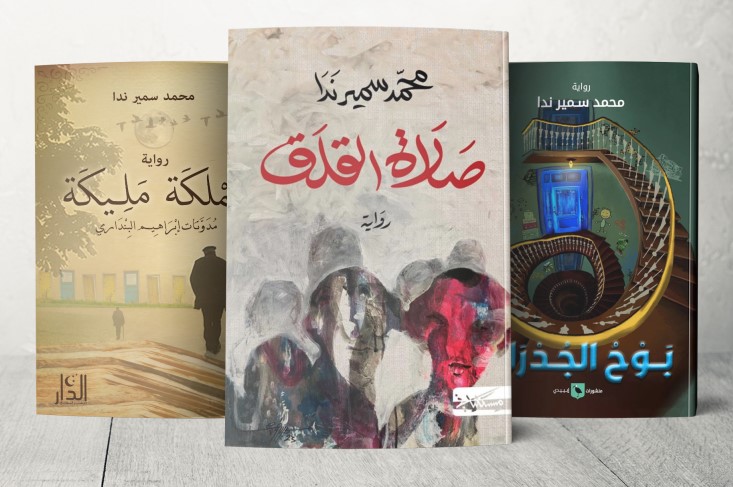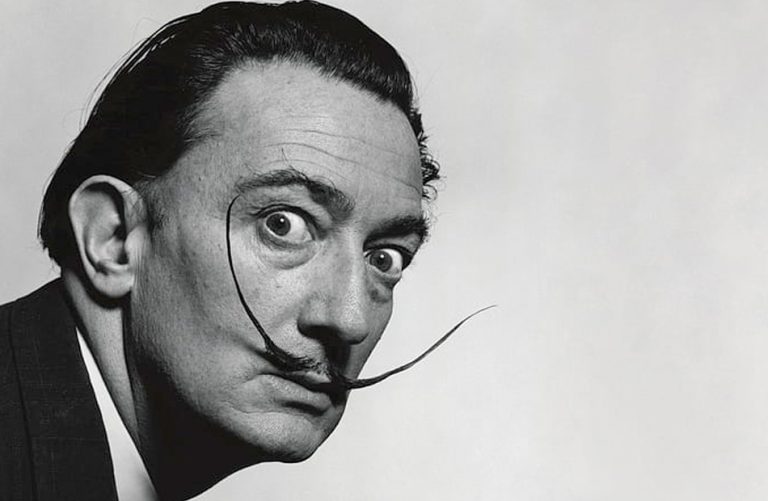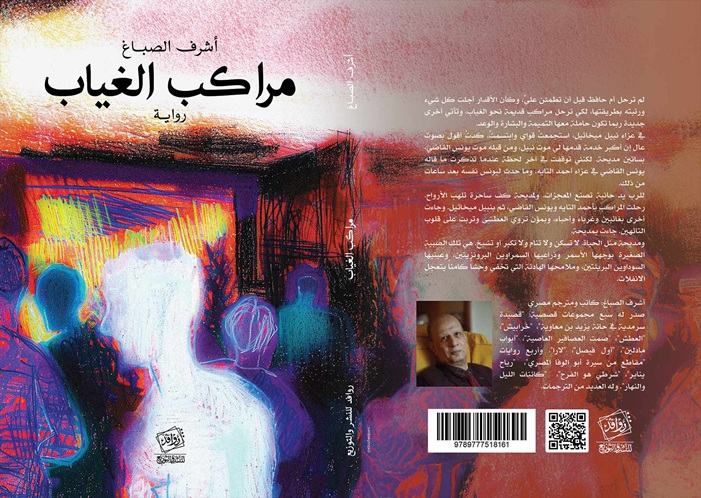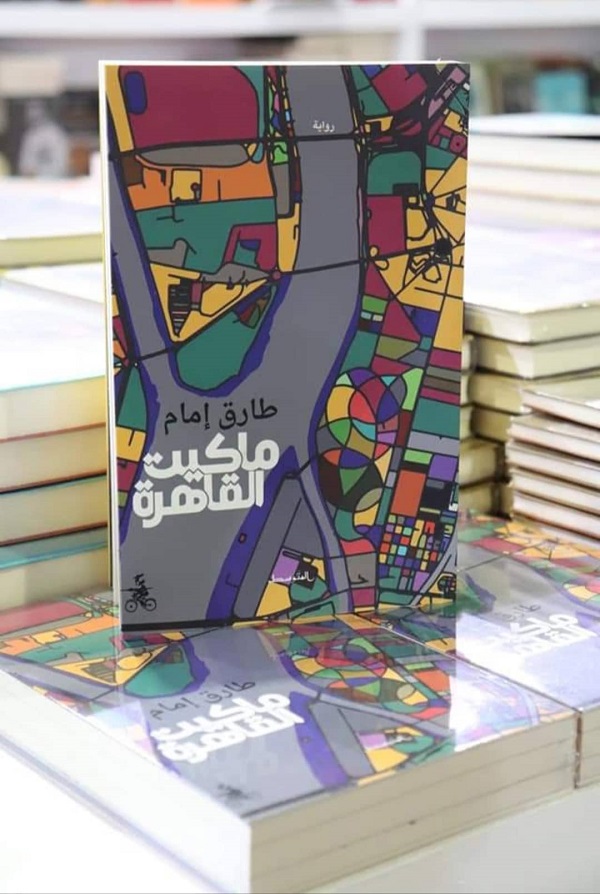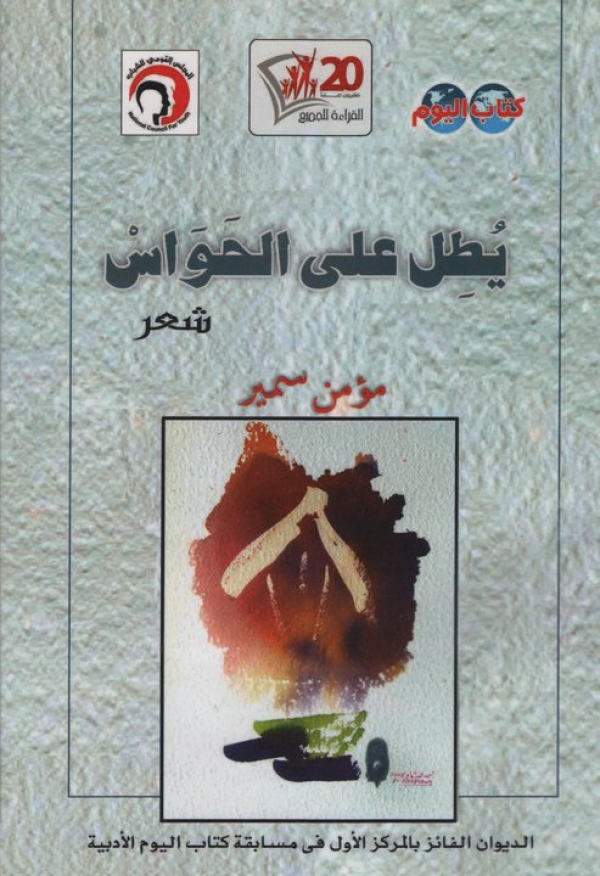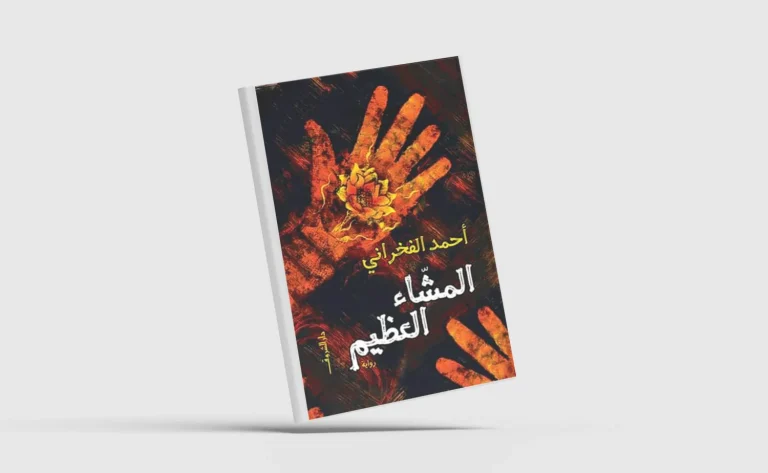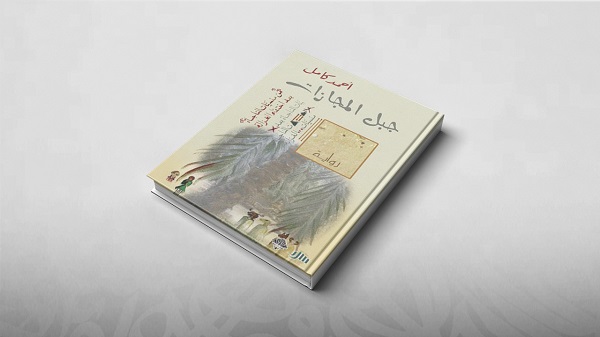د. شادن دياب
«ثمّ رأيتُ كليوباترا، احترقت بشهواتٍ لا تليق؛ ورأيتُ في الصحبة ذاتها زنوبيا، وقد أظهرت حرصًا أشدّ على كرامتها»
“زينوبيا” لموريس سارت
صخرة ألقيت في مايو 1968 من قِبل روائي متقدّم في السن من جنيف، في بركة الأدب الباريسي المشغول آنذاك بتجارب “الرواية الجديدة” الثورية، تُعد “جميلة السيد” اليوم واحدة من أعظم الروايات الفرنسية في القرن العشرين عن الحب الشغوف، وأوهامه، وخيباته.
في زمنٍ كانت فيه شخصية البطل الكلاسيكي تبدو أدبيًا متجاوزة، يغوص ألبير كوهين، القارئ المتأثر بكتابات فرويد ودوستويفسكي، عبر تحفته الفنية هذه في أعماق شخصيات تعيش تناقضات وصراعات نفسية داخلية معقدة.
العمل هو الجزء الثالث من رباعية تبدأ بـ “سولال” (1930) و”مانجكلو” (1938)، وقد نالت هذه الرواية الضخمة “جائزة الرواية الكبرى” من أكاديمية اللغة الفرنسية.
ورغم الاحتفاء الطويل بسولال، بطل الرواية الأيقوني، فقد وُجِّهت إليه مؤخرًا انتقادات لاذعة من بعض القرّاء والنقّاد، وحتى الكتّاب، ممن لم يُعجبوا بسحر شخصيته. فالبعض يرى أن “سولال ليس أميرًا ساحرًا، بل نرجسي مضطرب”. وفي نسخة الفيلم المقتبسة عن الرواية (إخراج غلينيو بوندر، 2012)، يُصوَّر سولال على أنه ذكرٌ متسلّط، مهووس، عنيف، غيور؛ أي التجسيد النموذجي لـ”النرجسي المتوحّش”، كما تصفه مجلات علم النفس النسائية، بحسب إحدى المراجعات النقدية القاسية.
ورغم أن مفهوم “النرجسي المنحرف” أصبح شائعًا في الخطاب العام، إلا أنه لا يندرج ضمن التصنيفات الرسمية للأمراض النفسية، ولا يزال موضع جدل كبير. وقد صاغه لأول مرة المحلل النفسي بول-كلود راكامييه في أواخر الثمانينيات، محددًا سماته الرئيسية في: الإغواء، التمويه، التلاعب، والتأثير النفسي المدمر على المحيطين بالفرد.
فلماذا إذن صار بطلٌ من ورق، مثل سولال، يجسّد هذه الصورة السلبية؟ هل يعكس ذلك إسقاطًا معاصرًا يغفل تعقيد الشخصية وطبيعتها الأدبية؟ أم أنه سوء فهم عميق للنص الروائي نفسه، وتحميله ما لم يقصده مؤلفه؟
قضية سولال
هل سولال نرجسي؟ لا شك في ذلك. حتى أريانا، “أخته المجنونة، المُحبة فورًا، والمحبوبة من خلال قبلة منحتها لنفسها”، لا تقل نرجسيةً عنه. فالعلاقة بينهما في الرواية تدور في فلك نرجس. لكن، هل هذه النرجسية “منحرفة” ومبنية على استنزاف نرجسية الآخرين؟ الجواب أكثر تعقيدًا.
منذ المشهد الافتتاحي، حيث تُدان أريانا بسبب عدم تلبيتها لتوقعات سولال غير الواقعية، يبدأ هذا الأخير بممارسة العنف الجسدي واللفظي ضدها. ويبدو أن عبارة “منحرف!” التي تصرخ بها ناتاليا فوديانوفا – التي أدّت دور أريانا في الفيلم – مصحوبة بكأس يُقذف في وجهه، تختزل هذا التصور.
تتوالى بعد ذلك المشاهد التي تُظهر سولال غارقًا في غيرة مرضية تجاه أريانا، بعدما تعترف له بعلاقة سابقة. فيتحول إلى “جلاد لا يرحم”، يُخضعها لتعذيب نفسي ولغوي متقن. ومع تضخم أناه حتى حدود الجنون، تتحول أريانا إلى كائن صامت، مسلوب الإرادة.
سلوك سولال المتقلب وغير المتوقع يترافق مع آلية خبيثة، يُغرق فيها أريانا بأوامر متناقضة، تحبسها في متاهة لا مخرج منها. يدخل أعماقها النفسية، ثم يحاكمها بصفته قاضيًا وجلادًا في آنٍ واحد. واحتقاره العميق للمرأة لا يضعف حتى في لحظات الهيام، فيما يظل ولاؤها له دائمًا موضع شك ورفض.
هذا النمط المزدوج من الرسائل، أو ما يُعرف بـ “الازدواج القهري”، صاغه هارولد سيرلز في كتابه الجهد لإيصال الآخر إلى الجنون. وفي هذا السياق، تبدو سادية سولال كمظهر خارجي لمازوشية داخلية. فهو، كما يصف نفسه، الذي يمقت “عبّاد القوة”، لا يفعل سوى إعادة إنتاج تناقضاته النفسية عبر إسقاطها على المرأة التي يحب، في محاولة لتبرئة نفسه منها.
وهكذا، فإن النرجسية المنحرفة، وفقًا لراكامييه، هي “آلية منظمة للهروب من الألم والتناقضات النفسية، عبر إسقاطها على الآخرين، مع تضخيم الذات على حسابهم”
سولال، ضحية سولال
لكن إدخال هذا الصراع النفسي في إطار أخلاقي يُبعد سولال عن الصورة النمطية لـ”النرجسي المنحرف”. فمن خلال حيله في الإغواء التي يمارسها، رغم احتقاره للمرأة، يبدو كأن سولال نفسه ينسج ملامح “النرجسي المنحرف” كما تصوّره المجلات النسائية. غير أن انحرافه النفسي يظهر انعكاسًا لانحراف مجتمع تُهيمن عليه القوة. هو نرجسي متوحش رغمًا عنه، يُجسّد هذا الدور كما يُجسّد دور “الرجل المهم”، فقط ليضمن لنفسه موطئ قدم في هذا العالم.
وبنمط آخر من الجنون، فإن كراهيته المستمرة لما يسميه “الإنسانية العدمية” تدفعه إلى حبس أريانا معه داخل نظام يخضع لقانون صارم وخانق. في هذا البطل “المضيء والمظلم” لألبير كوهين، يبرز التناقض الحاد بين مثله العليا وسلوكياته وأقواله.
هذه الأبعاد النفسية والأخلاقية، للأسف، تغيب عن النسخة السينمائية، حيث يتحول سولال إلى مجرد سادي كاره للنساء، في غياب أي استبطان لعمق شخصيته الداخلي. فالأداء السطحي لجوناثان ريس مايرز يُخفي الجرح الداخلي العميق الذي يفصل سولال عن الصورة الجامدة لـ”النرجسي المتوحش” التي تُقدَّم ككائن خالٍ من العواطف.
بل إن عطشه العميق إلى حب كوني، ذلك الحب الذي يتألم من غيابه لأنه “بلا أنداد”، يقودنا إلى أن نستنتج مع أريانا: “هو شرير طيب، أما الآخرون فهم طيبون أشرار.”
فبكشفه عن ألم سولال النفسي وقوته التدميرية الذاتية، ينتصر ألبير كوهين للمشاعر، ويدعو القارئ إلى أن يرى في هذا البطل المتقلب، الممزق، والمفرط، لا ككائن لا إنساني، بل كأخ إنساني عميق، بكل ما تحمله الكلمة من معنى..
الرغبة واللذة في شخصية سولال
في شخصية سولال، يتداخل الصراع الداخلي بين الرغبة واللذة في تفاعل مستمر. بينما تمثل اللذة لحظات مؤقتة من الإشباع، تمثل الرغبة دافعًا مستمرًا نحو المستحيل، حيث يصبح السعي ذاته جوهر وجوده. لا يسعى سولال فقط إلى اللذة، بل إلى لحظة غير محققة، إلى ما لم يولد بعد، في حالة دائمة من البحث عن الذات المفقودة.
تعكس شخصية سولال صراعًا معقدًا بين ثلاثة أبعاد: الذات الأصيلة التي تحمل ضعف الإنسان ونقاءه، الأنا المكتسبة التي تفرضها المعايير الاجتماعية، والمجال التفاعلي حيث يتصادم هذان البعدان. هذا التوتر بين الذات والأنا يخلق شخصية ممزقة، تسعى بين الرغبات المادية والروحية، بين الحياة والموت، وبين التملك والتحرر. في النهاية، يظهر سولال كرمز للإنسان الذي يسعى دائمًا وراء ما لا يمكن الوصول إليه، في صراع لا ينتهي مع ذاته ومع العالم من حوله.
الفراغ الوجودي والبحث المستمر
في عمق شخصية سولال، يتجسد الفراغ الوجودي كعنصر محوري لا يمكن تجاوزه. هو ليس مجرد رمز للرغبة، بل تجسيد للمسافة اللامحدودة بين الإنسان وما يسعى لتحقيقه. سعيه المستمر نحو الكمال المستحيل يكشف العذاب الوجودي العميق الذي يعيشه الإنسان في محاولاته الدائمة لإيجاد معنى في عالم مشبع بالتناقضات والصراعات الداخلية. هذا البحث الذي لا يتوقف يفضح هشاشة النفس البشرية التي تُصارع كي تجد السكينة والاكتمال في واقع يتصف بالضبابية والفراغ.
سولال لا يكتفي بالسعي وراء اللذة أو الإشباع، بل هو مدفوع بتوق داخلي يبحث عن تحقيق لحظة كاملة ومثالية، لحظة تبتعد عنه باستمرار. هذا التوق المستمر إلى شيء غير قابل للتحقق يخلق دائرة لا نهائية من الألم النفسي والعاطفي. وهكذا، يصبح بحث سولال عن الكمال رحلة مستمرة نحو مستحيل، حيث يكشف عن التوتر الوجودي الذي يعصف به بين الرغبة والواقع، بين الذات والأنا.
في النهاية، يظهر سولال كرمز لهذه الحالة الإنسانية الدائمة من السعي نحو تحقيق شيء لا يمكن الوصول إليه، مما يعكس ضعف الإنسان أمام التحديات الوجودية التي لا تنتهي.