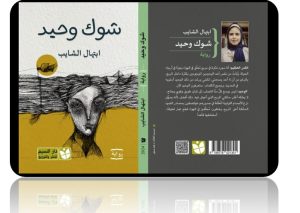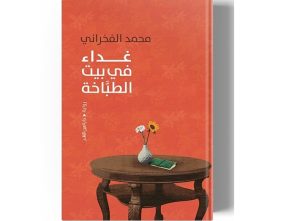عمار علي حسن
لا يُجلي الواقع مثل السرد الروائي، يفعل هذا في تمهل، وانشغال بالتفاصيل، بشكل أعمق كثيراً من علم الاجتماع، وحتى الأنثربولوجيا، بل إني حين قرأت في حقل “الجغرافيا الثقافية” أدركت أن الرواية والقصة ضالعة في خدمة هذا الفرع من علم مهم. أما السياسة التي يجب أن تبدأ من أسفل، فكثيراً ما تنسى هذا، مجذوبة إلى نقاش وجدل حول القضايا الكبرى، خاصة في أيام الاضطرابات والأزمات، وحين لا تكون قواعدها الأساسية قد استقرت بعد.
قبل سنوات حرصت على أن أسال الباحث في الفلكلور وشاعر العامية الأستاذ مسعود شومان عما وجده في حلايب وشلاتين، وجمعه في عدة كتب، كان آخرها حول أساطير البجا، عن هذا المكان الساحر وأهله، وأنصت إليه في إمعان، كي أعرف شيئاً جديداً، بالنسبة لي.
وكنت حين قرأت الرواية الشهيرة للأديب الراحل صبري موسى “فساد الأمكنة” قد وقفت على طرف مما يجري هناك، لكنه لم يكن كل شيء أبحث عنه، فالأديب الراحل شغله الحفر في نفوس أبطاله، أكثر من سحر المكان وروعته، ومن العادات والتقاليد وطرائق العيش والأساطير والخرافات والحكايات واللغة الشفاهية المتداولة.
وأتت رواية الكاتب وليد مكي “سواكن الأولى”، الصادرة عن دار العين للنشر بالقاهرة، لتغوص في كل هذا، وترسم لنا ملامح مجتمع تقليدي يشاكسه التحديث، فيأخذ منه، ويضيف إليه، ليبدو لنا الأمر كله على أنه ماضي لا يريد أن يرحل، وحاضر منشغل بالهوية وحائر حول معنى التقدم، ومستقبل لا يريد أن يولد دون عنت وعناء.
وإذا كانت رواية صبري موسى تعتني بالحبكة والتشويق، وربط الأحداث بالسياق السياسي، فإن رواية وليد مكي يشغلها أكثر صناعة صورها الجمالية من قلب المكان، فأتت مشبعة بروح أهله، لتبدو طازجة ومبتكرة وغريبة عن السائد، لكنها متآلفة مع البيئة الاجتماعية والجغرافية، الموزعة على الجبال والوديان والبحر والغيوم الكثيفة، وعرفنا معها الكثير عن اللهجات والأزياء، وملامح الوجوه.
بدا واضحاً أن مكي في روايته هذه كان مشغولاً، إلى حد بعيد، بما ورد لدى موسى في روايته تلك. هذا الانشغال ظاهر حتى قبل “سواكن الأولى” فقد سبق لمكي أن ألف كتاباً في أدب الرحلات بعنوان “حكايات على الحدود .. ما لم يقله صبري موسى”، ثم تحدث غير مرة عن أن رواية موسى كانت ملهمة له، ودافعة في الوقت نفسه كي يرى المكان وسحره وأهله بطريقة مختلفة.
هذا التأثر يعبر عن نفسه بوضوح أكثر في مقطع من الرواية، يدور فيه حديث بين “ود أوكير” والجنية “وجوك”، حيث يقول لها بعد أن أخبرته بأن في بطنها ولداً منه:
“أشعل آدم أوكير سيجارة، وجلس إلى كرسي بعيد عن سرير وجوك الناري، وقال:
ـ و “نيكولا الروسي”، مهندس المعادن اللي حبسك في الدرهيب؟
بغضب ردت:
ـ “نيكولا” مش مهندس. “نيكولا” أصله ساخر، غلبني وكانت غريبة أن بني آدم ساحر يغلب عفريتة.
ثم دمعت، والتوت شفتاها دليل خيبة الظن، وأكملت:
ـ حبيته، لكن الأصفر ما نسى لحظة أني من نار وهو من تراب. خد غرضه وحبسني في الدرهيب.”
وكما فسدت الأمكنة في رواية موسى لأسباب سياسية، يصورها هو في زيارة الملك فاروق للمنطقة وإقامته فيها، متساوقاً في هذا مع الذي كان يتم تداوله بإفراط عن العهد الملكي بعد انقضائه، فإن الأمكنة فسدت في رواية مكي لأسباب أخرى، طبيعية ونابتة من البيئة، ومبررة، وليست وليدة صورة نمطية أو رؤية سياسية صنعتها أيديولوجيا أو إحن. فقد توالت أشياء ترمز إلى الفساد، حيث فسد الجبل حين سال فيه دم قتيل، وفسد البحر بتسرب الزيت من السفينة، وفسد الفضاء حين تحولت غيمة إلى سجن، وفسد المكان، في نظر أهله، للقيود التي فُرضت على الترحال والتنقل بين الحدود، وفسد أيضاً لكسر التقاليد القديمة بفتح باب الاختلاط بين النساء والرجال، وفسد حين تم استبدال الأغاني والأناشيد المتوارثة بأغاني للسعودي محمد عبده، والسوداني محمد وردي. وتفسد بعض النفوس حين تريد مغادرة المكان لتسافر إلى بعيد، عبر البر أو البحر.
خيط البداية في الرواية هو اختفاء “همد”، وهو الاسم الشعبي المتداول في حلايب وشلاتين لاسم “محمد” وبدء البحث عنه في الجبال والوديان والبحر، ليجده الذين سعوا خلفه راقداً في غيمة بيضاء أشبه بإناء فخاري كبير، وهنا تبدأ صراعات بين أهل المكان حين يظنوا أن الفتى قد قتل، ثم بينهم وبين قبائل من الجن، لمعرفة المسؤول عن حبسه على هذا النحو.
يطل من بين سطور الرواية وجه مجتمع تقليدي، يستمتع أفراده بالعزلة والسكينة والذاكرة العامرة بالحكايات، فنراه في عادات متعددة، تتمسك بها قبائل العبابدة والبشارية والبجا، حيث لكل شيخها، الحارس على وضعها حدوداً للاختلاط بين الجنسين، والانزعاج من أن تعلن فتاة حبها لفتى، أو يبدي أحد رغبة عارمة في السفر إلى بعيد، حيث المدن.
ويؤمن أهل المكان بأسطورة التفاعل التام بين الإنس والجن، فللجن كبار أيضاً مثل القبائل من الإنس، نراه في الرواية ممثلاً في “أوثمان هساي”، الذي يدافع عن قومه حين يتهموا بارتكاب جريمة قتل، ويخضع لتحقيقات النيابة شأنه شأن الناس. ونراه في الجنية “وجوك”، تلك الساحرة الغريبة التي تفعل ما هو خارق للعادة بالطبع.
ونرى العالم القديم في بناياته الخفيضة البسيطة حيث “الكواجر” و”العشش” و”المضايف” التي يقصدها الغريب، ليجد ما يروى ظمأه، ويسد رمقه، وحيث الجبال التي تبدو بيوتاً، ووديانها أوطاناً، وأسرارها لا تنتهي، لاسيما جبل “علبة” أو “إلبا” كما ينطقه الناس هناك.
التمسك بالقديم يجعل أهل المكان حريصين على أن تظل الحدود مفتوحة بين مصر والسودان، فالقبائل عابرة للخطوط التي رسمتها السياسة، والمدن متكررة في الجنوب والشمال، والحكايات تذهب وتجيء بين هنا وهناك، والتواريخ لا تسقط من الذاكرة، حيث الأصول البعيدة للقبائل، والمنافع التي تتبادلها عبر التجارة في بضائع تتميز بها المنطقة، كانت تحملها الإبل في الزمن البعيد، والآن تأتي محمولة فوق الشاحنات.
مع القديم هذا تطل آلة موسيقية تخص الناس في حلايب وشلاتين، إنها “البانسكوب” ذات العزف الفريد، التي يجيده الفتى “بشير”، لكنه رغم مهارته واستقامته، لا يراه الناس سوى صاحب مهنة هامشية، ومرتبة اجتماعية متدنية، تجعل شيخ البشارية “الطاهر أولباب” وزوجته “حورية” يتأففان من وقوع ابنتهما “خديجة” في محبته.
تحول الرواية السجن نفسه، الذي نعرفه الآن باعتباره مؤسسة عقابية للدولة الحديثة والمعاصرة، إلى أسطورة، أو سجن مختلف، لا شبيه له في الريف ولا المدن. إنه مكان معلق في الفراغ، سحابة أو جرة عملاقة، تطوق جسد السجين، فيراه الناس هناك في الهواء، ينظر إليهم، لكنهم لا يستطيعون تخليصه إلا بالتعاويذ. هو سجن مقام على إرادة الجن، ويتعامل معه البشر على أنه واقع، لا فكاك منه. في هذا السجن الغريب يحل “همد”، ابن الشيخ أولباب، ومعه “بشير” عازف البانسكوب.
لكن هذا العالم القديم المتوارث لا يبقى على حاله، إذ سرعان ما يأتي التحديث ليجرحه، أو يغيره على مهل، طارحاً مظاهره ومعالمه في ثنايا الرواية، فنراه في الطرق المعبدة، والموانئ، والشاحنات التي تنقل البضائع، والحافلات التي تنقل البشر، والسيارات التي يرتادها المسافرون إلى هناك، والسفن التي ترسو على الموانئ، والدراجات التي يركبها المغامرون.
تولد المؤسسات التي تنتمي للدولة، لتأخذ بعض ما كان للعادات والتقاليد القبلية، فنجد المجلس البلدي، والمدارس والمستشفيات، ونقطة الشرطة، وتأتي النيابة من القصير لتحقق في جرائم القتل، بعد أن كان مشايخ القبائل يسوونها وفق أعراف ورثوها من الأجداد.
وسرعان ما تعرف الأسواق بضائع جديدة، من تلك التي يستهلكها أهل المدن، حيث المنظفات الصناعية، والتلفزة، والهواتف المحمولة، والأطباق اللاقطة، والأدوية الصناعية التي تحل محل الأعشاب، وألوان من الأطعمة والأشربة، والملابس، والأدوات المنزلية.. الخ.
إنه التحديث التي يعرف الكاتب وطأته على الحياة القديمة، وهو إن كان لا يرفضه، بل يقر بأنه التطور الذي يدخل إلى حياة البشر، شاءوا أم أبوا، فهو لا ينكر تبرم الناس هناك منه بعض الوقت، إلى أن يتركوه يتسلل إلى حياتهم، ويألفوه تباعاً.
ينتصر التحديث، وفق الرواية، حين يقبل مشايخ القبائل تحقيقات النيابة في جرائم القتل، واختفاء الأشخاص. ويستسلم الشيخ “أولباب” لقبض الشرطة على ابنه الثاني “أوشيك” واقتياده إلى الحبس، وتلين الأم أمام رغبة ابنتها في أن تتزوج بمن تحب، رغم أنها كانت ترى في البداية أن مجرد اعترافها بالعشق الذي نبت بين جوانحها من قبيل الجُرم أو العار.
لكن مع التحديث يأتي القلق والأرق، فمن قبل كان الشيخ الطاهر أولباب رابط الجأش، سابحاً في اطمئنان عجيب وقت أن تلقى خبر ضياع ابنه “همد”، ولم يخامره شك في أنه حي وسيعود. وفيما بعد لم يستطع الرجل نفسه أن يتفادى الارتباك الشديد والحسرة والقلق الذي انتابه حين عرف بأمر القبض على ابنه “أوشيك” بعد اتهامه في جريمة قتل.
الوحيد الذي بقي مطمئناً هو الراعي، لأن حياته البسيطة لم تتغير، فهو يقوم بالمهمة نفسها في السير وراء أغنامه، وعليه أن يمضي بها في الوديان باحثاً عن المراعي، وأن يأكل ويشرب بالطريقة ذاتها التي اعتادها أمثاله من الرعاة منذ آلاف السنين.
لم تكن موجة التحديث لتنال بالكلية من الهويات الفرعية أو الخاصة، التي تستدعي الأجداد الذين أسسوا الوجود البشري في هذا المكان. فيتحدث البشارية عن جدهم الكبير بشار بن كاهل، ويتحدث البجا عن جدهم هوبا كوكا. أما الكاتب فبدا حريصاً على أن يبدأ كل شيء من بدايته، ويحفر حتى قيعاته البعيدة، أو يتتبع الجذور إلى الأعماق، ولذا حرص على أن يجعل مقطعاً من كتاب “ابن بطوطة” المعنون بـ “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار” مفتتحا لروايته، حيث يقول فيه:
“وقصدت إلينا طائفة من البجا، وهن سكان تلك الأرض. سود الألوان، لباسهم الملاحف الصفر، ويشدون على رؤوسهم عصائب حمرا، عرض الإصبع، وهم أهل نجدة وشجاعة، وسلاحهم الرماح والسيوف، ولهم جمال يسمونها الصُهب، يركبونها بالسروج، فاكترينا منهم الجمال، وسافرنا معهم في برية كثيرة الغزلان، والبجاة لا يأكلونها، وهي تأنس بالآدمي، ولا تنفر منه.”
ويتحدث الجميع عن جبل “إلبا” صاحب المهابة والأسرار المغلقة، ويرونه على جهامته أقرب إليهم من البحر المفتوح على بلاد بعيدة. وعلى كثرة الشخوص والأحداث في الرواية يبدو هذا الجبل بطلاً أساسياً، بل متحكماً في تشكيل رؤى وتصورات وأخيلة وأحلام كل من يتطلعون إليه. ربما لهذا كان الكاتب حريصاً على أن يبدأ روايته بحديث عنه يحمل الكثير من المعاني، حيث يقول:
“كان يوماً نزل فيه الكل على هوى الجبل (إلبا)، وكان هو الناظر، وهو الحاضر الذي لا يغيب. وكانت كلمته في ربوع إقليم (إيتباي) هي العليا، دون أن يشعر أحد بشيء. لم يكن من الممكن ألا يتدخل (إلبا) إذا حدث في صدور بعض أبنائه ما لم ينبت فيها من قبل، وصارت خبيئة النفوس أفعالا. على منتصف النهار كان (إلبا) قد اتخذ لباس الملك والقضاء. انتصب قممه شاقة الغيوم، وانبسطت البراري بأشجارها وزواحفها وطيورها أمامه كحشود راكعة.”
ومع وجود هذا الجبل، يبدو السكان مختلفين مع الدولة في تعريف “الآخر”، فهو بالنسبة لهم الغريب، شرطياً كان أو محقق نيابة أو طبيباً أو مدرساً أو مغامراً أو تاجر مخدرات أو باحثاً عن الذهب في الجبال. وهو بالنسبة للدولة كل من يخترق الحدود، لتجارة أو هرب أو قادم، دون إذن، لزيارة لأهله الموزعين على جانبي الحدود.
لا يقول هؤلاء عمن أتوا إليهم من بعيد، أو يعرفون أنهم يسكنون الوادي والدلتا بأنهم “المصريون” ليعزلوا أنفسهم عنهم، إنما لمجرد تمييز ثقافة فرعية، لا تهجر الثقافة الأصلية أو ترفضها، إنما تضيف إليها، طالبة فقط الاعتراف بها، كنهير على الدولة أن تفتح لها الطريق ليصب في مجرى الثقافة العامة.
يريد هؤلاء أيضاً، كما نستنتج من تفاصيل الرواية، حيث وصف دخائل النفوس، والحوار بين أهل المكان والقادمين إليهم، أن يكسروا الريبة، التي تسكن نفوس أولئك الذين ينظرون إليهم على أنهم مختلفون بالضرورة، ويطلبون منهم، ولو بصوت خفيض، أن يفهموا وضعهم وحالهم، وأن يدركوا أن كثيراً مما لديهم من تصورات عن المجتمع والحياة والكون يشبه ذلك الموجود بعيداً عن جبالهم، حيث نجوع الصعيد وقراه ومدنه، خصوصاً في أسوان وقنا. وحتى ألوان الوجوه يشاطرهم فيها الكثير من أهل أسوان والنوبة.
لقد كانت “سواكن الأولى” بالنسبة لي أشبه برواية معرفية، رغم أنها في حقيقتها تنتمي إلى “الواقعية السحرية”، فقد أمدتني بمعرفة عن مكانها وأهله، وقربتني من لغتهم وطقوسهم، ونبهتني إلى أهمية احتوائهم دون الجور على تقاليدهم، فليس كل القديم شراً خالصاً، والقديم لا يمكن أن يموت كله، بل فيه ما يستحق الحياة، لأن به جمالاً وخيراً.
……………………………………..
*نقلا عن صحيفة “الوطن” المصرية