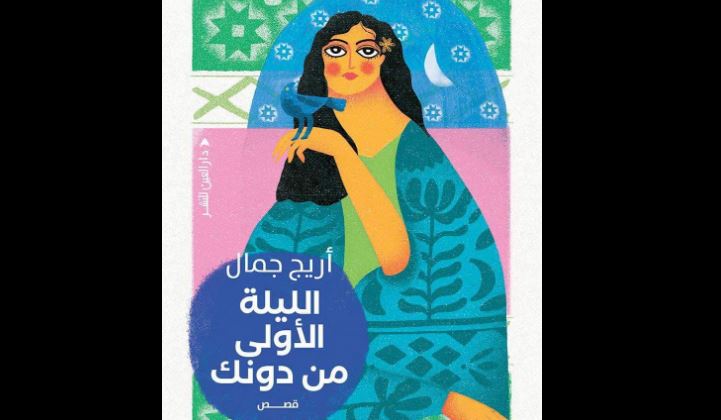إبراهيم سلامة
كان من عادته منذ زمن بعيد، أن لا يأكل الخبز الإفرنجي (الفينو) وكان يرتاح للخبز البلدى الأسمر فقد كان يعانى من بعض المشاكل فى المعدة والهضم.. أو ربما لأسباب اجتماعية أو نفسية..
فى طريق عودته للمنزل انجذب لرائحة السميط الطازة السُخن أبو سمسم عند مروره بجوار الفرن الأفرنجى القريب من بيته.. ركن سيارته جانباً ونزل منها يشترى اثنين من السميط، ذهب يستمتع به مع زوجته على كنبته الوثيرة المفضلة، دخل المطبخ يبحث عن شىء يمكن أن يأكله مع السميط فلم يجد سوى لفة جبنة رومى قديمة منزوية فى ركن من أركان الثلاجة الايديال القديمة، التى تجدها فى كل بيت من المحروسة، والتى اشتراها فى أول حياته الزوجية بالتقسيط..
جلس على كنبته، وراح يتخيل أيام القعدة على كورنيش النيل مع أمه واخوته انتظاراً لأبيه عند عودته من عمله مباشرةً عند الغروب ونزول الشمس الحمراء خلف الأفق فى الجهة الأخرى من شط النيل لتنعكس حُمرة غيوم السماء على ماء النيل الهادئ المتلألئ، ليعود به زمن فات ولكنه حاضر بقوة الحاضر المحفّز لكل الذكريات وتفاصيلها
فتح السميط مثلما يُفتح العيش الفينو ووضع فيه شرائح الرومى الرقيقة، وبدأ يأكل ويتلذذ بطعم الرومى بالسميط المسمسم ..
توقف مع هذا الطعم الرائع الذى كان مفتاح باب الذاكرة التى عادت به أكثر من خمسين عاماً فى عمر الطفولة والصبا، عندما كان فى مدرسته الابتدائية الأجنبية الخاصة والتى كانت تختلف عن المدارس الحكومية،
منذ نعومة أظفاره لم يتنعم مثل اقرانه فى المدرسة التى دخلها بناء على توصية من أحد الأقارب الذى استطاع أن يحصل لأسرته على تخفيض وتسهيلات فى دفع مصاريف مدرسته الخاصة، بعد أن كانت أسرته من تلك الطبقة المتوسطة ثم جار الزمان عليها بعد أن هاجر هؤلاء الذين يقال عنهم إقطاعيين فى حركة التأميم والإصلاح الزراعى..
عندما كان يرى زملاءه الآخرين أثناء وقت الراحة او الفسحة التى كان تمتد الى نصف الساعة وكل واحد منهم كان يخرج من شنطته الجلدية كيسا ورقىا أصفر كورق البردى القديم به وجبة الغداء، ويختار من مجموعة من سندوتشات الخبز الفرنساوى، ذلك الخبز الذى كان يراه فقط فى فرن الخواجة خريستو اليوناني فى الشارع الرئيسى بالحى القديم، والذى لم يكن يجروء صاحبنا شراء هذه الأصناف من تلك المحلات..
فهذا سندوتش الجبنة الاسطنبولى، وتلك شرائح اللحمة الباردة وهذه جبنة رومى و اخر مربة بالقشطة ومعها تفاحة امريكانى مستورد لم يكن متوفراً فى ذاك الزمان بالاسواق ذو رائحة نفاذة تثير الشهية او صابع موز مغربى كبير، أمّا صاحبنا فقد كان فى كيس سندوتشاته الفول المدمس داخل شقة خبز بيتى من عمايل أمه، وأحيانا كان الخبز مقددا لأن الخبز الطرى استُهلك كله ولا يوجد سوى العيش المحمص، فأمه تخبز كل خمسة عشر يوماً كمية من الخبز تكفى الأسرة، تقوم فجراً لعجن الدقيق وبعد الخمير صباحاً تقرّصه وتضعه فى طاولات خشبية ليأخذه الفران للفرن ويعيده لها ظهراً ساخناً طازجاً ذا نكهة تلهب الشهية، فكانت ثلث الكمية طرى والباقى محمص ليتحمل بدون تلف بقية الأيام الخمسة عشر، وعندما يفرغ الخبز الطرى تبلّل أمه العيش الجاف المحمص لتعيده طرياً وتضع فيه الفول، يجلس فى الفصل وحيداً ليأكله حتى لا يرى زملاءه ماذا يأكل..
كان ينظر لهم وهم يأكلون سندوتشاتهم ويكاد يشم رائحة الجبنة الرومي والتفاح، كان صاحبنا يشتهى بالشمّ والتخيّل، كذاكرته التى تعود له بالرائحة..
عادةً واثناء الأوقات المستقطعة بين الحصص يمشى فى حوش المدرسة وحيداً فهو من الأطفال المنعزلة صامت يرونه مكسور ليس له صديق من زملائه، ومن حظه انه لم يكن احد من زملائه يسخر منه رغم مظهره الرثّ الفقير، فهو من أسرة مازالت رغم الفقر من الطبقة الشبعانة بثقافة الرقى والحب والتى يراها فى زملاء المدرسة، قبل أن يجور الزمن على أسرته.. كان ناجحاً متفوقاً فى دراسته رغم كسرته وعزلته، لدية ثقة بالنفس لم تكن لدى هؤلاء المكسورين بفعل الزمن، و ربما كان ذلك سبباً لاحترام زملائه له، لم يمنعه كذلك من النجاح فى حياته الشخصية والعملية، فقد كان من ذلك النوع من البشر الذين كانت المواقف والأحداث بمثابة طاقة وقوة دفع للأمام وليس للخلف..
ذات يوم من أيّام الدراسة كان يمشى وحيداً فى فناء المدرسة كعادته وبجانب مبنى مدرسى منعزل، رأى كيس ورق مركونا بجانب الحائط، وقد رماه أحدهم حتى لا يعود به مرة أخرى للمنزل كعادة الأطفال، نظر حوله أولا ثم مال وأخذ الكيس ونظر داخله، وجد سندوتش خبز فرنساوي بالجبنة الرومي سليماً.. لقد اصبح وجهاً لوجه امام ما كان خيالاً..
كان السندوتش وحيداً مع بقايا سندوتشات أخرى فى الكيس الورقى، ولأول مرة على غير طبيعته العفيفة فقد كانت لديه رغبة عارمة لتذوق هذا الطعم..
وظل الطعم فى فمه وذاكرته إلى أن أعاد تشغيل الذاكرة بتذوقه السميط بالجبنة الرومي..