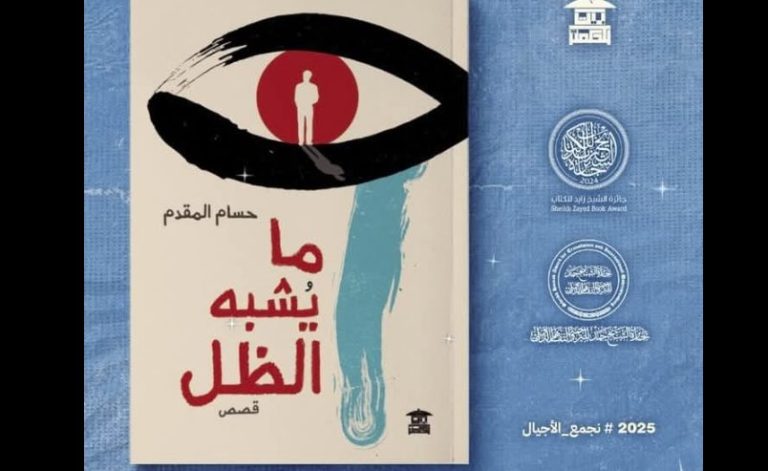محمد فايز حجازي
– من هذه الفتاة يا أمي!
كانت أمي كعادتها في ليالي الشتاء، قد أعدت أكواب الشاي باللبن ومعها أصابع البقسماط المُغطاة في مُعظمها بالسمسم، وضعتها في طبق كبير على المنضدة الخشبية الصغيرة بجوار السرير، جلسنا تحت الأغطية الثقيلة، كانت أمي تتصفح ألبوم الصور، وكنت في جوارها ألتمس الدفء، أتابع الوجوه وأسأل، أسأل عن أولئك الذين لا أعرفهم ولم أرهم قط في حياتي.
كان ألبوم الصور كتلك الألبومات التي نجدها في كل البيوت، يحوي صورًا قديمة جدًا، لرجال ونساء وأطفال.
سألت عن أحد الرجال وقد كان واقفًا كالأبطال يرتدي معطفًا طويلًا غامق اللون فوق جلباب فاتح لا يظهر من الجلباب إلا أسفله، فأجابتني أمي بشجن كبير أنه جدي وأنه توفي بعد ولادتها، ولم تكن قد تجاوزت عامها الأول.
سألت عن آخر، كان شابًا وسيمًا قصير الشعر يرتدي زيًا عسكريًا، فأخبرتني دامعة العينين أنه خالي الذي استُشهد في الحرب.
وشاهدت صورًا أخرى لزفاف أمي وأبي يحيطهم أقارب لا أعرف مُعظمهم، وصورًا لأبي صغيرًا رفقة أصدقائه، يلعبون الكرة على شاطىء البحر.
جعلت أمي تتصفح الألبوم وأنا أسأل، حتى جاءت صورة لفتاة صغيرة في مثل عمري تقريبًا، ربما لم تُكمل عامها العاشر، كانت الصورة كمعظم صور الألبوم، قديمة وغير مُلونة، ولكنها ليست كباقي الصور، كانت صافية تمامًا، صافية ونقية.
كانت الفتاة رقيقة للغاية، ذات وجه صغير ومُستدير، وبشرة ناعمة بيضاء خلتُها مرمرية، عيناها عسليتان وشعرها ناعم كستنائي، تنظر لمصورها في براءة نادرة.
على الفور أصبحت في عالم آخر لا أعلم كنهه، لم أدر سببًا لتلك الحالة الحالمة التي تملكت عقلي، وذلك الشجن الدافئ الذي ملأ قلبي.
لم أستطع أن أعزو حالتي تلك إلى ملمح واحد بعينه في الصورة، ولكن الفتاة كلها كانت حالة حالمة لا تتكرر، وكأن هناك -بالإضافة إلى ملامحها التي تفيض براءة- روحٌ طيبة ترافقها على الدوام، أو هالة مقدسة تُخبر الناس أنها أقرب إلى الملائكة منها إلى البشر…
هكذا رأيت!
– من هذه الفتاة يا أمي! (أعدت السؤال مرة أخرى).
عند صورة الفتاة كان الشجن قد بلغ بأمي مبلغًا عظيمًا. فأجابت وقد تحررت الدموع الحبيسة من مُقلتيها:
– إنها سالي يا بني، كانت جارة لي في بيتي القديم، بيت أبي وأمي.
– ولماذا لا تأتي لزيارتنا أبدًا.
– لأنها ماتت!
– ماتت! كيف تموت وقد كانت صغيرة!
– الصغار يموتون أيضًا يا بني، أصابتها حمي شديدة ثم ماتت.
– وهل لها أقارب؟
– كانت وحيدة والديها، كادا يُجنا بعد وفاتها، هجرا الحي ولم يُعرف لهما من خبر.
لم تكن صور الموتي في الألبوم كباقي الصور، كانت تُخلف في نفسي إعجابًا شديدًا لا قرين له، كانت مهيبة بها شيء من وقار وفخامة وقار الغياب وفخامة الموت.
الموت ذلك الشيء الغامض والمُخيف الذي يتسلل بيننا، لا نشعر به، لا نعرف كنهه أو ماذا بعده، ينتقي من يريد لصحبته، الموت الناعم الذي يُضفي شجنًا ساحرًا على أصحابه.
كنت أشعر في طفولتي أن كونك ميتًا لهو شيء فاخر، كان يُعجبني ذلك البيات الإجباري الذي يرقدون فيه مُرغمين في القبر.
في تلك الليلة أحببتُ سالي حبًا كبيرًا، وأمضيتُ ليلتي أحلم بها أحلامًا نادرًة، وفي اليوم التالي، أخذت صورتها من الألبوم خلسًة، وضعتها في إحدى كتب المدرسة، أصبحتْ رفيقتي الدائمة في صحوي ومنامي، على مدار اليوم أزورها في الكتاب، وفي الليل أراها في أحلامي، وفي الحالتين أتحدث معها كثيرًا.
رافقتني سالي لشهور طويلة، دون أن أُحدث عنها أحد، كانت زخرفة طيفها تزداد روعة في خيالي يومًا بعد يوم، وكنتُ ألجأ إليها في أحلك حالاتي، فلو أنني عوقبت لأي سبب من أمي أو أبي، أو أنني أردت الاختباء حتى لا يراني أحد، أو حتى إذا ما بحثت عن العُزلة بلا سبب، كنتُ أركض إلى الصورة، ألوذ بها، وكانت لي في هذا مراسم وطقوسًا، أحتضنُها في سريري، نتدثر معًا تحت الأغطية، أفكر فيها، أشكو لها، أحادثها وتحادثني، تبتسم لي… ثم أراها في أحلامي.
اعتدت أن فكر في الموت، ذلك الكائن غير المرئي، المخملي القاسي، الذي حرمني من رؤية سالي.
بعد أن نتناول الغذاء كانت أمي تجلس على الأريكة، تحت النافذة تراقب الناس في الحارة، وهي تحتسي الشاي الساخن، باعة جائلون وأطفال
يلعبون ونساء قبالتنا ينشرون الملابس المبتلة، وكنت بجوارها أفكر، أفكر
في سالي، وفي الموت.
بعد تناول الغذاء وما يتبع ذلك من تكاسل وخمول، كان صياح الفراخ والديوك المُنهكة طوال اليوم في الحارة، ومنظر أشعة الشمس الحزينة الآفلة نحو المغيب، يدفعاني دفعًا إلى التفكير في الموت، وفي سالي، تلك الحزينة المُهملة واليتيمة. كرهت العتمة وخفوت الضوء الذي يغزو بيتنا في ذلك التوقيت، عندما كانت الساعة تشير إلى الخامسة، كانت أمي تدير مؤشر الراديو على صوت أم كلثوم، فتصطلح عليَّ كل الشجون طفرة واحدة، تبدأ أعصابي في التنميل، ويتألم قلبي أشد الألم.
لم تبرحني تلك الذكرى يومًا، وظلت تلازمني بعدها طويلًا، بل ومازالت آلآمها تلاحقني حتى الآن.
لم أستطع أن أتمالك نفسي أكثر من ذلك، ذات مساء وبشجاعة بطولية، استجمعت قواي كلها، وصارحت أمي بأني قد أخذت الصورة من الألبوم، ووصفت لها ما يعتريني من حب جامح لسالي، ورغبتي في زيارة قبرها لأضع عليه الورود الجميلة والصبّار، ورؤية أحد من أفراد أسرتها.
لم تفهم أمي كلمة مما قلت، ملست على جبهتي، قادتني إلى الفراش وحصلتُ على كوب من الكاكاو الدافئ وفي الحال كان عليَّ أن أستلقي نائمًا.
بعدها فقدتُ صورة سالي، بحثتُ عنها كثيرًا في كتبي، ربما أخفتها أمي كي أبرأ من خيالاتي، هو ذاك بكل تأكيد، ومع هذا لم يُضنني البحث، ولم أجدْ لها من أثر.
ذات مرة سألت أمي عن الصورة، فقالت بحنان جامح:
– ستجدها يا حبيبي، ستجدها يومًا ما.
– نعم يا أمي… سأجدها… يقينًا سأفعل يومًا ما.
في غرفتي بكيت كثيرًا، كُنتُ أعض على لساني، كي لا أصرخ ويسمعني أحد، ركعت على ركبتيّ.
وبصوت يكاد لا يُسمع همست:
– حبيبتي.
ثم انتحبت كثيرًا وقلت:
– سالي.