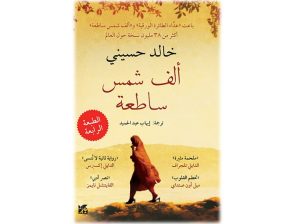د. صلاح السروى
نحن بإزاء عمل روائى جديد، ولا تنبع جدته من الحداثة الزمنية المجردة، بل من كونه (يُنازل) العالم بشكل مختلف، إلى حد كبير. وأقول ينازل العالم وليس مجرد أنه يقدم العالم. فهل لا يستخدم الرؤية “الكنائية” التى تحاول الايهام بحقيقة الواقع الذى تقدمه الرواية، كما درجنا فى الأعمال الروائية التى تقدم محاكاة دقيقة وصارمة لهذا العالم. كما أنها ليست الرؤية “الاستعارية”، التى تقول أن العالم انما هو، فى جوهره، يوجد على هذا النحو الكابوسى أو الحلمى السيريالى كما يراه الكاتب. انما تأتى كلمة (ينازل) العالم بمعنى أنه يدخل معه فى حوارية أقرب الى الصراع والتجاذب والادانة، منها الى الاقرار والتسليم بمحدداته وشروطه المُعاشة.
“سورة الأفعى” تنسب نفسها إلى الرواية، بمعناها المستقر، من حيث إنها تتناول الواقع المصري، فى اطار من الأحداث التى يقوم بها شخوص فى حيز زمنى محدد باللحظة الراهنة، القابعة فى أجواء ثورة يناير، وما بعدها. ولكن باعتبار أن اللحظة الراهنة انما هي بنت هذا التاريخ الطويل السابق عليها، الذى يتم ايراده بطرق متعددة. ويتم ذلك من خلال التكثيف الحدثى والرؤيوي. بيد أنها تتجاوز هذه الوصفة الكلاسيكية المعروفة، لتسير بتلك العناصر، ذاتها، في خط جديد يتواجد الآن فى القليل من الروايات المعاصرة.
هذا الخط يقوم على أساس الانطلاق من مسلمة، مؤداها: أننا بازاء واقع تعسٌ للغاية تغلب عليه صفة القِوادة، (أشرت الى “الأحدب” وهو أحد الأبطال الرئيسيين فى الرواية)، ولكن هذه الصفة ليست صفة هذا البطل وحده، بل هي حالة اجتماعية وسياسية عامة، ارتكزت على فكرة استخدام المرأة باعتبارها وسيلة لكسب الرزق، كما أنها وسيلة للتعامل مع الخصوم، والتعاطي مع السياسة. وهنا لايصح اعتبار أن “الأفعى” التى جاءت بالعنوان، هي المرأة، على التحديد. باعتبار أن الأفعى تمثل صفة سلبية، بما تحمل من استخفاء وغدر. انما هى هذا الواقع، برمته. بينما المرأة (والباقون) هنا هي ضحية هذا المجتمع الضائع، المنتهََك والمنتهِك، فى الآن نفسه. والذى تحول الى .. “مملكة تعيد زمن القوادة الجميل” ص 221. انه ضحية لهذه الشخصية التي لا تجد مأوى !!!، فهو الجانى – الضحية، لكونه مستخدما من قبل القوادين والسياسيين.
تبدأ الرواية بالقواد، الطالب الجامعي، الذي ينصدم بمجتمع آخر، أعلى طبقيًا، تتصدره فتاة لافتة الجمال اسمها “ملكة”. وأظن أن الجمال، هنا، لايمثل معطى حسيا، بقدر ما يمثل دلالة طبقية، بطريقة أو أخرى. فمن يملك المال أكثر، يستطيع أن يصير أجمل، بأن يرتدي أفضل .. الخ. والجمال الطبقي، هنا، ليس مسموحًا للأحدب (الدميم الفقير) الاقتراب منه. نتيجةً لتلك الفوارق، فهذا ليس من حقه.
حيث تقدم الرواية نوعا من الإحالة الشفيفة إلى بطل رواية “أحدب نوتردام”، ذلك الدميم المشوَّه، على الرغم من أنه يحمل قلب انسان. وفيكتور هوجو، الذى كان رومانتيكيًا، في المرحلة الأولى المنتصرة المزهوة للرومانتيكية، انتصر للأحدب، فما المانع، عنده، أن تعشق الفاتنة الجميلة الأحدب؟
لكن، هنا، في سورة الأفعى، المصير مختلف، بمعايير اللحظة الزمنية، فكيف يتجرأ الأحدب ويقترب من الملكة، من الأساس؟ وعلى هذا يتم تأديب الأحدب. وهنا تطرأ لحظة الانعطاف الحقيقية في حياة هذا الأحدب التعس، فهو يتحول من مولع ولهان إلى قاتل. كما يتحول من مُحب وعاشق إلى قوَّاد .. إلى شخص يرغب بالحصول على أي مكتسبات أو غنائم، فينتقم من الفتاة (الملكة) ويلقي بماء النار على وجهها، فيحرقها. والغريب أن تصير الفتاة، من فرط كراهيتها له، إلى أسيرة له. إنها النفس البشرية المركبة الى حد التعقيد، الى الدرجة التي تقع فيها أسيرة لجلادها. أوهو ما يذكرنا بما يعرف، فى علم النفس، “بمتلازمة ستوكهولم”. التى تعنى الوقوع المرضى في هوى الغالب. بما يوحى بالتشوه والغرابة.
مع هذا المسار تتواجد مسارات أخرى، لا تقل في التركيز، (التبئير)، إذا جاز استخدامنا لهذا المصطلح، الذى يعنى إلقاء الضوء وايلاء الاهتمام الحدثى والوصفى بشخصية معينة، أو أخرى. نذكر منها حكاية (الشيخ نجم الدين)، الطفل الذي تربى عند جده الولى الصوفي الورع، الذى كان يتمتع بمكانة وهالة تقديسية كبيرة، وغنى لاحد له، الى حد أنه يجد من المريدين من يغسل له قدميه. يتوفى الجد، فيسافر نجم الدين ليعيش مع (كاتي). والتي تمثل، بدورها، مسارا آخر، بحكايتها مع عاشقها الذى تعرفت عليه أثناء الحرب العالمية الثانية بالإسكندرية. وهكذا، فهناك عشرات المسارات، مع كل بطل. مسارات تتفجر، وخطوط تتقاطع وتتداخل، لكن مسار الرواية الأساسي هو أن هؤلاء جميعًا، هؤلاء الأبطال، يبحثون عن التحقُّق والسلطة، والوفرة المادية. سواء أخذ هذا البحث أشكال القِوادة الصريحة أو المقنعة، كالنصب باسم الدين أو الوطن. وكل الأبطال، هنا، ينصب هدفهم على امتلاك المرأة، ليس باعتبارها وسيلة سافلة لكسب الرزق، على نحو مباشر، ولكن، من ناحية رمزية، باعتبارها معادلا للحياة، بكل ما فيها من لذّات ومُتع.
إذا اعتبرنا أن هذا التتبُّع لمسارات الرواية هو تتبع نموذجي أوحقيقي، فاننا نحصل على مرمى محدد وهو طرح مكونات هذا الواقع الآسن في مبدأه، والذى تحول إلى واقع أكثر قبحًا وعفنًا في منتهاه، فى نهاية الرواية، وقد لا يأتى الأفضل منه، في القريب. فالجميع ساقطون ومنحطون.
من هنا تأخذ الرواية منحى عدميا، أسيانا، يقوم على جلد الذات ، بما يجسد طبيعة مرحلة ما أسميه: بمرحلة “ما بعد الثورات المجهضة”.
من هنا تبدو الرؤية مفتوحة على آفاق متعددة فى هذا الاتجاه. ولا مكان للقول الفصل فى مآلات، أو مستتبعات كل ذلك.
من هنا فان هذه الرواية ليست رواية اعتيادية، كما أسلفت القول. فهى لا تقوم على الحبكة التقليدية المعروفة، ولا تتطور على نحو خطى طولي، بل تتراكم عبر عدد كبير من الخطوط المتقاطعة والمتداخلة والمبعثرة هنا وهناك. لكنها تلتقي، جميعا، في بؤرة واحدة، أو ما يقترب من البؤرة، التي تشتبك في نقطة، مؤداها: “من الذي سيحكم؟ من الذي سيرث هذا الملكوت؟ من الذي سيمتلك المرأة؟”.
والأبطال في الرواية لا يملكون وجها واحدًا، بل بداخل كل منهم قسمات متعددة، لا تجعلنا نُدين في النهاية أحدًا، وفى الآن نفسه، لا تجعلنا نشفق، باطمئنان -في حقيقة الأمر- على أحد. حال نجاحها فى توريط القارىء فى الانخراط الانفعالى مع هذه الحالة المتداخلة، المشتبكة، المتعددة الخطوط، القابلة لأن تُفهم على أكثر من وجه. سواء، اذا تتبعنا خطًّا واحدًا، أو أكثر من خط أو الخطوط جميعًا.
لكي تصل بنا الرواية إلى هذه الحالة فقد اعتمد الكاتب وسيلة تتحدد فى ما يمكن تسميته بالواقعية الشبحيَّة. وهذا المصطلح أنا أتحمل مسؤوليته.
وتلك “الشبحية” ليست “الواقعية السحرية”. بل هى “واقعية”، من ناحية اشتباكها، على نحو مباشر مع الواقع، المُعطى الاجتماعي، التاريخي. باعتبار أن دور هذا المعطى هو تشكيل عوامل التأثير فى طبيعة النوع الإنساني، وتخليق سماته، وتلوين قسماته، فلا يوجد إنسان خارج المُعطى الاجتماعي التاريخي، بل انه يعد نتيجة مباشرة لفعالية هذا المعطى، فى اطار علاقته الجدلية بالفاعلية الانسانية للشخصية، من الناحية المقابلة. من هنا تعد هذه الرواية واقعية بهذا المقتضى، لأنها تناولت الإنسان في ظرفه الاجتماعي التاريخي المحدد، لكن هذه الواقعية ليست واقعية بلزاك، وليست واقعية نجيب محفوظ، التى تقوم على محاكاة الوجود بسماته وقوانين حركته السببية المعهودة. اننا بإزاء واقعية أخرى، فنحن لا نعرف إذا كان الفعل حقيقيًّا أم غير حقيقي؟؟ فهو يقبع في منطقة “الممكن” و”اللا ممكن”، وهي المنطقة المُحددة لمفهوم “العجائبي” و”الغرائبي”، مثل ما نجده فى أعمال أسطورية تراثية، مثل “ألف ليلة وليلة”. أو معاصرة، مثل ما نجده فى أعمال ماركيز. انه واقع ينحو نحو الغرائبية، لكن ليست كل عجائبية هي واقعية سحرية، فالواقعية السحرية تتعامل مع الواقع باعتباره أسطورة، ومع الأسطورة باعتبارها واقعا، فهي تمزج وتخلط بين الاثنين. اننا هنا بازاء واقعية – حقيقية- وأحداث تاريخية حقيقية، وليس بازاء واقع افتراضي.
لكن هذه الواقعية هي واقعية “شبحية”، فثمة ضبابية متعمدة للواقع، تتمثل فى إضفاء نوع من الطيفية على أحداثه، بما يجعلنا نتساءل: هل حدث ذلك حقا، أم لم يحدث، من خلال خبرتنا بما مر بنا من أحداث، تاريخية، أو معاصرة؟؟
إن أفعال الأبطال جميعًا تقع في هذه المنطقة، التى تنقل الرواية من منطقة “الرواية”، باعتبارها جنسًا أدبيًا، إلى الشعر باعتباره جنسًا أدبيًا مغايرًا. انها حالة من التهجين بين النوعين، أكدها وفاقم من احساسنا بها تلك اللغة التى صيغت بها كثير من مقاطع الرواية. مثل قولها :
“يراقبها ابن الجيران المراهق من النافذة البعيدة، كعادتهما كل مساء، وهى تراه .. لا تراه. لاتهتم كثيرا. تعود لتلقى نظرة على عقارب الساعة، فتلدغها وتقرص حلمتيها، قرصة خفيفة موجعة” (ص23)
حيث نلحظ هذا المجاز الذى يقتحم السرد على نحو حاد ومفاجىء. حيث تتحول عقارب الساعة الى عقارب حقيقية تلدغ حلمتيها بما يوحى، ربما بحالة ايروتيكية تتناسب مع حالة الوجد الجسدانى الواضح لحالة المرأة.
وبهذا فإنها تكسر الرواية، على نحو ملموس،الحدود بين الأنواع وتُذيب الفوارق بين الأجناس. وهى تدمج وتخلط بين الواقع بأُطره المادية وبين عالم آخر يدخل معه باعتباره أيضًا يمثل وجودا واقعيًا، ولكنه وجود مُضبَّب. وعمل الكاتب، هنا، يتمحور فى منطقة تحويل هذا الواقع إلى “رؤية”، إلى صورة ذهنية، مجردة، فالتجريد هنا، سيد الموقف، والفن يقوم على التجريد، بقدر ما يحشد من تجسيد.