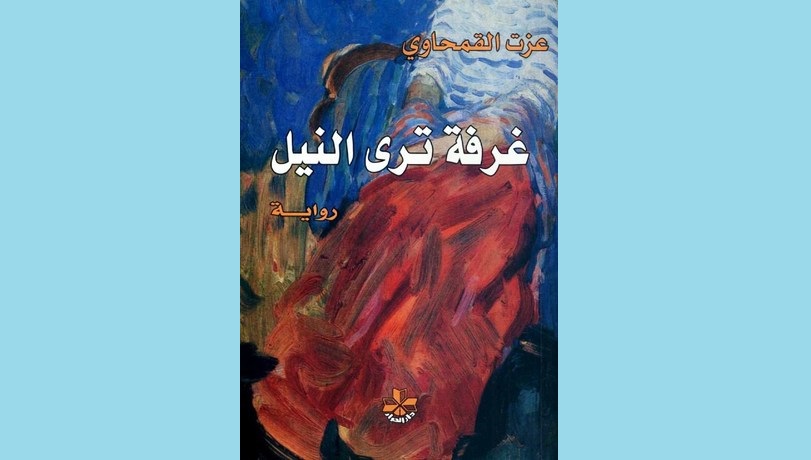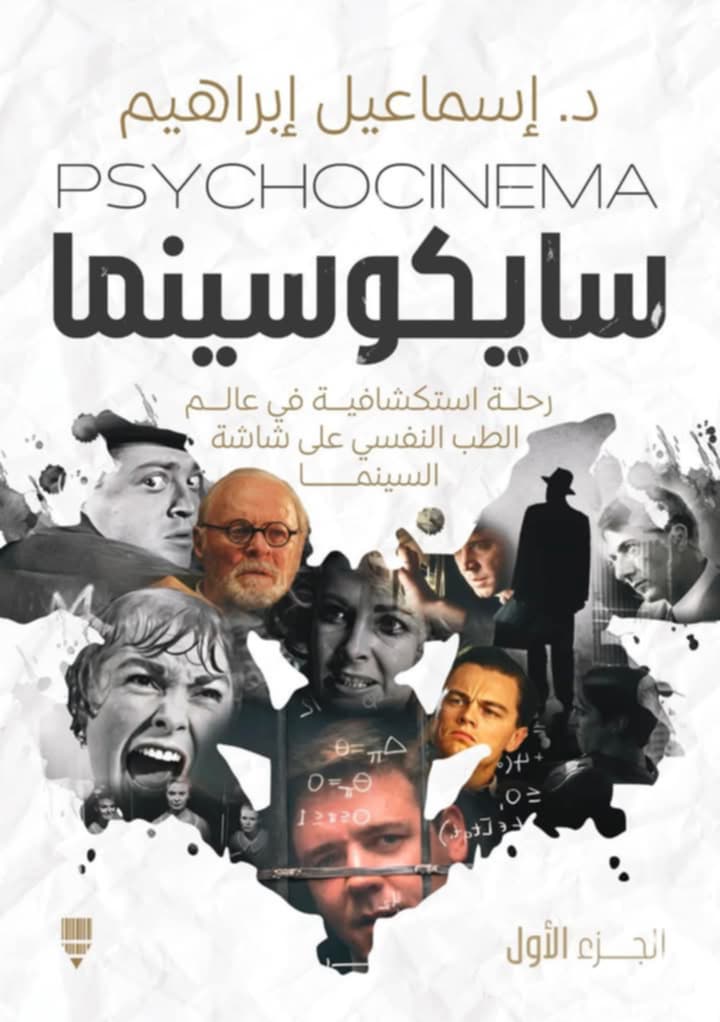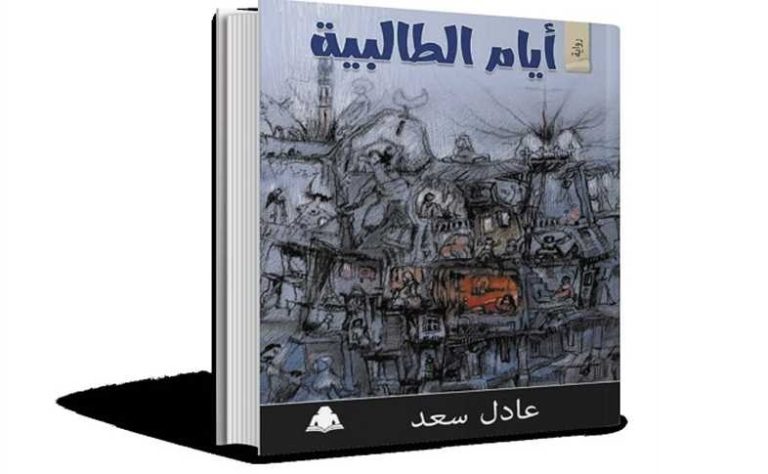حسن عبدالموجود
خلق عزت القمحاوي لنفسه منذ الصفحات الأولى لروايته «غرفة ترى النيل» مشكلة أشبه بجبل، وهي “موت” البطل عيسى، أو بشكل أدق “صعوده”.. أليس عيسى أشبه بمسيح؟!
هذه المشكلة صارت تحدياً فنياً، على الكاتب أن يحله، وأن يقول لنا إنه أرسى الجبل ليتسلقه بسهولة، ويجبرنا نحن القراء على الإكمال، فإن كنا نعلم أن البطل مات، وأن نعشه يعود إلى قريته “العُشَّ”، فما حاجتنا إلى إكمال الرواية؟ ما حاجتنا إلى قلب صفحة جديدة منها ونحن نعلم أن كل ما سيأتي هو اجترار لذكريات؟ استدعاء لقصص بعيدة نهايتها محتومة؟ وتفاصيل أصبحت جزءاً من الماضي حتى وإن كانت تفاصيل طازجة، تفوح منها رائحة المحاليل ونظافة المستشفى الاستثماري، في آخر أيام عيسى؟
منحتنا الرواية الجميلة إحساساً – منذ اللحظة الأولى – أن عيسى ميت لا محالة، إذ لا يخلو يومه من رؤية دماء في الحمام، وفي سريره، ولكن الكاتب لم يُشح بوجهه بعيداً، متجاهلاً المشكلة، أننا نعلم مثله ومثل رفعت وبقية أبطال الرواية بموت عيسى، وانهيار جسده الوشيك، فكل صفحة تخبرنا بمصيره. صحيح أن الأطباء منحوه هو وصديقه رفعت أملاً كاذباً في الحياة بضع سنوات أخرى، إلا أنه كان أملاً يشبه بيتاً رملياً على شاطئ، قد تعصف به هبّة ريح، أو هجمة موجة، أو قدم طفل.
لكن تلك الرواية تريد أن تقول – على ما يبدو – إن عيسى هو أكثر شخص من بين أقرانه، لا يستحق الأسى، فلم يجبره أحد على شيء، وقد اختار كل شيء بحساب وبمزاج. عمل في قسم الصياغة، لا ليصبح متحكماً في مصائر المحررين ولكن ليواري اسمه خلف أسمائهم. مارس هواية الاختباء من كل شيء. أراد أن يعيش في الظل. وجد متعته في العلاقات الصغيرة، مع نساء، تحولن بأسرع ما يمكن إلى عشيقات، يرسلن إليه الخطابات من بعيد، أملاً في تجدد اللقاء. كانت كل تفصيلة تُحوّله بالنسبة إليهن إلى شخص لا يمكن نسيانه أبداً، كل حكاية تصنع أسطورته، أخبر سميرة أنه سيتزوجها لو كانت هديته لها، ذلك الفستان الجميل على مقاسها، أما إن كان أصغر فسيظل يحبها، وبالتالي لم تشأ المخاطرة، فهي لا تعرف، إن كان الأفضل لها وله أن يتم تفصيلها على مقاس زوجة، أو أن تحصل على حرية عشيقة. كانت معجزات عيسى لا تُحصى، بإمكانكم أن تلمسوها في المستشفى. فرغم أنه على بعد أمتار من الموت، إلا أنه طارد المتعة، واحتفظ بوهج الرغبة داخله. صار قادراً بلمسة على إخضاع ممرضات وطبيبات. كان يزن كلماته بميزان، كل كلمة باحت بعدم اكتراثه، سخريته، تعاليه، “عظمة، مسخرة، مملكة، يا سلام، يا ولد، بنت هرمة، عيشة، خرع” وهكذا. لم يستطع أحد كسر عيسى حتى الموت نفسه لم يستطع. صحيح أن “رئيس التحرير” – وهو ألد أعدائه – اعتبر الموت هزيمة له، لكن عيسى حظي بالسلام بينما رأينا رئيس التحرير يختنق في غبائه، وفي دهونه، وفي تفاهته، وفي مساعدته على ظلم الناس وقتلهم، وفي تقنينه السرقة لأصدقائه الكبار. مات عيسى، لكنه على الأقل بقي في ذاكرة كل من قابلهم، حتى روزا زوجته التي باعت جسدها للجميع، كانت تتمنى لو يمنحها اهتماماً مثل هؤلاء النساء القادمات من شتى بقاع الأرض، ليقعن في غرامه وغرام مصر وأم كلثوم، عاش في ذاكرة عجوز “الأمفتريون” الأرميني ليفون، عاش في ذاكرة أشخاص لم يقابلهم إلا ساعات، أما رئيس التحرير فلم يبق منه سوى لقب خلعه عليه عيسى، لقب “أبو جهل”. كان رئيس التحرير يتخيل أنه عاش معهم كل هذه المدة لا معهم ولا عليهم، لكنه كان مخطئاً، فلم يكن مطلوباً من عيسى أن يرفع صوته بشعارات الشيوعيين، أن يتحدث طوال الوقت عن الاعتقال، والألم، وقسوة الحياة، فالحياة قصيرة، وينبغي أن نعيشها كما يليق بها، مخلصين لها، منتبهين إلى كل كلمة ننطقها، مدركين أن صرفها على المحبة أفضل من هدرها على الكراهية، حتى وإن كانت كراهية أبو جهل نفسه.
كان عيسى أكثر ذكاء من الجميع، بمن فيهم رفعت، الروائي الشهير، الذي قضى عمراً يبحث عن نفسه، ووجدها في الأيام الأخيرة بصحبة صديقه. لم يكن رفعت انعكاساً كاملاً لعيسى، لكنه اكتشف ربما في وقت متأخر أن صديقه منحه المعرفة، وجعله أكثر قدرة على التأمل، وعلى رؤية الانهيارات حولنا قبل أن تحدث بوقت طويل. انهار جسد عيسى، ومعه كانت تنهار بيوت البسطاء في جزيرة الدهب، كان معمار المدينة يزوي مثلما هو الحال في معظم روايات عزت القمحاوي، بينما تنشأ مدينة أخرى لا نعرفها ولا تعرفنا، مدينة ذات معمار مخيف، أبراج زجاجية صامتة ومصمتة، يختبئ فيها أصحاب مالٍ وذوو بأس بين سحابة وسحابة، حتى بيوت القرية الطينية الطيِّبة ابتلعتها الأرض ونهضت بدلاً منها عمارات عالية ذات حوائط من الطوب العاري. لم يكن مطلوباً من عيسى أن يسير على الماء ليؤمن رفعت بديانته، كان يجب أن يؤمن به من اللحظة الأولى، لكنه احتاج إلى عُمر ليفهم ما تعنيه الحياة على طريقة عيسى، مودعاً حكاياتهما، وبهجاتهما الصغيرة.
هذه ليست رواية عن الموت، بل رواية عن الحب، رواية مع البهجة ضد الملل، مع البراح ضد الأسوار العالية، مع الأمل وإن كان كاذباً، مع الجسد ومع الروح، رواية تستبطن ما يدور في عقول جميع شخصياتها (الثانوية قبل الكبيرة)، لكنها لا تنسى أيضاً الشوارع (التي تضيق عليهم، ولا يتبقى منهم سوى صوت اصطدام سيارتين، أو فرملة مفاجئة)، ضد المستشفيات الحكومية وضد الاستثمارية، مع الأطباء وضدهم، مع أصل القاهرة والدلتا المعماري لا مع تبرير التشوه والخراب هنا أو هناك. رواية عن النقاء وضد التشوه، رواية عن الأعمار القصيرة الجميلة، وضد الملاحم الكبرى، رواية عن الخلود، (ولذلك يمكن بدؤها بالموت) رواية عن الحب، وضد منحه بحدود، أو قصره على أفراد. رواية عن الاختباء خلف الصمت، وعن استقبال الموت بحفاوة، إذ تبدأ بعده حياة أكثر استقراراً لا مكان فيها سوى للعظمة بدون حساب.