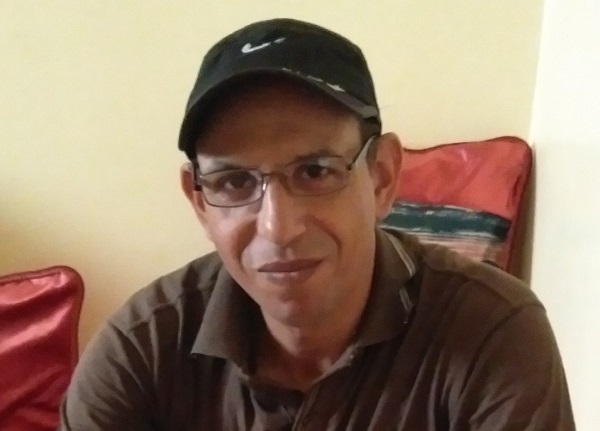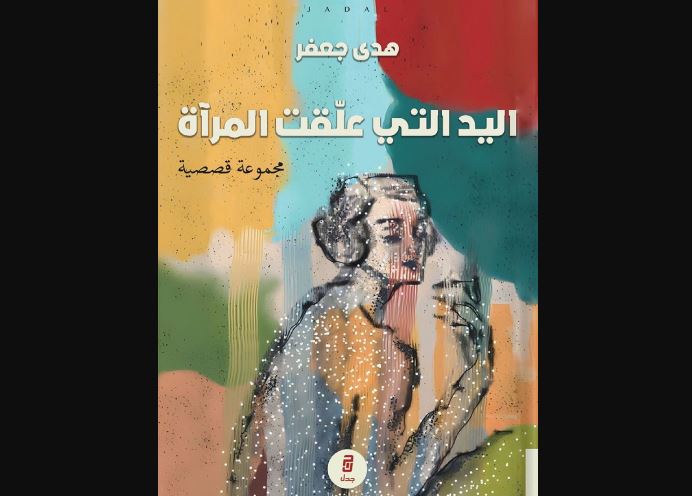عبد اللطيف النيلة
– آه يا لطيف.. لم تتوقف عن الكلام منذ انطلاقة التاكسي. كما لو أنك شغلت راديو.. بلا توقف يثرثر. تطلعت إليها لحظة دخلت التاكسي وأغلقت الباب، أو بالأحرى أغلقه صاحبها، بلباقة الرجل ولياقته. كانت ترتدي بذلة سوداء مفتوحة الأزرار تحتها قميص بلون الخردل. شعرها قصير أشقر.. ليست شقرة الطبيعة، أكيد أنها تصبغه من فترة لأخرى، فقد كان لونه خليطا من الذهبي والبني المائل إلى السواد، كأن طبيعة شعرها تأبى إلا أن تعلن عن نفسها. ربما كانت في الثلاثينات من عمرها. فقد ذكرت لصاحبها أنها قدمت إلى الجبل في بداية التسعينات. لم أستطع تحديد سنها بدقة، فقد كانت تضع نظارة سوداء حجبت عينيها والدائرة المحيطة بهما. كأن العينين بمحيطهما تؤشران على السن الحقيقي. على أية حال بدت لي أكبر سنا من صاحبها، فقد كان وجهه صغيرا نضرا، لا أثر فيه للتجاعيد، وشعره خفيف كأنه حلقه منذ أيام فقط.. لن أطيل عليك، فما يهم هو ثرثرتها التي امتدت لنصف ساعة تقريبا وهي المدة التي يستغرقها التاكسي من تحناوت إلى مراكش. لا أذكر بالضبط متى شغلت إذاعتها، لكن ربما كان ذلك حين نبهت السائق إلى ضرورة الانتباه إلى الطريق، فرد عليها بأن المقود اعتاد على سياقة السيارة وحده. كان جوابه مغلفا بروح الدعابة. وفعلا استملحت دعابته، فضحكت، وقالت: لا مانع لدي إذا كان يعرف الطريق. أجابها السائق ضاحكا على الفور: لقد حفظها عن ظهر قلب. ضحك كل من في التاكسي، ثم أخذت تحدث صاحبها بصوت مسموع عن كونها، ذات مرة، قادت دراجتها النارية إلى المدرسة، دون أن تدري كيف تم ذلك. لقد وجدت نفسها، فجأة، أمام المدرسة، فاندهشت. الطريق مليئة بالانعراجات الخطرة، وهي ساقت دراجتها شاردة، كأن الدراجة قطعت الطريق على نحو آلي، ودون تدخل منها. العادة تصنع العجب، هكذا عقبت. أمن صاحبها على قولها بكلمة واحدة: صحيح. وفي هذه اللحظة ارتفع هدير السيارة، فلم أتمكن من متابعة كلامها. كانت تجلس، في الظل، بجوار الباب الأيمن للسيارة، وكنت أجلس، في الشمس، بجوار الباب الأيسر. كان يفصل بيننا راكبان. وحين التقطت رأس الخيط مرة أخرى، كانت تقول إن تلاميذها لا يعرفون إلا قليلا من الكلمات العربية، وبعضهم لا يفهم إطلاقا عباراتها، وهي بدورها لا تعرف إلا بعضا من الجمل الأمازيغية، فكانت تضطر إلى الإشارات أو الصور أو الرسم لتحقيق التواصل. علق صاحبها ضاحكا باحتشام: كأنك تعلمينهم الصينية!
فضحكت بقوة، ثم استرسلت تتحدث عن الوجه الآخر للمدرسة. فبعد انصراف التلاميذ إلى بيوتهم، يعمدن – هي وزميلتاها المعلمتان- إلى تحويل إحدى الحجرات الدراسية إلى مكان للمبيت. فيزحن صفا من الطاولات جانبا، ويستخرجن من الخزانات الحائطية ما يلزم لإعداد الفراش والطعام.. الخ. وقد أشارت إلى وجود حارس يبيت ساهرا عند مدخل المدرسة، مسلحا بهراوة وكلبين. لكنها اشتكت من شعورهن بالخوف ليلا، رغم أنهن يضاعفن أسباب الحيطة، فلا يكتفين بإغلاق باب الحجرة بالمفتاح، وإنما يدعمنه بأكثر من طاولة…
– يا لطيف!
– إييه!.. وأنا أحاول التقاط كلماتها المتتابعة، أدركت بغتة أمرين: الأول أني بصدد استراق السمع، عمدا وبإصرار، وقد بررت ذلك لنفسي بأنه وسيلة لتكسير روتين الطريق ونسيان حرارة الجو التي كانت في بدايتها، وربما في غير موعدها. والثاني أني كنت أول من حجز مقعدا في التاكسي، وقد تحريت أن أجلس إلى جوار النافذة حتى لا يشتد إحساسي بالحرارة إذا جلست في الوسط، لكني كنت مغفلا. لقد جلست في المكان الذي تأتي منه أشعة الشمس… ما أريد التأكيد عليه هو أني وعيت بهذين الأمرين في اللحظة نفسها التي كنت فيها أحاول جاهدا التقاط كلماتها. كيف يحدث ذلك، وبدون مقدمات؟ كأن كل واحد منا شخصان: أحدهما يقوم بالفعل، ونحن نحس بوجوده كل حين، والآخر يراقب ما نقوم به، ونحن لا نكتشف وجوده إلا أحيانا، وعلى نحو مفاجىء وخاطف. لكني أخرست صوت هذا المراقب، لم أدعه يفسد علي متعة الاستماع للآنسة الثلاثينية..
– آنسة؟
– لقد تطلعت إلى يدها اليسرى، حين نزل الراكب الذي كان يجلس بجانبي، فلم ألحظ وجود أي خاتم. كانت عانسا.. وربما العوانس أميل إلى الثرثرة من غيرهن. هذا ما خطر ببالي لحظة دفعتني ثرثرتها إلى التفكير في المنطق الذي يحكمها.. كيف يتناسل الكلام ليصبح ثرثرة؟ هل يعتمد التسلسل أم الاستطراد أم التداعي أم.. ؟ لقد استبدت بي الرغبة في معرفة كيفية انتقالها من موضوع لآخر، إلا أن صوتها كان يختلط بهدير السيارة، فيلتبس حينا ويتميز حينا آخر. لم يكن حديثها يصلني كاملا، كنت ألتقط منه أمشاجا، ولم أعرف كيف يفضي بها موضوع إلى آخر. غير أني أستطيع أن أؤكد أنها لم تكن تقدم أفكارا مجردة، أو تتأمل، أو تناقش وتحاور، بدليل أن صاحبها كان يكتفي بالإصغاء، وقلما يعلق أو يطرح سؤالا أو… كان صوته أخفض من صوتها. ربما كان يشعر بالحرج، وسط سيارة غاصة بالرجال. لعل ذلك سبب صمته. هل يمكن ألا تقع في الحرج إذا كان صوت امرأة يوهمك بأنه يتوجه إليك دون غيرك، لكنه في الواقع، بفعل كونه قويا مسموعا، ليس لك وحدك، بل هو شيء يتقاسمه الغرباء معك؟ كأنه بصمته، أو بشح ردوده، يتبرأ من صاحبة الصوت.. هل فهمت قصدي؟
– أجل.
– وفي الحقيقة فإني قد تعاطفت معه، أو لعلي أشفقت عليه. لقد كان في ورطة.. أتصور أنه ينتشي بالجلوس قريبا منها، ويحب أن توثره بالحديث عن نفسها، إلا أنه لم يكن يستطيع أن يطلب منها أن تخفض صوتها. وجود الآخرين يجعل هذا الأمر صعبا، بل مستحيلا. حتى الهمس لم يكن متاحا.. تصور نفسك في زحمة التاكسي، وتحت أنظار الآخرين، تدنو بشفتيك من أذنيها لتهمس.. ربما يكمن سر عجزه في طبيعة العلاقة بينهما. أهو صاحبها فعلا؟ مشروع صاحب أو خطيب؟ قريب؟ أخ لأحد تلاميذها؟ كانا بعيدين عن مجال رؤيتي، أسمع الصوت ولا أرى الصورة.. أعتقد أن الصورة تكشف وتفضح أكثر من الصوت. بدونها تبقى الحقيقة نسبية، أو فلنقل إن أسئلة كثيرة تبقى عالقة. فهل نعتبر الصورة أفضل من الصوت؟
– لا أتفق معك. هل يمكن أن تستمتع بشريط سينمائي دون صوت؟
– معك حق. ذات مرة وأنا أشاهد فيلما أمريكيا كتمت الصوت، واكتفيت بقراءة الدبلجة. لكني أحسست أن الأحداث خلت من الحياة، من القوة، من التأثير. بدون صوت تموت الصور، الصوت هو الحياة. أما في مثل حالتي، فإن الأذن أفضل من العين: إني أستمع إليها، بحرية ودون أدنى حرج، لأنها لا تراني. على حين أني لو كنت أنظر إليها، لتنبهت إلى حقيقة وضعي. العين تفضحك، تعري موقفك، فتحس بالخجل أو الارتباك أو أي إحساس آخر. أما الأذن فهي حجاب، تسترق السمع دون أن يعرف الآخر أنك تفعل ذلك. لاحظ أيضا أن العين حساسة، تلتقط المنبهات، فتنفعل. ينعكس انفعالها على رفة الرموش، على حركة البؤبؤين، وعلى تعابير الوجه. أما الأذن فهي لا تحرك ساكنا. حساسية العين خارجية، وحساسية الأذن داخلية. تخيل لو أن الأذن تتحرك حين تلتقط الأصوات! كأن تلتوي جهة الصوت، أو تهتز شحمتها مثل قرني استشعار!.. لذلك كنت محميا ومحصنا.. بكل راحة واطمئنان أصغي، لولا أن هدير السيارة يشوش على سمعي، فتتعثر بوصلة التحليل والاستنتاج. لا أرغب أن أكون مستمعا سلبيا. فحتى ثرثرة هذه المرأة المتدفقة على امتداد الطريق، يمكن أن أتعلم منها شيئا. مثلا، من هو الحيوان الثرثار؟ الرجل أم المرأة؟
– سؤال غريب!
– لكنه يقتضي التفكير: إذا كان الانسان حيوانا ناطقا، فمن يجسد، على نحو جلي، خاصية الثرثرة؟ يبدو لي أن الرجل يلجأ إلى الكلام مرغما. يتكلم عند الضرورة، وباقتصاد، فيتخذ كلامه شكل واجب لا مناص منه. أما المرأة فهي ميالة إلى الكلام تلقائيا، لا تتصنع ولا تتكلف، بل تطلق نفسها على سجيتها، وتلتذ.. كأن الكلام طبيعة عند المرأة، وثقافة عند الرجل. وإذا كان الأمر كذلك، فالمرأة هي..
– الحيوان الثرثار!
– نعم، مادامت تتكلم بالطبع، وتكثر من الكلام.. لكن هل الكلام على السجية يعني الكشف عن الذات في حقيقتها؟ هنا تلح علي حكمة لأحد الفلاسفة قرأتها هذا الصباح، في الفصل، بينما كان التلاميذ منخرطين في إنجاز فرض المراقبة المستمرة. قال إن الإكثار من الحديث عن النفس ليس سوى طريقة لإخفائها. استعدت هذه الحكمة وأنا أستمع إليها، كانت في الظاهر تكشف عن نفسها أمام صاحبها، وأمام الملأ، ملأ التاكسي، غير أنها قد تكون بصدد إخفائها. لقد كانت تتكلم بعفوية وطلاقة، لكنها ذكرت أثناء كلامها، عندما أصبحنا على مشارف مراكش، أن أباها خلف لهم أملاكا كثيرة: مقهى، أراض، ومسكنا للكراء. وراحت تتحدث بتفصيل عن مشاكل الكراء: يدفع لك المكتري ثلاثة أشهر أو أربعة، ثم يبدأ في التماطل، فتضطر إلى رفع دعوى قضائية ضده، وتخسر أكثر مما تجني.. لقد لفت انتباهي شيء ملتبس في كلامها. إذا كان والدها قد ترك أملاكا، فهذا يعني أنهم أثرياء. لكنها تشتغل معلمة في الجبل! ما حاجتها إلى ريالات التعليم البئيسة؟ أما كان بإمكانها أن تدير مقهى أبيها، أو تشرف على استخلاص أجرة الكراء، أو.. ؟ خصوصا وأنها تحدثت بمرارة، في معرض كلامها، عن المخاوف والمخاطر التي تعترضها في الجبل. لقد استنتجت أنها تكذب.. ثم..
في تلك اللحظة، توقف التاكسي في المحطة، ونزل الركاب الآخرون. أما هو فقد طفق يتحدث، دون أن يفطن إلى توقف التاكسي، بينما بدا التململ على صاحبه. اضطر السائق إلى تنبيههما:
– لقد وصلنا آسْيادْنا!
فرد عليه دون أن يلتفت ناحيته:
– حسنا.. دقيقة من فضلك!
واستأنف يقول لصاحبه:
– تصور أنها لم تتوقف لحظة عن الكلام حتى حين توقف التاكسي في المحطة! لقد غادرت التاكسي وتركتها تتدفق بالكلام. يبدو لي أن..
وقاطعه السائق متذمرا:
– بسرعة، الله يخليكم، فأنا مستعجل!