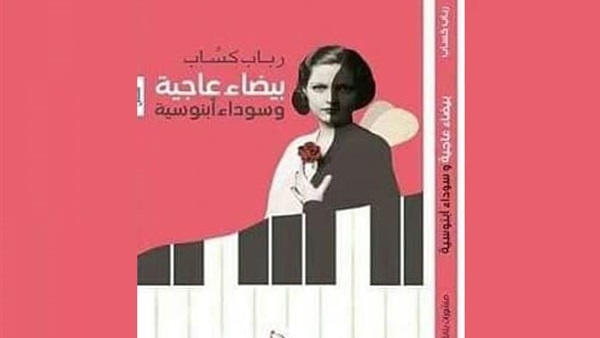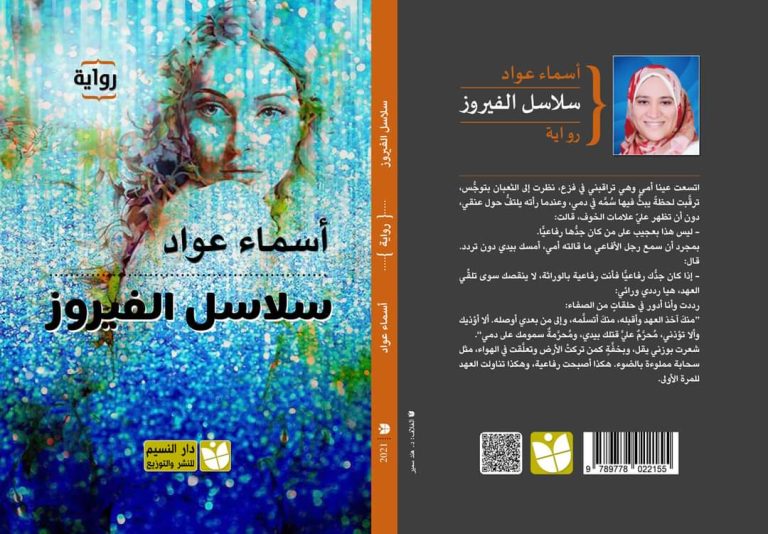موضوع الرواية يتصل بكاتب نجح في بلوغ عكس ما أشرنا إليه تماماً. ففي لغة سهلة، وسرد مكثف وعبارات رشيقة قصيرة، تقفز “حرب الكلب الثانية” فوق أسوار الملل المتعلقة بقصص المستقبل السوداوي، والعوالم الكئيبة، ومن ثم تحتل بجدارة قمة القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية للأدب، حيث ينجح الكاتب، خلافاً لروايات الديستوبيا العربية في الأونة الأخيرة، في التنقيب عن رسالة بالغة الحساسية، في غياهب النفس البشرية، ويصوغها بشكل صالح لكل زمان، ولكل مكان.. وبسرد مشوق مع ذلك.
ففي مستقبل غير محدد، وبعد حرب طاحنة أتت على اليابس قبل الأخضر، وحرمت السلطة على إثرها كل علاقة بالبشر مع ماضيهم، وعلى أرض مدينة لها أبواب، وتحكمها سلطة “القلعة” خلف ستار من الرشاشات الآلية التي تتصل بكاميرات آلية، ترقب البشر عند نقاط التفتيش لتصدر قراراتها القاتلة بمنأى عن هشاشة عواطفهم، وتغيب عنها الشمس ويقصر فيها النهار تدريجياً بطريقة غير مفهومة، وتنفق فيها الحيوانات والطيور، بينما تتوحش الكلاب وتتخلى الطبيعة عن وداعتها لتصير متناغمة مع وحشية الأنسان.. يرسم “إبراهيم نصر الله”، الكاتب الفلسطيني المعروف، ملامح روايته “حرب الكلب الثانية”، من خلال بطلها “راشد”، الذي يتحول من مناضل يساري عريق ضد أنظمة الحكم، إلى موالٍ ومناصر، وصهر لأحد ضباط القلعة، بل وشريك تجاري ومدير للمستشفى الوحيد في البلدة.. وإلى ما يمكن وصفه بـ”مهرج الملك” في إطار المستقبل، فهو يبتكر مشروعات جديدة تصب في مصلحة “القلعة”، ورجالاتها، بينما يحاول القاريء استكشاف سبب حرب الكلب الأولى، ويعايش الإرهاصات المخيفة لحرب الكلب الثانية..
روايات الديستوبيا، أو استشراف مستقبل المجتمع الفاسد في مستقبل مظلم، صيحة ليست بجديدة على الأدب العالمي. فالعالم عرف أشهر تلك الروايات على الإطلاق مثل 1984 و451 فهرنهايت وغيرهما منذ زمن طويل، لكنها في الأدب العربي لم تظهر بقوة إلا في الأونة الأخيرة، واشهرها “يوتوبيا” لأحمد خالد توفيق، و”عطارد” لمحمد ربيع، و”موسم صيد الغزلان” لأحمد مراد هي الأخيرة.. لكننا في “حرب الكلب الثانية” إزاء رواية بديعة، تتمتع بعدة ميزات تفردها عن مثيلاتها، بل وتدشن في إطار ما طرحته.. تساؤلات عن جوهر وخلفية روايات أخرى عديدة..
نبدأ بمميزات الرواية التي تفردها عن مثيلاتها، والتي تتصل بجزئية “تاثير المبدع”، يقص علينا إبراهيم نصر الله حدوتة الإنسان، التي يتوجها بصرخة “راشد” قرب نهاية القصة حين يقول”ماذا يريد الإنسان حقاً؟”. أجاد الكاتب استخدام أدواته السردية والوصفية، فخلت الرواية تقريباً من تفاصيل الوصف الخارجي للأمكنة، وملامح الشخصيات إلا فيما ندر، بل والشوارع والفضاءات، كلها تركها نصر الله لخيال القاريء، ربما لرغبته ألا تتقيد الحدوتة ولا الفكرة بخيال محدد الألوان والملامح، لأنه كما قلناـ معني بقصة الأنسان، أكثر من قصة شخص ما بعينه، أو بقصة مجتمع ما بذاته. ففي إطار موحش يغلب على فضائه الليل، وتحيط شرفات مبانيه الظلمة، وتسيطر على إبصار أبطاله ظلمة الليل، بينما الأطفال يخاطبون آلاتهم، وحواسيبهم، والكبار يغرقون في ظلام الشك في كل من حولهم، بعد انتشار ظاهرة الأشباه.. وهي نتاج علم حديث متوحش، يحول البشر إلى أشباه لبعضهم، لا يفرقهم شيء، فتجد الناس وقد خرجوا من أنقاض حرب الكلب الأولى التي قامت بسبب الاختلاف، ةورفض البشر للاختلاف فيما بينهم، يجدون أنفسهم على أعتاب حرب قد تقوم بسبب “التشابه”.. في مفارقة تراجيدية حياتية يصوغها الكاتب بتسلسل أحداث مقنع في أوجه عدم الإقناع الذي تحمله تلك الأجواء الأسطورية..
ثم نأتي لنقطة أخرى، والتي يمكننا الإشارة إليها بـ”تأثر المبدع”. في رأيي أن معظم روايات الديستوبيا الحالية كان أصحابها يبغون مناقشة قضية الإنسان، وحياته وسقوط هالة الأخلاق، وأسطورة الإنسان التقدمي المتمدين، وطغيان الوحشية والسوداوية على المستقبل، لكن تلك الروايات ارتكبت خطأ فادحاً، فشلت على أثره في بلوغ نفس الهدف الذي نجح “إبراهيم نصر الله” في بلوغه، ونحاول أن نصل فيما يلي للسبب الذي يجمعها معاً، والذي يقف وراء ذلك: الروايات التي ذكرناها تحديداً، كان كتابها الثلاثة مدفوعين بحاضر يرفضون بعض أجزائه، ولا يتقبلون بالكثير من المعطيات المجتمعية والسياسية التي يحويها، لكنهم وقعوا أسرى ذلك الواقع لدرجة أنهم أسقطوا رفضهم على أحداث رواياتهم، كما وقعوا ـ دون وعي منهم على الأغلب ـ في فخ الانحياز لمواقف بعينها، بعد أن نحتوا جزءاً من تكوينها بأزميلهم الخاص، وشكلوها بألوانهم الخيالية، وقدموها للقاريء على أنها تنتمي لمستقبل قريب، لكن بفجاجة لم تسمح للقاريء، كما هو المفترض في هذا اللون من القصص، بالانفصال عن الواقع والاستغراق في مفردات مستقبل غامض بجوه، وساحر بمعطياته، فبدت كلها تشابهات صارخة، ومد للخط على استقامته، وهو ما بدا أشبه بعملية هندسية، منه إلى عمل إبداعي حقيقي، يمس الوجدان، ولا يخاطب العقل فقط..
إذا ما نظرنا لما وراء ذلك، وحاولنا تحليل أسبابه، فربما كان المؤلفون مدفعوعين برغبة منهم في انتقاد الحاضر بأدوات من المستقبل، وربما أتى ذلك انحيازاً لمواقفهم الفكرية الشخصية، أو نأياً بأنفسهم عن صبغة رواياتهم بما ازدروه من صبغة روايات الخيال العلمي البحت، والتي لا تحمل قدراً كبيراً من الاحترام في عقلية القارئ العربي، وربما هنا.. الكاتب العربي أيضاً: فمن تطور وضع مجتمعات المرفهين الصفوة و”كومباوندات” القاهرة في يوتيوبيا، مروراً بـ إعادة انتاج صراعات السلطة واعتصامات الجماعات السياسية في الميادين والتعامل الدموي مع المعارضين في “عطارد” بشكل روائي كابوسي، انتهاء بـ مناقشة الإلحاد بشكل موسع من أستاذ علم النفس التطوري الذي يهجر القاهرة بعد أن فاض تلوثها على الحد الذي يسمح بالعيش بها، والذي يحب “حميراء الشعر” الماجنة في عالم مستقبلي تنمحي فيه برلين الألمانية من على الخريطة إثر هجوم نووي، ويصل فيه الطب لتركيب أطراف صناعية لكل شيء، تماماً مثلما كان لـ”راشد”، بطل “حرب الكلب الثانية” الذي كان يشاهد في أحد مقاطع الرواية حديثاً لأستاذ الأحياء التطوري، ويتعلق بحميراء شعر فاتنة، وسلطة تراقب الجميع وتهديدات بحرق ألمانيا، دور كبير في الرواية..
نجح “نصر الله” في تقديم وجبة دسمة خلت من الوصف وأطلقت لعقال الخيال الكابوسي لقاريء عنانه، وربما كانت التأملات والمقارنات السابقة تدفعنا لتحية قلمه الذي تجنب تلك الهفوات التي وقع فيها آخرون، سلكوا نفس الخط برواياتهم.. فبينما حملت روايته رسالة عابرة للأزمان، وغير مقيدة بالمكان، حاول كتاب أخرون الوصول لنفس ما كان يصوب إليه، لكنهم وقعوا في فخ شخصنة الزمان والمكان.. فخرجت الروايات السائرة في نفس السياق الخيالي، وبرغم النجاح الجماهيري المشهود لكل منها، كأن كل منها تكبلها كرات حديدية من الذنب، والغضب.. وكل هذا وكتابها يظنون أنهم يحسنون صنعًا!