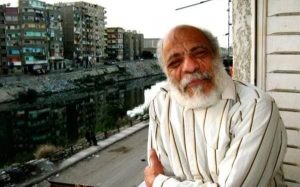ولماذا هذا التشبيه كله؟ لأن التشبيه الآخر مبتذل، أعني التشبيه الخاص بالفراشة والزهور، أو النحلة التي تنهل من رحيق كل زهرة بعضه، ولأن تشبيهي الفراشة والنحلة ينطويان على عيبين جسيمين يفتقر إليهما ياسر عبد اللطيف، فالنحلة تتنقل بين الزهور، صحيح، وتنال من كلٍّ بعض رحيقها،نعم، لكنها في النهاية تقدم منتجا واحدا، عسلا، قد يكون بنكهة زهر البرتقال مرة، أو بنكهة براعم البرسيم مرات، لكنه في النهاية عسل النحل نفسه، أما الفراشة فلا تنتج من تجوالها بين الزهور أي شيء، اللهم إلا المزيد من الزهور، فهي تساعد على الإنتاج بدلا من أن تنتج. في حين لياسر رواية وشعر وقصص، وعما قريب، كتاب مقالات.
نمط غريب في هذه الآونة ذلك الذي يمثله ياسر عبد اللطيف. نمط الكاتب الذي لا يراكم الطوبة فوق الطوبة أو الكتاب تلو الكتاب في قالب أدبي معين يألفه ويؤلف به، بقدر ما يتوسع أفقيا. تشبيه آخر من عالم العقارات والأراضي هذه المرة، ولم لا؟ ولكنه ـ أي النمط ـ ليس غريبا إلا في هذه الثقافة وفي هذه الأيام (باستثناءات قليلة منها يوسف رخا، وأنا، ومن أيضا؟). أما في الأدب العالمي فالأمثلة أكثر من أن تحصى: الروائي الشاعر كاتب المقال المخرج السينمائي الرسام، كل هذا في واحد. لبول أوستر مثلا، وهو حي يرزق، روايات، وشعر، وترجمات، ومقالات، وسيناريوهات، وأفلام أخرجها، وبرامج للإذاعة، ويعلم الله ماذا أيضا. سوزان سونتاج أيضا، ولم ترحل عنا إلا قبل سنوات قلائل، ناقدة روائية مخرجة سينما ومسرح وناشطة سياسية. ولكن الأهم من النماذج العالمية أن لدينا نحن في الثقافة العربية إرثا من هذا الكاتب متعدد المواهب. ألا يذكركم بشيء مثلا صلاح جاهين؟ أليس مثالا ناصعا على فنان تفيض طاقته على حدود نوع كتابي معين؟ ألم يكتب الأغنية والقصيدة والأوبريت، ويرسم، ويمثل، ويلحن؟ ألا تعرفون يوسف إدريس إلا بقصصه؟ وماذا عن مسرحياته ومقالاته وروايته ونوفيلاته؟ طه حسين؟ أهو طه حسين الشعر الجاهلي فقط؟ أما من مؤرخ فيه؟ وروائي؟ وناقد؟ وتوفيق الحكيم؟ ألا تقول “يوميات نائب في الأرياف” شيئا غير الذي تقوله المسرحيات الكثيرة؟ وما الذي يقوله مثلا “حمار الحكيم”؟ وماذا عن لويس عوض؟ صحيح أنني لن أتكلم عنه شاعرا فقد كان ـ في رأيي ـ شاعرا لا يطاق. ولكن العنقاء؟ أليس رواية كبرى من رواياتنا؟ ثم لماذا لم يعد أحد يكتب سيرته الذاتية فيمنحنا مثل ما تمنحنا أوراق العمر؟ ولماذا لم يعد أحد يرى في حوادث حياته ما يمكن أنينتج كتابا أعتبره أساسيا مثل “مذكرات طالب بعثة”؟ وهذه الكتب جميعا كانت بجوار ـ وليست على هامش ـ كونه في الأساس ناقدا ومترجما ومؤرخا ومفكرا. ولا أريد أن أستشهد بأنيس منصور؟ فالشائع أن الإشارة إليه تنال من كل اسم آخر في هذه المقالة. لكنه يبقى مترجما جيدا، وقاصا ومسرحيا لا بأس به، وكاتب مقال من طراز رفيع وكاتبا آسرا في أدب الرحلات، ولولا باعهالطويل في كتب الخرافات والماورائيات والمواقف السياسية التي تخالف المواقف السياسية المعتمدة في صفوف الأدباء لكان له شأن آخر بيننا. ولكن ما الذي يجعلني أشير إلىأنيس منصور وهناك يحيى حقي؟
***
في تسعينيات القرن الماضي، راج مصطلح استحدثه الروائي “إدوار الخراط”، أو استعمله لا أدري، هو مصطلح الكتابة العابرة للنوع، وقيل “الكتابة عبر النوعية”وهو ـعلى ركاكته ـ عنوان الكتاب الذي ألّفه الخراط في المصطلح وأدبه.
يقول الخراط في حوار منشور في العدد الرابع والأربعين من مجلة نزوى إن المبدع قد يقحم “إحدى [كذا] منجزات أو تقنيات فن ما أو نوع أدبي ما بجانب الأنواع الأخرى بحيث ينشأ نوع من التجاور فقط أو النتوء أو النشاز” فلا تكون هنا الكتابة عبر النوعية قد تحققت، ولكن قد يحدث “تمثل واستيعاب [لـ]هذه المنجزات المختلفة من الأنواع الأخرى ومن الفنون الأخرى تمثلا واستيعابا تامين ثم صهرها وإدراجها في هذه الكتابة بحيث يتكون منها شيء لا أدري هل أسميه نوعا جديدا؟” ويمضي فيقول إنه إذا غلبت السردية بعد هذا على الكتابة فهي تنتمي إلى القص، وإذا غلبت عليها الإيقاعية فهي شعر، وإذا غلبت المشهدية فهي سينما. “ولكن قد يحدث، وهذا أمر نادر جدا وصعب جدا، أن تتوازن هذه المقومات وتتكافأ، بين الايقاع والسرد والحوار… الخ. كلها أو بعضها.. عندئذ، في هذا النوع النادر من التكافؤ أو التوازن تصبح الكتابة “عبر نوعية” بالمعنى الدقيق للكلمة“.
***
لا أميل إلى الزج بأدب ياسر عبد اللطيف في ركام الأدب العابر بين الأنواع، وذلك لفارق جوهري بين أدبه وأدبهم: هو أنني لم أحب أكثر أدبهم وأحببت أدبه.
كان الأدب العابر للنوع في الأغلبية الكاسحة من نماذجه يميل إلى توشية الكتابة القصصية والسردية عامةً بنفحات من الشعرية أرى الآن أنها لم تكن تضيف إلى تلك الكتابات إلا الترهل، والتهويم، ولم تكن تزيدها وزنا بل ثقلا، إذ تحيلها إلى كيان كتابي عجيب يوقف القارئ مثلا من الرواية وقفته من القصيدة، فإذا هو مكرَه على القراءة السلحفائية، لتدبر الإعجاز في المجاز، وتذوق القيم الصوتية ـ أو الإصاتية بلغة الخراط، والنفاذ إلى أغوار الاستعارات والخيالات والرموز، وهذا نهج في القراءة قد يكون ممتعا في قراءة القصيدةأو حتى لازما في بعض الأحيان، لكنه لا يكون إنسانيا أصلا في قراءة رواية لها أن تمتد على مدار مئات الصفحات.
غير أنها وصفة وراجت في زمان قد يكون غير بعيد عنا، لكنه يبدو الآن نائيا، مثلما تبدو الوصفة نفسها بائدة.
ياسر عبد اللطيف لا يفعل هذا، لا يقترض للرواية أو القصة من جماليات الشعر مثلا، وهو شاعر، بل يمزج بين القص والمقال. فثمة إذن عبور بين نوعين، ولكنه ليس العبور السهل، فالانتقال هنا ليس من فن ذي جماليات مستقرة إلى آخر غني بالجماليات، بل هو عبور من الفن إلى جنس طالما قيل في حقه إنه يتنافر مع الفن، فطالما اعتبرت “المقالية” عيبا في القصة أو الرواية ـ ولو على المستوى المحلي البائس. (أما في العالم، فيكاد كونديرا مثلا ألا يوعز إيثاره الرواية الأوربية على الأمريكية إلا إلى سبب واحد هو ترحابها بالتفلسف والتأمل والمقالية).
ليس العبور الذي يقوم به عبد اللطيف في كتابته هو العبور الانتهازي بحماقة، فالمقال ليس أول مغارة ينبغي أن يبحث عنها الراغب في السطو على جواهر الجماليات، فليس فيه مشهدية السينما، أو غنائية القصيدة، أو إيقاع الموسيقى، ولكن فيه ما ينبغي أن يثير لعابا معينا فيمن يملك القدرة على إفراز هذا اللعاب: فيه الأفكار، فيه فسحة التأمل، وفيه أيضا أداة للتخفف من السنتمنتالية التي قد تلوث كاتب القصة مثلما قد تلوث الشاعر، لكن كاتب المقال يبقى الأقل احتمالا للتلوث بها.
وأحسب أنه لولا قيم المقال لتحولت “قانون الوراثة” ـ وهي باكورة سرديات عبد اللطيف ـ إلى بكائية، لكن التأمل ودرجة من التوثيق والتأريخ كبحا ما كان يمكن أن يثيره موضوع الرواية من نزوع إلى النوستالجيا والنواح. والمقال يحقق للكاتب انفصالا عن الموضوع قد يستعصي على كثيرين من الكتاب، لا سيما حينما ينهلون في كتبهم من حياتهم الخاصة، أو حياة من يكونون قريبين منهم.
***
دأب “ياسر عبد اللطيف” على كتابة مساهمة أسبوعية لملحق شرفات الثقافي الذي يصدر مع جريدة عمان، وكنت الوسيط بينه وبينه الملحق، أتلقى هذه الكتابات وأحولها إلى الزملاء، ولم يحدث مرة أن مررتها دون قراءة، ولم يحدث مرة أن صدر العدد دون أن تعاودني الرغبة إلى معاودة قراءتها، ولما تحولت المساهمة الأسبوعية تلك إلى كتاب، أرسله لي ياسر ضمن برنامج الكتاب المصريين المغتربين لتبادل الكتب إلكترونيا، وهو برنامج، لو تعلمون، ضرورة.
لا أعرف هل سيكون هذا الكتاب الوشيك لا يزال وشيكا أم سيكون قد صدر عند نشر هذه السطور. عنوان الكتاب على أية حالة هو “في الإقامة والترحال”، وبه يستكمل عبد اللطيف تقليدا كتابيا مصريا أحياه قبل سنوات قليلة الراحل ابراهيم أصلان في بعض كتبه الأخيرة، وكان لدينا من قبل في هذه السكة كتب لعشرات الكتاب أبرزهم بالنسبة لي يحيى حقي، ولويس عوض، وكثيرون غيرهم.
لا أقصد كتب السيرة الذاتية بالضبط، لكنني أقصد ما يعرف بـ المقال الشخصي. وأنا ـ بصفة شخصية ـ تسهل عليّ التفرقة بين المقال الشخصي وبين المقال السيري. ففي الأخير ثمة قصة تروى، وفي الأول ثمة فكرة تبتغى، لكنها على عكس أفكار المقالات لا تطرح بغرض إثباتها، فليس في الأمر حجج، ولكنها تجربة تصفى إلى جوهرهاأوتقلب على أوجهها، ثم توضع بين يدي القارئ في تواضع.
في المقال الشخصي، حسب ما أسميه، أو حسب ما يسمى، لن تجد الكاتب الحكيم بل الكاتب السائل، ولعل السائل لا سواه هو الحكيم. في المقال الشخصي، لن تجد الكاتب المتباهي بمعارفه، بل الكاتب المستمسك في معارفه، لا ليقينه بهابل لأنها ما لديه. ثمة في المقال الشخصي لون من التواضع يذكرك بأن من وراء السطور التي تطالعها إنسانا مثلك لا كاتبا يمتاز عنك بثقافة وقلم وحق في أن يحيل ما يعبر في ذهنه إلى سلعة بل إلى ثقافة. تقرأ المقال الشخصي فتجد من ينبهك إلىأن حياتك ببساطة ثرية، صالحة كما هي لأن تكون مصدرا للمعرفة.
في الكتاب، أي “في الإقامة والترحال”، وعلى سبيل الاختيار العشوائي، مقالة عنوانها “فيتامين د”،يستهلها الكاتب بمعلومة استقاها من لقاء مباشر مع طبيبه، وهي أن المهاجرين من البلاد الحارة إلى كندا غالبا ما يعانون من نقص فيتامين د لافتقادهم الشمس. تصحبه هذه المعلومة، أو هي تؤرقه، ولكنه لا يكشف لنا عن هذا، سيتضح في نهاية المقال أنها بقيت كامنة في رأسه طول الوقت. ينتقل من حيث يقيم إلى حيث يقصف، في برد كندا، وفي البار يتعرف بفاطمة المنتمية إلى الجيل الثاني من مهاجرين أفارقة هنود، فاطمة التي فقدت لكنة المهاجرين الأوائل، والتي لعلها أيضا استعادت النسبة الطبيعية لفيتامين د في جسمها.
بين قوسي الفيتامين هذين، ثمة حانة، وحوار مع نادل أبيض، ومع نادلة سمراء، وإشارة إلى طقس قديم منسي منذ سنوات هو “تدوين هذا الكلام بالقلم في دفتر”.
“هذا الكلام“. التسويد والإمالة من عندي. لا ادعاء هنا. بل أقل وصف ممكن من الكاتب لكتابته. الكلام. لا الخواطر، ولا المشاهدات، ولا التأملات، ولا الأفكار بطبيعة الحال. إن هو إلا كلام، وإن هو إلا تدوين. ولكن هذا التواضع خادع أيضا. لأن ثمة وصفة، أو بالأحرى معادلة يعرفها ياسر عبد اللطيف فيحيل بها ما يمر في ذهنه إلى ما يجب أن يبقى في أذهاننا.
هو مكوِّن كالذي عرفه يحيى حقي من قبل فجعل قراءة مقدمته لرباعيات صلاح جاهين ممتعة مشبعة مدهشة بقدر ما في قراءة “دماء وطين” أو “خليها على الله” من إمتاع وإشباع وإدهاش. مكوِّن لعله يسمى الأسلوب، ويا لها من كلمة غامضة لا أعرف لها أولا من آخر.
إنما أعرف، أن ياسر عبد اللطيف في كتبه الأخيرة، القليلة ولكن إلى حين (وهذه نبوءتي)، يمتلك هذا المكوّن الذي يجعل به ما يكتبه، مهما اختلفت أنواعه وقوالبه، أدبا. لعل هذا المكوّن ـ الذي يختلف بالطبع من كاتب لآخر ـ يتعلق بلغة الكتابة نفسها، بروح في الكتابة قد تكون خفة الدم الآسرة عند يحيى حقي، أو القدرة الملفتة على الملاحظة عند ياسر عبد اللطيف، وعلى صياغة الخاطرة الغائمة في فكرة بل وفي حكمة في بعض الأحيان. ولكنني أحسب أن ثمة ملمحا مشتركا ـ أو يجدر به أن يكون مشتركا بين كل الكتاب إن هم شاءوا أن يكونوا هذا النوع من الكتاب: أن لا يكون للمقال عند أحدهم قلم غير الذي للرواية أو للقصة أو للقصيدة، أن لا تكون للمقال غاية أدنى من غاية المسرحية أو الأغنية، أن يؤمنوا بأن الاسم الذي ينسب إليه المقال هو نفسه الاسم الذي تنسب إليه الرواية. هذا أمر يراعيه ياسر عبد اللطيف، وتغفل عنه الأغلبية الكاسحة من كتّاب ما يسمونه المقال والمقال منهم بريء.
***
لا أعرف من أي مصدر بالضبط بلغني أنه كان يقال ليوسف إدريس إن كثيرا من مقالاته الأسبوعية في الأهرام “قصص مجهضَة”. لا أذكر أين قرأت هذا أو سمعته. أما ما أذكر أني سمعته من وحيد حامد في لقاء تليفزيوني معه فهو أنه نشر مقالا في “روزااليوسف” وقرأه “شريف عرفة” فاتصل به يعنِّفه على أفكاره التي يهدرها في المقالات، قال له “هذا فيلم يا وحيد”، فلما أعاد حامد قراءة مقاله، شرع فيما أصبح لاحقا “الإرهاب والكباب”.
كثير من “مقالات” ياسر في كتابه الوشيك هذا فيها بذور قصص قصيرة، أو هي قصص قصيرة لا ينقصها لكي تقرأ قراءة القصص أو تعامل معاملتها إلا أن توضع تحت هذه اللافتة. ربما لهذا السبب انسقت وراء فكرة الكتابة العابرة للنوعية، ربما لأن ما يكتبه ياسر عبد اللطيف في الإقامة والترحال كان يصلح فعلا أن يكون نواة سيرة ذاتية أو مجموعة قصصية أو رواية، ولعل من أصحاب ياسر من سيقرأ هذا الكتاب فيقول له “خسارة يا بِلْد، كانت مشاريع قصص ممتازة”.
لكن مثل ذلك يقوله الراغبون في عمارة يتكرر فيها الطابق فوق الطابق فوق الطابق، في بلادة وسقم. دعوا هذا للمساكن الشعبية وبُناتها، ودعوا ياسرا ينثر بيوته، لكل بيت روحه وشخصيته ومكانه، فهذا بيت صغير في المعادي، وذاك بيت صغير في كندا.