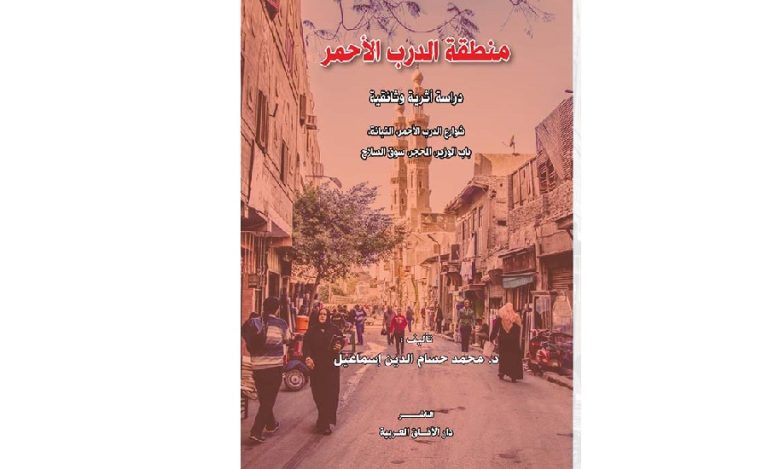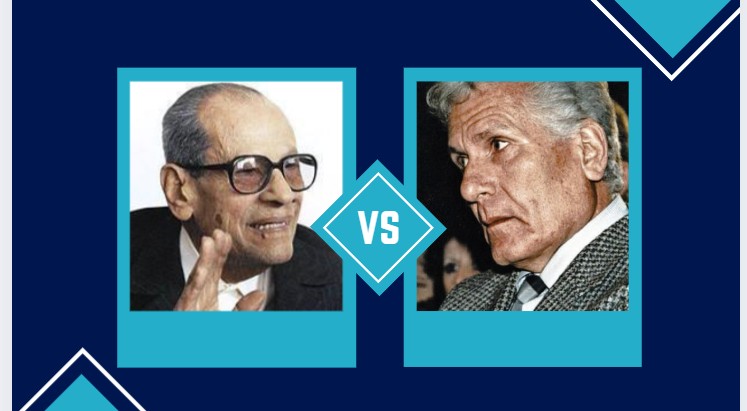د. إبراهيم عرفات*
كانت حالة بائسة. لكنها انتهت عندما ظهرت الدولة. مرحلة من التاريخ الإنساني أسماها الفلاسفة بحالة الطبيعة الأولى. كانت تعيسة ومليئة بالشرور. خاف فيها كل الناس من كل الناس. شهدت عنفاً يومياً واعتداءات متكررة وسرقات لا تتوقف ومخاوف لا تنتهي. سادها التوحش وكان الإنسان فيها ذئبا لأخيه الإنسان. قاتلُ بلا قيود ولصُ بلا رادع وطاغيةُ بلا مشاعر. ولما تساءل الناس عن مخرج منها تفتق ذهنهم عن فكرة الدولة. أسسوها لكي يخرجوا من حالة الطبيعة الأولى. أسسوها لكي تسعدهم. لكي تؤمنهم وتحنو عليهم. لتوقف الفوضى وتوفر الأمان. لتحقق العدل وتنصف المظلوم. لتمنع القوي من البطش بالضعيف وتقضي على الشر وتدفع العدوان.
هذا بعض ما يقال لطلاب العلوم السياسية عن نشأة الدولة. ومع أنها افتراضات أسماها الفلاسفة “بنظريات العقد الاجتماعي”، إلا أنها ليست خيالات محضة. فالناس وُجِدوا قبل السلطة وقبل الدولة. هم الذين أسسوها. ولا يفرق إن كانوا أسسوها في جلسة تعاقدية أم بعد معركة حربية. المهم أنهم من أسسها. وقد أسسوها لمصلحة. أسسوها كما يؤسسون بيوتهم ويعمرون شوارعهم ويطورون مخترعاتهم. أرادوا أن يكونوا أسعد. أرادوها أن تخرجهم من حالة الطبيعة الأولى. تعاقدوا فيما بينهم ليقيموا سلطة تعهدوا لها بالطاعة والالتزام وتعهدت لهم في المقابل بالسعادة والنظام.
وقد قطعت الدولة– لكن ليس في كل الأرض– شوطاً كبيراً في الخروج من حالة الطبيعة الأولى. وتلك حقيقة واضحة في قارة مثل أوروبا وفي كل الحالات الناجزة في نصف الكرة الغربي وشرقي آسيا. أما في الحالات العاجزة فما ظهرت الدولة لتقضي على حالة الطبيعة الأولى إلا ووجد المجتمع نفسه يعود إليها من جديد. صحيح أن الدولة تأسست بكامل أجهزتها في بلدان الجنوب وحملها الناس بأحلام عريضة بعد الاستقلال، إلا أن التوقعات الحالمة فيها كانت في غير محلها. فقد استيقظ الناس في كثير من أرجاء الجنوب على كابوس. فالدولة التي أملوا أن تخرجهم من حالة الطبيعة الأولى أعادتهم بدهشة إليها. عادت الفوضى لتضرب ربوعهم بقوة برغم وجود السلطة. وعاد القتل والنهب والاعتداء برغم وجود أجهزة الضبط والسيطرة. عاد الإنسان للاعتماد كثيراً على نفسه بعد أن عجزت الدولة التي ائتمنها عن إشباع حقوقه واحتياجاته الأساسية. عاد للتنمر وخرق كل القوانين الطبيعية والوضعية. عاد ليكون ذئباً لأخيه الإنسان. غاب الأمن. نقصت الحماية. زاد الاعتداء على الممتلكات. كثرت سرقة الأصول وقنص الأرواح. قلت الحصانة وانتهكت الحدود وزادت التدخلات الأجنبية. وكان أن أعادت هذه المخاوف الإنسان إلى المربع الأول. إلى حالة الطبيعة. لكن هذه المرة ليس في غياب الدولة وإنما في حضورها. باتت الدولة نفسها مصدراً للقلق. لا تقاومه أو تمنعه كما كان منتظراً منها بل باتت ترعاه وتضخمه وتغذيه. باتت لها مصالح مستقلة تختلف عن مصالح المجتمع الذي أنشأها. صُدم الناس حول العالم. فبدلاً من الفوضى التي كانوا يعيشون فيها بسبب عدم وجود الدولة، باتوا يعيشون فيها من جديد لكن في ظل وجودها. كانت الفوضى في حالة الطبيعة الأولى ناتجة عن غياب الدولة فصارت في حالة الطبيعة الثانية بسببها.
لقد بنى الإنسان الدولة ليتخلص من هواجسه. ليجعل القانون مجرداً لا يعرف المحاباة والعدالة عمياء لا تعرف المجاملة. بنى الدولة ليتخلص من الشر. بناها لكي تحمي المجال العام وتعلم الناس الذوق والالتزام بالقانون والنظام. بنى الدولة لتضع سياسات عادلة وقواعد عامة مجردة. وقد نجح في ذلك في أماكن دون أخرى. خرج من حالة الطبيعة الأولى في ألمانيا مثلاً بوضوح أكبر بكثير عن تشاد، وفي الدنمارك مقارنةً بالنيجر، وفي اليابان بالقياس إلى اليمن. خرج من حالة الطبيعة الأولى في الدول الناجزة. أما في الدول العاجزة، وما أكثرها، فقد عاد المجتمع من بعد نشأة الدولة إلى حالة الطبيعة من جديد. وللدقة دخل في حالة الطبيعة الثانية. لم يجد مساءلة صارمة من السلطة التي أنشأها، فأوغل من جديد في الفساد والتوحش وانتهاك حقوق الآخرين. عاد كل ما كان يجري في حالة الطبيعة الأولى ليتكرر في حالة الطبيعة الثانية، مع بعض الفروق.
فحالة الطبيعة الأولى كانت افتراضية رأى فلاسفة مثل هوبز ولوك وروسو أنها الحالة التي سبقت ميلاد الدولة. أما حالة الطبيعة الثانية فواقعية يعيشها الناس في كنف الدولة. في حالة الطبيعة الأولى لم تكن الدولة موجودة أصلاً. أما في الثانية فالدولة حاضرة. كانت الدولة في الحالة الأولى مجهولة أما في الثانية فأصبحت كسولة. تتراخى مع كل ما يطلبه منها المجتمع وتتشدد فيما تتوقعه هي منه. كان العنف يحدث في حالة الطبيعة الأولى بسبب غياب الدولة. أما في حالة الطبيعة الثانية فبسببها. لم تكن هناك سلطة في حالة الطبيعة الأولى تمنع الناس من بعضهم فتسابقوا بغريزية إلى تبادل التدمير. أما في حالة الطبيعة الثانية فالسلطة موجودة، وبرغم ذلك عاد الناس بسبب قصورها إلى نفس الغريزية والتوحش. في حالة الطبيعة الأولى لم يكن ثمة عائق يمنع الناس من تأسيس الدولة كمخرج من حالتهم التعيسة. أما في حالة الطبيعة الثانية فباتت الدولة تمنع الناس من أن يتحدوها أو يغيروها أو يتعاقدوا فيما بينهم من جديد من وراء ظهرها. فهي تراقبهم وتسترق السمع وتعاقب من يخالفها مع أنها ربما كانت أول من خالف نصوص العقد الاجتماعي الذي صاغوه معاً ليقيموها. في حالة الطبيعة الأولى كانت الدولة ثمرة التعاقد بين الناس. أما في حالة الطبيعة الثانية فباتت تقمع أي دعوة لتعاقد جديد يجري بين الناس. لم تعد تترك أحداً في حاله. تفشل ولا تريد أحداً أن يحاسبها. تخل بتعهداتها أمام الشعب لكنها تحاكمه بدلاً من أن يحاكمها. تقصر وتعلن أنها أنجزت وتستبد وتدعي أنها قلعة الحرية وصمام الأمان.
والناس لا تنسى. فعندما تعاقدوا لينشئوا الدولة تعاقدوا بشروطهم وليس بشروطها لأنها ببساطة لم تكن موجودة. ولما اقاموها استطاعت أن تنهض بأعبائها في بعض المناطق لكنها إما فشلت أو عجزت أو استبدت أو أخلت في مناطق أخرى. فكان أن ساءت أحوال الناس واضطروا إلى العودة إلى الفوضى القديمة. إلى حالة طبيعة جديدة برغم وجود الدولة. وأغرب ما في الأمر أن الدولة كانت تشجع الناس على العودة إلى حالة الطبيعة من جديد. ترى السرقة فلا توقفها. والقهر فلا تتصدى له. والظلم فلا تمنعه. انتهكت الدولة القواعد التي تأسست عليها وصارت هي نفسها ذئب يتربص بالناس. انتهكت قواعد العقد الاجتماعي الأول فبدأ الناس يتهامسون عن الحاجة إلى كتابة عقد اجتماعي جديد يخرجهم من حالة الطبيعة الثانية التي رمت الدولة بهم فيها. لكن الدولة حرمتهم ومنعتهم. قالت إني حاضرة ولست غائبة. قوية ولست ضعيفة. أنا أمنعكم. قالوا لها نحن من أنشأك. فقالت ولو. قالوا لها تذكري أنك قد تعهدتِ بخدمتنا. فردت لا أهتم فأنا الآمرة. منعتهم من التعاقد مجدداً ووضعت نفسها وصيةً على إرادتهم. خلعت على نفسها قداسة متجاهلة دناسة حالة الطبيعة الثانية التي صاروا فيها.
وإذا كانت حالة الطبيعة الثانية تتشابه مع كثير من ملامح حالة الطبيعة الأولى إلا أنها تختلف عنها من حيث وجود جهاز للدولة وجبروت للدولة وتكنولوجيا قمع ورقابة هائلة في يد الدولة. وأصعب ما في الموضوع أن الخروج من حالة الطبيعة الثانية لم يعد ممكناً ما لم تكن الدولة نفسها طرفاً في العقد الجديد، هذا إذا وافقت أصلاً على تحرير عقد جديد بينها وبين الناس. والدليل الأبرز على ذلك أن الناس قد ثاروا ليحرروا عقداً اجتماعياً جديداً فيما بينهم لكنهم فشلوا. لم يعد الأمر سهلاً. كانوا من قبل يستطيعون كتابة عقداً فيما بينهم ليتخلصوا من حالة الطبيعة الأولى. أما بعد أن أسسوا الدولة فلم يعد أمر العقد الجديد بيدهم وحدهم. فهم في كفة والدولة في كفة. والكفتان غير متكافئين. المجتمع منقسم وضعيف يقف في وجه دولة، أو للدقة سلطة، أخذت كل ما عهد لها به المجتمع من مصادر قوة وراحت تتصرف فيها كما يحلو لها. ونتيجة حالة اللا تكافؤ فإن الخروج من حالة الطبيعة الثانية يبدو أقرب إلى المستحيل وتبدو كتابة عقد اجتماعي جديد أقرب إلى الخيال. ولو خيرت الدولة، بالتحديد في العالم الثالث، بين كتابة عقد اجتماعي جديد وبين ترك الناس يعيشون في حالة الطبيعة الثانية لاختارت البديل الأخير. فانشغالهم ببعضهم يشغلهم عنها، وعذاباتهم اليومية تلهيهم بعيداً عنه.
………….
*كاتب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة