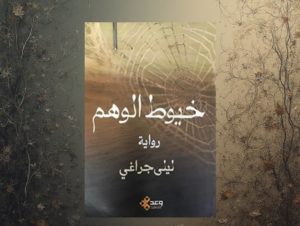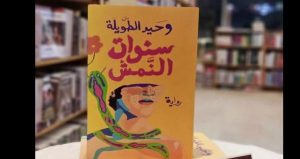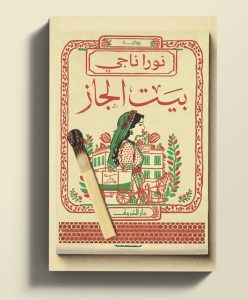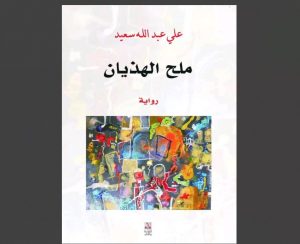د. رضا عطية
في عرض ميلودرامي محكم البناء إلى حد كبير قدَّم- مؤخرًا- فريق كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالاشتراك مع فريق Better Show على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون ضمن مهرجان “إيزيس” لمسرح المرأة- العرض المسرحي المتميز، ثلاثة مقاعد في القطار الأخير، من تأليف وإخراج مايكل مجدي. هذا العرض سبق وأن حصد خمس جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها كُلٌ من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، أما جائزة أفضل مؤلف صاعد ففاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.
يبدو تميُّز هذا العرض في اجتماع عناصر عديدة لتكفل له أهمية خاصة، من حيث موضوعه الرئيسي والقضايا التي يتصدى لها؛ إذ تنبني قصة الحكاية المسرحية على استلهام ثلاث حوادث لانتحار فتيات، فيتأسس البناء الدرامي على قضايا حرجة تمس المرأة أو بالأحرى، الفتيات في عمر المراهقة والحداثة العمرية، فيما يفرضه النسق الاجتماعي من قيود عليها وما يثقل به كاهلها من أعباء وما يخنقها من ضغوطات تدفعها إلى الانفجار وترمي بها إلى الهاوية. غير أنَّ مرجع تميز هذا العرض ليس في أهمية موضوع حكايته وخطورته وحسب، لكن يتجلى أيضًا في تنوع الأسايب المسرحية التي استخدمها تشكيلاً للعرض المسرحي وتجسيدًا لمقاصده الدلالية في سبيكة فنية متجانسة العناصر ومتآلفة الأجزاء.

مأساة الفتاة بين غياب الأب والحبيب والقهر المجتمعي
يتبدى جوهر المأساة التي تعيشها الثلاث فتيات، بطلات الحكاية للعرض المسرحي، ثلاثة مقاعد في القطار الأخير، في فقدان الأب بأشكال مختلفة، فـ”بسنت” رحل والدها عن الحياة وتركها يتيمة الأب في سن صغيرة، أما “ياسمين” فقد هجر أبوها أمها وانفصل عنها بالطلاق وقطع أية علاقة بأسرته بعد تطليقه أمها. وعلى الرغم من وجود والد “مريم” على قيد الحياة وعدم انفصاله عن أمها مثلما فعل والد “بسنت” إلا أنَّ وجوده أقرب إلى العدم، فهو مغيب عن التأثير الإيجابي في حياة الأسرة وخصوصًا ابنته، الأمر الذي يلجئ الفتيات الثلاثة إلى الارتكان على الحبيب، بوصفه طوقًا للنجاة وأملاً في مداواة جراح التفسُّخ الأسري وسندًا في مواجهة قهر المجتمع ومكافحة رجعيته، غير أنَّ هؤلاء الثلاث فتيات يتلقين أعنف الصدامات بتهاوي جدار الحب والأمان الذي كانوا يعتبرنه جدارهن الأخير للاستناد عليه والاحتماء به، فمريم تفقد حبيبها “يوسف”، زميلها في دروس الثانوية العامة، إذ يموت بالسرطان وتصاب باكتئاب بالغ لفقده، ولا تجد من أسرتها مَنْ يشعر بها في أزمتها أو يلاحظ الآثار التي أحدثها الاكتئاب على جسدها كتساقط شعرها. أما مريم فتتوسم في “أيمن” حبيبًا يعوضها فقدانها أباها وقسوة أخيها “عُمر” لكنه يغرر بها بعد أن امتلك ثقتها فيه ليبتزها بتركيب وجهها على صورة عارية، ما أفضى إلى تنكيل أسرتها بها. وعلى الرغم من الحب البالغ الذي عاشته ياسمين التي ارتبطت عاطفيًّا بـ”أكرم” وعدته حبيبًا وسندًا يخفف عنها وطأة غياب الأب وأعباء وضغوط الدراسة في كلية الهندسة فإنَّ أكرم ما يلبث أن يتخلى عنها ويتركها بأنانية قاسية مفضلاً السفر إلى الخارج لتلقيه منحة دراسية في الخارج.
تضافر الآليات المسرحية
تتضافر عدة وسائل وتتعاضد آليات تعبيرية مختلفة تشكيلاً لبنية مسرحية متعددة المكونات؛ حيث يتخلل التمثيل الدرامي أغان ورقصات تعبير حركي كحلقات وصل بين المواقف الدرامية، وفي بعض المواضع يكون هناك توظيف للكورس، ما أتاح لعرض ثلاث مقاعد في القطار الأخير تنويعًا في طرق البث الفني وتعددًا في أدوات التوصيل الدرامي، وفي كثير من المواقف الدرامية يكون هناك أكثر من دائرة للحدث الدرامي المحكي.
تبدأ المسرحية باستعراض راقص على أغنية “كنت بخاف” للمطربة دينا الوديدي، ويكون الاستعراض بتقنية خيال الظل مع راقصة حقيقية تتفاعل مع خيال الظل على الخلفية، ويعكس الاستعراض تناقضًا إذ تبدو الراقصة مبتهجة وسعيدة بينما خيال الظل تبدو على العكس وبعد انتهاء الاستعراض تظهر ثلاث فتيات يرتدين فساتين بألوان مبهجة أحمر وأصفر وأرزق، ومن البداية بالتأمل في كلمات الأغنية من تأليف ندى الشبراوي تتكشف بعض قضايا الحكاية المسرحية، فتقول:
أنا كنت بخاف م الضلمة/ وبعوِّد خوفي يقل
دلوقتي بخاف م الضلمة/ وبخاف م النور والضل
وبخاف من وحدة تموت/ وبخاف من حب يذل
وبخاف من حد اتعود/ واتعلق بيه ويمل
وبخاف من حضنه احتاج له/ لحظة ما يكون هيزول
لتعكس هذه الكلمات صراعًا نفسيًّا تعيشه الذات الأنثوية بين الشعور بالخوف ومحاولة الذات مجابهة هذا الإحساس بالخوف وترشيده لكنها ما تلبث أن يتطور شعورها بالخوف ليشمل الخوف من النور وليس فقط الظلام، ما يعني أنَّ الخوف صار ملازمًا للذات، وهو ما توضحه الأسطر التالية من كلمات الأغنية التي تكشف عن خوف الذات من الحب الذي قد يجلب لها إذلالاً أو تجد منه هجرانًا بعد تعلق واعتياد على حبيب قد تفقد حضنه وقت الاحتياج له.
وتكون العناصر الثلاثة المتداخلة: الأغنية والراقصة الظاهرة في صدارة الركح المسرحي التي تبدو مبتهجة وسعيدة والراقصة التي في الظل على النقيض منها- بمثابة ما يمكن ان نسميه “استعارة برولوجية” تمثِّل لحالة اضطراب نفسي وشعور انفصامي تعيشه الذوات أو حتى انقلابية أحوالهن من حال إلى نقيضه، وهو ما تبدى بالفعل في فقدان بطلات الحكاية المسرحية الثلاث من أحببن لأسباب مختلفة.
وبعد الانتهاء من “الضلمة” (العتمة) تبدي كل شخصية من الثلاث شخصيات، بطلات الحكاية، (ياسمين- مريم- بسنت) عدم تخوُّفها من الظلام لائتناسها بمن يدعمها أو من تدعي أنه يدعمها ويكون سندًا لها، كالأب والأم في حالة ياسمين والأخ في حالة بسنت والكلب “زيكو” في حالة مريم التي تقول إن أباها أحضره لها، ثم تسفر أحداث الحكاية المسرحية عن أن الواقع هو عكس ذلك، وهو يكشف عن حالة انفصام نفسي تعيشه هذه الشخصيات، بممارستها أحيانًا حيل دفاعية بالانسحاب من واقعها المرير وادعاء عكسه ونقيضه، وهو ما يكشف عن تواز لمساري بنية الحكاية المسرحية بين الواقع وأحداثه من ناحية، واللاوعي وتمثلاته من ناحية أخرى.

استثمار الفضاء المسرحي وتعدد البؤر
يتبدى في عرض ثلاثة مقاعد في القطار الأخير تناغم التوظيف الإخراجي لوضعية الممثلين/ الشخصيات على خشبة المسرح والتشكيل السينوغرافي للديكور والإضاءة في تقسيم الفضاء المسرحي لعدد من البؤر المنفصلة المتصلة، فاستخدام الستارة الشفافة في الاستعراض المصاحب للأغنية في مفتتح المسرحية، إشارة لانفصامية وتناقضية بين حال الفتاة التي ترقص بابتهاج وحركة سريعة للجسد وفتاة أخرى ترقص بإيقاع متباطئ بحضور ظلي خلف الستارة، بما يوازي حالة اضطراب هؤلاء الفتيات بطلات الحكاية المسرحية.
وفي مشهد ينقسم فيه الفضاء المكاني للمسرح إلى بؤرتين، تقف “مريم” ممسكة بعروستين في بؤرة يسار خشبة المسرح، بينما يظهر أبوها وأمها في حالة تشاجر في بؤرة يمين خشبة المسرح، فتجري مراوحة حوارية بين الأب والأم في بؤرة ومريم مخاطبة عرائسها في البؤرة المقابلة:
الأب: هو أنتِ ماتعرفيش تعدى يوم من غير نكد؟.. كرهتيني في عيشتي
مريم:) ممسكة بعروسة الأب وتقلد صوته) هو أنتِ ماتعرفيش تعدي يوم من غير ما تحلوي .. أنا بحب عيشتي معاكي.
الأم: دي عيشة سودة .. أنت لسانك ده إيه؟ بينقط سم
مريم: (ممسكة بعروسة الأم وتقلد صوتها) لسانك على طول بينقط عسل يا أبو مريم.. مابشبعش من كلامك الحلو.
مريم: (ممسكة بعروسة الأب وتقلد صوته) أنتِ مايخلصش فيكي الكلام الحلو.. ده أنا أكتر واحد محظوظ في الدنيا
الأب: أكتر واحد محظوظ في الدنيا هو ابن عمك اللي أنتِ رفضتِ تتجوزيه… أنا عملت إيه في دنيتي يا ربي علشان يبتليني بيكي.
الأم: لا عملت يا خويا كت ي .. ولسه بتعمل.. عمايلك كلها سودا
مريم: (ممسكة بعروسة الأب وتقلد صوته) دي أيامي اللي قبل ما أعرفك هي اللي كانت سودا.. ربنا يباركلي في عمرك…
الأب: وياخدك علشان أرتاح منك
تكشف هذه الموازاة الحوارية التي تصنعها الصياغة المسرحية بتتابع بين مبادلة حوارية في بؤرة من المسرح تمثَّل الواقع الذي يحتدم فيه الصدام والتشاجر بين الأب والأم من ناحية، ومحاولة تحايل الابنة، “مريم”، على هذا الواقع المرير بحوار تجريه مع عروستين إحداها تمثِّل الأب والأخرى تمثِّل الأم، في بؤرة أخرى مقابلة- عن توظيف الصياغة المسرحية لكلتا البؤرتين تمثيلاً لتأرجح الشخصية الدرامية/ الابنة مريم بين الواقع بقسوته، والوهم الذي تقيمه في خيالاتها، تجاوزًا لهذا الواقع الأليم وفرارًا من جحيمه المأساوي، وكأن هاتين البؤرتين تمثلان لتوترات الذات/ الابنة مريم وتمزُّقاتها بين مستوى الشعور واللاشعور، بما تمارسه من حيل دفاعية، تخلصًا مما يكابده وعيها بمعاينة واقعها المفجع بالانسحاب منه إلى تمثُّلات اللاوعي وتوهُّماته.

توزيع وتظليل الشخصية الواحدة
من الأساليب الفنية التي تمارسها الصياغة المسرحية هي تفتيت الشخصية الواحدة أحيانًا وتوزيعها في عدد من الممثلين، بما يشبه استنساخ الشخصية وتدويرها في مجموعة من الممثلين، وهو ما تكرر في هذا العرض المسرحي، غيرة مرة، بشكل لافت.
في مشهد ينتقل فيه الخط الدرامي من صدام الفتيات مع أمهاتهن إلى خروج إحداهن إلى الشارع، وكأنَّها خارجة من مدرستها لتجد أربعة من الشبان يحيطون بها، والأربعة هم “أيمن”، يغازلونها ويستعرضون قوتهم الجسدية والشخصية، وكأنَّ هذا التوزيع للشخصية الواحدة/ شخصية الفتى الذي يراود الفتاة ويغازلها في أربعة ممثلين هو تمثيل لمحاصرة شخصية الفتى الذي يراود فتاة تعاني قهرًا أسريًّا وتفتقد الاحتواء في عائلتها، ويبدو توزيع الشخصية الواحدة في أربعة ممثلين إحالة لرمزية الرقم أربعة في إشارته للجهات الأربع، فكأنَّ حضور الفتي المراود الفتاة المقموعة في أسرتها التي تتوتر علاقتها بأمها- هو حضور مُحاصِر للفتاة من كل الجهات.
وفي مشهد حول تساؤلات الفتيات في طفولتهن وحداثتهن العمرية، محاولةً منهم من أجل استكشاف الجسد الإنساني وبخاصة الأنثوي والتعرُّف عليه، هذه الأسئلة التي أول ما تتوجه البنت بها يكون لأمها، حيث تظهر سبع فتيات في مراحل عمرية مختلفة كل فتاة تمسك عروسة مختلفة وخلف كل فتاة أم مبتسمة مثل الروبوت، فالانتقال من مناقشة ثنائية بين فتاة وأمها حول الجسد، إلى تموضع سباعي لفتيات ممسكات بعرائس وأمهاتهن، بما يحمله الرقم سبعة من رمزيات، أبرزها دلالة الاكتمال، ما قد يشي دلاليا إلى أن ثقافة تعريف الأمهات لفتياتهن بالجسد هي إشكالية عامة، لا تخص فقط حالات الحكاية، فمثَّل هذا الانتقال من المشهد الثنائي بين فتاة وأمها إلى مشهد أكثر اتساعًا وعمومية بتراص صفين سباعيين من الممثلات، من الفردية إلى الكورسية، انتقالاً من الحالة الخاصة إلى التعميم بما يشبه القاعدة.
تعدد مستويات الحوار
تتأسس بنية الحوار في عرض ثلاثة مقاعد في القطار الأخير على تعدد مستويات في بعض مواضع المسار الدرامي للدرامي، وثمة غير شكل لتعدد مستويات الحوار الدرامي، ومنها التدوير والتقاطع الحلقي، حيث الانتقال الحواري من حيث بين أم وابنتها باستئناف حديث بين أم أخرى وابنتها، من غير تداخل منبثق من كلمة أو جملة مفتاحية تتكرر بشكل تدويري، أي أنها بعدما ترد في مختتم مبادلة حوارية بين شخصيتين ما تلبث أن تجيء في مستهل مبادلة حوارية بين شخصيتين أخرتين، ما يجعل الحوار في بعض المواضع عبارة عن حلقات متصلة رغم تنوع طرفي المبادلة الحوارية.
كذلك أحيانًا ما توظَّف الصياغة المسرحية “الكورس” تدخلاً في الحوار لغرض درامي، كما في تدخل الكورس في حوار بين مريم وأسرتها:
بابا: خير يا حبيبتي مالك.. إيه اللي تاعبك؟
الأخت: أكيد علشان شعرها هو فعلا بقاله فترة بيقع )الكورس “بفرحة”: أخيرًا حد خد باله( ودي يا جماعة أعراض )الكورس: قلق مرضي) قلة تغذية.
الأخ: قلة تغذية إيه يا عبيطة أنتِ، أنتم إزاي مش واخدين بالكم )الكورس “بأمل: الأخ السند).. مريم بقالها فترة تخنانة وبتاكل بشراهة جدًا.. وده لما بيحصل فجأة عادة بيبقى سببه (الكورس: اكتئاب (طفاسة ولازم تروح لدكتور دايت.
الأم: بس يا واد منك ليها أنتم مش فاهمين حاجة.. أنا عارفة بنتي (الكورس: قلب الأم) أنتِ إمبارح ماكنتيش قادرة تاخدي نفسك ده أكيد (الكورس بأمل: Panic attack) حساسية على الصدر… أنا هادفيلك شوية تيليو وألفلك جرنان بزيت مغلي و….
مريم: يا جماعة.. أنا حاسة عندي اكتئاب.. عايزة أروح لدكتور نفساني.
تأتي تدخلات الكورس في بعض مواضع الجمل الحوارية، بالتعليق في ثنايا بعض الجمل التي تتلفظها الشخصيات، بتلفظ ما يجب أن تقوله الشخصية أو ما يجب أن تفعله، بينما يجيء تلفظ الشخصية على عكس ما ينبغي قوله إبرازًا لمفارقة انفصام شخصيات أهل الفتاة عن الواقع أو المنطق الطبيعي لما يجب أن يكون عليه رد فعلهم على شكوى الفتاة نتيجة تثاقل حدة الاكتئاب الذي تعانيه.
وأحيانًا ما يرواح الحوار ما بين المبادلة الحوارية الدائرة في الآن ما بين شخصيتين، صوتين يتلفظان جملهما الحوارية، وفي ثنايا هذه المبادلة تتداعى تلفظات شخصيات أخرى تستدعي الشخصية ما سبق وأن قالوه أو ما تتوقع أنهم سيقولونه في الموقف الدرامي، ففي مشهد توسل ياسمين الطالبة المتفوقة في دراستها في كلية الهندسة إلى مراقب اللجنة الامتحانية بأن يمنحها فرصة لتصحيح موقف طمس الدم الذي نزفته لاسمها ورقمها من على كراسة الإجابة، ما سيتسبب في فقدانها فرصة التعيين معيدة بالكلية- تتداعى جمل تأنيبية من “أكرم” حبيبها الذي تخلى عنها بالسفر وكذلك الأم والعمة، ففي بعض مواضع الحوار تتداخل أصداء أصوات أخرى خارجة من أعطاف الذاكرة أو اللاوعي في ثنايا التبادل الحواري، تمثيلاً لإلحاح اللاوعي على الشخصية في حوارها.
التهكمية وكاريكتورية التمثيل
مما يتشكل منه التكوين الدرامي لعرض ثلاثة مقاعد في القطار الأخير، الرؤية التهكمية للمواقف وكذلك التمثيل الكاريكتوري لبعض العناصر، إمعانًا في إبراز عبثية الواقع ومرارته، وهذه التهكمية والتشكيل الكاريكتوري يشمل بعض المواقف والشخصيات، كما في موقف اجتماع أسرة الفتاة “ياسمين” والجيران لتقرير مصيرها الشخصي وتحديد مسارها التعليمي، ما بعد دراستها الثانوية، إلى حد إشراك حارس البناية “البواب” في تقرير مصيرها هذا، كما تتجلى الكاريكتورية في الإبراز الجسدي لبعض الشخصيات الثانوية/ الجارات في هيئة شديدة التضخم والتخمة الجسدية، إبرازًا لتخمة أخرى نفسية لدى هذه الشخصيات وحضور ثقيل الوطأة بقبولهن التدخل في خصوصيات تلك الفتاة.
وفي مشهد آخر تتبع فيه الرؤية المسرحية أسلوب الإبراز الكاريكتوري انتقادًا وتهكمًا، يدخل الأستاذ الجامعي بكلية الهندسة، يظهر عدد كبير من الطلبة الجامعيين في تجمُّع عشوائي وتبدأ موسيقى فرعونية مهيبة توحى بدخول الآلهة، فيدخل دكتور جامعي يرتدي ملابس الفرعون محمولاً على أربعة أكتاف لطلبة تئن من الألم. ثم يجلس على كرسي مرتفع جدًا.. يمد الفرعون يده بتكاسل وضيق فيتيخل الطلبة أنًه يصافحهم( ثم يطالب الفرعونُ/ الأستاذُ الطلبة بأشياء شاقة تكاد تكون تعجيزية.
غير أنَّ هذا الطرح الكاريكتوري للأستاذ الجامعي في هيئة “فرعون” متأله، تمثيلاً لإفراط الأستاذ الجامعي في مطالبه من طلبته يبدو طرحًا قاصرًا في رؤيته لأزمة التعليم، هو مجرد طرح يتبنى فقط وجه نظر “الطالب” التي ترى أنَّ “الطالب” دومًا على حق، وأنَّ الأستاذ دومًا هو “الجاني” والطالب ليس إلا مجنيًّا عليه، فلا يعي هذا الطرح أزمة الفجوة الهائلة التي قد تسبب صدمة عنيفة للطلاب، بالانتقال من نظام التعليم الأساسي حتى الدراسة الثانوية، هذا النظام القائم على تيسير معرفة تعليمية بأساليب تلقينية، إلى نظام الدراسة الدراسة الجامعية الذي يتطلب من الطالب أحيانًا أن يكون باحثًا بنفسه عن المعرفة وهو ولم يعتده من قبل، ما يسبب أزمة لدى بعض الطالب نتيجة الاعتياد على الحصول السهل للمعرفة، فهذا يطرح يلعب على دغدغة أوتار مظلومية الطالب/ الشباب والفتية من جيل المعلمين والآباء، لكنه يتغافل عن تبصر الأسباب الجوهرية وجذور مشكلة التعليم الحقيقية التي تعود في أغلبها إلى بيئة وثقافة اجتماعية تكرس دومًا لاستسهال الحصول على المعرفة بأساليب تلقينية للطالب. كذلك فثمة مشكلة أخرى في هذا الطرح الكاريكتوري التهكمي للأستاذ الجامعي تشبيهًا له بالفرعون أنه يقصر ايضًا في تصدير صورة للفراعنة/ ملوك المصر القدماء بأنَّهم ليسوا إلا طغاة مستبدين، هو تصوُّر قاصر الرؤية عن دور ملوك المصريين القدماء في بناء حضارة إنسانية عريقة لها الكثير من الإسهامات الإنسانية والثقافية والمعرفية.