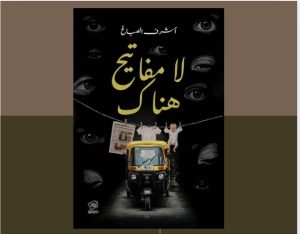“دائما كان يكتب صفحة واحدة ويرسم مؤخرات كبيرة سمينة، ثم حين يذهب إلى الاستديو يستدعى اللقطات من أحلامه، يخلق المشاهد التى لم تكن خطرت على باله من قبل، أحيانا كثيرة يستخدم الذى يقع بين الممثلين والمساعدين وبقية فريق العمل فى الاستديو فى اللقطات التالية، ثم يقوم بتنفيذ اللقطات التى حلم بها، هذا شاعر وليس مخرجا وما يصنعه ليس أفلاما كما يتوهم البعض، إنه يبدع قصائد”.
أتصور أنه من البديهى للغاية التفكير فى أن “مطاع” هو الذى يرتجل ذلك الماضي، كما أنه من الوارد أيضا مسايرة أى خدعة محتملة تفترض باللؤم التأويلى اللازم، الذى يفكك اليقين الظاهرى للسرد أن من يمارس هذا الارتجال حقا هو الضابط أو زوجته عبر وسائط متقنة، أو أن “وحيد الطويلة” أراد أن يجعل تلك الذاكرة خيالا جماعيا مشتركا بين شخصيات الرواية.. لكننى أعتقد أن علينا الاندماج أكثر مع فكرة أن الذى يرتجل الماضى داخل الرواية هو قارؤها.. هو الذى يتكفل عبر صفحاتها باكتشاف المسارات وبالتصارع مع التفاصيل وبتعديل الكوابيس كما يليق بأرقه الخاص.. هو الذى يسحب الذيل القصير حتى يجد الفيل.. ربما هذا ما يجعل من كل الاحتمالات حقائق مؤكدة بكل ما يتضمنه هذا التأكيد من المرح المماثل لذلك الذى يكمن فى المؤخرات الكبيرة السمينة التى كان يرسمها “فيلليني” قبل الذهاب إلى الاستديو.. هذه الذاكرة تخص “مطاع” أو الضابط أو زوجته أو “فيلليني” نفسه أو أى شخصية أخرى أو تخصهم جميعا.. ما الفرق؟.. إنه التناسخ الناجم عن ارتجال القارئ للماضي.. الذى يجعله نسخة جامعة، مؤلفة من “مطاع” والضابط والزوجة رغم الغضب والنفور والألم.. الارتجال الذى يدفعه لخلق الحكاية دون استقرار دلالى ودون أحكام يجزم بواسطتها أنه يعرف حقا المقصود بـ “العدل”.. الإقامة بين “مطاع” و”مطيع”، والتسلل خارجهما متحصنا بروح كاريكاتيرية.. ذلك ما فعلته رواية “حذاء فيلليني” حينما تناسخت بأوجه متعددة مع فيلم “Amarcord” لـ”فيديريكو فيلليني” عام 1973.. لنتذكر مثلا مشهد التحقيق مع “أوريليو” فى الفيلم:
“الضابط: ماذا تعنى بـ “أنا حقا لا أعرف؟”
أوريليو: أنا لم أقل أى شيء مثل هذا. أتكلم عموما عن عملي. ربما قلت أنا حقا لا أعرف كيف تجرى الأمور السياسية.
الضابط: أهذا تهديد؟
أوريليو: بالتأكيد لا.
الضابط: قلة إيمان بالفاشية؟
أوريليو: لا.. لماذا؟
الضابط: الدعاية الهدامة ربما؟
أوريليو: لا.. ليس هناك سبب لذلك.
الضابط: ألا تعرف شيئا عن الجرامافون؟
أوريليو: جرامافون؟
الضابط: لا تحاول أن تدعى الحكمة.. جاوب.
أوريليو: لقد أيقظونى من نومي. لم أجد وقتا حتى لربط كرافتتي.
الضابط: كرافتتك أم فوضويتك؟”.
لنراجع الآن هذا المشهد من رواية “حذاء فيلليني”:
“هل تعرف فيلليني، وما علاقتك به!!!
الدنيا كلها تعرف السيد فيللينى يا سيدي، إنه رفيق أممي، نحن نرى أفلامه وندرس شخصياته وكيف يتعامل معها، فيللينى شاعر وليس مخرجا فقط يا سيدي.
مخرج يا حيوان، مقيد فى دفاترنا أنه مخرج فقط.
لماذا استعملت فى قراءتك للأفلام تعبير العجول الكبيرة؟
يا سيدي، إنه تعبير استخدمه فى أحد أفلامه عن الشباب العاطلين الذين كانوا يتسكعون على أرصفة الشوارع، يتحرشون بكل امرأة وحقيبتها، وأحيانا يتحرشون بعمرها ولم يفلت حتى الرجال منهم.
أنت كنت تقصد معنىً آخر بالتأكيد، احك كما حكت النملة يا بن القحبة”.
وهذا المشهد أيضا: “هل كنت تربى الحمام؟
الحمام كان يمرُّ عابرا فوق سطوحى مثل سطوح الآخرين.
هل تعرف مأمون؟
مأمون من يا سيدي.
صفعة ثم هل تعرف مأمون؟
أنا لا أعرف سوى المأمون بن هارون الرشيد، وكل مأمون فى التاريخ أشعل التاريخ.
لم أكمل جملتي، لا أعرف من أين تأتينى الركلات ولا كيف دخلت الكهرباء فى جسمى ولا كيف خرجت ولا كيف أفاقونى ومتى، ولا أين نحن الآن.
لكن مأمون يعرفك.
هذا الرجل أعرفه ويجب قتله الآن، الآن عرفته من صوته، صوت لا يخرج من حنجرته وإنما يخرج من الهواء، صوته ليس مخيفا، هو أكبر من الخوف، الخوف الذى نتنفسه بعد فراغنا من فسحة أغانى فيروز.
كل ما أتذكره أنه أعاد جملته: مأمون يعرفك يا حقير، قلت له وأنا تائه بالألم: يا سيدى أحضر مأمون، ضعه فى غرفة وأحضر معى ثلاثة آخرين، ودعه يكلمنا وإذا عرف صوتى فأنا مأمون نفسه إذا شئت.
الصفعة التى تلقيتها ليست ككل الصفعات القديمة، كانت أنفاسه أمام وجهى ساخنة ويده محمية وهو يقول:
أنت تعرف فيللينى وتقرأ أيضا قصص أجاثا كريستى يا بن الكلب.
لا بد أنه كبيرهم الذى علمهم السحر، فى كل مرة يأتى تنكمش الحيطان ثم تتمدد.
وأنا معصوب العينين والروح، كأننا فى فيلم، لا تعرف هل الدراما أمام الكاميرا أم خلفها.
ما اسمك؟
اسمى مطاع يا فندم.
اسمك مطيع منذ الآن يا بن المحروقة، أعد كتابة كل ما كتبته وابدأ باسم مطيع، هو اسمك منذ الآن وحتى تموت قريبا.
ثم نادى بصوته الذى لم أنسه يوما ودرَّبت أذنى ألا تفعل، ودرَّبت روحى أن تتذكره جيدا فى القبر:
خذوه ولفوه فى ورق سيلوفان.
خذوه ولفوه فى ورق سيلوفان”.
فى فيلم “Amarcord” أذاق الفاشيون “أوريليو” نخب نصر الفاشية “زيت الخروع”.. لنتذكر الضابط المشلول الذى يحمل النياشين، ويجلس فوق كرسى متحرك أثناء التحقيق مع “أوريليو”، ونقارن نظرته وملامحه بوجه الجلاد وجسده فى الرواية.. لنتذكر كلمات هذا الضابط، وحديث المحقق أثناء إجبار “أوريليو” على شرب زيت الخروع عن حماية الفاشية لكرامته “إذهب إلى الجحيم يا جاهل.. حيوانات”، وعن الرفض المطلق للفهم ثم نقارن ذلك الهذيان الأمني، بهذه السطور من الرواية:
“قلت لك يوم لقيتك: سأفرغك من جوفك، سأخرج مطاعا منك وأحل محله لتصير نظيفا من جرائمك، ثم يحل محله واحد على الشاكلة التى أريدها، على طريقتنا فى الخلق، العجينة التى يجب أن تكون عليها لتحظى بمكان فى جنتنا، كان لا بد من تحويرك وتحويلك إلى مطيع على مقاسنا، متعاطفا معنا، مؤمنا حقا بنا، نحن الدين والوطن والأسرة، ولعلك سعيد الآن، تشعر أنك تحب مطيعا وأنك هو، أليس كذلك؟. أنا حاولت أن أغيرك لتصير أفضل، وأنت الآن تتغير فعلا إلى الأفضل، أنت كنت تخرب الوطن وأنا كنت أحمى الوطن، وصرنا الآن فى خندق واحد.
نحن نحكى كل شيء، مفردة الكذب تم شطبها من اللغة، المصارحة والمكاشفة وسيلتنا ونتأكد من ذلك كل يوم ونبدأ بأنفسنا. ضابط كبير سأل ضابطا صغيرا فى إحدى جولاته التفتيشية: بمَ حلمت بالأمس؟ رد الضابط الصغير دون تفكير: كنت أحلم أن كل النساء فى بنايتنا يقفن صفا واحدا بسعادة فى انتظار أن تضاجعهن، لكنك فى النهاية اخترت أمي!
فكرتنا بسيطة يا مطيع، أنت تعرف أن من اخترع قماش الجينز الذى تلبسه وتتبختر به كان هدفه أن يخترع قماشا يصلح فى كل الأحوال ولكل المناسبات مهما اتسخ، ونحن مثله تماما أردنا تحويلكم جميعا إلى سراويل جينز متشابهة صالحة لكل الأغراض ونظيفة أيضا، ولعلك تعرف بحكم تعليمك أن ذلك يحقق المساواة بين الجميع، ويؤكد أننا كدولة نتوخى العدل الكامل بين أبناء الأمة. أنا مندهش! أنتم جاحدون، هناك من يختلف مع زوجته أو أولاده على صحن فاصوليا فيربطهم فى عواميد السرير، وأنت تشعر بأنك ضحية لمجرد أنك شرفتنى شهرا يتيما فى ضيافتنا فى القبو”.
لنتذكر أيضا “تيتا” فى الفيلم وهو يضع رأسه بين الثديين الضخمين لبائعة السجائر ثم نستعيد كلمات “فيلليني” فى الرواية لـ “مطاع”: “لو أننى مكانك لانضغطت بين هذين الثديين اللدنين الواقفين كأنهما حارسان على باب معبد، كأنهما إعلان عن الحليب ولغُصت فيهما حتى امتلأت أكواب الحليب وفاضت”.
كأن رواية “حذاء فيلليني” تجسيدا متخيلا لحياة الفاتنة “جراديسكا” بعد زواجها فى نهاية الفيلم من أحد العسكريين.. كأن “وحيد الطويلة” نفسه نسخة من راوى الفيلم أو المحامى الذى قام بدوره “لويجى روسي”.
أنت هنا لا تقرأ عن الطبيب النفسى الذى حضر مؤتمرا انتهى به إلى السجن ليعذَّب، ثم وجد نفسه كمعالج لجلاده المتزوج بجارته التى يحبها.. أنت تواجه تاريخك الشخصي، وتعيد كتابته وفقا للاشتباك جماليا مع ما يمكن أن يعنيه التشتت القابض على هاتين الكلمتين “الجلاد” و”الضحية”.. السحر الصلب، والمخادع للعقائد النرجسية وراء هاتين الكلمتين.. مجددا يضعنا “وحيد الطويلة” وبشكل أكثر تحديدا فى مواجهة هذه التساؤلات القديمة: هل يبرر عدم ممارسة التعذيب الجسدى تجاه شخص آخر نفى صفة “الجلاد”؟.. ما المقصود بالتعذيب الجسدى أصلا؟.. ماذا عن أنواع التعذيب الأخرى التى تُصنف اعتيادا كجرائم أخف وطأة؟.. ماذا عن الجرائم التى لا تُرى؟.. ماذا عن التعذيب الحاضر فى كل ما يتم تقديسه كفضائل؟.. ماذا عن ضحايا ذلك الذى لم يسبق له أن قام بتعذيب أحد جسديا كما يحدث فى السجون والمعتقلات؟.. ماذا عن ذلك الشعور بالقهر داخل الإقرار بالذنب، والمقترن بالرغبة فى التطهّر؟.. ماذا عن الشعور بالإثم الذاتى عند الخضوع الظلم؟.. هذه الرواية ليست عن السلطة بل عن ماهية الحرية الضرورية التى ينبغى أن يمتلكها الإنسان لتوثيق رعبه الباطني.. عن طبيعة الخيال الذى يترك من خلاله الفرد بصمة شخصية داخل العماء.. هذا هو الوجه الآخر للتناسخ.. أنت تنتمى كقارئ إلى هذا الظلام الكلي، وإذا كانت رواية “حذاء فيلليني” قد أوجدت سبيلا حكائيا كى تتأمل هذا التشابه بينك وشخصياتها، فإنها تعطيك أيضا الطريقة التى بمقدورك استخدامها لصياغة ماضيك مثلهم.. الطريقة التى حددتها مسبقا فى ذلك الفعل “الارتجال”.. أن تكتشف سردك الخاصك، الذى لا ينكمش داخل الحدود النمطية: المهانة والفقد والانتقام والشفقة والتسامح بل يمتد إلى استجواب الذاكرة.. مصافحة ضحاياك الذين لم يكن لديك الفرصة من قبل لأن تعتبرهم كذلك، والأهم أن تسبح داخل الفضاء الغيبى الذى يتخطى الجريمة والعقاب.. أن تتفحص اللعبة الإلهية مستخدما نفس سلاحها: اللغة.. أن تعيد اختراع أوهام هذه اللغة.
يمثل الارتجال نوعا من مقاومة ما يفترض أنه نظام ثابت للأشياء.. مجابهة الترتيبات الذهنية والتحديدات الحسية عبر تكوين مضاد، قد يدعى أنه نظام مناقض ولكنه دعابة فى حقيقته.. نسق شكلى للطيش.. هذه المقاومة لا تعالج جروحا بقدر ما تسعى للمحو.. إزالة التاريخ أو ما يسمى هكذا، دون ترك أثر.. دفنه فى النسيان.. لكن المجابهة تثبّت هذا التاريخ مع سعيها إلى محوه، وذلك ما يجعل من الارتجال نفسه هدفا وليس إنقاذ الجسد فعليا.. إرجاء حضوره وتعطيل دلالته.. مع كل محاولة للكتابة أى للتخيل هناك صورة مغايرة تُرسم لثنائية الضحية والجلاد.. هناك علامة هازئة تُرفع فى الوجه المعتم، المختبئ وراء الإلزامات العبثية التى تسيطر على هذه الثنائية الأزلية.. إذا كان الارتجال هو الهدف فما يقوده هو الشهوة.. الارتكاب الجنسى الذى بقدر ما هو خاضع لهيمنة “الجريمة والعقاب” بقدر ما هو أكثر ما بوسعه خلخلة النماذج القمعية الناتجة عن تلك الهيمنة.. دمج “وحيد الطويلة” للخيال والشهوة فى رواية “حذاء فيلليني” هو تبديد للطغيان.. ليس الطغيان “الفاشي” بالمعنى التقليدي، وإنما الحضور العدائى لجسد الآخر فى كل تجلياته.. الجسد المعزول حتى عن ماضيه.. الارتجال إذن هو بعثرة لآليات الهيمنة بالتحالف مع براهينها.. بتقمصها.. كأن كل حكاية مرتجلة تحاول أثناء المقاومة أن تكون هى نفسها ما تقاومه.. أن تكون الطغيان ذاته.. كأنها بذلك تُروّض وتتحكم فى المفاجآت الرمزية المتوقعة للعبة.. تراوغ مثلها.. تخضع للخوف وهى تسعى لأن تكون جزءًا منه.. أن تكون منتجة لهذا الخوف، وهو ما يجعل الرواية كجزء من الدعابة فعلا عدوانيا.. نعم يمكن تصور أن قراءة رواية “حذاء فيلليني” نوع من الجَلد.. ليس فقط لمن يعتبرها ممارسة ضدية تحت أى مسمى وهذا بديهى بل أيضا لذلك الذى منحته اللذة وهى تخبره بأنه ليس شرطا أن تكون “فاشيا” حتى تكون جلادا، كما أنه ليس من الضرورى أن تتعذب جسديا “بالمفهوم الشائع” حتى تكون ضحية لمن يعذبك.. اللذة التى تكمن فى الإزاحة الشاقة لهذا اليقين السهل، غير المكلّف، الذى ربما لا يمكن خدشه عن الجريمة والعقاب.. شج الرأس الذى يحاول أن يبلغك بأنه ليس هناك ضحية ولا جلاد وإنما هناك مأساة عظيمة من المسميات التى تلهو بالأجساد الغارقة فى الظلام، مثلما تحاول هذه الأجساد أحيانا أن تلهو بالخيال.