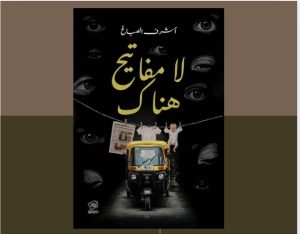تلك القصيدة التي أسست لنفسها كما ونوعا عبر انحيازها للشأن اليومي والتفاصيل بوصفها المعطى الحيوي للحيوات العادية المشروطة والتي تحتاج لمن يعيد اكتشافها ويحرر خصوبتها، محاولة إعادة الاعتبار “للإنسان الصغير” والقضايا المعاشة والمهملة، مخلفة وراءها ذلك الإرث الثقيل من الزخرف والبلاغة والخطابة ذاهبة بوعي للملمة البخار الشعري عن كل الأشياء وسفحه بهدوء ورهافة.
هؤلاء الشعراء غجر المدن الجدد ينصبون مضاربهم/ مخيلاتهم في المقهى، على الرصيف، على السلالم وفي الحدائق العامة، وعلى بقايا أثار الأزمنة التي تخف مسرعة من البيت إلى العمل محفوفة بأحلام وهموم لا تنتهي وعلى حافة نساء يمكثن ويغادرن في نفس الوقت… شعراء يقذفون نيران حواسهم في وجدان اللغة لشحذ طفولتها وإبراز مفاتن عريها.
أحمد يماني الشاعر المصري الشاب أحد هؤلاء الغجر، استند في مجموعته الشعرية “تحت شجرة العائلة” إلى هذا المنجز، هذه الحساسية، مضيفا تلويناته التي تستحق الانتباه.
صحيح أن قصيدة يماني لا تخوض في التجريب ولا تدعي ولا تغامر. لكنها تدخل في غابة الشعر طفلة هادئة أنيقة مهذبة موهوبة وحساسة، ومشاكستها لا تخرج عن طبيعتها. قصائد قطفت طزاجة الحميمية ومعاصي الوداعة من وعورة المناخات وخطابات القسوة بخفة ورهافة وببساطة ممتعة وأحيانا بسهولة لا تؤدي سوى إلى نفسها.
يسعى الشاعر لتصدير ألفة جارحة مع المكان فيسرده ليحميه من صيرورة الموجودات والمشاعر مستجيبا لخاصية لحظة ليس لها أن تكون بكرا. ثم يفرد تفاصيله في استعارات خجولة جميلة محاولا أن يهيئ مشهدا آخر جديدا.
الغابة أشجار ضخمة وحشائش
ممرات صغيرة وكائنات حية
يدي في يد حبيبتي ندخل باحتراس
لكني نجد المكان نفسه، مكان الأجداد
المكان المثالي لمطارحة الغرام
تحت ضوء القمر الباهت
وأصوات صراصير الليل
كنا نتفتح مثل زهرتين كبيرتين
عيوننا تتسع مع اقتراب الفجر
وملابسنا مفتوحة في بعض الأحيان
لكل منا سلسلة ظهر بارزة وأسنان نظيفة
وحياتنا موجودة هنا
كما لم توجد من قبل.
الآخرون يدخلون قصيدته، يخلعون أعباءهم وجراحهم، ينظفون مصائرهم الصغيرة ويخرجون بينما المرأة الحبيبة تمكث في القصيدة تشدها إلى جسدها لتكونها حتى النهاية.
القصيدة مفكرة الحب الذي كان وما زال متدرجا عامرا في أشكال متباينة من الوصل إلى الفقد إلى الحنين إلى الخيبة ومؤكدا كينونته/ الحب/ التي تسطع طارحة الرغبة التي لا يحدها وصل ولا فقد.
عندما أغمضت عيني وفتحتهما
رأيت بيتي الصغير وسريري
يتأرجحان أمامي
كجرسين عملاقين في كنيسة فارغة.
تتألف مجموعة “تحت شجرة العائلة” من سبع قصائد آخذة شكل المقاطع الصغيرة تتهادى في سياق لا يني يحاول الالتفاف على أحوال السيرة في أسلوبية سردية تفوح منها رائحة أسرية تتراسل حينا وحينا تهب من الباب الذي فتحه الشاعر ليشرف على “شجرته” التي تعبرها الفصول وعلى تلال لحظات آفلة حاضرة.
كل ذلك بلغة سردية إخبارية، مرجعها مخيلة مطعمة بالحنين، لكنه حنين إلى الصورة، الدلالة التي تتضمن حالة الشعر بمعناها المفتوح على العالم الناجز/ الناقص قبالة عين الشاعر. حس رومانتيكي هو معادل للحواس وتحديدا حاسة البصر. هكذا تترتب مشاهد الذاكرة وتفاصيل الماضي الحميمة ويعاد توظيفها بانتقائية تشكل منعكسا لوعي وحساسية الشاعر والذي يتذكر ويلمس البساطة من جانبها المخفي ويستخرج مستقبل المشاعر من سيرورة الماضي في “الآن وال هنا”
ما زلنا معا تحت شجرة العائلة
نقرفص وراء أيام أخرى
أنت قلت
لقد جاءت الحياة يا أولادي
بعدما كسرت أنفها
وانتزعت منها خرم إبرة كبيرة
تماسكوا جيدا سأدخلكم فيها
بعدما أبلل خيطكم بفمي
تماسكنا لكننا خرجنا من الناحية الأخرى
بلعابك الذي يسرح في رؤوسنا
ولا ضير من الانتباه أن ثمة مقاطع تشكل فجوات صغيرة في مسار المجموعة إذ تقع خارج سيرورتها الإنسيابية لينطفئ الوهج الشعري كما في قصيدة “سرير ضيق” دراجة بخارية تعبر سريعا فتنغلق إمكانية الصورة في مستوى سردي يتوخى الشعر أكثر مما يحققه.
ربما قصائد يماني لا تصدم ولا تدهش إذ يتوافق شكلها مع طبيعة مشاغلها ومن ثم مع المقاصد. يلفها هدوء لا يصل إلى حد الصمت كبعد فلسفي معرفي. فكل الأشياء أمام عدسة الكاميرا التي يحركها جسد عاطفي مغرم بجماليات الحنو وضمات المكان.
وليس ثمة زمن يسفر عن انشراحاته وانغماره في نفسه وهو يمضي عموديا. حسبه أنه لحظات، لحظات تهرّ من الذاكرة العاشقة وتتشابك مع الأشياء وأكثر مع ظلالها المتحولة.
قصائد تشبه أغاني الغجر، فأشياء وأحداث الشاعر العادية والتي تذهب عادة إلى النسيان والتي لا يرضه لها ذلك هي مادته وهوية انشغالاته.
“تحت شجرة العائلة” ليست أناشيد لتخبط الحناجر بها وليست مرثية تقلد حزنا عتيقا. إنها لحظات ثمار وقعت من شجرة الحياة، تعلق روائح دمعها على أنفاس البساطة النشطة. قصائد تذهب بدعة إلى أحلامها هادئة دون ضجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة القدس العربي 23 يونيو 1999