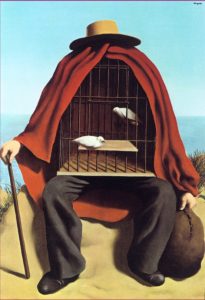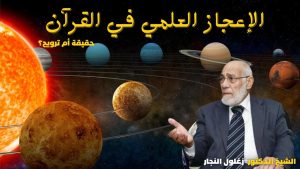أسامة كمال أبو زيد
منذ أن ضرب – فرديناند دي لسبس – أول معول في تربة القناة في السادس والعشرين من أبريل عام 1859، لم يكن يحفر مجرى مائيًّا فحسب، بل يشق شقًّا عميقًا في قلب الجغرافيا، ويطلق مدينة من رحم الرمال، مدينة تُشبه حلمًا جرى ذات يوم على ضفاف المتوسط. وفي عام 1869 خرجت بورسعيد إلى الحياة، لا كمدينة وحيدة، بل كمجموعة مدن متجاورة تسكن الاسم الواحد. مدينة الوجوه العديدة، كل وجه منها يحمل ذاكرة تخصه وحده، لكنها في النهاية تُرتّل جميعًا تحت سقف واحد: المدينة التي حلمت بنفسها، ثم استيقظت على امتداد قرن ونصف بين الحنين والخذلان. كان أول الوجوه أكثرها أناقة، مدينة المتعددين، المدينة التي اختارت منذ ولادتها أن تكون مرآة لبحر لا يعرف النقاء الأحادي، ففتحت ذراعيها لليونانيين، الفرنسيين، الإيطاليين، المالطيين، القبارصة، الشوام، الفلسطينيين، وغيرهم ممن جاؤوا من شتى مشارب البحر، وشكلوا ما يشبه أوركسترا مدنية مصغّرة لكل شعوب المتوسط. امتزجت اللغات في حي الإفرنج، وتهادت الأبنية كأنها مقاطع موسيقية ترتدي شُرفات فيروزية، وتمشي في ميدان دى لسبس ( المنشية حاليا ) خطى ملكيّة ناعمة. وعلى الضفة الأخرى كانت بورفؤاد، هذه الضاحية الأنيقة التي وُلدت أولًا في أوراق المهندسين عام 1902، ثم أعلنها الملك فؤاد رسمية في 1926، لا كملحق إداري، بل كاستكمالٍ صقيل لحلم فرنسي – يونانى أرادت به المدينة أن ترى صورتها في مرآة البحر.
لكن البحر، كما يمنح الياقوت، يمنح الملح أيضًا، وكان لزامًا أن يكون هناك وجهٌ آخر، خشنٌ، غارق في عرق الجباه وشقوق الأقدام، وجه حي العرب، الذي بدأ كأكواخ من العريش والقصب، مبنية على أطراف المدينة، حيث انتهت حدود حلم الأغنياء وبدأت أحلام الفقراء. هناك جاؤوا من دلتا الجوع وصعيد الغبار، حاملين معهم الأمل والعمل والخضوع للضرورة. خدموا في منازل الإفرنج، جابوا الشوارع كباعة متجولين، ثم امتهنوا البحر ذاته، حتى صاروا بمبوطية، رجال البحر، ومفاتيح السفن، وأدلاء الطرق في ليل القناة الطويل. تداخل الحيان، لا لأن أحدًا أراد، بل لأن الزمن أراد، فذاب التمايز بين ساكني القصر وخادميه، وصارت المدينة تعرف أبناءها جميعًا بالاسم واللكنة والحكاية.
وكان لا بد أن يتكلم البحر، لا البحر كممر، بل البحر كأب، كغيب، كنداء لا يُقاوَم. من حي المناخ خرج الصيادون، وسكنوا ما بين مَدِّ المتوسط وسحر بحيرة المنزلة. هناك، على الشاطئ، خُلقت الأساطير، وانداحت حكايات النداهة والجنيات، لا على سبيل الخرافة، بل كجزء من نسيج الحياة اليومية. وفي الجنوب، عند القابوطي، كانت الحكاية أكثر غموضًا ودفئًا، حي من الصيادين نُسب إلى وليّ لم يذكره كتاب، لكنه ذكره قلب كل من سكنه. القابوطي لم يكن مكانًا فقط، بل تميمة جماعية تحمي ساكنيها من الفقر، ومن الغرق، ومن النسيان.
ثم جاء عام 1956، وجاء العدوان الثلاثي، ووقفت المدينة الصغيرة على قدمين من دمٍ ونخوة. لم تُسندها جيوش، بل أسندها ناسها، صغار الحرف، كبار الهمة، ودافعت عن نفسها كما لم تدافع مدينة من قبل. صار اسم بورسعيد أيقونة، لا في مصر وحدها، بل في كتب المقاومة حول العالم. لكنّ ذلك الشرف لم يأتِ دون ثمن. غادر معظم الأجانب الذين أسسوا المدينة، وتركوا مبانيهم كأصداف فارغة، وبقي حي العرب محتفظًا بشعبيته العتيقة، واختلطت الذكريات في ساحة واحدة، لم تعد تفرّق بين شارع وشارع، بل بين صوت وصدى.
وفي عام 1969، هُجّرت المدينة، لا لأن أبناءها أرادوا، بل لأن القدر قرّر أن يبعثرهم على خريطة الوطن. البعض عاد إلى قُرى أجداده، البعض رُحِّل في أتوبيسات لا يعرف وجهتها، البعض بقى، لا اختيارًا بل عسفًا. صار اسم “المُهَجّر” تعريفًا جديدًا للمواطن البورسعيدي، كما صار “المستبقى” صفة لمن بقي داخل المدينة تحت ذرائع الوظيفة أو الخوف أو الارتباط. لم يعد أحد كما كان، ولا المدينة كما كانت.
ثم جاء زمن السبعينات، وأعلن السادات فتح المدينة كمنطقة حرة. كان الأمل أن تصبح بورسعيد مثل هونج كونج، أو تايوان، وأن تنهض صناعة، أو تنمو طموحات. لكن ما حدث هو أن المدينة تحولت إلى متجر كبير. تاجر الجميع بكل شيء، صارت البضائع المستوردة دينًا، والتهريب بطولة، والمهربون أبطالًا شعبيين. ازدحمت الشوارع، وعلت الأصوات، وصار شارع الحميدي والتجاري والشرقية قبلة الزائرين من كل مصر، يبحثون عن صفقة، أو قميص، أو وهم.
منذ الثمانينيات، خفتَ صوت المدينة الأصلي، وارتفعت نبرة أخرى، نبرة الجماعات الدينية، بثيابهم الثقيلة ومفرداتهم المتشددة، ففقدت بورسعيد نكتتها، وفقدت روحها الهجائية الساخرة. زحفت عليها موجات بشرية من مدن وقرى أخرى، غطّت ملامحها بطبقات من الطين الريفي، حتى لم يعد البورسعيدي البهي كما عرفناه، بل مجرد ظل باهت، أو استنساخ شاحب لصوت بعيد.
ما بقي من المدينة القديمة في حي الشرق أطلال وظلال، الفنار العتيق، البيت الإيطالي، كنيسة سانت أوجين، محلات سيمون أرزت، الجامع العباسي، مسرح الألدورادو، وعمارة اليهود… لكنها كلها تئن الآن تحت أقدام الأبراج الإسمنتية التي لا تعرف التاريخ ولا تحترم الذاكرة. شيء ما انكسر في الجدار، ليس جدار البيت، بل جدار الحلم.
ورغم كل ذلك، يبقى شيءٌ من سحر الأزقة القديمة في حي العرب، وحنين المناخ، وظلال القابوطي. في الضحكة العابرة، في طَرقات السمك الطازج على الألواح، في نداء الصباح الباكر، في صوت طفل يجري بحذاء البحر، يبقى هناك شيء يقول إن المدينة لم تمت. لكن مع اتساع الرقعة، وانتقال الناس إلى أحياء جديدة كالزهور والضواحي والجنوب، انزاحت الذاكرة، وتقلص وجه المدينة القديم في مرآة الأيام.
بورسعيد، تلك التي حلمت بنفسها، لم تعد تحلم. كل ما تفعله الآن أنها تتذكّر… تتذكّر فقط.