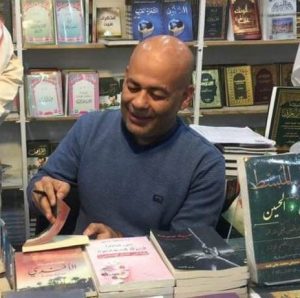أتذكر ذلك المساء البعيد حين دعيت لحفلة توقيع لصديقتي الشاعرة، والتي تربطني بها صداقة حميمة منذ عشر سنوات، غير أنها تصفني بالنعجة المدللة التي تخشى الثعلب المكار المتخفي دومًا وراء ثوب رجل وهمي غير عائش أصلاً.
وتمجد شجاعتها في قصائدها؛ لأنها لا تكذب ولا تتجمل حين يباغتها ألم ولذة القصيدة، وتتوحد مع ذاتها، رغم أنها تعود منهكة دامعة العينين وتقسم أن كل رجال العالم فقاعات صابون كبيرة.
كان عليَّ الإنصات لها، وهي تشدو بقصيدتها وألمح دموعها تترقرق في مآقيها.. تحكي عن الخيانة بصدق شفيف.. يتهدج صوتها وتبتلع ريقها بصعوبة وهي ترنو إلى آخر الصف حيث يجلس رجل وقور ببزته العسكرية، ونظارته السوداء التي أضفت غموضًا مليحًا على ملامحه.. ما إن شارفت الانتهاء حتى انتصب واقفًا ورحل دون وداع.
كنت أعرفه من خلال حديثها الدائم عنه وعن طبيعة عمله الخاص وأنه مثلها يهوى الشعر، لكنه لا يجرؤ على البوح بسبب حساسية منصبه الأمني.
ارتبكت صديقتي لما شاهدت رحيله المفاجئ، لكنها تماسكت وانتبهت إلى تصفيق الحضور وهمهمات الاستحسان حتى ثابت إلى رشدها وأكملت الحفل في نشوة مصطنعة.. يقف أمامها طابور من المعجبين، تصاحبهم نسخ ديوانها الأخير، توقع على عجل وتتمنى لو أنها اخترقت السقف أو مرقت كشظية مشتعلة من بين صفوف الناس؛ لتودعه الوداع الأخير، وربما لتبصق عليه وتخبره أنه خائن ووغد ولا يستحق أن يسكن بين قوافيها، أو تخبئه بأقصى ركن بقلبها.
بعد سنوات، أجدها شاحبة.. لم تحاول نسيانه.. كلما مر يوم تأكد لي أنه لعنة أبدية تطاردها وستحجب عنها شمس أي رجل، وستظل بانتظاره خلف الباب، أو تترقب رسائله على تليفونها المحمول…. أو تتصيد اسمه على بريدها الإلكتروني.
ما زالت ترفض الزواج وتتشبث بحقها في الحياة وحيدة وترمقني في استهزاء وسخرية قائلة:
أأبدو كنعجة مثلك، أو قطة خائفة مبللة بماء المطر والعجز؟
لم أسلَم أنا وهي من سياط قسوتها، وحينما تشعر أني غبت عنها تلكزني بقصيدة حزينة، تحدثني فيها عن وحدتها وألمها ودمها المسفوح أسفل قدميه، وهو بالكاد لا يتذكرها.
في كل زيارة لها، تمرر لي تحريضًا بالحرية وأن العمر حتى لو كان أيامًا معدوداتٍ، يستحق أن نعيشه، وكانت تقصد بهذا أن أعود امرأة مطلقة حرة، خاصة أننى لم أُرزق بالأولاد، فلِمَ إذاً أحزمة المسامير التي تلتف حول وسطي؟! كانت تقصد زوجي الذي يكرهها كثيرًا ويراها امرأة سيئة السمعة وأنني لا يصح أن أصادق مثلها.. إلا أن مثلها يشبهني كثيرًا.
وصلني صوتها في منتصف الليل، مبحوحًا من أثر بكاء حاد وطويل، تستغيث بي وتتوسل أن أذهب إليها، فهي تشعر بدبيب الموت وتسلله إلى جسدها الضعيف، وحينما اعتذرت وتعللت بزوجي لم أسمع منها شيئًا، فخفت أن تكون قد فاجأها الموت وحيدة على سريرها البارد، وهممت بالذهاب إليها، غير أن زوجي استوقفني وأقسم بالطلاق إن تجاوزت عتبة الباب أكن حرة.
حرة؟!
قلتها في دهشة وحزن مصطنع.
هز رأسه في جرأة وثقة، ذهب للباب وفتحه على مصراعيه قائلاً:
هيا..اخرجي، إن كنت تستطيعين.
ثم أشعل سيجارته ووارب الباب بإحدى قدميه، وكالمنتصر قال:
كنت موقنًا من رد فعلك حبيبتي، لن تجرؤي أبدًا وهذا ما أريده منك دائمًا.
تسمرت مكاني وهو ينتشي بسيجارته، أنظر للباب الموارب.. أراني كنعجة خرقاء مستسلمة للذبح!!
أتلفت حولي فلا أجد سوى جدران ملونة بشخابيط وحدتي ودموعي، تسيل عليها، في انتظار يوم جديد.
تحاملت على عجزي وتوكأت على نشيج صديقتي المتعبة التي ربما تكون قد فارقت الحياة للتو.. ذهبت بكل قوة وفتحت الباب على مصراعيه.. أعدو مسرعة إلى الشارع.. لا أنظر خلفي وأتنفس هواءً باردًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أميمة عز الدين
قاصة وروائية – مصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللوحة للفنان: ماكس ارنست ( 1891 – 1976 )