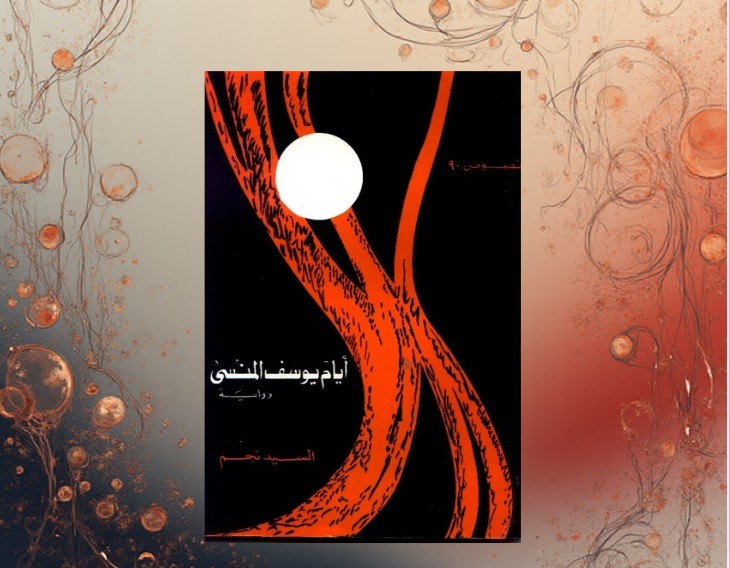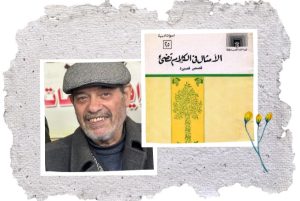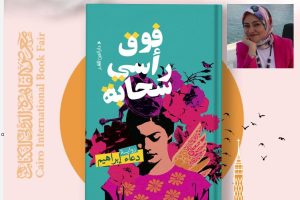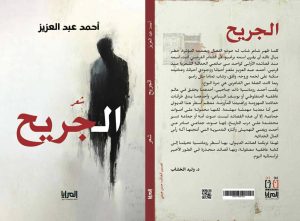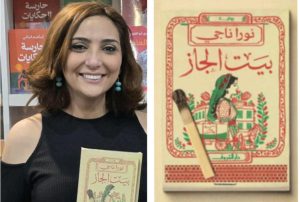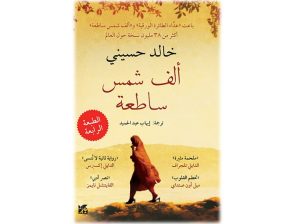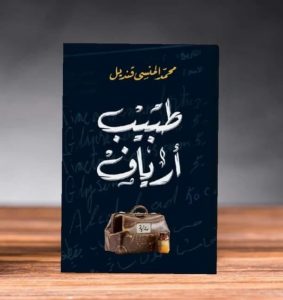د.مجدي توفيق
لا يتيح لي منهج التحليل الاسلوبى الذي اصطنعه فى هذا المقال أم أعالج ما يسمى عادة سلبيات العمل الادبى، لانه منهج يعنى بالوصف أكثر من عنايته باتخاذ سمت الخبير المثمن. لا يرضى هذا أتوجه –بلا شك- القارئ الذي يفهم النقد كما كان يفهمه ناقد عظيم مثل “قدامه بن جعفر”، كان يرى النقد ضربا من التأليف ينسب إلى علم جيد الشعر من رديئة. يكفى أن يقال الآن أن كثيرا من السلبيات يمكن أن يرى فيها القارئ المدرب على إنتاج الدلالة الأدبية دوالا على معاني بعيدة. وربما نلمس فى بعض المواضع القادمة شيئا من هذا.
ويعتمد منهج المقال على مقدمتين: تسلم أولاهما بأن الأبنية النحوية تتضافر لتصنع مستوى من مستويات بنية النص تقوم عليه الدلالة، ويمارس كثيرا من الفعالية. هذه المسلمة شبيهه بكرة عبدالقاهر الجرجاني عن “النظم” الذي هو ليس “إلا إن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو”.
لكنها فى نفس الوقت تتجاوز عبدالقاهر. ولا يسمح الموقف باستعراض مواطن الخلاف. يكفى أن نشير إلى أن ما تأسس لتأمل جماليات البيت الشعري لا يصلح لبنية أكثر تعقيدا كالقصة أو الرواية. ولنشر كذلك إلى أن النص مع انه فى بناء أسلوبه يدور فى مدار النحو وهو يختار أبنيته اللغوية من هيكل اللغة ومن ذاكرتها، إلا انه يمارس قدرا من المخالفة تسمى بالانحراف الاسلوبى، هذا الانحراف ليس خروجا تاما عن القواعد النحوية، ولكنه عدول عن الأصل إلى الفرع، وإلحاح –أحيانا- على اختيارات معينة لا تدأب عليها اللغة، وإضعاف لنسبة توقع القارئ للنمط اللغوي، مما يولد لدى القارئ شعورا بالمفاجأة.
وتسلم المقدمة الثانية بأن علم النحو يحاول أن يستنبط من اللغة بناء من الميتافيزيقا والمنطق، حتى أننا نستطيع أن نستخرج المقولات العشر المتداولة فى المنطق الصوري من مقولات علم النحو العربي. ههنا السر الذي يستخرج به المبدع من الهيكل النحوي للغة أبنية جمالية شامخة. ومن الأمثلة المعروفة على هذه النقلة للمفهوم النحوي من مكانه فى علم النحو إلى قمته فى علم الجمال نقلة مفهوم “الفاعل” من النحو إلى النقد الادبى على ايدى البنائيين، خاصة من يعاملون النص بوصفه جملة واحدة شديدة التعقيد.
وما يحاوله النقد الادبى حينئذ هو أن يكشف عن نجاح المبدع فى تحويل النمط اللغوي إلى بنية فنية شديدة التعقيد والاختلاف. وربما كان الاختلاف الذي يوصف أحيانا بالانحراف هو ما يدعو إلى القول إننا بحاجة أمام كل نص إلى تأسيس علم للنحو بهذا النص وحده.
من ههنا نستطيع أن نقرأ أيام يوسف المنسي ونبحث فى انجازها النحوي، ونحصر أبنيتها الأسلوبية الفاعلة، ونرى أساليب الإضافة، والنعت، والتعريف، والضمائر، والزمن النحوي، والزمن المعجمي.
وذلك ما دام الأسلوب محصلة مجموعة من الاختيارات المقصودة بين عناصر اللغة القابلة للتبادل. وأظن أننا لسنا بحاجة إلى التذكير الملح بان تحليل الأسلوب يقع فى منطقة وسطى بين علم اللغة والنقد الادبى. وإنما يجب الإلحاح على أننا لا نصنع صنيع “ليش” الذي وضع تحليلا لبنية المقاطع فى الانجليزية ليصف على نحو شامل بنية الأنماط الشكلية المحتملة فى الشعر، لكننا نتذوق جمالياته الأسلوبية وانجازه النحوي فحسب.
- لأسلوب الإضافة فعالية كبيرة فى النص. ذلك أننا من بعض الوجوه إمام رواية من روايات الانتماء. لقد انهار بيت وفقد الأهل، أصبح فى حاجة إلى أن يكتشف عالما من العلاقات يندرج فيها. والإلحاح على أسلوبي الإضافة يجسد هذا الشعور، كأن الأشياء تحاول أن تتماسك.
والإضافة نحويا نوعان: إضافة غير محضة، وهى إضافة الاسم الذي يعمل عمل الفعل لمحمولة، كقولهم مررت بضارب زيد، فضارب هنا تعمل عمل يضرب، والمضاف إليه زيد هو المضروب. مثل هذه الإضافة امكانبة غير مستعملة فى الرواية لأنها تحتاج إلى فاعلية يفتقدها يوسف فى ظروفه.
والنوع الثاني الإضافة المحضة، وهى الشائعة، وتفيد عند النحاة التخصيص مثل رسالة شوق، أو التعريف مثل رسالة زيد.
ونستطيع أن نجد هذه الإضافة فى عنوان الرواية أيام يوسف المنسي. إضافة الأيام إلى العلم يوسف، وإضافته إلى العلم المنسي (هناك احتمال أخر له موضع قادم) يؤسسان شعورا مبكرا بالحاجة إلى الترابط. ومع أن الإضافة إلى علمين إلا إن يوسف يتساءل: “هل إنا نكرة؟”، بل أن اسمه عنده “بلا معنى ألبته”. إننا إمام إضافة مفرغة من دلالتي التعريف والتخصيص. والأيام ههنا ليست عظيمة كأيام العرب، إنها هنا فى هذا النسق شيء يوحى بالتعاقب البارد الخالي من الفعالية. ويقول يوسف عن المعلم محرز:
“يعشق لعبة الأنساب وتأصيل الأسماء ومعرفة كل صغيرة وكبيرة داخل بيوت الحارة”
وتأتى بنية العبارة على النحو التالي:
يعشق لعبة الأنساب..
= فعل بفاعل (غائب) + معول به + مضاف إليه
وتأصيل الأسماء..
= فعل بفاعل (غائب) + معطوف عليه + مضاف إليه
ومعرفة كل صغيرة..
= فعل بفاعل (غائب) + معطوف عليه المضاف إليه السابق
داخل بيوت الحارة..
= فعل بفاعل (غائب) = ظرف + مضاف إليه + مضاف إليه
فلإضافة ذات الحضور القوى تتسق مع لعبة الأنساب، وتأصيل الأسماء، والبحث عن الانتماء.
- وأسلوب “النعت” له فعاليته الكبيرة. وهو متصل بطبيعة الرواية، إنها رواية من روايات التعرف. لا التعرف الارسطى الذي “موضوعه الأشخاص”، وإنما التعرف على العالم والبيئة ونسق العلاقات الاجتماعية. ويشترك هذا التعرف الذي يعيد تنظيم الوعي مع التعرف الارسطى على الأشخاص فى أن كليهما “انتقال من الجهل إلى المعرفة يؤدى إلى الانتقال: إما من الكراهية إلى المحبة، أو من المحبة إلى الكراهية عند الأشخاص المقدر لهم السعادة أو الشقاوة. لكن الانتقال فى الرواية أكثر تعقيدا من ثنائيات وتبادليات الكراهية والمحبة، والسعادة والشقاوة. انه على اتصال بوجود الإنسان فى العالم وبالقوى المتحكمة فى هذا الوجود.
ونستطيع أن نستبدل بمصطلح الرواية التعرف مصطلح رواية التعلم الشائع فى النقد الادبى والذي ظهر مفهومه عند هيجل حين حديثه عن الرواية. لكن البطل فى الرواية خلافا لرواية التعلم لا يمارس تمردا واضحا على المجتمع قبل أن تدفعه التجارب إلى التعقل والخضوع. انه يبدو فى الرواية، خاصة قسميها الأولين، ينظر إلى العالم من قمقم الذات، نظرة اقرب إلى التعرف من التمرد.
وفى مثل هذا الموقف تصبح نعوت الأشياء نوعا من تحقيق المعرفة بها. وربما يصح أن نرى النعت نحويا فى عنوان الرواية، ذلك أن دلالة النسيان فى كلمة “المنسي” جزء من شفرة تحكم أسماء الأشخاص فى الرواية، وتقوم بتنميطهم. وكلمة المنسي بدلالتها النعتية تجعل يوسف نموذجا للقوى المهمشة فى الواقع . يعين على هذه النمذجة اسم الأب “عبدالواحد” المشتق من الواحدية فى الأسماء الحسنى، والمشتق من الوحدة والانفراد فى الدلالة المعجمية. ويعين عليها كذلك التناص الواضح بين يوسف فى الرواية الذي يرى نفسه ملقى فى جب، ويوسف النبي الذي طرحه إخوته فى البئر. وها هو يتعرض لصنوف من الإغراء، منها الإغراء الجنسي مع زوجة النجار، وينتهي إلى العمل فى نشاطات اقتصادية ملوثة، مما يجعل اليوسفين يتناقضين قدر ما يتماسان.
والدلالة النعتية للإعلام تظهر على نحو خاص فى الأشخاص الكثيرين الذين يظهرون فى مساكن الإيواء. شمروخ مثلا “مجهول المولد والأهل” (تذكر الإضافة والنسب) وهو يرى كل شيء وينقل الأخبار فى المساكن، فكأن كلمة شمروخ وهى تعنى العصا الكبيرة، تجعله يرى الأشياء واضحة من اعلي ولنسمع حيرم العضل يصف نفسه:
“المهم، إنا حيرم العضل ملك السلخانة. هباش عنبر3، اكبر العنابر، عنبر الأكابر وملوك السوق –عنبر الحكومة”
إنها طائفة من النعوت المسوقة مساق الإخبار ترسخ مفهوم القوة، وتستمد من شفرة المذبح، فلم يطلق عليه حيرم الحديد مثلا، لان العضل انسب. وكلمة حيرم قليلة الشيوع مما يساعد على الإيحاء بالنمطية. ومثل هذا فى أسماء أخرى كثيرة. لنرى تعرفه على أم وردة:
“تعرف على صوت أم وردة من بين الأصوات المقذوفة إلى إذنيه، نهض مسرعا يلقى نظرة عليها، وجدها منتصبة وسط حلقة من رجال المساكن، فى العقد الرابع من العمر، عيناها الحور أحاطتها بكحل اسود فازدادتا جمالا، شعرها الطويل مصبوغ بالحنة الحمراء وقد تركته على كتفيها ناعما مستقرا، اكسبها ثقة مع صوتها العالي الواضح القوى الواثق أيضا، بدت خفيفة الحركة باليد والحاجب، سريعة التفكير..”
موقف التعرف واضح فى الكلمة الأولى. والاسم المشهور به “أم وردة” اسم اضافى، فهي ذات حضور بيئة تنتسب إليها وتمارس فيها فعاليتها، ولا تبحث عن هوية ووجود مثل يوسف. والأوصاف فى الفقرة كثيرة بعضها يعرب نعتا، وبعضها له إعراب آخر مع تشبعه بالدلالة النعتية. الموقف سرديا هنا موقف نعتى إلى حد كبير، وذلك فى سياق محاولة يوسف أن يتعرف على العالم.
- ينبثق عن الموقف المعرفي ليوسف شيوع ظاهرة “التعريف”. ولقد اشرنا إلى
التعريف بالعم وما يحكم شفرة العلم من دلالة وتنميطية. يبقى التعريف ب “ال” .
نجد هذا الضرب من التعريف فى كلمة “المنسي” . ونجده فى عناوين الأقسام الأربعة.
القسم الأول: “الخريف الحزين”، القسم الثاني: “أطول أيام الخريف”، القسم الثالث: “الشتاء والربيع قد يأتيان معا”، القسم الرابع: “الصيف الساخن”. ومن الواضح أن الأسماء كلها معرفة، لأننا فى الحقيقة أمام رحلة معرفية للذات.
- الضمير له أثره فى بناء الخطاب القصصي فى الرواية. وإذا كان النحاة يقولون أن الضمير ما دل على غيبة أو الحضور فان ضميري الغيبة والحضور يتجاوران على نحو ملحوظ فى لغة السرد. لنقرا هذه الفقرة من مطلع الرواية:
“شق قصير فى حائط المنزل، تابعه يكبر طولا، عمقا، وعرضا. أخبرهم –الجيران وأباه- كان جوابهم: ليكون آيلا للسقوط.. لن نتركه، إلى أين المسير.. إن هلك نهلك معه، إن بقي سيبقى سترنا؟! وقتها لم يفهم يوسف سر رغبتهم الدينية –الجماعية- فى الهلاك!
ماذا على أن أقول؟
عن ميتة أبى.. احتواه الهلاك وهو فى المرحاض…”.
كان من الممكن تعريف الحائط بأداة التعريف، لكنه عرف بالإضافة إلى المنزل، لن المنزل يجسم العالم المفتقد الذي ينتسب إليه يوسف. وكان فى إمكان القارئ أن يستنتج من يعود عليهم الضمير هم قوله “أخبرهم” لكن عناية الأسلوب بهم العالم الانسانى جعلته يوظف البدل لغمر الضمير بمزيد من الضوء، فالكتابة ههنا تحاول أن تصنع العالم المجهول المهمش فى دائرة الضوء. وفى جوابهم عليه توحيد واضح بين مصير البيت ومصير البشر يتفق مع موقف الانتساب إلى العالم.
وفى “سترنا” ملمح اسلوبى، فالشائع أن يقال سيبقى سترا لنا، لكن إضافة الستر/ المنزل إلى ضمير الجماعة تحرك فى جماليات لإضافة دلالة الانتماء. وتقدم ظرف الزمان “وقتها” على الفعل “لم يفهم”، انحراف اسلوبى آخر يميز بين وقتين الأول خاص بلم يفهم، والأخر خاص بالرحلة المعرفية التي تبدأها الذات بالسؤال: “ماذا على أن أقول؟” ههنا تحول واضح من الإشارة إلى يوسف بضمير الغائب، إلى الإشارة إليه بضمير المتكلم الذي يستحضره ويستنطقه.
ويستطيع القارئ أن يلاحظ بنفسه الحضور الخصب للمزاوجة بين ضمير الغائب وضمير المتكلم الحاضر، وان يلاحظ أن هذه المزاوجة تنحسر مع القسم الثالث والرابع من الرواية حيث يعمل يوسف، والعمل يعنى الاندراج فى مصفوفة الواقع، والانضمام إليه –من موقع المشاركة لا التغير- وانتهاء التخبط بين دخول جب الذات (ضمير المتكلم) والخروج بالوعي إلى العالم (ضمير الغائب).. لكنه لم يكن خروجا موفقا.
6-يعالج علم النحو مشكلة الزمان فى ثلاثة أبواب: الأول والثاني منها هما الظروف واسم الزمان والمكان من المشتقات، وهما اقرب إلى ما نسميه بالزمن المعجمي. إما الثالث فهو الفعل، فالأفعال فى النحو يتلبسها الزمان ويصنفها إلى ماض وحاضر ومستقبل. ولا نستطيع أن نفصل الأفعال عن أدوات افصل والوصل فى الأنساق الأسلوبية للرواية الحالية.
إن الزمن النحوي فى أسلوب الرواية يمثل معادلة تجمع بين الزمان والفعل وبين الفصل والوصل. نقرا هذا فى النص التالي حيث يصف يوسف لحظات انهيار البيت:
“لحظتها ما كنت اشعر أنها لحظات الموت، كنت أفكر فيما يجب على أن افعله.. قررت الرقاد تحت السرير، وجدته أفضل بالرغم من الأرض الممزقة تحتي، تكورت داخل بطانية صوفيه، شعرت بالطمأنينة داخلها. قررت ألا أبول، أن اشرب دمعات عيني إن بكيت. قررت أن أصيح بأعلى صوتي على فترات منتظمة. لا أحفظ كثيرا من الآيات القرآنية، اكتفيت بالفاتحة والصمدية”
تقديم ظرف الزمان “لحظتها” يشبه تديم الظرف “وقتها” الذي مر بنا فى الفقرة الخامسة. انه تثبيت للحظة الصدمة التي يولد فيها الوعي. لذا انتفى الشعور، “ما كنت اشعر” وثبت التفكير: “كنت أفكر”. وموضوع التفكير هو الفعل الواجب لا الحر. الواقع يهاجمه وعليه أن يقوم برد الفعل ليحافظ على حياته. والفعل “قررت” يتكرر ليبرز شعور الذات بذاتها، وبالنشاط الذي بدأه يتكرر ليبرز شعور الذات بذاتها، وبالنشاط الذي بدأه الوعي. والطمأنينة التي شعر بها داخل البطانية زائفة طبعا بدليل الخوف الأحق بها من البول والدموع. هذا الزيف يمارس ما اسماه رولان بارت تفريغ العلامة ودفع موضوعها إلى الوراء. بإرادة خالية من الوعي بالعلامات السببية. ذلك أن بنية النص تجميعية مكانية وليست سببية رمانية. ومظهر هذا التجميع المكاني انتفاء أدوات الوصل . لنعد كتابة النص موصولا:
“لحظتها ما كنت اشعر أنها لحظات الموت، بل كنت أفكر فيما يجب على إن افعله، قررت الرقاد تحت السرير، الذي وجدته أفضل بالرغم من الأرض الممزقة تحتي. ثم تكورت.. الخ”
لا شك انه نص آخر بأدوات الوصل، إننا إمام وعى واضح ينسق علاقات الاشياء، وهذا يتنافى مع طبيعة وعى يوسف، ولو كان له هذا الوعي ما انتهى إلى ما انتهى إليه فى تكية المولودية.
7-يبقى لنا ما اسميه بالزمان المعجمي. وقد مر بنا انفا موضعان لتوظيف ظرفي الزمان، “وقتها” و”لحظتها” أسلوبيا. والواقع أن معجم الزمان ينهض بعبء كبير فى بنية الرواية، وبصفة خاصة معجم الفصول.
القسم الأول: “الخريف الحزين” يعالج سقوط البيت، وانفصال يوسف عن عالمه كانفصال الورقة عن شجرة الخريف، لتتلقاه ارض الواقع، فتصدمه بما فى الواقع من تشوهات أولها الشذوذ الجنسي بين عمال المخبز. يتلوها الفصل الأخير من القسم، وفى الفصول الستة عشر في القسم الثاني: “أطول أيام الخريف” مشاهد الحياة فى مساكن الإيواء بتشوهاتها العجيبة. لهذا الخريف بين عنواني القسمين.
أما القسم الثالث: “الشتاء والربيع قد يأتيان معا” ففيه يكف يوسف عن مراقبة العالم ويخرج إلى العمل، فيعمل طبالا وراء الراقصة سونه، وتقوده الظروف لإحياء فرح محبوبته “أمل” على شاب غيره، مما يدفعه إلى عالم المخدرات، حتى يمل ويهجر المساكن ليعيش مع نجار ترابيسك من ازدراء الناس عن مهنته لساد الذوق وبينما يعمل مساعدا للنجار تجتهد زوجة النجار فى غواء يوسف.، ويجتهد يوسف فى الرفض، حتى يكتشف النجار الأمر فيرجع يوسف إلى المساكن، ومن الصعب أن نميز الشتاء من الربيع فى هذا القسم، ولعل الربيع هو “أمل” ولعل الشتاء هو صدمته بزواجها.
أما القسم الرابع: “الصيف الساخن” فيعمل فيه يوسف مع أم وردة فى تهريب البضائع من بورسعيد، يقوم عنها وعن شخصية كبيرة تحمى أم وردة بشراء الملكية التي يملكها والد أمل لتحويلها إلى متجر لتوزيع البضائع المهربة. ونظرا لان أمل قد طلقت فلقد حاول معاودة العلاقة لكنها رفضته لان يوسف فقد نقاءه القديم. وينتهي الأمر به فى إحدى التكايا القديمة التي يدور فيه كالدرويش حتى يقع على الأرض بين الإغماء والموت. لعل الصيف هنا يشير إلى حرارة الصراع مع قوى الفساد بالفصل.
وتكمن الصعوبة ى تحديد دلالات الفصول فى أنها تتصدر عناوين الأقسام مع أن السرد لا يعنى بعناصر الطبيعة، ولا يذكر شيئا من مظاهر الفصول، مما يحيل إلى شردة رمزية تهيب بتحولات الوعي فى اكتشافاته داخل الواقع المهمش الذي يضئ إلى قوى خطيرة لا تراها العين مباشرة. وتمضى تحولات الوعي فى اقسم الأول فى حركة راسية تنتقل من عالم المخبز إلى عالم المساكن ولكنها تخلو من مشاركة الذات فى حركة الواقع- هذه الحركة الراسية المتنقلة من عالم إلى عالم، تملا القسم الثالث والرابع- لذا تتعادل هذه الأقسام.
هذه الكثرة من الفصول تصنع أمامنا الوعي غارقا فى تفاصيل الواقع، وهو أمر لا افلات منه إلا بالخروج إلى العمل.
ولما كان الزمان ههنا يؤسس النص ويحمل أعمدته فى الوقت الذي لا يعنى فيه السرد بمظاهر الزمان فى الطبيعة، فان النص يقوم بتفريغ العلامة من دلالاتها المعجمية المألوفة، ثم يقوم بتشفيرها مسقطا عليها دلالات الوعي الذي يتعرف على العالم، ويعجز أن يغيره ويعجز الاستمرار مشاركا فيه، أو الاستمرار فى قبول تشوهاته.
8- وما يحدث مع الزمان المعجمي يتفق مع إستراتيجية النص كمحاولة لتحقيق انجاز نحوى واسلوبى، يعيد توظيف أبنية اللغة، لخلق عالم لغوى واسلوبى، يشي بتوترات وتمزقات الوعي المعبر عن تشوهات الواقع، ويرفضها ويعجز عن تغيرها، ولا يملك إلا أن يظل واعيا، بل أن وعيه ليزداد رهافة وجدة ورفضا.
…………..
*نشرت الدراسة مرفقة بالرواية عام19990م