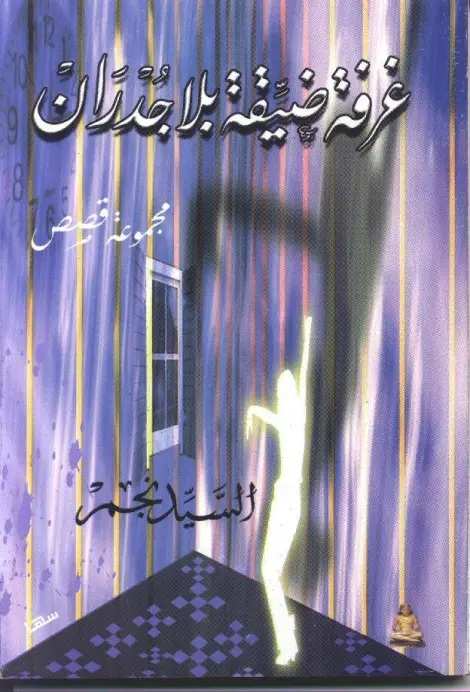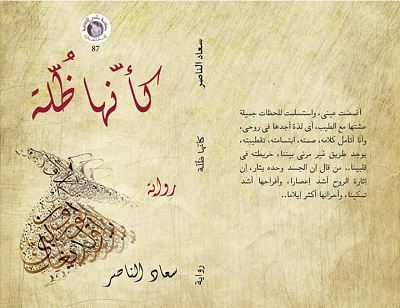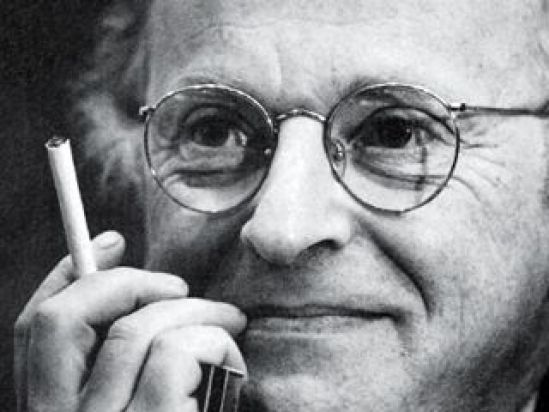تعاني الأمم في فترات بعينها من ضغوط مجتمعية، وأحداث جسام تلقي بظلها على كل شيء.. فمن المعاملات بين الناس، ووسط الأسرة الواحدة، إلى وتيرة الأخبار اليومية، إلى إحباطات العام وظلالها على الخاص.. تسير مصر منذ سبعة سنوات كاملة في ذلك الركاب الكئيب. لا شك أن تداعيات الأحداث منذ 2011 جنبت كل من ليس منوطاً بالعمل الصحافي أو السياسي، مشقة المتابعة الحتمية لكل حدث، فمن الناس من ألقى بعبء الانخراط بمشاعره خلف كل حدث، والتحيز بأفكاره مع أو ضد أي جديد، عن كاهله.. فصارت هموم الناس منحصرة في أعبائها اليومية، وصار الانصراف عن الشأن العام حلماً، وفي بعض الأحيان ضرورة.. الأدب جزء من الحياة، وصناعه يعيشون وسط خضم أمواجها، لذا كان من الصعب التأثر بتلك الأمواج أن ينتج أدباً من ذلك النوع الذي يؤثر، بل ربما صار حلم كل مؤلف أن يتأثر قلمه بزخم الأحداث ورحيقها من مشاعر وشجون، ولا يبين عليه.. ربما لعلة في طرح الواقع بقبحه، وربما لانغلاق قلوب القراء عن متابعة الواقع الذي تهرب منه مرة اخرى في شكل رواية..
ربما يكون ذلك الطرح أكثر طرح مكروه لدى أي كاتب، أن يتم الربط بين شخوصه وعوالمه التي ابتدعها على الورق، وبين حياته التي عاشها وأحداث احتوته.. لكن العذر هنا قد يكون أن “همام” يعبر، دون أن نشعر، عن أحداث وعوالم وتداعيات عالم نعيشه، ويعيشنا.. كل يوم، ببراعة مؤلف ينجح برغم كآبة الواقع في الهروب منه، دون أن تلمس ظلال ذلك الواقع في سطوره، ودون أن تنفصل تلك السطورـ في نفس الوقت ـ عن تلك الظلال..وهذا هو بيت القصيد..
عندما يواجهك “همام” بتلك الشعوب الخيالية، “حراصيد” في حجم الفئران، و”أباشير” في مروءة الأسود، و”عماليق” بقلوب أطفال، وجزيرة تسمى “اللابوريا”، وبطل يولف الخلطات ويبذل المجهود المضني لتصنيع خلطة جديدة من المكيفات أو المخدرات، بعد أن قطع الحاكم، الذي ينعته همام بالديكتاتور هنا، كل المكيفات والحشيش وأشباهه عن أيدي الناس.. عندما يواجهك بكل هذا، تسأل نفسك السؤال اول: هل نحن هنا بإزاء أدب يهرب من الواقع، لأنه يأس منه؟.. الإجابة تظل حائرة طول صفحات الرواية، لأسباب عديدة لكن أهمها هو ما يغشاها من سؤال ثانٍ: هل يقع الكاتب في فخ الإسقاط الواضح، فلا تصبح الرواية رحلة للإبحار في محيط هادر من الخيال الملون البديع، بل مجرد رواية هربت من السياسة وظلالها، لتسقط في فخ التلميح والتصريح؟
ظللت طوال صفحات الرواية أجاهد ألا تفسد علي الفكرتان استمتاعي بسلاسة السرد، واتصال الأحداث، ولم يعب الرواية إلا بساطة التصوير المكاني في مواضع عديدة، الذي تفادى فيه “همام” المحددات البصرية والوصفية، ربما حرصاً منه على تحفيزالقاريء أن يخلق من تفاصيل بسيطة خياله الخاص.. لكن هذا لم يمنع أن “أحمد مجدي همام” قد جر قارئه لوجبة دسمة، بدأت بداية عابثة تجذبك لأن تعرف ما وراءها.. وفي النهاية ينجح بإبهارك بقوة الحدوتة، وبساطة الحبكة..
على أن الرواية لا تسقط في ذلك الفخ مطلقاً، وهو فخ الإسقاط.. حتى مع إغراءات الحدوتة، وسلاسة ولباقة الحبكة.. ومحاولتي كقارئ تلبس ثوب المشاغب أن ألعب لعبة التأطير مع شخصياتها وشعوبها، فمن تظنهم رمز لشعوب عربية، لا يكونون كذلك في النهاية، وريثما تستقر على أن العماليق مثلاً، هم الروس أو الاسكندنافيين، حتى تتخلى عن فكرتك لضعف خيوطها مقابل قوة ومتانة نسج المؤلف.. حتى تضع سلاحك في النصف الثاني منها وأنت مطمئن أنك أمام متعة خالصة، وليس طبق شهي، يهديك رائحة زكية، وتلسعك برودته عندما تقضم أولى قضماتك منه مطمئناً..
على أنك لا تفهم، شأن الأعمال العظيمة، إلا مع آخر صفحات الرواية.. فـ “مليجي الصغير” يقرر أن يذهب لأخر مدى في جزيرة اللابوريا، حتى يصل لجمهورية الكابوريا، أو أرض كل الخلق، التي لا تفرق بين شخص وآخر ويعيش فيها كل الخلق في سلام. حلم لا يتفق مع شخصية عابثة “حشاشة” مثل “مليجي”.. يخطر ببالك فجأة أنك لا تعرف عن “مليجي” الكثير، ويدور بخلدك أن حلم كهذا كبير على أحلامه الضيقة، التي لم تنحصر فيما علمنا عنه إلا في نوع الصنف القادم، ونوع “الدماغ” التي يبغي أن تغلف وعيه فتغيب به لعوالم وأحلام تحمله لسعادة زائفة.. ثم يداهمك السؤال فجأة: لماذا بحث “مليجي” عن جمهورية “الكابوريا”؟ ماذا شهدت يا “مليجي”، يا من انحصرت أحلامك في جذبة نفس مغموس في الجنون، وشهقة انبهار بالخيال.. ماذا رأيت بحياتك، حتى تقودك خيالاتك لشعوب غريبة، تدور بينها صراعات لا تفهمها، ولا تهمك في شيء، بينما تتمحور حياتك وأفكارك كلها حول البقاء، والهرب من الآتون، من صراعات الفراغيين والظهوريين، ومن دهس العماليق، وتفقد في الطريق أحبابك، وحلفاءك، وأنت في النهاية لم تفهم ماذا جاء بك إلى هنا، وماذا ينتظرك في الغد؟ ثم ما الذي عانيته من الخلق، حتى تحلم بأرض هي لـ”كل الخلق”؟
ثم ماذا تعني نهاية رحلتك، وماذا نفهم من عودتك؟ ما الذي ينتظرنا إن سعينا لبلاد كل الخلق، وهل تستحقنا أو نستحقها، ونحن مثل “مليجي” الباحثون عن المتعة لتغييب وعينا، عن الحادثات المكئبات، وعن خيبات الأمل ووعث الحياة؟
الوصفة رقم 7، عمل عظيم لكاتب عظيم، مرهف الحس والوجدان، نجح وجدانه البديع أن يترجم مشاعره دون أن يخوض بأسبابها، ودون أن يغرقنا في تفاصيل سئمناها، ليخرج عملاً يحقق المتعة التي يفتقدها كل قارئ للأدب، والتي من أجلها تقتنى الأعمال وتقام لها الاحتفاءات.