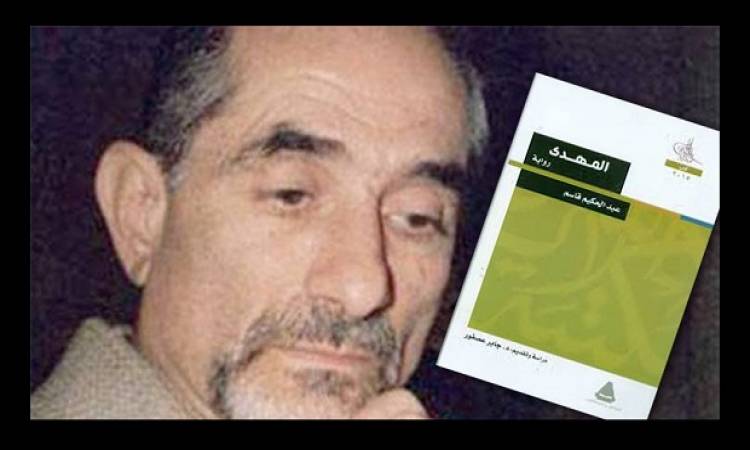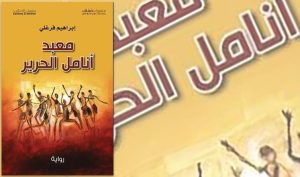جمال الطيب
رواية “المهدي” للكاتب والروائي الراحل “عبد الحكيم قاسم” (1935- 1990)، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب- مكتبة الأسرة – سلسلة “أدب” – عام 2015, رواية تتفجّر الإنسانية من جنبات حروفها.. تدفعك إلى التعاطف مع هذه العائلة القبطية في النكبة التي أحلّت بها، وعلى الجانب الآخر تُشعِرك بالمقت والكراهية لهؤلاء أصحاب الفكر المتخلّف، ومحاولاتهم للسيطرة والهيمنة، لفرض هذا الفكر بالارهاب والقتل وسفك الدماء.
إرهاب السبعينيات والثمانينيات في مصر.
جاءت كتابة الرواية، بعد الأحداث التي كانت تشهدها مصر خلال تلك الفترة: عملية “كلية الفنية العسكرية” عام 1974 بمهاجمة حرس البوابة والاستيلاء على مخازن السلاح، ولكن انتهت خطتهم بالفشل، وكان عدد الضحايا في هذا الحادث 24 قتيلًا من المهاجمين و65 جريحًا من الحراس، وتم الحكم على صالح سرية، طلال الانصاري وكارم الأناضولي بالإعدام شنقًا، ومعاقبة قيادات التنظيم الأخرى بالأشغال الشاقة، وبراءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت الأدلة ولصغر سنهم، تنظيم “التكفير والهجرة” عام 1975 بقيادة “شكري مصطفى” الذي أعلن الجهاد ضد النظام الحاكم وضرورة تغييره بالقوة والقضاء عليه لتعارضه مع الشريعة الاسلامية، وقتلهم “للشيخ الذهبي” عام 1977، وبتاريخ 30/ 11/ 1977 أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بإعدام شكري أحمد مصطفى، ماهر عبد العزيز بكري، محمد عبد المقصود السيد غازي وأحمد طارق عبد العليم “ضابط شرطة”, كما أصدرت أحكامًا على باقي المتهمين من أعضاء التنظيم تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن، وأخيرًا تنظيم “الفريضة الغائبة” بقيادة محمد عبد السلام فرج والذي نادى بتكفير الحاكم وقيام الدولة الاسلامية كنواة للخلافة الاسلامية، لكن الصدفة هيأت للتنظيم الفرصة لاغتيال السادات عندما اشترك الملازم أول خالد الاسلامبولي في طابور العرض العسكري يوم 6 أكتوبر1981، ليسقط بعدها كل أعضاء التنظيم في يد الأمن، ولكن عاد الجهاديون تحت اسم جديد هو “الجماعة الاسلامية”، تعتنق نفس الفكر حول تكفير المجتمع، وتعطي لهم سببًا ودافعًا نفسيًا وغطاءًا فكريًا لارتكاب القتل والارهاب باسم الدين.
الفقر والجهل.
من خلال الرواية نتبين المناخ والأرضية اللذين تترعرع فيهما أفكار هذه الجماعة، فالفقر والجهل هما ركيزتهما لنشرها، بل تُلقِي الرواية الضوء أيضًا على قادة هذه الجماعة الذين يطغى عليهم الجهل والسطحية من خلال شخصية “طلعت مشرقي” وكيل شعبة الإخوان بقرية “محلة الجياد” التي تدور فيها أحداثها، والذي تعمّد المؤلف/ الراوي الإسهاب في وصف قدراته الذهنية من خلال تحصيله العلمي في المدرسة، وقدراته الجسمانية، ليضع أمامنا صورته كاملة، فيقول عنه على لسان “عبد العزيز” ذلك الشاب المستنير الذي زامله في مدرسة “طنطا الثانوية”، وفي حلقات الإخوان المسلمين وقت انضمامه إليها، ورفضه كما سنتبين من خلال السرد لمحاولات جماعة الإخوان إرغام المعلم “عوض الله القبطي” الدخول في الإسلام وعدم مشاركته في هذا القمع، ومبادرته بمغادرة البلدة، فيقول: “هائل الطول عريض الكتفين، يتأتئ، ولا يفتح الله عليه بشئ، وربما لأن “طلعت” على هذا القدر من الضخامة استشاط المدرس غضبًا وصفعه صفعةً هائلةً على وجهه”، ويواصل في سرد تفاصيله الجسمانية، فيقول عنها: “رأسه مبططة كأنها قرص قائم بين كتفيه، وعرف كذلك أنه مصاب باعوجاج فى الحاجز الأفقي ويتنفس من فمه دائمًا، وربما يغير هذا طعم ريقه أو يجفف حلقه فتراه دائمًا يمصمص فمه بصوت مسموع، ولحم أسنانه يدمى بلا انقطاع ويجعل هذا ابتسامته مقززةً، ولكنه طيب وفيه شئٌ من البلاهة”، ويكشف العم “على أفندي” الموظف بالمجلس القروي جانب من شخصيته يتعلق بنشأته، مخاطبًا ابن أخيه “عبد العزيز”: “رزيل منه أن يحاول الانتساب إلى أسرة مشرقي، وما سمى أبوه مشرقيًا إلا زلفى إليها، وهو من عائلة أبو حبة الصغيرة الهزيلة، والأب مدرس قليل الشأن فى المدرسة الالزامية”.
المعلم عوض الله القبطي صانع الشماسي.
فما أُبتليَّ به “المعلم عوض الله القبطي” الشخصية المحورية في الرواية، على أيدي جماعة الإخوان المسلمين في بلدة “محلة الجياد” التابعة لمدينة “طنطا”، بعد أن حطّ الرِحال في هذه البلدة بعد رحلات متوالية، بدأها من “ميت غمر” مرورًا بـــــ “طنطا”، دفعه إليها ضيق الرزق، مازالت تدور مثيلاتها في واقعنا الحاضر لإخوته من المسيحيين في القرى التي أوقعها حظها العاثر في قبضة هؤلاء “الداعشيين”، ولم يلتفت لمقولة زوجته “فلة” أثناء رحلة المسير، حين خاطبته في رجاء وانكسار، هامسة: “لننشد كَفْرًا مسيحيًا يا عوض الله.. فيه كنيسة وراع صالح”. وبإيماءة منها تتكثف فيها حالة الخوف والرعب والتوجس من المجهول “وتلفتت فلة حولها ثم رسمت بعجلة صليبًا على صدرها”، ليقع في براثن جماعة الإخوان المسلمين هناك والذين تعاملوا معه كأهل الذمة الذين يجب هدايتهم ودخولهم في الإسلام! يعيش عوض الله وأسرته في حالة قلق وفزع، وعدم إرتياحهم لمكوثهم في منزل العم “علي أفندي” بعد استضافته لهم، وتوجسهم من شر قادم. كل معاني الشفقة والحزن تلمع في عيون الزوجة “فلة” وهي تراقب الحالة التي آل إليها زوجها.. الصمت والسكون يهيمنان على أجواء الغرفة.. حزن وإنكسار يرسمان ملامح الزوج؛ الحيرة والقلق تروح وتجيء بينهما.. حالة من الترقب تكاد تفتك بالزوجين تشكّل صورة قاتمة إطارها يتّشح بالسواد، يقول “عبد الحكيم قاسم” عن معالمها: “وتنهض فلة، تجلس في مكان رقادها تلملم ملابسها السوداء، تحبكها على أقدامها وعلى رأسها، ترافق زوجها من تحت أجفانها بنظرات مشفقة، إنه يزداد هزالًا كل يوم، ويزداد وجهه امتقاعًا وتتسع مقلتا عينيه، تراه فلة الآن، تعرف عظامه تحت جلبابه وفى أكمامه، وتضوي كمدًا”.
جهامة الإخوان وغلظتهم.
ينتقل “المعلم عوض الله” وأسرته إلى دار “فكيهة” التي آلت إلى العمدة “مشرقي بك” بعد وفاتها، بطريق المزاد العلني الذي لم يشارك فيه سواه! وكانت تبريرات “طلعت مشرقي” للعمدة بشأن المأوى أو المسكن المطلوب للعائلية القبطية، تفضح أسلوب الفكر التنظيمي للإخوان، فيقول: “ولقد اهتمت الشعبة بالرجل، فالمسلمون مأمورون بالحدب على أهل الذمّة وأن يستألفوا قلوبهم للاسلام”.، ولكن العمدة يحمل الكثير من المعاني والمشاعر بداخله تجاه ألاعيب ومَكر هؤلاء الإخوان، فقال في نفسه: “قبطي صانع شماسي.. رجل من أهل الذمة يراد تأليف قلبه للاسلام.. الشعبة والمجلس القروي والبلدة جميعها.. أي فأر سقط من السقف.. يلهون به حتى ينفث الدم من أنفه.. أو يلبسونه رداء الجوالة ويسوقونه عاري الركبتين.. هاتفًا الله أكبر”. بعد الانتهاء من نقل متاعهم وحاجياتهم، يقول طلعت مخاطبًا عوض الله وفلة: “تلك هي داركم الجديدة، نرجو أن يبارك الله لكم فيها، الآن سوف نمضي ونترككم في حالكم، لكننا قبل أن نمضي نقدم لكم باسم الإخوان المسلمين في محلة الجياد هدية، ألا وهي كتاب الله.. أرجو أن تتقبلوها بقبول حسن”. يتجمع أهالي البلدة من رجال ونساء وأطفال في مسيرة بغرض الاحتفال بإشهار إسلام “عوض الله”، والمشاركة في المراسم المصاحبة للإشهار بالمسجد الجامع، وانعقاد مؤتمر كبير يشهده أهالي البلد بما يليق بهذا الحدث الجلل الذي لم يكن جديدًا عليها!
الانفعالات الداخلية للمعلم عوض.
يسير المعلم “عوض الله” وسط هذه الجموع بين شابين من الإخوان يسوقانه الي المسجد وسط هذا الحشد الهائل، كمتهم يساق لتنفيذ حكم إعدامه، تدور في رأسه الهواجس من المصير القاتم الذي ينتظره دون إرادة أو رغبة منه، عيناه زائغتان تحدق فيما وراء الحجب، يشاهد مراسم العزاء التي ستقام في الكنيسة، والوجوه التي يكسوها الحزن والعيون التي تذرف الدموع، تندب فراقه، يناجي ربه أن ينقذه ويأخذ بيده وينتشله من الكابوس الذي ينتظره، كل هذه الصور والأخيله يراها وكأنها تحدث أمامه، يبرع المؤلف/ الراوي في نقل تفاصيلها، فيقول: “إيها الرب، قد أتت الساعةُ، مجّد ابنك، ليمجّدك ابنك أيضًا”. هكذا صرخ المعلم بصوت عظيم لم يسمعه أحد من الذين دخلوا عليه وهو واقف في فناء الدار عاري الرأس، عاري الصدر في ثوب نومه الخلق البسيط، ووجهه محمر بالحمى، وعلى جانبي فمه زبد أبيض، عيناه نصف مغمضتين، لا تريان طلعت ومعه رهط من شبان الأخوان المسلمين يدفعون الباب داخلين”. ثم يواصل في نقل الهواجس والانفعالات التي تدور داخل المعلم “عوض الله”: “هكذا بصوت عظيم يرن في داخله ولا يبرح شفتيه يجاوب المعلم بكاء الشعب في الكنيسة، وزوجته “فلة” واقفة في ركن الفناء، قد عصبت رأسها بمنديل أسود وكفاها متحاضنان على صدرها، وعيناها ناكستان وعلى جانبيها “لوزة” و”حنتس”، تتعلق نظراتهما بقدمي المعلم العاريتين”.، بهذا المشهد العبقري للمبدع الراحل “عبد الحكيم قاسم”، واستعارته للإصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا: “وضفر العسكر إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه، وألبسوه ثوب أرجوان”.، والتي تقول التفاسير لهذا الأصحاح: “كنا نظن أنه حتى قلب الحجر يلين من مشاهدة إنسان برئ مظلومًا ومضروبًا بلا سبب”.
لحظات ما قبل النهاية.
تقترب النهاية والمعلم “عوض الله” يساق وسط هذا الجمع، ولكنه يجول بمخيلته هناك إلى ما وراء الغيب، حيث تقام له مراسم العزاء في كنيسته في كفر سليمان يوسف، فهناك نهايته وسط جموع أهله ومحبيه، وهم يذرفون الدموع حزنًا عليه وعلى فراقه الذي أحدثه الموت… “وتقدم الثلاثة وأحاطوا بالمحموم الذي أسلمهم جسده دون أدنى معارضة وهو يرتعد ارتعادًا خفيفًا، وشفتاه تتحركان بذلك الصراخ العظيم الذي يرتد إلى داخله ولا يسمعه من الذين حوله أحد، وخلف أجفانه المشاهد الحزينة من كنيسة كفر سليمان يوسف، والأب اندراوس البهيدي يقود القداس وعم رزق الله شماس الكنيسة يجاوبه وسط بكاء الشعب في بهو الكنيسة المجلّل بالسواد وصور القديسين”. وينقلنا المؤلف/ الراوي إلى المشهد كما هو وارد بالإصحاح الثامن عشر: “ثم أن الجند والقائد وخدّام اليهود قبضوا على يسوع ومضوا به”، ليقوم بعمل تزاوج بين الحالتين، يستحضر فيه مشهد “يسوع المسيح” وهو يُقاد إلى الخشبة حيث سيصلب، وسط تهاليل وصراخ اليهود فرحًا وسعادة بصلبه والتخلص منه، ويعلو صوته وهو يقترب من إسدال الستار، معلنًا نهاية الرواية، وتزدحم الصورة بأهالي القرية وهم في حالة من البهجة والصخب.. مهللين مكبرين بإسلام المعلم “عوض الله القبطي” ليتحول لقبه الذي يحمله طوال السنين التي مضت من عمره إلى “المهدي”! وينقل إلينا هذه الصورة، ويسردها بحرفية، قائلاً: “… الموكب يقترب من الجامع، يزداد الصراخ من مكّبرات الصوت انفعالًا، تزداد قرعات الطبول عنفًا، يزداد وقع أقدام الجوالة في الأحذية الرثة حماسًا، والناس المحيطون بالمعلم يزدادون كثافةً والشمس تدق مسامير محمّاة بالنار في جبين المعلم، يترنح على الفرس، وإذ ينزلونَه عند باب المسجد ينكفيء على وجهه فاقد الوعي تمامًا، وكالنار في الهشيم تنطلق في الناس صرخة.. “لقد مات المهدي”، والناس حوله يجلسونه على الأرض يهزونه ويربتون على صدغيه دون جدوى، وحلقة الأجساد الحامية للمعلم تكاد تصدع، لكن فجأة يجدون “فلة” قد تسللت من وسط هذه الجموع وألقت بنفسها على المهدي، أخذته على صدرها، وفي لحظة كأنما غرق هدير الجماهير في بئر ليس لها قاع، صمت يطن بعمق والناس ترى فلة تأخذ المعلم إلى صدرها وتصلي بحرقة:
– باسم الرب يسوع المسيح.
وترسم على صدرها علامةَّ الصليب”، ولكن هذه المرة أمام الجموع الحاشدة من أهل البلدة دون خوف أو وجل .. متحدية. برع الراحل “عبد الحكيم قاسم” من خلال الرواية في خلخلة وتشريح فكر هذه الجماعة الارهابية، التي تتواري خلف الدين كوسيلة لتحقيق أهدافها في السيطرة والاستيلاء على الحكم، لتطبيق هاجس “الخلافة الاسلامية”! في لغة رصينة عميقة الدلالات، وفي سرد متدفق، وصور ومشاهد عامرة بالتفاصيل الدقيقة، لتتحول عبر كلماته وأسلوبه المتفرّد إلى لوحات فنية.