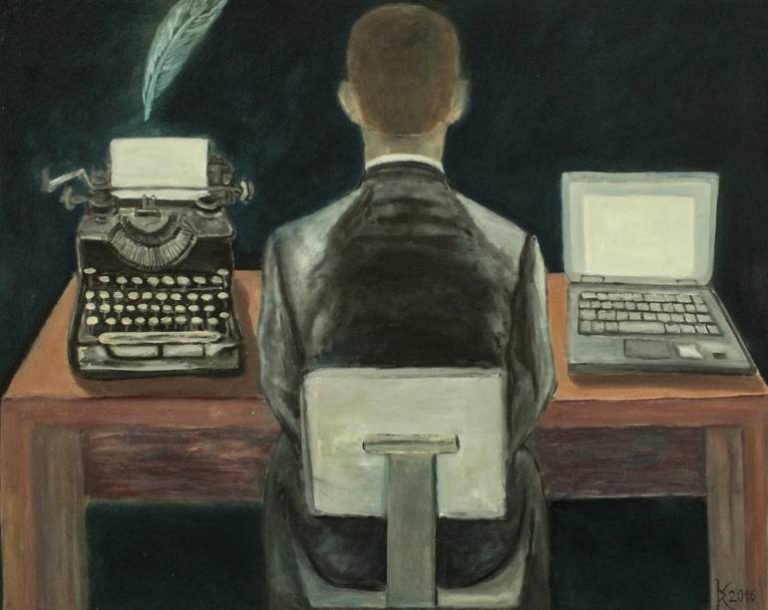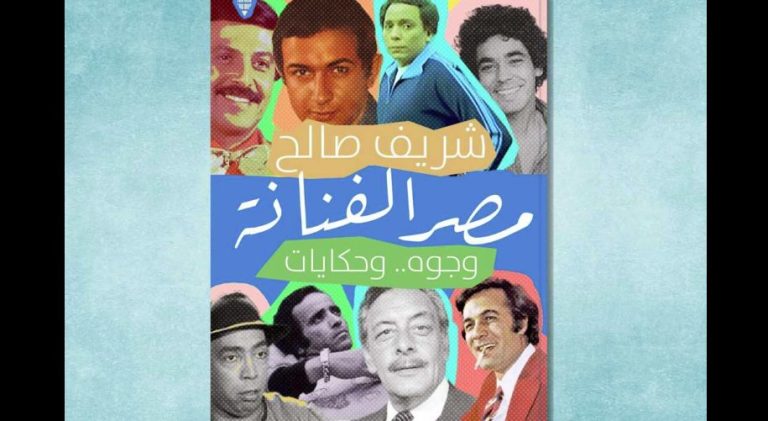د . مصطفى النشار – رئيس الجمعية الفلسفية المصرية
فى هذا البستان رحلة ممتعة إلى الماضى السحيق، إلى عظمة الحضارة الفرعونية، وكيف تأسست فيها، عبر مئات السنين، دولة مصرية قوية تقوم على الحق والعدل ونصرة المظلوم، ويخدم فى بلاطها الملوكُ شعبهم ولا يتجبرون عليه. دولة عرفت الفلسفة قبل اليونانيين، ووضعت مواثيق لحقوق الإنسان تشبه إلى حد بعيد مواثيق الأمم المتحدة فى عصرنا.
أولا: قضية أصل الفلسفة:
أعجب مما لا يزال يتردد من كُتّاب تاريخ الفلسفة الذين لا يزالون مصرين على ترديد ما درج عليه الحال فيما يتعلق بأصل الفلسفة، ذلك الأصل الذى يردونه دائمًا إلى بلاد اليونان محتجين عادة بأن كلمة الفلسفة تعود فى اصطلاحها الأول إلى كلمة يونانية من مقطعين هى Philo-Sophia. ولما كانت الفلسفة بهذا المعنى الأصلى تعنى محبة الحكمة، وكانت الحكمة تعنى آنذاك كل ما يمكن للمرء أن يتوصل إليه من آراء وأفكار واختراعات جديدة، فقد أضحت الفلسفة منذ ذلك الحين أمَّ العلوم ولم يكن ثمة فصلاً يذكر بين مجالها الخاص ومجال العلوم الأخرى. ومن هنا سرت المقولة الشائعة بأن الفلسفة والعلم اختراعان يونانيان، وأن الفلسفة نشأت كمعجزة (أى على غير مثال سابق) عند اليونان منذ طاليس فى القرن السادس قبل الميلاد.
والحقيقة التى أود أن أنبه إليها أن هذه المقولة التى ترد الفلسفة والعلم إلى اليونان وتعتبرها معجزة يونانية هى من قبيل الخرافات التى تروج لها الكتابات الغربية العنصرية التى لا تريد أن تعترف للأمم الأخرى بأى إنجاز حضارى حقيقى! وقد سار المؤرخ العربى عادة على درب المؤرخ الغربى فى النظر إلى الفلسفة على أنها معجزة يونانية وأن اليونانيين اخترعوها على غير مثال سابق، وهذا خطأ شائع تكذبه الدراسات المعاصرة المحايدة حول هذا الموضوع كما تؤكده كتابات المؤرخين والفلاسفة اليونانيين القدامى أنفسهم! فبالإضافة إلى ما هو معروف من تأكيدات لهؤلاء الفلاسفة القدامى عن زيارتهم لبلدان الشرق القديم، خاصة مصر والاستفادة منها والتعلم على يد حكمائها ومعلميها، وبالإضافة إلى كتابات المؤرخين اليونان القدامى وعلى رأسهم هيرودوت الذى أفرد فى تأريخه قسمًا كبيرًا لتوضيح التأثير المصرى غير المحدود على الفلسفة والديانات والعلوم اليونانية.
أقول بالإضافة إلى كل ما هو معروف فى هذا الشأن وأكده سارتون فى تأريخه للعلم وول ديورانت فى روايته لقصة الحضارة وغيرها، أقول: إننى اكتشفت أن أفلاطون قد أكد فى محاورة «قراطيلوس» أن أصل كلمة Sophia غير يونانى، وأنها من أصل أجنبى. وقد كشف مارتن برنال فى كتابه «آثينا السوداء» عن أن أصل هذه الكلمة مصرى، فهى تعود إلى لفظة هيروغليفية هى sb3 التى تعنى يعلم تعليمًا ونقلت إلى اليونان وحرفت لتصبح Sophia.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن أول من أطلق كلمة فيلو سوفيا فى اليونان هو فيثاغورس الفيلسوف والعالم اليونانى الشهير حينما سئل: هل أنت حكيم؟ فرد قائلاً: الحكيم هو الإله، أما أنا فمحب للحكمة! وعرفنا أن فيثاغورس قد قال ذلك متأثرًا بتعليمه فى مصر القديمة – حسب المكتشفات الأثارية الحديثة وروايات المؤرخين القدامى – لأكثر من عشرين عامًا. ذلك التعليم الذى كان يرد العلم فيه إلى الإله وينسب فيه كل شىء إلى الملك – الإله.
أقول إذا ما عرفنا ذلك وأضفناه إلى ما قاله أفلاطون قديمًا وأكده برنال – رغم عدم قراءته لهذه المحاورة الأفلاطونية – بدراساته اللغوية حديثًا لأدركنا بكثير من اليقين أن الـ Sophia أى الحكمة أو ما ندعوه بالعربية الفلسفة هو إبداع مصرى قديم نقل إلى بلاد اليونان عبر العلاقات الثقافية والصلات الحضارية التى كانت بين بلاد اليونان حديثة العهد بالفكر والعلم وبين الحضارة المصرية بكل عراقتها وأصالتها اللامحدودة فى مجال الإبداع الحضارى بكافة صوره وأشكاله.
ثانيا: قضية تفسير الوجود والألوهية فى الفلسفة المصرية القديمة:
إن البحث عن مبدع لهذا الوجود وأصل له بدأ بلا شك منذ بداية الخليقة، فقد فطر الإنسان على التساؤل وكانت أولى تساؤلاته عن هذا الوجود الإلهى. وقد تراوحت إجابات الإنسان على هذا التساؤل بين الإجابات المغلفة بالأساطير والأسرار وبين الإجابات المشفوعة بالأدلة العقلية والبراهين، والكثير من هذه الإجابات كانت بمثابة حدوس للإيمان بإله واحد أبدع هذا الوجود دون حاجة لمادة سابقة.
وليس صحيحًا تمامًا ما جرت عليه عادة الكثير من الباحثين حول الألوهية من أن «الإنسان قد ترقى فى العقائد، كما ترقى فى العلوم والصناعات، فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته». وقد دللوا على ذلك – «بالمشاهدات التى أحصاها علماء المقابلة والاجتماع» حيث «تتوافى كلها إلى نتيجة يجمعون عليها وهى أن الإيمان بالأرواح شائع فى جميع الأمم البدائية، وأن الأمم التى جاوزت هذا الطور إلى أطوار الحضارة وإقامة الدولة لا تخلو من مظاهر العبادة الطبيعية، وعبادة الكواكب على الخصوص، وأن عبادة الأسلاف تتخلل هذه الأطوار المتتابعة على أنماط تناسب كل طور منها حسب نصيبه من العلم والمدنية، أما التوحيد فهو نهاية تلك الأطوار كافة فى جميع الحضارات الكبرى، فكل حضارة منها آمنت بإله يعلو على الآلهة قدرا وقدرة وينفرد بالجلالة بين أرباب تتضاءل وتخفت حتى تزول أو تحتفظ ببقائها فى زمرة الملائكة التى تحف بعرش الإله الأعلى».
وليس أدل على ذلك من أنه مع بزوغ أول حضارة بشرية فى الوجود وهى الحضارة المصرية القديمة كانت كل هذه الصور للعقيدة موجودة فى آن معا، حيث إنه كان هناك ذلك الظن السائد بأن التوحيد الإلهى لم يظهر فى مصر إلا فى عهد ملكها الفيلسوف أخناتون فيما بين عامى 1369- 1353 ق. م. ولكن الحقيقة التى أثبتتها الدراسات العلمية والأثارية «أن التوحيد ظهر فى مصر منذ زمن قديم جدا منذ حوالى10500 عام قبل الميلاد وأنه كان توحيدا مفاده أن الله يتجلى فى كل شىء. إن المفهوم الصحيح للمعتقد المصرى منذ تفتح وجه التاريخ وأشرق نور العقل أن الإله واحد لا شريك له، خالق كل شىء، وأنه هو الله منذ البدء ولم يكن يوجد شىء، وهو الواحد الأزلى وأن الله هو الأبدية، وهو خفى لا يستطيع أحد أن يتصوره أو يبحث عن شكله، وأن أسماء الله بلا عدد ولا نهاية؛ وأن الله هو الحق، والله هو الحياة، والله لم يولد قط، وأن الله يخلق ولم يُخلق، والله هو الخالق لكل ما وجد فى العالم وما يوجد فيه وما سوف يوجد، وأن الله مد السماوات وأنشأ الأرض، وأنه إذا صدر من الله كلمة تحققت فورا (أو كانت فى التو)، وأن الله رحيم بهؤلاء الذين يقدرونه وأن الله يعرف من يعرفه، وأن الله يكافئ من يخدمه، وأن الله يحمى من يتبعه (أى يتبع طريقه ويسير على منهاجه) الله هو الأب والأم إلى آخر ذلك من معان راقية.. وعلى مدى التاريخ المصرى كله، وقد نفضت مصر أغلب آثارها، لم يظهر تمثال واحد للإله الأعظم، إنما كانت التماثيل للملوك والناس والرموز ولم يكن ثمة تمثال واحد للإله الذى آمنوا بأن لا شكل له ولا صورة ولا هيئة وأنه لا يمكن لأى إنسان أن يتصوره».
إن هذه الصورة التوحيدية للعقيدة المصرية منذ فجر التاريخ بدت فى كل المذاهب التأليهية فى مصر القديمة، وهذا ما ستوضحه التفاصيل التالية.
إن أقدم صورة للتأليه فى مصر قدمها مفكرو مدينة أون أو مدينة الشمس هليوبوليس القديمة حيث يرجع هذا المذهب إلى حوالى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد حيث الإيمان بالإله أتوم بوحدانيته على رأس التاسوع الإلهى الذى عنه صدر كل الوجود بما فيه من عوالم وكائنات حية وجماد. انظر إلى ما ورد فى كتاب الموتى معبرا عن ذلك المذهب فى حوالى 2000 قبل الميلاد: إن الإله «أتوم» فى شروقه (الواحد الوحيد) أتيت إلى الوجود فى «نون».. أى «رع» الذى نهض فى البدء وحكم، قد صنع.. إن الإله العظيم الذى أولد نفسه.. إنى أنا هو فى الصدارة من الآلهة..»
وجاء فى نفس السياق وإن كان ذلك بصورة فيها ما يشبه الحدس الإعجازى فى هذه الفترة السحيقة من تاريخ العالم، ما يسمى بالمذهب المنفى الذى أكد فيه مفكرو مدينة منف أن الإله الخالق «بتاح» هو الذى فكر ودبر قبل أن يخلق ويعمر وأنه قد شمل الكون برعايته ورسم لكل ما فى الوجود قدره. إنه كان العقل المقدس الذى فكر ونطق فكان الوجود وكانت الموجودات. انظر إلى هذا النص المنفى البديع: «وهكذا إنما هو فى الأصل قلب (أو عقل) أرسل الأرباب جميعا وإنما هو كان لسان أزلى جرى على ترديد ما قدره الفؤاد.. فعن طريق «الفكر» إذن و«النطق» من بعده بدأ الخلق، فخلق الأرباب جميعا وأتوم وتاسوعه أيضا، ثم حدث أن أفضت كل كلمة ربانية تدبرها العقل (الإلهى) وأمر بها اللسان إلى أن تتابع خلق الأنفس وتقرر شأن الأطياف الحوارس وتوفرت الأقوات جميعا، الخيرات جميعا، وتقرر ما يستحب من أمور الناس وتقرر ما يكره، وحق أن توهب الحياة لمن يعمل بالسلم والفناء لمن يتحمل بالإثم..»
إنه الإيمان إذن بالإله الواحد الخالق لكل شىء فى الوجود والذى جاز خلقه لهذا العالم بمجرد أن فكر وتدبر ثم نطق فكان الوجود بكل ما فيه بالتتابع من آلهة التاسوع حتى النفوس والأطياف الحوارس وكل الخيرات المادية التى تساعد البشر على الحياة.
ولا شك أن سر هذا النص المنفى العظيم والمعجز، أنه قرر ولأول مرة فى تاريخ البشرية أن الله الواحد لم يكن محتاجا ليخلق العالم إلا التفكير وإرادة الخلق فكان «كن فيكون». وهى ذات النظرية التى أكدتها كل العقائد السماوية المنزلة فيما بعد وهى التى تمثل قمة النضج فى علاقة الإله الواحد بالعالم الذى أبدعه.
ولا شك أن هذا النص المنفى قد وجد صداه فى الفكر الدينى التالى؛ فها هو المذهب الواستى (وهو نسبة إلى مدينة «واست» المصرية القديمة (الأقصر حاليا)، يؤكد أصحابه أن إلههم المقدس الواحد الأحد «آمون» هو «الذى صدر عنه نون، وأنه من هدى الخلائق أجمعين، وأنه هو الذى أنجب من أستولدوا الشمس من الأرباب الأولين، وأنه من استكمل ذاته فى هيئة آتوم، وأنه رب العالمين وأنه بداية الوجود».
>>>
وبالطبع فإن مذهب التوحيد عند أخناتون إذن لم يأت من فراغ وأن ما أحدثه يعد ثورة شاملة فى العقيدة الدينية فى مصر القديمة كانت له أصوله وتداعياته. لقد رأى أخناتون الحق فى أن يصور إلها واحدا أعظم تطل سماؤه حانية من علٍ، فوق جسم الأرض، وقد غير من طرق العبادة التقليدية وهذا هو مكمن ثورته لأنه رأى أن عبادة هذا الإله الذى أطلق عليه «آتون» إنما تكون فى الهواء الطلق وأن أخناتون ليس إلا مكرسا لخدمة هذا الإله، لقد تميزت العقيدة الأخناتونية بالدعوة إلى هذا الإله الواحد على أنه الإله الذى ينبغى أن يعبده البشر جميعا فى كل مكان؛ إنه كما يقول فى قصيدته الشهيرة «الإله الواحد الحى لجميع الكون، إنه الأب المحب للناس جميعا، فى مصر وسوريا وجميع أقطار الأرض».
والطريف فى الفكر اللاهوتى المصرى أن كل هذه المذاهب التوحيدية ربما تنبع أو ربما تتماس أو تتقاطع مع عقيدة دينية راسخة تدعو للإله الواحد وتعتبر فى نظر الكثيرين سواء من دارسى التراث المصرى أو من دارسى الديانات وخاصة فى أوربا العصور الوسطى إحدى الديانات الأربعة الموحدة بالإضافة إلى اليهودية والمسيحية والإسلام، تلك هى الديانة الأوزيرية المنسوبة إلى أوزير لدى علماء المصريات أو نسبة إلى تحوت قرينه الذى أطلق عليه اليونانيون هرمس Hermes أو النبى إدريس عند المسلمين، وهى ديانة وجدت منذ ما لا يقل عن عشرة آلاف عام واستمرت على مدى التاريخ. ورغم تعدد الآراء بشأن الديانة الهرمسية إلا أنها تعود بلا شك إلى هرمس- تحوت المصرى وإن لم تكتب نصوصها إلا بين القرنين الثانى والثالث الميلاديين باللغة اليونانية فى عصر الإسكندرية وفى فترة وجود سابقة قليلاً على فيلسوف الإسكندرية المصرى الكبير أفلوطين السكندرى (205- 270م).
أما بخصوص تصورهم للألوهية فإنه يغلب عليه الطابع الصوفى السلبى الذى دائما ما يرى دعاته الألوهية أكبر من أى تصور إنسانى لها. إذ أن أى صفة تقريرية للإله من الخير أن نبتعد عنها حتى ننفى عنه أى طبيعة جسمانية، فالإله عندهم هو «الحد الذى لا حد له، أو الكائن الذى يحوى كل شىء ولا يحويه شىء» إن الله هو «العقل الخالق المتحد مع الكلمة والذى يحيط بالأفلاك ويبرمها بدواره جعل ما خلقه يدور، جعلها تدور من بداية لا حد لها إلى نهاية لا نهاية لها). إنه «العقل والكلمة اللوجوس، كمال من كمال حامل لذاته، حر من كل جسمه، من كل خطأ لا يمس به الجسم ولا يلمس، نفسه فى نفسه، حاويا لكل شىء، حافظا ما هو موجود، ضياؤه بالتشبيه هو الصلاح والصدق، نور يفوق النور ونموذج النفس الأعلى.
إذن ما هو الله!! ليس هو أى واحد من هؤلاء، لأنه من يوجدهم، الكل وكل واحد وكل شىء مما هو كائن، ولم يترك شيئا آخر لم يكن.
إذا ماذا تقول أن يكون الله؟! الله ليس العقل، بل هو علة العقل، الله ليس روحا بل علة وجود الروح، الله ليس النور بل علة وجود النور. لذلك يجب على المرء أن يكرم الله بهذين الاسمين (الصالح- والأب) اسمان يعودان إليه وحده ولا أحد غيره».
وهكذا فإن هذا اللاهوت السلبى- إذا ما استخدمنا اصطلاح ولتر ستيس فى «الزمان والأزل»- هو السائد عند الهرامسة. إنهم لا يفضلون وصف الإله بأى صفة إيجابية، لكن هذا لا يعنى أنهم يوحدون بينه وبين المجهول أو العدم، بل هو الوجود الحقيقى وأصل كل وجود. كل ما هنالك أن الإله فى رأيهم «لا يشبه إلا ذاته وحده» وأن «الوحدانية هى مصدر وجذر الكل وفى كل الأشياء أصل ومصدر، وبدون هذا المصدر يكون العدم، بينما المصدر ذاته ليس من شىء غير ذاته».
إن الإله عند الهرامسة ببساطة «فوق أى اسم، هو الخفى وهو الأكثر ظهورا» فى ذات الوقت؛ إذ «ليس هناك شىء ليس هو لأن الكل هو وهو الكل. ولذلك له كل الأسماء لأنها جميعا لأب واحد. ولهذا هو ذاته ليس له اسم لكونة أباهم جميعا».
إن هذه الوحدانية وأيضا التكرار فى محاولة تسمية وفهم طبيعة الإله كلها تؤكد إيمان الهرامسة بهذا الإله الواحد الأحد الذى وإن تعددت أسماؤه أو تشابهت علينا صفاته فهو هو، ولا يوجد إلا هو، وما الأشياء إلا تجليات لما هو. ومن ثم فهو الخفى وهو الأكثر ظهورا فى ذات الوقت لمن يعرف طبيعته الحقة..
وهكذا نجد بالفعل أن أصل كل الديانات التوحيدية منبعه هذه الرؤى الدينية التوحيدية التى قدمها مفكرو مصر القديمة سواء عبروا عنها فى نصوص مجهولة النسبه لفلاسفة بعينهم حيث كان طابع السرية وجماعية التفكير والتعبير هو الغالب أو جاءت فى نصوص واضحة النسبة لأصحابها كما رأينا فى قصائد إخناتون.
ثالثا: فلسفة حقوق الانسان فى مصر القديمة
أما فيما يتعلق بفلسفة المصريين القدامى حول حقوق الإنسان فقد بلغت حدا راقيا من النضج لدرجة أنها يمكن أن تكون على نفس المستوى ان لم تتفوق على ما نشاهده اليوم!
إن الناس فى مصر القديمة كانوا أحرارا يعيشون حياة مدنية مستقرة فى ظل دولة مركزية تعددت فيها الطبقات فهناك طبقة الحكام وهناك الكهنة والحكماء وهناك كبار الملاك وهناك عامة الناس من العمال والفلاحين وهناك العبيد. ولقد كانت العلاقة بين هذه الطبقات محكومة بمفهوم واحد محدد كان بمثابة العقد الاجتماعى الذى تقوم عليه مدنية هذه الدولة هو «الماعت».
والماعت Maat لفظة من اللغة المصرية القديمة وأصل الكلمة ماع قبل إضافة تاء التأنيث ومعناها يضبط، ويقيس ويعطى الاتجاه الصحيح واستخدمت هذه العلامة كأداة قياس وأساس يقف عليه الإله. وماعت كلمة تستعصى على الترجمة بكلمة واحدة مقابلة لها، فهى تلخص الرؤية الفلسفية المصرية القديمة للجوانب الاجتماعية والفكرية والكونية.
لقد صور المصورون ماعت فى هيئة امرأة رشيقة صغيرة جالسة وتضع ريشة نعامة فوق رأسها فاستعمل هذا الرمز فى كتابه اسمها. كانت كذلك صنجة الحق توضع فى الميزان لوزن قلب الميت عند المحاكمة لمعرفة ما إذا كان «ماعتيا» أى يطابق الماعت أى هل هو إنسان خير أم لا! وتصفها النصوص المصرية عادة بأنها ابنة رع. وكانت هى التى يقدمها الملوك قرباناً للآلهة يحملونها فى أيديهم كأنها دمية صغيرة وتُرى كثيرا فى النقوش البارزة فى الأجزاء الداخلية البعيدة للمحاريب. وكانت ماعت هى التقدمة المفضلة التى تقوم عادة مقام جميع التقدمات الأخرى لأنها تتضمن تلك التقدمات. ولهذه الأسباب اعتبرت ماعت تجسيداً للحقيقة والعدالة.
أطلق المصريون القدامى كلمة ماعت على توازن العالم كله وتعايش جميع عناصره فى انسجام، وعلى تماسك وحداته، إذ لا غنى عنه للمحافظة على الأجسام المخلوقة. تلك كانت القواعد هى التى اشتُقت منها عدالة العلاقات الاجتماعية والحياة الخلقية، وهكذا كانت ماعت كلاً من النظام الكونى والأخلاقى اللذين يعملان معاً فى جميع الظروف تبعاً لوجهة نظر الإنسان عن نظام الكون.
إذن لقد انبثق العالم وفقاً للماعت والإله هو الخالق للعالم وهو الذى يضمن استمرار الماعت حتى لو حاول بعض البشر مخالفتها وقد عبرت عن ذلك فقرة مشهورة من نصوص التوابيت يعلن فيها الإله الخالق ما يتعلق بضرورة المساواة بين البشر لقد خلقت كل واحد مساوياً للآخر، وحرمت أن يقترفوا الظلم، ولكن قلوبهم خالفت ما قلته».
لقد عاش المصرى القديم حياته معتقداً فى مبدأين هامين، أولهما: أن الكون كما خلقه الإله الخالق غير قادر على أن يعيش بدون الماعت. والمبدأ الثانى هو أن الكون غير قادر على أن يعيش ويستمر فى الازدهار بدون «الدولة الفرعونية» فالملك المصرى (الفرعون) – الذى هو الإله على الأرض، أو على الأقل ممثل الإله فى الدولة – هو القادر على فرض الماعت والحريص على استمرار وجودها بين شعبه؛ فالفرعون «هو مساعد إله الشمس، الذى يهزم الأعداء بقوة كلمته، الذى يجعل من مركب الشمس تبحر فى سعادة» وكل النصوص المصرية القديمة تشير وتتفق على أن النظام الملكى – الفرعونى هو الشرط الأساسى للنجاح ليس فقط للفعل البشرى ولكن أيضاً للفعل الإلهى أى الكونى.
ولتتأمل معى صورة هذا التوافق بين ما هو بشرى وما هو كونى ممثلاً فى هذا النشيد الذى يعود إلى الدولة الحديثة والذى يتغنى بقيمة الماعت وانتصارها الذى يعنى انتصاراً للكون كله بما فيه من بشر وآلهه ويعنى أن تعم السعادة والبهجة الجميع دون فرق بين ما هو بشرى وبين ما هو كونى، فالكل يسعد ويحيا بالماعت ويشقى ويتهدم إذا ما اختفت. يقول النص:
ابتهجى يا أيتها الأرض بأكملك لقد أقبل الوقت السعيد
وأشرق السيد على كل البلاد وعادت ماعت إلى مكانها
يا كل الأتقياء احضروا، انظروا لقد انتصرت ماعت على الماعت
وسقط الأشرار على وجوههم وأصبح الجشعون محتقرين
وستزيد المياه ولن تنضب أبدا ويأتى الفيضان
ويصبح النهار أطول وتحمل الليالى الساعات ويأتى القمر فى موعده
ويهدأ الآلهة ويسعدون ونعيش فى الضحكة وفى دهشة
إن هذا النص يعبر خير تعبير عن أن الماعت هو جوهر بناء الدولة المصرية القديمة وهى أساس أى فعل حضارى بها من شأنه أن يسعد الكون والبشر على السواء.
ولنأخذ مثلاً على تقدير الملوك للماعت وحرصهم الشديد على تطبيقها بين مواطنيهم من تعاليم الملك خيتى الثالث إلى ابنه مرى – كا – رع حيث يقول له أقم العدالة ما دمت تعيش على الأرض هدئ من روع من ينتحب، لا تقهر الأرملة، لا تطرد إنسان من ممتلكات أبيه، لا توقع ضرراً بالعظماء وهم يمارسون وظائفهم، تجنب أن توقع عقوبة بالباطل لا تقضى على من هو غير ذى فائدة لك. وإذا وقعت عقوبة فليكن بالضرب أو بالسجن، ومن ثم تستقر أحوال البلاد فيما عدا المتمرد الذى تنكشف مخططاته لأن الله يعرف الإنسان صاحب القلب الخسيس والله يعاقب بالدم العمل السىء.
وكم كانت صياغة الملكة حتشبسوت لمدى تقدير الملك فى مصر القديمة للماعت وسهرها على تطبيقها رائعاً حينما قالت بصيغة ارتبط فيها ما هو بشرى بما هو إلهى عن دور العدالة وضرورة تجسيدها فى المجتمع ودور الملك فى ذلك، قالت: «لقد مجدت الماعت التى يحبها الإله لأنى أعرف أنه يعيش منها، إنها أيضاً خبزى، وإنى أشرب رحيقها بكونى جسداً واحداً معه».
>>>
وهذا الدور الذى كان يعيه الحكام والمفكرون لمعنى العدالة وتطبيقها داخل الدولة ليس مقصورًا عليهم فقط بل كان يعرفه ويقدره ويعيه تماماً الإنسان العادى فى مصر القديمة وكان هذا هو أساس حبه وانتمائه لبلده ووطنه. ولنأخذ من نصوص شكاوى القروى الفصيح خو – أن – أنبو دليلاً على ذلك؛ فحينما استبد القلق بهذا القروى من عدم استماع رئيس الحجاب رنسى بن ميرو لشكاواه ومطالبته برد حقه إليه صاح قائلاً فى الشكوى السادسة أياً رئيس الحجاب، يا سيدى… استدع إلى الوجود الحقيقة والعدالة، أعمل على ظهور الخير، اقضِ على الشر مثلما يحل الشبع عندما يزول الجوع أو تضع الثياب حداً للعرى، مثلما تهدأ السماء بعد عاصفة هوجاء، وتمنح الدفء إلى جميع من كانوا يشعرون بالبرد، ومثل اللهب أيضاً الذى ينضج النبات الطازج، ومثل الماء أيضا الذى يروى العطش.. ولما لم يستجب له رئيس الحجاب ذكره بالمصير الحسن الذى ينتظر من يقيم العدل فقال له فى الشكوى الثامنة أقم العدل من أجل سيد العدالة الذى يقيم عدالته الخاصة. إنك أنت القلم وقرطاس البردى ولوحة الكتابة، أنت «تحوت» فتجنب اقتراف الشر.. الخير طيب عندما يكون سعيداً، العدالة تدوم إلى الأبد، إنها تهبط الجبانة مع من يقيمها، عندما يدفن تتحد الأرض معه ولا يمحى اسمه من على وجه الأرض، سوف تدوم ذكراه بسبب ما قدمه من خير.
وحينما صم رئيس الحجاب أذنيه عن كل ذلك هدده فى الشكوى التاسعة بالمصير السيئ الذى ينتظره طالما لم يقم بعمله المفروض عليه قائلاً: «لا وجود للبارحة لإنسان لا عمل له، ولا صديق للإنسان الذى يصم أذنيه عن العدالة، ولا أيام سعيدة هناك للإنسان الشره».
وبالطبع ينبغى أن نقرأ مدى هذا الوعى من قبل القروى الفصيح بضرورة أن يطبق رنسى بن ميرو العدالة باعتباره ممثلاً للدولة! والحقيقة أنه قد تحققت هذه العدالة بأمر ملكى حينما جرد المعتدى – جحوتى – نخت ورجاله من أملاكه وأعطاها للقروى فيما قدر بأنه كان تعويضاً له عن الظلم الذى تعرض له وعن الأيام التى ظل يشكو فيها دون جدوى.
والحقيقة التى نود أن نلفت الأنظار إليها فى ضوء ما سبق أن الإنسان المصرى القديم قد تمتع بالمواطنة الحقيقية فى ظل نظام سياسى ملكى عادل، إذ على الرغم من النظر إلى الملك على أنه إله أو ابن إله إلا أن الملكية فى مصر القديمة كانت مقيدة بالتزام محدد وهو تطبيق العدالة بين كافة المواطنين، لقد كان الحق الملكى يقابله واجب باستمرار، فإذا كان من حق الملك على الشعب التقديس والاحترام فإن من واجب الملك أن يعمل بموجب هذا الاحترام فيمارس سلطاته بأقصى درجات النزاهة والحيدة محققاً أقصى قدر من العدالة بين مواطنيه لقد كانت العلاقة بين الملك وشعبه علاقة يسودها الاحترام المتبادل والسعى المتبادل لتحقيق العدالة بكافة صورها وخاصة العدالة الاجتماعية التى يتساوى فى ظلها الجميع والتى تعد فى نظرنا نوعاً من الديمقراطية حيث كان يؤمن الجميع حكاماً ومحكومين بأنهم متساوون أمام الخالق وأن لهم نفس الفرص التى ينبغى أن يتمتعوا بها فى حياتهم كل حسب وظيفته. وليس للحاكم أن يتدخل فى حريات الأشخاص إلا بالقدر الذى يسمح له بتحقيق العدالة بين مواطنيه
أما عن الحقوق التى تمتع بها الإنسان فى مصر القديمة فإن تحليلاً معمقاً لواحد من أشهر النصوص المصرية القديمة وهو «شكاوى القروى الفصيح» التى أشرنا اليه من قبل يفصح عن أن ثقافة حقوق الإنسان كانت موجودة وكان الإنسان المصرى يعى تماماً حقوقه وواجباته ويحرص على المطالبة بحقوقه كاملة فى مواجهة أى ظلم يتعرض له وأياً كانت المكانة السياسية والاجتماعية لمن ظلمه وتعدى على حقوقه، وقد أفلح يان اسمان حينما أطلق على شكاوى القروى الفصيح «موجز عن الماعت». فهى بالفعل توضح بجلاء أن المطالبة بالعدالة وبرد الحقوق إلى أصحابها كانت ثقافة شائعة فى مصر القديمة للدرجة التى جعلت القروى خو – إن – أنبو يقول حينما التقى لأول مرة برنسى بن ميرو رئيس الحجاب ليشتكى له من الظلم الذى وقع عليه: «واه! ليتنى أسعد قلبك بشأن هذه المشكلة التى حدثت لي» فقد كان القروى واثقاً من أنه سيسعد قلب رئيس الحجاب حينما يضع أمامه ملابسات الظلم الذى وقع عليه والاستيلاء على حماره وحبوبه، فهو بذلك سيمكنه من أن يرد الحقوق إلى أصحابها ويحقق العدالة فهذا هو ما يحقق له الفخار فى الحياة الدنيا ويضمن له المصير الحسن فى الحياة الأخرى.
>>>
وإذا كان ذلك كذلك فيما يتعلق بانتشار ثقافة العدل والحرص على حقوق الإنسان فيما بين مواطنى مصر القديمة حكاماً ومحكومين، فإن التساؤل الآن ربما يكون حول ما أهم هذه الحقوق التى كانت مرعية من قبلهم ومدى التوافق بينها وبين نظرية حقوق الإنسان المعاصرة والتى يمثلها خير تمثيل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 1948م.
الحقيقة أنه ربما يدهش الإنسان المعاصر من مدى ذلك التوافق بين أقدم صور مراعاة حقوق الإنسان فى المدينة المصرية القديمة وبين أحدث وأهم وأرقى صيغها فى عصرنا الحالى، فمنذ ديباجة الإعلان المعاصر لحقوق الإنسان ومادته الأولى التى تنص على «إن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين فى الكرامة والحقوق «نجد ذلك التوافق حيث تشير واحدة من أشهر فقرات «نصوص التوابيت» التى أشرنا إليها من قبل إلى إعلان الإله الخالق بأنه قد خلق كل واحد مساوياً للآخر وحرم على البشر أن يقترفوا الظلم وقد آمن المصريون بذلك إيماناً جازماً لدرجة أنهم كانوا ينظرون إلى حاكم الدولة الملك الإله على أنه لا يُخلق إلا لتحقيق المساواة بين البشر وتحرير الإنسان من يد الإنسان وحماية الضعفاء منهم.
وتلك بعض الأمثلة على ماكان يتمتع به بالفعل الانسان المصرى القديم من حقوق.
(أ) حق الحياة والسلامة الشخصية:
اذا كانت المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثانية عشرة والثالثة عشرة من الإعلان العالمى لحقوق الانسان تنص كلها على حق الإنسان فى الحياة والحرية وسلامة شخصه وعدم استرقاقه والتجارة فيه كرقيق وعدم الحط من كرامته وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة القاسية، فقدكانت تلك الحقوق مكفولة تماماً للإنسان المصرى القديم، ونظرة واحدة على النقوش الموجودة على جدران المعابد وقراءة العديد من النصوص التى تخص الحياة اليومية للإنسان المصرى القديم تكشف عن مدى تمتعه فى حياته الخاصة بالحريات المختلفة وبالاستقلال الذاتى ولم يكن يسمح بأن يحط من كرامة هذا الإنسان تحت أى وضع. وقد أكدت شكاوى القروى الفصيح ذلك تماماً وخاصة خاتمة هذه الشكاوى التى تنتهى بأن يحكم لصالح هذا القروى بأن يتسلم كل أملاك جحوتى نخت الموظف الذى ظلمه وتعدى عليه وعذبه كتعويض له عن هذا التصدى وهذا الظلم الذى تعرض له. وقد اتضح حرص الملوك على مراعاة هذه الحقوق الأساسية للمواطن المصرى من خطاباتهم ووصاياهم السياسية. انظر على سبيل المثال لوصايا الملك خيتى أحد ملوك الأسرة العاشرة لابنه مرى كا رع حينما يقول له مؤكداً على حق المواطنين على الملك فى التمتع بالمساواة وتكافؤ الفرص وحسن المعاملة، يقول له: اجعل الكفاية مقياسك فى استخدام ابن العظيم وابن الصغير.. لا تؤذ أحداً بغير حق.. إن من الخير لك أن تكون رحيماً وأن تقيم لنفسك تمثالاً من الحب فى القلوب.. أكرم الذين يستحقون الإكرام وأحسن معاملة شعبك وأعمل للمستقبل.. اجتنب أن تسىء إلى الأرملة ولا تحرم أحداً مما تركه أبوه ولا تطرد القضاة من كراسيهم ولا تعاقب بغير ذنب.
وقد عبر عن مدى تمتع الإنسان المصرى القديم بهذه الحقوق الأساسية خير تعبير آرثر ويجل Arthur Weigall حينما قال كانت الحياة فى ذلك العصر ناعمة بالغة حداً بعيداً من التأنق حتى يدهشنا ما نراه فيها من أوجه الشبه بالحياة فى عصرنا الحاضر. وبعد أن عدد بعض جوانب الرفاه فى العادات المصرية القديمة أضاف إن نظرة فاحصة تنطق بأن عاداتهم قريبة كل القرب من عقلنا الغربى وأن أفكارهم متصلة بأفكارنا إلى حد بعيد فى بعض الأحيان».
(ب) حق التقاضى:
وإذا كانت المادة السابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أن «كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أى تفرقة» ويشاركها فى التأكيد على ذلك المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة حيث تنص على الحق فى اللجوء للتقاضى وللمحاكم الوطنية ولا يجوز القبض على أى إنسان أو نفيه تعسفياً وإن كل شخص متهم برىء إلى أن تثبت إدانته، أقول إذا كانت هذه المواد تؤكد حق التقاضى والمساواة أمام القانون، فإن المجتمع المصرى القديم كان مجتمعاً يقدر القانون ويحميه ويٌخضعُ المتهمون فيه لمحاكمات عادلة أمام محاكم مختصة وقد كانت إجراءات المحاكمة فى مختلف عصور التاريخ المصرى واحدة ولم تختلف كثيراً فى عصر عنها فى عصر آخر.
وليس أدل على مدى قوة القانون المصرى واستقلال القضاء والمحاكم فى مصر القديمة أكثر من هذين الحدثين البارزين فى تاريخ مصر القديمة؛ أولهما أن الملكة «ورت حتس» زوجة بيبى الأول أحد ملوك الأسرة السادسة أجرمت فى حق زوجها فلم يعاقبها من غير تحقيق قضائى بل أمر بالتحقيق القضائى وتولاه قاضى كان يسمى «وني» وقد شهد هذا القاضى فى نقش تركه فى قبره أن الملك أمره بالتحقيق فى هذه الجريمة وقد حقق فيها وحده وبدون تدخل من أحد. وثانيهما: حادثة مؤامرة دبرت للملك رمسيس الثالث أحد ملوك الأسرة العشرين وجرت هذه المؤامرة إلى غايتها وهجم المتآمرون على الملك لقتله لكنهم فشلوا ونجا الملك وربما يكون قد جرح كما يرجح برستيد. وكم كان الملك رابط الجأش حينما كلف محكمة خاصة مؤلفة من 14 قاضياً لمحاكمة هؤلاء المتآمرين ولننظر ما جاء فى أمر التكليف لنعرف كم كان القضاء مستقلاً والحرص على المساواة أمام القانون رغم عنف الجريمة مسألة يرعاها الملك نفسه حتى ولو كان هو المقصود بها. يقول الملك فى أمر التكليف: «إننى لا أعرف شيئاً مما دبره المتهمون، عليكم أن تتثبتوا منه وتفحصوه، ومتى فرغتم من فحصه فعليكم أن تعدموا على غير علم منى من يستحقون الإعدام منهم وأن تعاقبوا الآخرين على غير علم منى أيضاً واحذروا أن تعاقبوا أحداً بغير حق…».
إن هذا النص البديع فى إقرار استقلال القضاء وعدم معاقبة أحد إلا على ذنب اقترفه أو جريمة ارتكبها لهو خير دليل على مدى سمو الحضارة المصرية القديمة فى إقرار أهم حقوق الإنسان وهو حق الحصول على محاكمة عادلة مهما ارتكب من جرم، إن ما فعله الملك بيبى الأول منذ نحو خمسة آلاف عام وما فعله رمسيس الثالث منذ نحو ثلاثة آلاف عام يدل على تمسك بالعدل كانت مصر وحدها هى التى تعرفه فى تلك العصور القديمة. ورغم أننا لا يمكن أن نزعم – على حد تعبير عبدالقادر حمزة – بأن جميع ملوك مصر القديمة كانوا يفعلون مثل بيبى الأول ورمسيس الثالث، إلا أن هذين الملكين لم يفعلا ما فعلاه وبين أحدهما والثانى أكثر من ألف سنة إلا وقد عرفا أن العدل كان من أقوى الفضائل عند الأمة المصرية وفى القوانين المصرية.
وعلى كل حال فقد كان خضوع الجميع للقانون فى مصر القديمة واحترامهم له أساساً متيناً من أسس المدنية والحضارة المصرية القديمة، وكان ملوك مصر القديمة هم أول من خضع للقانون ويؤكد ذلك ديودورس الصقلى حينما يروى أن ملوك مصر القديمة لم يحكموا البلاد حكماً اتوقراطياً مطلقاً كغيرهم من الحكام فى الدول الأخرى ولم يحيوا حياتهم طليقة من كل ضابط أو قيد، وإنما كانوا يراعون حرمة القانون فى كافة تصرفاتهم سواء أكان ذلك خاصاً بأمور الحكم أو بشئونهم الخاصة.
(ج) الحقوق الأسرية والاجتماعية:
أما بخصوص حق الفرد فى الزواج وتكوين الأسرة والتمتع بجنسية وطنه وهى الحقوق التى عبرت عنها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المواد 15، 16، 17 فقد تمتع بها الإنسان المصرى ونظمتها عادات وقوانين واضحة المعالم فى التراث المصرى القديم فقد حث معظم حكماء مصر فى بردياتهم على ضرورة الزواج وأهمية التبكير به، فقد وردت فى مخطوط الحكمة لبتاح حوتب أنه نصح ابنه قائلاً: «إذا كنت رجلاً رفيع المقام فأسس لنفسك بيتاً وأعز زوجتك فى منزلك كما ينبغى.. اجعلها سعيدة ما دمت حيا». وتكررت نفس النصائح طوال عصور الدولة المصرية حتى أنى حكيم الدولة الحديثة الذى يوصى ابنه قائلاً: «اتخذ لنفسك زوجة شابة وأنت شاب لترزق منها بولد» ويضيف: «إذا ولدته لك فى شبابك، فعلمه ليكون نافعاً فما أسعد الرجل الذى يكثر أهله ويحترم من أجل أولاده» وفى العصر المتأخر أوصى الحكيم عنخ ششنقى ابنه قائلاً: «اتخذ لنفسك زوجة وأنت فى سن العشرين لترزق منها بأولادك فى شبابك».
وقد كان للزواج تقاليد مرعية بدءً من طلب يد الفتاة من والديها، إلى المهر الذى يُدفعُ لها – إلى العقد الذى يتم بموجبه الزواج وشهوده – وكذلك كان للطلاق أيضاً صيغة وتقاليد.
>>>
ومن الأمور اللافتة للنظر أن القانون المصرى القديم قد منح للمرأة المصرية حرية التعامل إذا كانت تعرف القراءة والكتابة وما يؤكد ذلك أن أورلياثيسوس Aureliathaisous وشهرتها لوليانا ابنة أحد كتبة الأسواق المتقاعدين تذكر فى طلب لها لجهة من جهات الاختصاص أنها قادرة على الكتابة بسهولة تامة، ولهذا فإن من حقها أن تتصرف فى شئونها بنفسها. وبعد مضى أربعة أعوام وكان ذلك فى عام 267ق.م نجدها قد قامت بشراء منزلين وقطعة من الأرض.
والطريف أيضاً أن فرع الأم كان يوضع موضع الاعتبار فى النسب فقد كان اسم الأم يذكر دائما أما اسم الأب فكثيرا ما يغفل ذكره وكان الأبناء إذا انتسبوا يذكرون أسماء أسلاف أمهاتهم لا أسلاف آبائهم، ولم يكن الأب إلا حامل لقب، أما الأم فكانت واسطة عقد الأسرة، وكان يستثنى من ذلك شاغلى بعض الوظائف التى يرثها الأبناء بحكم القانون عن آبائهم أباً عن جد فإنهم كانوا ينسبون إلى الآباء لا الأمهات وكانت الممتلكات العقارية يرثها الأبناء عن الأمهات سيدات البيت.
وإذا كانت حقوق الزوجة كانت معروفة ومصانة بل ومقدسة فى نظر الإنسان المصرى القديم، فإن للأولاد هم أيضاً حقوقاً كانت مرعية بدءاً من اختيار الاسم الصالح للابن وتأكيد نسبه بتسجيله فى سجل المواليد، وتكشف إحدى الوثائق عن ذلك حيث تقول إحدى الأميرات: «قد أنجبت هذا الطفل الصغير الموجود أمامك – لقد سميناه ميراب وسجل فى سجل بيت الحياة». لقد كان لدى السلطات المدنية فى مصر القديمة سجلاً للمواليد والزواج والوفيات. وكانت الحياة الاجتماعية والمدنية موثقة حسب القوانين والتقاليد المرعية كما تكشف عن ذلك الوثائق والرسومات الجديدة التى سجلت فى البرديات وعلى جدران المعابد.
(د) حقوق العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية:
أما بخصوص الحق فى العمل والحصول على الأجر المناسب الذى نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والحق فى الرعاية الاجتماعية من المجتمع الذى ينتمى إليه الذى تنص عليه المادة 22 من نفس الإعلان، وكذلك الحق فى مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية للفرد ولأسرته كما تنص المادة 25 من هذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
إن هذه الحقوق كانت فى معظمها كذلك مكفولة للإنسان المصرى القديم، فقد كان الجميع يعملون ضمن تسلسل وظيفى هرمى معروف ومقنن بدءاً من الملك والوزير وموظفى البلاط الملكى وحكام المقاطعات إلى الموظفين العاديين والفلاحين والعاملين حتى العبيد وخدم البيوت. الكل يعمل بين المدن والحقول. وبينما كان الكتبة والكهنة والقضاة وكبار موظفى الدولة لهم مكانة وحصانة طبقاً لوظائفهم فإن الطبقات الدنيا من العمال غير الفنيين كانوا يعملون جماعات كل عشرة منهم لهم رئيس من أنفسهم.
وكان رؤساء العمال يستطيعون جلب مئات منهم للعمل فى المشروعات الكبيرة وهذا هو ما كان يسمى بنظام «السخرة» – حيث كانت تلك – على حد تعبير فلندرزبترى – ظاهرة مألوفة فى تنفيذ المشروعات.
ولا ينبغى أن نفهم كلمة السخرة هنا بمعنى الظلم والاستعباد للعمال، لأن الواقع يقول غير ذلك، فقد كانوا يعملون ويسخرون للعمل فى هذه المشروعات الكبيرة، لكن حقوقهم فى الحياة والأجر مكفولة، وقد ورد أنه فى الأسرة الثانية عشرة فى مدينة كاهون (اللاهون) كان يوجد فيها ثلاثمائة وخمسون منزلاً للعمال وصغار الموظفين يتراوح عدد غرف كل منزل منها 4 و7 غرف وكانت تلك المنازل صغيرة المساحة فى صفوف متراصة مزدحمة، والى جوارها نجد اثنى عشر داراً عظيمة يحتوى كل منها على حوالى ستين غرفة فسيحة وذات أعمدة عالية. والحق – فيما يشهد بترى – إنك لا تجد فى تلك المدينة شيئاً وسطاً بين ثراء عريض وفقر مدقع. إن الفرق بين مساكن المواطنين العاديين من أفراد الشعب ومساكن الأثرياء فى عهد كل من الأسرة الثانية عشرة والأسرة الثامنة عشرة كان يشبه إلى حد كبير الفرق بين المنازل الفقيرة فى حى مصر القديمة بالقاهرة والفيلات الجميلة فى ضاحية المعادى.
أما إذا تساءلنا هل كانت السخرة تعنى الرق، ينفى المختصون هذا الأمر حيث كان استخدام الأرقاء ضيق النطاق فى العصور الأولى من تاريخ مصر. وكان الفلاحون أى العمال الذين يعملون فى الأرض مرتبطين بالمزارع التى يعملون فيها والذين كان ينظر إليهم على أنهم رقيق الأرض لارتباطهم الشديد بها لهم مساكنهم الخاصة ولا يجوز التصرف فيها بالبيع، وفى عهد الأسرة الثانية عشرة كان من الممكن تأجير هؤلاء وأسرهم لأداء بعض الأعمال. ولكن ليس هناك دليل واحد على التصرف فيهم بالبيع والشراء.
أما الأقوال الشائعة عن الظلم الفادح على عمال بناء الأهرام وما كتب عن أنهم كثيراً ما ذرفوا الدموع وأطلقوا الأنين والشكوى من الظلم الذى عانوه، فهذه ترهات غير صحيحة واتهامات باطلة، فقد شهد المؤرخون الموضوعيون والمنصفون بأن الإشراف على بناء هذه الأهرامات ونظام العمل فيها كان محكماً بفضل ذلك التنظيم البديع الذى يدل على ذلك العمل العظيم ولم تستعمل أية قسوة ولا شدة ولا عنف فى إتمام ذلك العمل. فقد كان كل فرد فى البلاد مكلفاً بالعمل بنظام السخرة (أى بالعمل فى هذه المشروعات الضخمة فى غير أوقات الفلاحة والزراعة) مرتين فقط طيلة حياته وكان يعيش فى دعة ويسر كما لو كان فى منزله إذ لم يكن فى استطاعته أن يعمل شيئاً خلال فترة فيضان النيل، و«قد كان كسباً عظيماً لهؤلاء القوم أن يتعلموا نظام العمل الجماعى ويتلقوا دروساً عملية فى التدريب المهنى».
أما بخصوص حق التعليم، فإن المعروف أن الحضارة المصرية القديمة كانت تقدس العلم والمعرفة للدرجة التى جعلت الحكماء يؤكدون أن مهنة الكاتب أقدس مهنة وأنفعها. انظر على سبيل المثال المثال لقول «سنب حتب» الذى نصح ابنه قائلا: «أعد نفسك لتكون كاتباً وحاملاً قلم المعرفة.. إنها أشبه مهنة وأجدر وظيفة تليق بك وترفع من شأنك وتقربك من الآلهة».
ولقد قال رع حتب واصفاً لذة مهنة الكاتب إن الكتابة «تجعل الكاتب أسعد من امرأة وضعت طفلاً فالكتابة كميلاد الطفل الذى يعوض الأم ما تحملته من آلام فى حمله وولادته.. فرح هو قلب الكاتب الذى يزداد شباباً كل يوم.. فرح وهو يسترد أضعاف ما أعطى من حبهم وتعظيمهم له وتقديسهم لأعماله».
وما دام ذلك كذلك، فقد كان الحرص على التعليم كبيراً رغم أنه فى واقع الأمر كان مقصوراً على طبقة معينة هى فى الغالب طبقة الكهنة والكتبة وكان من بين هؤلاء العلماء فى كل فروع العلم والمعرفة التى جعلت من مصر القديمة مقصداً لكل شعوب الأرض آنذاك ليتعلموا فقد كانت مصر مهد اختراع الكتابة، كما كانت مهداً نشأت فيه كل فروع المعرفة العلمية والأدبية.
والحقيقة أنه لا توجد لدينا نصوص توضح نظاماً محدداً للتعليم وهل كان مجانياً أو غير ذلك لكن مما نعرفه أنه كان متاحاً لأطفال الطبقات الراقية؛ فقد كانوا يذهبون إلى مدرسة الحضانة التى كانت ملحقة بالقصر الملكى، وكان يشرف على تعليمهم وتربيتهم هيئة كبيرة العدد من الوصيفات والأتباع. وكان يُخصصُ للكبار من هؤلاء الأطفال معلمون كان يطلق عليهم «الآباء المربون» الذين كان لهم حق الإشراف على تعليمهم وتنشئتهم ولقد جرى العرف فى عصر الأسرة التاسعة عشرة على أن جميع الأطفال الذين يولدون فى يوم ميلاد ولى العهد لهم الحق فى تنشئتهم معه فى القصر الملكى.
ويبدو بوجه عام أن التعليم وخاصة تعليم القراءة والكتابة كان متاحاً لمن يرغب ولمن يقدر على ذلك بدليل أنه كان متاحاً حتى للفتيات من الأسر المتوسطة فقد عثر – على وثيقة أشرنا إليها من قبل – لابنة كاتب لأحد الأسواق تقول فيها «إنها تستطيع الكتابة فى سهولة ويسر».
وعموماً فإن النظام التعليمى فى مصر القديمة كان يبدأ منذ حداثة سن الطفل حيث يبدأ الأطفال تعليم القراءة والكتابة بوسائل عدة منها الألواح الفخارية أو الألواح الفخارية بعد طليها بطبقة رقيقة من الجص لمنع تسرب الحبر إلى مسامها. وقد كانت بعض المدارس تُلحقُ بداووين الحكومة المختلفة بهدف إعداد طائفة من الموظفين للنهوض بالأعمال الحكومية. وقد كان يوكل إلى الكهنة القيام بتدريس الموضوعات التى تتطلب بحثاً عميقاً مثل الحساب والهندسة والفلك والفلسفة وعلم الأخلاق.
ويعد كتاب «الموتى» أقدم الكتب التى كانت مقررة للدراسة وخاصة ذلك الجزء الخاص بالتبرؤ من الخطايا والذنوب الذى يتألف من فصول يشمل كل فصل منها على خمسة بنود. وهى طريقة ابتدعها المصريون القدماء لتساعد الذاكرة على الحفظ عن طريق العد بالأصابع.
ويعتبر أنى ومدرسته أقدم مدرسة أشبه بروضة للأطفال حيث كان يتم فيها التعامل مع الكلمة المكتوبة أى القراءة. ثم ينقل الطلاب بعد ذلك إلى التعليم الجاد على أيدى مدرسين قساة عتاة، وتلك كانت التعليمات التى يوجهها الآباء والمعلمون للتلاميذ فيما بين 13، 19 سنة: لقد أدخلتك المدرسة التى يدخلها أولاد الكبراء كما أعلمك وأوجهك لهذه الوظيفة التى سوف تقودك إلى القوة والسلطة، انظر سأخبرك بمنهج الكاتب: أثبت مكانك، أكتب أمام أقرانك. نظف ثوبك بنفسك واعتنى بخفيك. أحضر لفافة البردى التى تخصك كل يوم وحافظ عليها ولا تكن كسولاً ،اكتب بيدك، سمع بفمك، أقبل النصيحة لا تتملل، لا تضع يومك فى الكسل، تعمق فى فهم أساليب مدرسك واطع تعاليمه.
ويبدو أن الضرب كان معمولاً به فى مدارس مصر القديمة حينما لا ينتصح التلميذ أو حينما يتكاسل عن استذكار دروسه. وقد ورد فى بردية الكاتب آمنموبى موجهاً كلامه إلى تلميذه بنتاور: لقد يئست من تكرار النصح.. هل أضربك مئة ضربة ثم تذهب أدراج الرياح.. أيها الولد السيئ.. افهم هذا.
وبوجه عام فإن المعلوم أن المصريين تمتعوا بحق التعليم كل حسب طبقته الاجتماعية وحسب حاجته ولم يكن أحداً ليمنع أحدا عن التعليم إذا أراد وقد كان المركز الاجتماعى للإنسان يتحدد – كما هو واضح من كل النصوص المصرية القديمة – حسب درجة تعليمه وتدريبه.
وعلى كل حال فقد أعجب القدماء بالنظام التعليمى المصرى القديم لدرجة أن أفلاطون فيلسوف اليونان الكبير قد أشاد به واتخذه نموذجاً يحتذى به فى محاورة «القوانين».
(هـ) حقوق حرية التفكير والتعبير والملكية واللجوء السياسى:
هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين بأن المصرى القديم لم يكن يتمتع بحرية التفكير أو التعبير وحرية الرأى التى نصت عليها المواد 18، 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. والحقيقة أنه توجد أمثلة كثيرة تؤكد عكس ذلك. كما أن أشهر بردية فى اعتقادى توضح مدى حرية التفكير والتعبير والنقد التى تمتع بها الإنسان المصرى القديم هى بردية أيبوور، ذلك الحكيم المصرى العجوز الذى عاش على الأرجح فى أواخر عهد الملك بيبى الثانى. وقد أطلقت عليها كلير لالويت «مرثيات أيبوور»، وإن كنا نميل إلى الاسم الذى أطلقه عليها برستيد «تحذيرات أيبوور». فهذا النص البديع يكشف عن مدى الحرية التى تمتع بها هذا الحكيم وهو ينقد علانية الملك وأفعاله فى البلاد معدداً خطاياه وأخطاءه فى حق البلاد والعباد للدرجة التى قال له فيها بعد أن عدَّد أمامه الكثير من صور الفساد والفوضى فى البلاد وهدر حقوق الأفراد فيها «إن الأمر الملكى والمعرفة والعدالة (ماعت) فى قبضة يدك ولكن ما تصنعه فى البلاد هو النزاع وصوت القلاقل… ولقد فعلت ذلك لتشتد علينا هذه الأمور. لقد نطقت زوراً وبهتاناً». لقد وصل به الأمر إلى اتهام الملك بالزور والبهتان. والطريف أن الملك لم ينزل به أى عقاب بل رد على تلك الاتهامات بأن قال إنه حاول قدر طاقته حماية شعبه بالوقوف فى وجه الأجانب الذين كانوا يهاجمون البلاد.
ولقد كانت تلك الإجابة الهادئة من الملك فى تبرير سوء أحوال البلاد والمواطنين فى عصره دافعاً لأيبوور لأن يهدئ من لهجته النقدية مفضلاً عليها فى ختام البردية أن يحلم بصورة الأمن والأمان والرخاء للمجتمع المصرى فى ظل ملك قوى قادر على تحقيق الاستقرار وترسيخ العدالة من جديد.
أما بخصوص حق الملكية الذى نصت عليه المادة 17 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بشقيها حق كل شخص فى التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وعدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفا. فقد جاء خير تعبير عن تمتع الإنسان المصرى البسيط بهذا الحق، وأيضاً فى قصة ذلك القروى الذى رفض أن يتنازل عن ملكية حماره وأمتعته لهذا المعتدى. وظل يشكو وهو واثق أنه سيحصل على حقه إلى أن تم ذلك فعلاً وحصل بأمر ملكى ليس فقط على أملاكه وإنما على التعويض المناسب عن الظلم الذى وقع عليه كما أشرنا من قبل.
أما حق اللجوء السياسى الذى قد يتصور البعض أنه مسألة مستحدثة فى الفكر السياسى المعاصر، فالحقيقة أن تاريخ الدبلوماسية القديمة قد عرفته، فإذا كان الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته الرابعة عشرة قد نص على أن «لكل فرد الحق فى أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد وأن لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة فى جرائم غير سياسية. فإن نصوص أول معاهدة سياسية عرفتها البشرية قد عقدت بين رمسيس الثانى ملك مصر مع خاتوسيل الثالث ملك الحيثيين وذلك فى العالم الحادى والعشرين من حكم الأول وكان ذلك حوالى عام 1278ق.م قد ورد فيها نصاً صريحاً عن مسألة اللجوء السياسى بين البلدين حيث نصت المعاهدة على تبادل تسليم الفارين واللاجئين بين البلدين وقد ميزت بين فئتين من اللاجئين السياسيين، فئة الرجال المعروفين فى بلدهم أى أولئك الرجال من رفيعى الشأن وأصحاب المناصب العليا، وفئة الرجال العاديين غير المعروفين من عامة الناس، وسواء كان اللاجئون من الفئة الأولى الذين يطلبون عادة اللجوء السياسى ليقيموا فى أرض الدولة الأخرى أو من الفئة الثانية الذين غالباً ما يتسللون خفية إلى أراضى الدول المجاورة فإن الاتفاقية دعت إلى قيام الطرفين بتبادل هؤلاء وأولئك وتسليمهم إلى بلدهم الأصلى.
وإذا كنا سنسارع إلى الحكم بأن ذلك قد يؤدى إلى أن يتعرض هؤلاء الذين سيسلمون إلى بلدهم للقتل أو للسجن أو لأى عقوبة أخرى فإن أجمل ما ورد فى هذه المعاهدة نصاً يشير إلى أن اللاجئ الذى يسلم إلى بلده «لا ينبغى أن تقف ضده هذه الجريمة – أى جريمة اللجوء أو الهرب إلى الدولة الأخرى – أو يحاسب عليها وألا يتعرض بيته أو زوجته أو أولاده لسوء وألا تضار عيناه أو أذناه أو ساقاه. وألا يحاسب على أى جريمة».
إن هذا النص يؤكد مدى ما وصلت إليه الأخلاق السياسية من سمو يعنى بحقوق الإنسان إذ نص على أنه لا ينبغى أن يُضار أى إنسان نتيجة توقيع معاهدة صداقة وسلام بين ملكى البلدين حتى ولو كان هذا الإنسان ممن خالفوا القوانين واللوائح فى بلدهم أو حتى من الخارجين على القانون فيها.
وبالطبع فإن أحداً لا يستطيع أن يدعى أن كل ما تضمنه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من حقوق وحريات كان موجوداً ومعلوماً للمصريين القدماء. فالفارق الزمنى الهائل ومستحدثات عصرنا كثيرة ومتنوعة للدرجة التى دعت إلى وجود عشرات الوثائق والملاحق المتجددة لهذا الإعلان العالمى نفسه منذ صدوره عام 1948 وحتى الآن.
ومع ذلك فإن الحقيقة تقتضى التأكيد على أن الوثائق التى تم اكتشافها وترجمتها حتى الآن من التراث الفكرى لمصر القديمة توضح بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام مجتمع مستقر يتمتع الجميع فى ظله بحياة هادئة مستقرة يعرف كل واحد فيها دوره ويؤديه بأكبر قدر من الاتقان من الفلاح الذى لا يفارق أرضه إلى الملك الذى يرعى الجميع رعاية اجتماعية وسياسية وبإحساس عال من المسئولية تجاه شعبه.
>>>
وقد كانت العدالة (الماعت) الأساس القوى الذى بنى عليه استقرار هذا المجتمع وسعادة ورفاهية شعبه؛ إذ لم ينظر لهذه العدالة فى مصر – على حد تعبير ت. ج جيمز – باعتبارها امتيازا يتمتع به الأغنياء والأقوياء، بل فتحت العدالة صدرها حتى لأدنى الناس. ولم يكن السبب مجرد اعتياد الكبراء، بطول الممارسة، على الحدب على الضعفاء والفقراء ولكن لأن المساواة كانت حقاً مكفولاً للجميع بين يدى العدالة. ولا أدل على ذلك من أن خطاب التنصيب الذى كان عادة ما يلقيه الملك على الوزير الأول حال تعيينه كان أهم ما فيه من توجيهات تتعلق بضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع «عامل بالمساواة الرجل الذى تعرفه والرجل الذى لا تعرفه، والرجل القريب منك والرجل البعيد عنك».
وبالطبع فما دامت التوجيهات الملكية للوزير وتابعيه من موظفى السلطة التنفيذية بضرورة تحقيق العدل والمساواة وما دام الجميع يلتزمون بهذه التوجيهات باعتبارها توجيهاً إلهياً يرتبط فيه الإنسانى بالإلهى والدنيوى بالمصير الأخروى، فإن من الطبيعى أن يحرص عليها الجميع وتتبدى فى أعمالهم وسلوكهم اليومى فيحرصون على تحقيق العدل والمساواة والتحقيق الفورى فى أى ظلم يقع على أى مواطن ومن ثم فقد كان الإحساس العام لدى المواطن المصرى أنه يعمل فى ظل منظومة عادلة تحرص على حقوقه ومساواته بغيره. ومن هنا تولد لديه الإيمان بضرورة الجدية فى العمل والإنجاز وكان ذلك دافعاً للجميع إلى تحقيق الرخاء والسعادة والاستقرار باعتباره مطلباً قومياً فى ظل قيادة قوية عادلة.
إن حياة المصريين القدامى فى ظل «الماعت» كانت تعنى إذن بكل بساطة أننا أمام شعب يتمتع أفراده بحقوقهم التى تكفل لهم حياة سعيدة هانئة مستقرة. ومن ثم كان ولاء الجميع وانتماؤهم للوطن فى ذلك الزمان البعيد يبلغ حد القداسة.