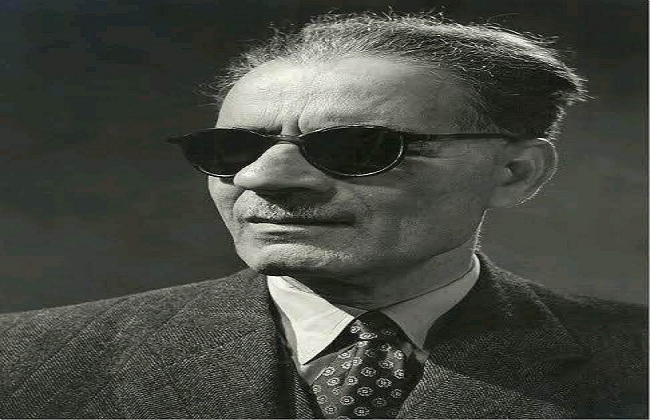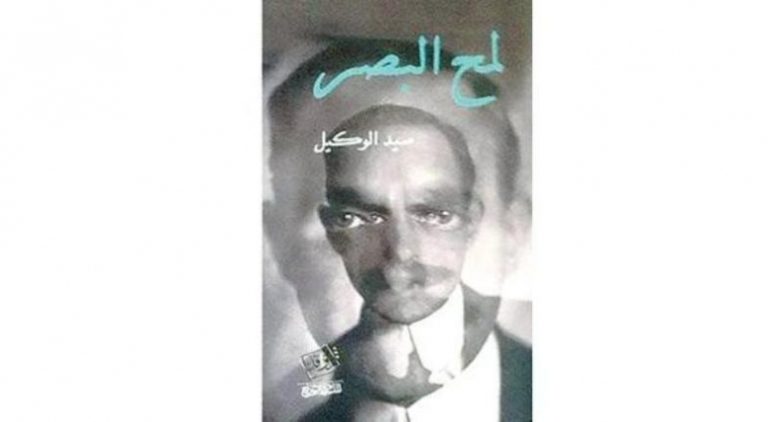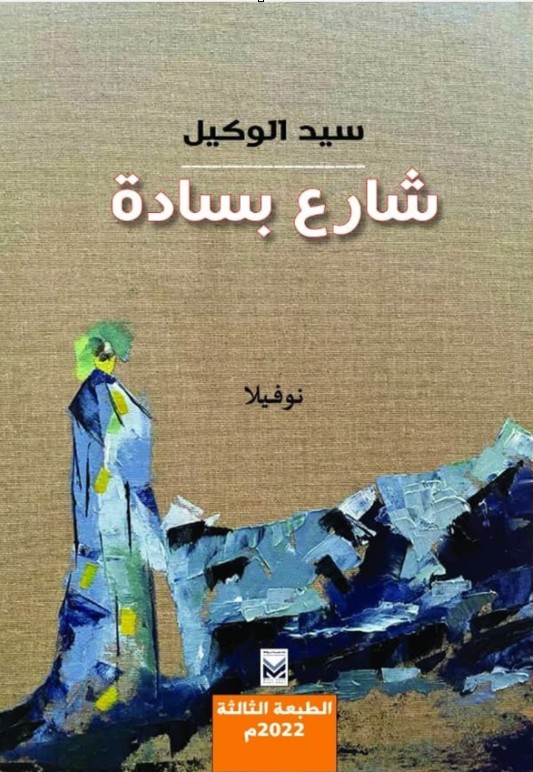ممدوح فرّاج النّابي
يفطن هرمان ملفيل في روايته الشهيرة «موبي ديك» 1851. إلى التمييز بين الخير والشرّ، وبين الإنسان والطبيعة، منتهيًّا إلى هذه القاعدة “أنّ شرور الكائن الإنسان في العنف والشدّة والحقد، لا تُقارَن بأيّ من سلوكيات الكائن الحيوان.”
«لا أرى الأشياء على حقيقتها. كنت أرى أكثر من اللازم، أعمق من اللازم« هنري باربوس، الجحيم
«على المرء ان يقتل أباه دائما». أوسكار وايلد
يمثَّل الأب في المخيال الفردي والجمعي رمز القوة والهيبة والسلطان، وقد احتلّ الأب وما يوازيه (في السلطات) مكانة عالية في مختلف الديانات والثقافات والمجتمعات (بما فيها البدائيّة التي اخترعت الطوطم، الأب الأوّل للعشيرة، والروح الحامية لها)؛ فهو السيد الآمر الناهي، والحامي والسند، وهو المثل الأعلى لابنه، الذي يريد أن يكون مكروره، وشبيهه في كثير من الحالات، ونظرًا لهذه المكانة التي يحتلها الأب (دينيًّا وعرفيًّا، و-كذلك – قيميًّا)، يرى البعض بأن آلاف بل عشرات آلاف الآلهة التي عبدها الإنسان منذ أقدم العصور، هم في الواقع رموز أبويّة أسقط عليهم المؤمنون بهم صفات آبائهم الرمزيين: الحماية وإملاء القوانين والشرائع وعقابهم.
وتأكيدًا لهذه القيمة (الماديّة والمعنويّة) التي يحتلها الأب كرمز، فإن سقوط / قتل الأب (أو ما يرمز إليه)، يوازيه عقاب للآبناء، قد يصل إلى الجنون أو المرض (فالصرع كما في حالة دوستويفسكي، بمثابة العقاب للذات التي رغبت موت الأب المكروه)، أو التوهان أحيانًا (كما في حالة الشعوب التي انتفضت ضدّ سلطة الرئيس/ الأب)، وأحيانًا في صورة عنف دموي، كعقاب أبدي (حائط مبكى أو صليب) كما في حالة الشيعة الذين يحمِّلون أنفسهم التخلّي عن الرمز الأبوي / سيدنا الحسين، وخذلانه في موقعة كربلاء (عام 61 هجرية).
ومع هذه الصورة (المثاليّة) التي تبدو عليها مكانة الأب، إلا أن العلاقة بين الآباء والأبناء تبدو عكس هذا تمامًا؛ فهي في ظاهرها علاقة مبنيّة على مشاعر متباينة تجمع بين الحب والاحتواء من طرف الأول (الأب) للثاني (الابن)، والاحترام والطاعة من جانب الثاني للأول، إلا أنها في باطنها قائمة على صراع متبادل بين طرفين؛ فالأول (الأب) يريد احتواء الثاني (الابن) بعدم الخروج عن طوعه / إرادته، في حين يسعى الثاني (الابن) إلى الانفصال (أو التمرد على) عن الأول (الأب)، فالانفصال كما يقول فرويد “أحد الإنجازات الضرروية، لكن المؤلمة”، فالانفصال أولاً راجع إلى طبيعة تأثير جنس الطفل، فالصبي يميل إلى الانفعالات العدوانيّة إزاء أبيه أكثر من أمه، وتكون نزعته شديدة في التحرّر من الأب وليس من الأم. فالتمرد يعني أنه يريد أن يكون صوته الخاص، وكأنه يسعى إلى قتل الأب، أي قتل أوامر الأب وقد تصل إلى القتل المادي على نحو ما صوّر دوستويفسكي. ومن أطرف الاستعارات التي استثمرت هذه العلاقة الشائكة ما فعله رولان بارت عندما صور العلاقة بين المؤلف وكتابه / نصه، مثل العلاقة بين الابن وأبيه؛ إذ هي علاقة لا تحول دون نمو الطفل نموًا ذاتيًّا خاصًّا به.
ونظرًا لطبيعة العلاقة الإشكاليّة، وتأثيراتها التي تتجاوز الأفراد إلى المجتمع بأثره، سعت الديانات السماوية (على اختلافها؛ يهوديّة، مسيحيّة، إسلاميّة) إلى ربطها بطاعة الرب ومخالفته، فالأب هو رمز العائلة، كما حاولت الديانات السماويّة تقنينها وتهذيبها في إطار الحقوق والواجبات، بأن جعلت للأوّل (الأب) واجبات يُسْتَوجَبُ القيام بها للثاني (الابن)، في مقابل هذه الواجبات، فرضت حقوقَا على الثاني صارت بمثابة القيد، اقترنت بالله وطاعته كنوع من الردع والزجر على عدم إغفالها. فبولس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس، بقدر ما أوجب على الأبناء طاعة الآباء في الرب(لأن إكرام الوالدين إكرام للرب)، حذر في الوقت نفسه، الآباء من سوء معاملة الأبناء هكذا: “أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره” (العهد الجديد: سفر أعمال الرسل: 6: 1-4)، وتتكرّر النصحية في رسالته إلى أهل كولوسي، هكذا: «أَيُّهَا الآبَاءُ، لاَ تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ لِئَلا يَفْشَلُوا» (العهد الجديد: سفر أعمال الرسل: 3: 21) وفي سفر ملاخي يحثّ الرب على حسن العلاقة بين الطرفين، حتى لا يحل غضبه، هكذا: «فَيَرُدُّ قَلْبَ الآبَاءِ عَلَى الأَبْنَاءِ، وَقَلْبَ الأَبْنَاءِ عَلَى آبَائِهِمْ. لِئَلاَّ آتِيَ وَأَضْرِبَ الأَرْضَ بِلَعْنٍ» (سفر ملاخي 4: 6).
وبالمثل حثّ الدين الإسلامي في مواضع كثيرة على وجوب البرِّ بالآباء وآداء حقوقهم، بل وجعلها في مرتبة ثانية بعد طاعة الله؛ فقرن الله سبحانه وتعالى رضاه برضا الوالدين، كما ورد في قوله تعالى: {وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا، إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا} [الإسراء: 23]، وفي تفسير هذه الآية، وما اشتملت عليه من آداب تجاه الوالدين، يروي السيوطي – في الدر المنثور – عن عائشة (رضى الله عنها): “أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومعه شيخ فقال: مَن هذا معك؟ قال: أبي (فقال له): لا تمشِ أمامه، ولا تقعد قبله، ولا تدعوه باسمه”، أو على نحو قوله عزّ وجل: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الأنعام: 151]، فجعلها من المحرّمات. كما أوجب على الآباء حُسن التربية ورعاية الأبناء كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [التحريم: 6].
ومع هذه الإلزامات والضوابط التي تحكم طبيعة العلاقة بين الطرفين، إلا أنّ العلاقة في كثير منها تجنح وتخرج عن مسارها، بل عُدَّ الابن عاقًا من وجهة نظر الشّرائع السّماويّة والأرضيّة، لمجرد أنه خرج عن النسق، وتمرد على الأب، إيمانًا بالمقولة “إن أبي سيظل أبي ولو كان شيطانًا رجيمًا أو مجرمًا عاتيًا في حق أولاده، وذلك لأنه مجرد أنه أوجدني”.
الجديد بالذكر أن هذا الصراع، صراع أزلي / قديم لم (ولن) يُحسم لصالح أحدهما على الإطلاق على حساب الآخر الشريك في علاقة معقدة ومتشابكة في آن معًا؛ لأن المتحكم في هذه العلاقة على تعدُّد أسبابها هو العاطفة فحسب، والعاطفة لا أحد يستطيع التحكم فيها، وتوجيهها حيثما يريد أحد الأطراف، ومن ثمّ شاب هذه العلاقة الغموض تارة، والصّراع تارات عديدة؛ لذا تشتمل هذه العلاقة على عاطفتي الحب والكـراهية المتزامنين نحـو الأب، وهذا يرمز إلى الصّراع الأبدي القائم بين كراهية الأب وحبه؛ أي بين الخوف منه كمصدر للخطر، والشعور به كمصدر للأمن في وقت واحد.
وقد تكون عوامل الكراهية التي يُكنُّها الأب للابن (في حالات نادرة واستثنائيّة) ناتجة عن الخوف منه على الملك والعرش، والشاهد على هذا ما نقلته لنا المدونة التاريخيّة عن حادثة السلطان سليمان القانوني وقتله لابنه الأمير مصطفى (38عامًا) بعدما تمّ وغر صدر الأب من قبل زوجته حُرّم سلطان بأنه يستعد للانقلاب على عرشه، وأقدم على ما يعدُّ سابقة لم تحدث من قبل، امتثالاً لنوازع شخصيّة، ثمّ استمر مسلسل القتل للأبناء فقُتِل الأمير بايزيد (37 عامًا) بعد صراعه وأخيه سليم (أبناء حُرّم سلطان) على العرش، وبالفعل تمّ تدبير الفخ له، فأسقط فيه الأمير الغاضب، وعندئذ ثار الأسد الجريج سليمان القانوني، وأرسل له وزيره محمد باشا صوقوللو لمحاربته والقضاء عليه، وكانت التعليمات السُّلطانية واضحة للوزير بألا يُبقي على ولده، وبعد هزيمته في معركة بالقرب من قونيه في مايو عام 1561، فرّ بعدها بايزيد إلى الشاه في إيران لكن رُسل موت السلطان تعقبتُه، وتمّ قتله مع أبنائه الأربعة؛ أورهان ومحمود وعبدالله وعثمان، ونُقلت جثثهم إلى مدينة سيواس حيث دفنوا،
صاغ سيجموند فرويد (1856- 1939) من هذه الجدليّة (الأب – الابن) نظريته عن العقدة الأوديبيّة التي هي “مجموعة من الأفكار والتصـوُّرات اللاشعوريّة، المثقلة بشحنة وجـدانيّة قويّة متناقضة في مضمونها الانفعالي تجاه الأب”. ويشير فرويد في كتابه “الغريزة والثقافة” (1930) إلى أنّ ثمّة أحداثًا صغيرة مرّ بها الأبناء في حياة الطفولة تتسبّب في نشوء مزاج عَكِر، يدفعهم في مرحلة لاحقة إلى أمريْن؛الأول يتمثّل في انتقاد الآباء / قتل الآباء، أو ما يوازي الرمز الأبوي في مخيلتهم في مراحل لاحقة، كالرؤوساء والمديرين والقادة إلخ… والثاني إلى تفضيل آباء آخرين على أبويه. وقد يزيد من الأمر تعقيدًا معرفة الطفل / الصّبي العلاقات الجنسيّة المختلفة بين الأب والأم، فعندها الطفل / الصبي يفهم الأب باعتباره شخصًا غير مأمون الجانب على العكس من الأم.
وفي مرحلة البلوغ يعتقد الأبناء أن تحقيق الأماني – على حدّ نظرية فرويد – يمثّل تصحيحًا للحياة نفسها، وفي ذلك يتبع الأبناء هدفيْن بالدرجة الأولى وهما: الشهوة الجنسيّة والطموح، وفي نفس الوقت تنشغل فانتازيا الطفل في هذه المرحلة بمهمة محددة ألا وهي “التخلّص من الأبوين المستهينين به وتعويضهما عادةً بمن هم أرفع منزلة اجتماعية” (الثقافة والغريزة: ص، 77). اللافت أن فرويد يعود ويقول إن مراجعة الخيالات الروائيّة، أي تصورات الأبناء للآباء في مخيلتهم، تأتي عوضًا عن الأباء الحقيقيين؛ أي فكرة تعويض الأبوين، أو إبدال الأب بمن هو أفضل منه شأنًا، فبعد المراجعة ستكتشف أن الأبوين الجديدين والنبيلين يحملان عمومًا ملامح الأبوين الحقيقيين ذوي الأصل المتواضع”.
وهو ما يعني أن محاولة رفع الابن الأب، لأبٍ أعلى منه منزلة، لا يعني إلغاء الأب على الإطلاق، وإنما هي مجرد “تعبير عن حنين الطفل إلى الزمن السعيد المفقود الذي بدا فيه أبوه من أشد الرجال نُبلاً وقوة، وكانت فيه أمه من أطيب النساء وأجملهن على الإطلاق“، وهو ما عبّر عنه أورهان باموق تعبيرًا جيدًا في ترسيم علاقته بأبيه بقوله “إننا لا نريد آباءنا أن يكونوا أفرادًا، إنما نريدهم أن يكونوا متوافقين مع المثال الذي نرسمه لهم”.
في هذه الدراسة سأتوقف عند تمثيلات مختلفة قدمت أوجهًا متنوِّعة لهذه العلاقة الصراعيّة سواء على مستوى الأدب (تمثيلات من شكسبير، وبلزاك، ودوستويفسكي، وكافكا، وباموق، ويوسف رخا)، أو على مستوى الفن / السينما كما في نموذج فيلم “الأب“، في محاولة لاستجلاء عوالم هذه العلاقة الخفيّة والمربكة في آنٍ، ومحاولة الكشف عن دوافع وأوجه الشر العائلي الذي سمّم العلاقات، وأزّم المشكلات! وشوّه الشخصيات.
البحث عن الأب
لم تبعد هذه الإشكاليّة عن سياقات الأدب ومخرجاته، فتجلّت هذه العلاقة في كثير من نتاجات المبدعين، وقدّموا تنويعات مختلفة ما بين الإيجاب والسّلب مظهرين طبيعة الصّراع، ونتائجه التي كانت – بلا مبالغة – كارثية على كافة المستويات، وقد جاءت كتابات ديفيد هربت لورانس (1885- 1935) صاحب رواية “عشيق الليدي تشاترلي” (1928) تجسيدًا لهذه العلاقة المتأزمة بينه وبين أبيه، وهو ما صوّره بصورة تفصيليّة في روايته “أبناء وعشاق” (1913) حيث عكست الرواية أزمته العائليّة، فحسب فلسفته أن الأسرة التى لا يأخذ فيها الأب دوره الرئيسى تُعدُّ – بمقاييسه – “أسرة مفكّكة وهشّة وهى عُرضة للدمار تدمرها العُقد النفسيّة التى تظهر نتيجة العلاقات الأسرية المريضة“، وهو ما برع في تصويره عبر شخصية الابن (بول)، الذي يعجز عجزًا تامًا عن منح حبه لـ(ميريام) الفتاة التى أحبها، فعجزه هو نتيجة لأثر علاقته المتأزمة بأبيه.
وقد عبّر نجيب محفوظ (1911- 2006) في مشهد رائع في رواية “قلب الليل” (1975) عن هذه العلاقة الصراعيّة على لسان محمد شكرون لجعفر الراوي عندما سأله عن موقف جده من أبيه، فقال:
“علاقة الأب بابنه علاقة غامضة على الرغم من وضوحها السطحيّ، أحيانًا يتدفق منها الحنان وأحيانًا تتجمد بالقسوة، عَرَجي هذا الذي تراه ما هو إلا عاهة صنعها أبي في ساعة غضب، أما أخلاق الرجل الحقيقية فتُقيَّم على ضوء علاقته بالآخرين…” (قلب الليل: ص: 43).
التمثيل الأدبيّ الأكثر وضوحًا لهذه العلاقة الإشكالية / الصراعيّة يتجسّد في مسرحية “هاملت” لشكسبير، على نحو ما زعم الكثير من النقاد خطأ، وإن كانت المسرحية – كما سيأتي – تُجسِّدُ لأصل هذا الصِّراع وهو الشّر العائليّ، الذي في ظني أحد العوامل الأساسيّة التي ولدت هذ العداء للأب، وبمعنى أعم خلقت هذه الشخصيات المشوّهة والعنيفة وحادّة الطباع، التي لا تبالي بأي شيء إلا نفسها.
جاء تعامل معظم النقاد والمحلّلين النفسيين أمثال (فرويد وجاك لاكان) مع مسرحية “هاملت“، بوصفها تمثيلاً لهذه العلاقة، على اعتبار أن جريمة القتل مصدرها عقدة أوديب الشهيرة كما ظهرت في مسرحية سوفوكليس “أوديب ملكًا“ حيث الأب لايوس ضحّى بابنه “أوديب” قاصدًا قتله، بعد أن تنبّأت له العرّافة بأن ولدًا سيولد له، ثم يقتله وينتزع منه عرشه ويتزوج أمه. وما إن يولد الطفل (ولم يمر على مولده ثلاثة أيام) حتى أوثق الملك قدميه، وعهد إلى أحد الأشخاص بإلقائه في جبل مهجور.
ومن ثم يكون الصّراع الذي يحكم مسرحية “هاملت“، هو صراعُ الابن وأبيه، وعلى إثر هذا الصّراع يقتل الابن أباه، كي يستحوذ على امرأته؛ لذا تتوالى الأسئلة حول ماهية القتل، على نحو: هل قتل الابن أبيه فعلًا؟ أو هل هذه هي الجريمة الأساس في المسرحية؟ أو حتى من قبيل هل هاملت الابن موجود فعلاً هنا في النص المسرحي، من أجل قتل أبيه أم من أجل الانتقام لأبيه الذي قتله أخوه من أجل أن يستحوذ على ملك وزوجته الخائنة؟ هل الصراع داخل المسرحية تجاوز الابن وأبيه إلى الأخ وأخيه، ثم بين الابن والعم؟ هل أن هاملت كان يخطط لقتل أبيه ليستحوذ على العرش، ويستفرد بأمه، وهو ما لم يتحقق، وعندما حققه العم،هل كان بمثابة إنجاز له؟
ثمة مَن ذهب إلى أبعد من هذا التحليل الذي ذاع وانتشر، واعتبر الجريمة تجسيدًا حقيقيًّا للشر العائلي بالمعنى الحرفي للكلمة، فالمحور الحقيقي للصراع داخل المسرحيّة هو خيانة العم كلاوديس لأخيه، ببثّ السُّمِّ في أذن أخيه الملك (والد هاملت)، بحديثه عن علاقته بزوجته وابنه ورغبته في أن يستحوذ على المـُلك، وهو ما يتحقّق بالفعل بعد موت الملِك، فيصير كلاوديوس هو الملِكُ ويتزوج من زوجة أخيه “جيروتورد”، فالصّراع هنا يُختصر في عبارة واحدة “صراع الإخوة الأعداء” كما وصفه حسن المودن (مسرحية هاملت: أهو قتل الأب أم قتل الأخ؟ نحو قراءة نفسانيّة جديدة، مجلة نقد،العدد الأول، ديسمبر 2021، ص 39).
فالحقيقة التي يُدركها قرّاء المسرحية أن “هاملت” لم يكن قاتلاً / شريرًا، وفقًا لمفهوم تيري إيجلتون للشر، فالشخص لكي يبادر إلى فعل الشر، لا بد أن يكون شريرًاـ (إيجلتون: عن الشر، ص 12)، على عكس العم تمامًا الذي كان شريرًا في نواياه أيضًا، فهاملت كان شابًا عاشقًا لأوليفيا، فحسب وصف غوته “إن هاملت رجل لطيف، ذو خلقية صافية سامية…”، إذن أين الخلل؟ الخلل يكمن في الشّر العائلي الذي أسهم في تبديل شخصيته، وتحويله إلى منتقم، فالثابت أن الأخ (كلاوديوس) هو الذي قتل أخيه، وليس الابن، والأم هي التي خانت الزوج والابن، فالتحول بتأثير الشر العائلي في صورة العم والأم، وهو ما يتوافق مع الأسباب التي عرضها إيجلتون والتي تدفع بالشخص لأن يؤدي الأعمال السيئة، وهي حتمية البيئة وحتمية الشخصية، ومع الإقرار بتأثير البيئة وحتميتها إلا أن فرويد يقول إن شبح والد هاملت الذي عاد، ما هو سوى تجسيد لرغبات هاملت الطفوليّة في قتل أبيه، والزواج من والدته، ويصبح الأب في هذه المرحلة، غريم الابن في حبّ الأم وعواطفها. وهاملت مثل غيره من الذكور البالغين، لا بدّ وأن يكون قد مرّ بمرحلة عقدة أوديب، التي توضح لنا أخيرًا ومن زاوية سايكولوجية دقيقة أن الشبح الذي كان يظهر لهاملت هو اللاوعي المكبوت عِند هاملت بالفعل.
ولكن لو تأملنا المشهد جَيدًا لاكتشفنا أن عودة الأب في صورة الشبح للابن، ما هي إلا عودة للانتقام من الأخ في صورة الابن (هل صدفة أن يكون اسم الأب والابن واحدًا) فكما يقول حسن المودن: “لم يكن للأب أن يعود من خلال جسده المادي، فعاد في صورة شبح، عاد روحًا تقمصت الابن من أجل أن يستمرّ الصراع بين الأخوين، من أجل أن تظهر حقيقة الأخ القاتل”
فشل بطل شكسبير هاملت المتردد في عملية القتل (الذي كان يتمناه) وأوكلها إلى عمه كلوديوس الذي تآمر مع والدته الملكة لقتل أبيه، يتكرّر مع ديمترى بطل دوستويفسكي، فهو الآخر لم يقتل أبيه رغم أمنيته القديمة وفقًا لتهديداته أمام محكمة الدير، وقام آخر بالإنابة عنه، وبالمثل في فيلم الأب نجد الأب يتخيّل زوج ابنته هو الذي يقوم بصفعه وليس ابنته، مع أن الرغبة بادية في الابنة حيث ضجرها وسأمها من تصرفات الأب، وهذا الفشل الماديّ في تحقيق فعل القتل، مع تحققه مجازيًّا (على مستوى اللاوعي) يستدعي تساؤلات عدة عن لماذا لم يتحقّق الفعل ما دامت النيّة موجودة على يد الأبناء مباشرة؟ هل فعل القتل المادي المقابل لأفعالهم المشينة في حقّ أبنائهم يرفضه الآباء منهم، على الرغم من الإيماءات بحدوثه (لاحظ دفاع الأب جوريو عن بناته، وتحميل نفسه اللوم كما سيأتي)، لذا يتحقّق عن طريق آخر (وسيط) إرضاءً لهذه النيّة، وفي ذات الوقت رغبة في عدم سقوط آخر ورقة توت تجمع بين الطرفين، مهما بدت العلاقة إشكالية ومتوترة؟
تستدعي هذه العلاقة الإشكاليّة / الصّراعيّة – في المقام الأوّل – تثبيت المفهوم الحقيقيّ للأب في صورته الطبيعيّة والسّويّة؛ باعتباره المفهوم الأصلي الذي يعدّ فيه الأب المضحي الأكبر لأبنائه يفني عمره من أجلهم، وهو ما تمثّل بصورة جليّة في نموذج “ الأب جوريو” لأونريه دي بلزاك (1799 – 1850) عام 1834، حيث رأينا صورة الأب، بكل ما تحمل هذه الصفة من قيم ونُبل وفخر واعتزاز بالأبناء (البنات)، لدرجة أنه ما إن ذكر اسم ابنته حتى نطقه بنوع من “الزهو” الذي رأى فيه النزلاء “غطرسة عجوز راح يُحافظ على المظاهر” (الأب جوريو: ص 48).
يظهر الأب في الرواية بصورة الشخصيّة المُضحيّة لابنتيه، اللتين أحبهما حبَّ عبادة، وأفرط في دلالهما، فقد “أعطى [لهما] خلال عشرين عامًا أحشاءه وحبّه” إلا أنهما قابلا هذا بجحود وعقوق، فأنكرتاه وجردتاه من كل ثروته، وأبعدتاه عن قصورهما بعدما نفذ ماله، بل إن الابنة الكبرى (انستازي دي روستو) تتمادى في هذه الجفوة، فلا تُبدي اهتمامهما به وهو مريض طريح الفراش يحتضر، أو حتى تمنحه بعض النقود لشراء الدواء والكفن والتكفل بنفقات دفنه، وهو الذي كان بذل كل جهده، وصحته وماله، لسعادة ابنتيه.
ومع هذا الجفاء والغلظة من قبل ابنتيه إلا أنه تعامل بعاطفة أبوَّة نادرة، فرفض أن يلومهما، بل قال مدافعًا عنهما: “إن ابنتي تحباني كثيرًا، أنا أب سعيد، ولكن صهريّ هما السيئان معي، أنا لا أريد لهاتين المخلوقتين، الغاليتين أن يُعانيا ويُقاسيا بخلافاتي مع زوجيهما؛ ففضلت رؤيتهما في السّر” هذه العاطفة الجيّاشة التي يُضمرها الأب تدفعه لأن يصوّر مدى حبه للجياد “التي تحرك عربتيهما” وتمنى أن يكون “الكلب الصغير الذي يحملانه في حجريهما” فهو “على سرورهما يحيا وينبض قلبه” فحسب قوله “لكل طريقته في الحب” فهو جثة كريهة، أما الروح ففارقْتُها لتحوم حول ابنتي” (الأب جوريو: ص 155 – 156). العقوق كان بسبب المال! الغريب أن الأب لم يطمع في المقابل بأي شيء سوى بحبهما الذي لم ينله. فيموت وحيدًا في البنسيون البرجوازي الذي تديره مدام فوكيه.
تتكالب على البنتين المحن، وقد صارت ثروتهما مهدّدة، عندها ينصرفان إلى الأب طالبتين العون والمساعدة، ونراه يَهِبُّ بكل ما أوتي من قوّة كي يُساعدهما، تأتي أوّلاً البنت الصُّغرى “دلفين” التي استغلها زوجها، وسعى لنهب مدخراتها، ثمّ في نفس اللحظة تأتي البنت الكبرى (انستازي)، صائحة بأنها “في غاية التعاسة، ضائعة” وعندما يسمع الأب مأساتهما يصيح بأعلى صوته “أقسم باسم الله المقدّس، أن من يؤذي أيًّا منكما، وأنا حيّ أرزق، فإنني سأحرقه على نار هادئة! أو سأمزقه إربًا…” (الأب جوريو: ص289)، ومع الأسف يعجز الأب عن إيجاد المبلغ المطلوب لنازي، فيضطر إلى أن يعلن في أسى :”عليّ أن أموت، لم يعد لدي سوى أن أموت! نعم، لست صالحًا لشيء، ولم أعد أبًا! …فمت كالكلب الذي هو أنت! أجل، أنا أقل من كلب. فالكلب لا يسلك هكذا! آه! رأسي ، إنها تنفجر!” (الأب جوريو: ص 295). يتبدل هذا كلية مع حاجته إليهما في مرضه، ورفضهما القدوم إليه، فتنتابه موجة غضب عارمة ويصرح بأنه السبب فيما وصل إليه من هجر وجفاء، لأنه دللهما، ولكنه يشعر بأسى شديد، ويلح في حضورهما،مذكرًا إياهما “بأن عدم مجيئهما نوع من قتل الأب” (الأب جوريو: ص 330).
على عكس بلزاك قدم فيودور دوستويفسكي (1821- 1888) في “الأخوة كارامازوف” (1969)صورة الأب الجاني، القاتل قبل أن يكون مقتولاً، فعلاقة الأب السيئة واللإنسانية بأسرته كانت سببًا لهذه النهاية الفاجعة التي انتهت بقتله. وقد سعى المحامي فيتوكفتش أثتاء دفاعه عن ديمتري بافلوفتش أن يبرئه من جريمة قتل أبيه “فيدرو بافلوفتش كارامازوف”، وهي الجريمة التي روّعت روسيا كلها،وفي نفس الوقت راوغ محاولاً أن يجعل من الضحيّة (الأب) جانيًّا، والجاني (الابن) ضحية، في لعبة هدفها الأول والأخير، إلقاء اللوم والذنب على الأب الذي فشل في تقديم واجباته كأب لأبنائه، فهذه المراوغة كان غرضها غير المعلن، هو طرح المفهوم الحقيقي للأب، في مقابل الصورة التي تعامل بها الأب مع أبنائه؛ فراح يستثير عواطف المحكمة بحديث فضفاض عن الأبوّة، والأب ودوره المنوط به، وواجب الأبناء نحوه، فبدأ حديثه بتساؤلات مطلقة دون إجابات، هكذا: “ما الأب يا سادتي المحلفين؟ ما الأب الحقيقي؟ وبعد أن استثار خيالهم وعقولهم يجيب في يقين أن كلمة الأب “هذه كلمة كبيرة، تسمية تهز النفس وتؤثر في القلب إلى غير حدٍّ“، فالأب كما تصوُّره هو: “إنسان وهبَ لنا الحياة وأحاطنا بحبه … [هو] رجل لم يدخر في سبيلنا وسعًا، وكان في طفولتنا يتألم إذا مرضنا، لم يفكر في حياته إلا في سعادتنا، ولم يغتذ طوال حياته إلا بما نشعر به من أفراح وما نصيبه من نجاح! ثم تساءل في استنكار: أن يقتل امرؤ أبًا كهذا الأب، فذلك سادتي شيء لا يتصوّره العقل، ولعل الخيال يرفض أن يصدّق جريمة كهذه الجريمة“، ومع هذه المرافعة التمهيدية التي بجّلتْ دور الأب كما يجب أن يكون، بغرض إزاحة التهمة عن الابن، لأنه في نظره “بين الآباء من هم كارثة” واستمر “وإذا لم نفعل ذلك لم نكن آباء أبنائنا بل كنا أعداءهم، وسيصبحون أعداءنا هم أيضًا “ (الإخوة كارامازوف، ج4، ص 480) فسيكونون أعداءنا بسبب خطئنا نحن: فـ”بالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم”.
الأب القاتل
علاقة دوستويفسكي بأبيه علاقة غامضة بعض الشيء، حتى إنه تمنَّى قتله على مستوى الواقع، وعندما حدث هذا بالفعل على يد عبيده في مزرعته، تمنّى لو تحقق الأمر على يديه؛ فالأب كان طبيبًا عسكريَّا قاسيًّا جدًّا ويتعامل مع أبنائه وفقًا لطبيعته العسكرية، فانعكست هذه التقاليد الصارِمة على علاقته بأبنائه، فدومًا ما كان يجمع بينهم هو الأوامر والإملاءات، وهذا واضح في الرسائل(القليلة) المتبادلة بينهما (أي دوستويفسكي وأبيه).
في رواية “الإخوة كارامازوف” – وهي آخر أعمال دوستويفسكي” – يجسِّد هذه العلاقة الإشكاليّة التي كانت بينه وبين أبيه في صورة مجازية / متخيّلة من خلال شخصية بطل الرواية ديمتري فيدوروفتش كارامازوف الذي جعله نموذجًا مصغرًا للأب “فيدرو بافلوفتش كارامازوف“؛ في دناءته، ومقامراته، وعربدته، فهو حسب مرافعة وكيل النيابة غير مبال بشيء، فحسب مبدؤه “فليهلك المجتمع كله، شريطة أن أكون بخير“. منذ بداية الرواية وهو لديه الرغبة في قتل الأب دون أن يشعر بذنب في ذلك أو يقر به، وعندما تحدث الجريمة يصرخ قائلاً: “لست القاتل! أنا لم أسفح ذلك الدم ! لم أسفح دم أبي، كنت أريد أن أقتله، ولكنني لم أفعل” (ج3، ص 265).
علينا أولاً أن نعيد ترسيم العلاقة بين الابن والأب كما رسمها دوستويفسكي، لنتبين أسباب هذا الحنق الذي اختمر في صدر الابن وانتهى بالجريمة، فصورة العقوق لم تكن مجانية من قبل الابن لأبيه، وإنما كانت نتيجة لفعل / سلوك الأب الذي تلخصه هذه العبارة الفاتنة لمحفوظ على لسان بطل روايته “قلب الليل” هكذا “عرجي كان عاهة صنعها أبي“، وليس كنتيجة – كما حاول أن يبرر فرويد – للتنافس الجنسي بين الأب والابن على المرأة، فقتل الأب الرمزي والمادي والذي يُخالِف ما تعارف عليه في المجتمعات البدائية من المحافظة على الطوطم وعدم قتله كاستجابة لعرف مقدس بألا يبيدوا طوطمهم، وأن يستغنوا عن لحمه أو أي متعة يمكن أن يقدمها، فدوستويفسكي صنع لبطله كل عوامل الحقد والجفاء لأبيه، فكما يقول فرويد إذا كان الأب صعبًا وعنيدًا وقاسيًا، تأخذ الأنا العليا منه هذه الصفات، وهو ما كان في حالة ديمتري الذي هيّأ له دوستويفسكي كل الظروف لأن يكون هكذا، فهو : ابن لـ:
- أب مقامر دنئ، يستولي على أموال زوجهته كرهًا.
- وأم تهجره وهو في الثالثة من عمره، وتذهب مع شاب صغير.
- ينساه الأب، فيرعاه “خادم أمين: جوريجوري لمدة سنة في كوخ يسكنه الخدم.
- بل يقطع الراوي أي صلة للطفل بأفراد من عائلة أمه :
- فأسرة أم ميتيا “قد بدا أنها نسيت الصبي”، والجد الشيخ “ميوسوف “أبو آديلائيد إيفانوفنا ، بارح هذا العالم إلى العالم الآخر، وأرملته انتقلت من موسكو تعاني المرض، في حين أخوات آديلائيد فكن قد تزوجن. لذا كان البديل عن هؤلاء الخادم جوريجوري.
- ثم تعود كفالته إلى بيتر ألكسندروفتش ميوسوف ابن عم “آديلائيد”.
- يعود الابن مطالبًا بميراثه من أمه.
- يفطن الأب لشخصية الابن، ويستغل رغبته للمال من أجل نزواته.
- يعيش في المدينة “لاهيًّا، قاصفًا، مستترًا” مشوّش الذهن مندفعه.
- يصل إلى مرحلة الاهتياج المرضي في خصوماته مع أبيه.
- تكون جروشنا وظنه أن أباه أغواها بالمال، وستتركه هي نقطة النهاية في علاقتهما.
بهذه الصّورة يكون دوستويفسكي رسم صورة مزرية للأب بسبب دناءته وخسته وعربتده وسكره الذي لا يفيق منه، هذه الصورة ربما تدفع بشكل غير مباشر إلى عدم التعاطف معه، خاصة في تعامل ابنه الأكبر معه (وهو الأمر الذي لم يختلف مع ابنيه الآخرين من زوجته الثانية (صوفيا إيفانوفنا)؛ إيفان وإلكسي، فهما أيضًا نسيهما نسيانًا تامًا وهجرهما هجرًا كاملاً، وضمهما الخادم الأمين جريجوري في كوخه مثلما ضمّ إليه أخاهما ميتيا من قبل)، هكذا نشأ الأبناء الثلاثة وهم يشعرون بأن أباهم “إنسان شاذ يضيق المرء ذرعًا حتى بالكلام عنه”، وجراء هذا فإن الابن الثاني إيفان بعد وفاة المعتني به “إيفيم بتروفتش”، ولصعوبة تحصُّله على الروبلات الألف التي أوصتْ بهما الجنرالة المهووسة له ولأخيه، وإزاء التعسُّر والمصاعب أثناء الدراسة في الجامعة رفض أن يطلب العون من أبيه، وحسب دوستويفسكي؛ فالرفض كان “إما عن كبرياء وشمم في نفسه، وإما عن احتقار وازدراء لأبيه، وإما لأن عقله الهادئ الرصين، قد حدّثه بأنه ليس له أن يعوّل على الحصول من أبيه على معونة ذات بالٍ” (الإخوة كارمازوف: ج1، ص 50).
فدوستويفسكي البنّاء العظيم، رسم معالم هذه الشخصية بحيث يقطع أيّة مشاعر تعاطف معه أو إيجاد محاولة للوم الابن على معاملته القاسيّة، ففي الفصل الثاني، بعد أن يستعرض سيرة الأب وقد هجرته زوجته، بأن هربت مع شاب صغير إلى بطرسبورج؛ بسبب احتياله عليها ونهبه لثروتها، وما إن يُقرِّر ملاحقتها في بطرسبورج، حتى يأتي له خبر وفاتها المفاجئ، وكانت تركتْ له طفهلما الصغير “ميتيا” الذي رعاه خادم وفِيّ اسمه جريجوري “وقد حَنا على الصغير، … وضمّه إليه وعنى به“، نراه يعنون دوستويفسكي الفصل الثاني بعنوان صادم: “كيف تخلّص من ابنه الأول”، فالراوي في إشارة إلى تبرير هذا الفعل الشائن كما يظهره عنوان الوحدة الثانية؛ يقول: “ليس من الصعب طبعًا أن نتخيّل كيف يقوم مثل هذا الرجل بواجباته أبًا ومربيًّا [فهو] لم يعبأ قط بالطفل الذي ولد له من آديلائيد إيفانوفنا، وجهله جهلاً تامًا. لا لأنه يضمر له كرهًا ويحمل له حقدًا من حيث إنه زوجٌ خانته امرأته، بل لسبب بسيط جدًّا، هو أنه قد نسيه نسيانًا تامًا”
هكذا يبدو نموذج الأب في علاقته بأبنائه، مُفتقدًا لكل مشاعر الأبوة وما تحمله من حنان وشفقة ورعاية، وقد تجسدت هذه العلاقة في أبشع صورها في علاقة الأب بابنه الأكبر ديمتري فيدورفتش؛ فهو الابن الوحيد من أبناء فيدرو فافلوفتش الثلاثة الذي شبّ على الاعتقاد بأنه “يملك ثروة لا بأس بها ستؤول إليه حينما يبلغ سن الرشد”، فأواصر العلاقة بينه وبين أبيه تكاد تكون مقطوعة منذ طفولته، فهو “لم يرَ أباه لأول مرة منذ تركه في طفولته، ولم يعرفه إن صح التعبير، إلا بعد بلوغه سن الرشد بقليل” (الأخوة كارامازوف، ج 1، ص 42)، أوّل لقاء جمع بينهما كان بسبب الميراث، ولم يمكث كثيرًا إذ نفر منه وقفل راجعًا بعد أن عقد معه اتفاقًا غامضًا ماديًّا مفاده “أن يرسل إليه أبوه ريع أرضه تباعًا، دون أن يستطيع حمل أبيه على أن يعين له قيمة الأرض وإيرادها” (الرواية: ج 1، ص 42). يتكرّر اللقاء بعد أربع سنوات بعدما يصل إلى أبيه ليسوي ميراثه، فيفاجأ بأن “أصبح لا يملك شيئًا البتة” فحسب رواية أبيه بأنه “قد قبض بالك الدفعات المتعاقبة مبالغ يصعب تحديدها على وجه الدقة، ولكنها تتجاوز قيمة الأرض الموروثة على كل حال، حتى إنه قد يكون مدينًا لأبيه الآن، وأنه بحكم الصفقات التي أبرمها في التواريخ الفلانية، والفلانية لا يحق له أن يطالب بشيء البتة! إلخ .”(ص 43)
في مشهد المحاكمة بين الأب “فيدور بافلوفتش” والابن “ديمتري” الذي وقعت أحداثه في الدير، ينكشف ما تكنه الصدور على الرغم من المشهد الاستعراضي الذي أجاده ديمتري أمام الجميع حيث حيّاه تحيّة إجلال وتقدير عظيم، بأن انحى له انحناءً شديدًا، وهو ما قابله الأب بانحناءة مماثلة، وهو مشهد مخادع تمثيلي بامتياز أمام الجميع، فما إن انتهى سجال إيفان والشيخ عن الروح ومعتقداته، حتى راح الأب يفتخر بهذا الابن إيفان فيدروفتش، في مقابل الانقضاض على ديمتري، فدون سابق إنذار توجّه إلى الشيخ قائلا: “أيها الشيخ المقدّس الرّباني، هذا ابني (في إشارة إلى إيفان)، هذا فلذة كبدي، هذا ولدي الحبيبّ! إنه أكثر أبنائي احترامًا؛ هو من نوع “كارل مور” قليلاً إن شئت… أما ابني الذي وصل الآن، ديمتري فيدورفتش هذا الذي جئت أستعين بك عليه. فإنه أقلهم احترامًا، إنه صنو “فرانتس مور”، إنك تعرف هذين البطلين من أبطال مسرحية شيللر “قطاع الطرق” اقض في الأمر! أنقذنا فنحن في حاجة لا إلى دعواتك فحسب، بل إلى نبواءاتك أيضًا” (ص : 162).
لا يكتفي الأب فيدور بهذه المقارنة التي تكشف مخاوفه من ابنه، وإنما يقوم بتعرية الابن تمامًا أمام الجميع، ليزود التهم عنه والتي هم مجتمعون بشأنها؛ فيفضح ابتزازه له بالمال، واستغلاله للعفيفات الشريفات بالروبلات، وكيف أنه كسر قلب خطيبته، اللافت أن ديمتري يقابل هذا المشهد الابتزازي من الأب بسخرية واصفًا إياه بأنه: “ممثل هزلي وقح”، وهو ما يستغله الأب لصالحه، فيحاول أن يستثير الجميع قائلا: “انظروا كيف يعامل أباه! فهل تتصورون معاملته للآخرين؟”، ويبدأ في استعراض ما فعله بالرجل الفقير المتقاعد، وكيف أنه أمسكه من لحيته في إحدى الخمارات، وجرّه إلى الشارع وأخذ يضربه ضربًا مبرحًا على مرأى ومسمع من جمهرة الناس
في الحقيقة أن ديمتري استبق الأحداث المفجعة وقتل أباه بالكلمات كما هو واضح في تساؤلاته: “لماذا يجب أن يعيش مثل هذا الرجل؟ هلا قلتم لي، هلا قلتم لي هل يجوز أن ندع له أن يدنس الأرض برذائله مدة أطول؟” (الرواية: ج1، ص 169). يأخذ الصّدام بين الابن ديمتري والأب فيدرو بافلوفتش، طورًا آخر يصل إلى حدّ الاعتداء عليه الصريح، عندما يقتحم ديمتري بيت أبيه بحثًا عن جروشنا (حيث كان يظن أن أباه أغواها بالمال كي يتزوجها)، فيتطوّر الأمر والصراع على أشده بأن يعتدي ديمتري على أبيه حيث “أمسك العجوز فجأة من خصلتي شعره الباقيتين على صدغيه، وشده منهما شدًا قويًّا فرماه على الأرض في قرقعة، واتسع وقته كذلك لأن يطرق وجه أبيه بكعب حذائه مرتين أو ثلاثًا وهو متمدد بين قدميه، فأطلق العجوز من صدره أنينًا حادًّا”(الرواية: ج 1، ص 306)، وأثناء تخليص أخويه (إيفان وإليوشا) الأب منه، يصرخ إيفان فيه قائلا: “أيها المجنون، لقد قتلته”، فصاح ديمتري قائلاً وهو يختنق:
- “هذا ما يستحقه! وإذا أخطأته هذه المرة، فسأعود مرة أخرى لأجهز عليه! ولن تحموه مني عندئذٍ!” وعندما همّ بالخروج رمقه بنظرة تفيض كرهًا وبغضًا وقال له:
- “لست نادمًا على أنني سفحت دمك! حذار أيها العجوز إذا كان ما يزال لك أمل، فاحذر من أملي أنا! إنني ألعنك وأتبرأ منك!”
بعد أن تمّ قتل الأب فعليًّا، واتهام ميتيا من قبل الشرطة بأنه هو القاتل، يدافع عن نفسه، ويعترف بأنه يكرهه والكل يعرف هذا، وأنه اعتدى عليه في الدير في حجرة الشيح زوسيما، وهدده بأنه سيقتله لكن لم يفعل، ويصفه في اعترافاته بأنه :”نعم يا سادتي… كنت أكره مظهره؛ كان في هيئته ما يوحي بالدنس، كان فيه تبجح واحتقار لكل ما هو عظيم مقدّس، كان فيه سخرية وكفر.. أوه! كان هذا دنيئًا، دنيئًا جدًّا! ولكنني الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود” (الرواية: ج3، ص 275)، وعندما يسأل: “هل أنت نادم؟” يقول: “لا، لا يعني أنني نادم، … أنا نفسي ملئ بالعيوب أيها السادة! أنا لست مثال جمال النفس، فلم يكن من حقي أن أنفر منه ذلك النفور كله…. ” (الرواية: ج3، ص 275).
وبعد أن تُليت عليه التُّهم، وفقًا لاستجواب قاضي التحقيق، وبما أنّه عجز عن تبرئة نفسه، فقد قُرر أن يودع السجن، كي لا يستطيع الفرار من وجه العدالة، وما إن أُعلم ميتا أنه معتقل حتى أقر قائلا: “ليكن ما تشاؤون لست أؤاخذكم ..” ولكنه طلب الكلمة، وقال ضمن ما قال، وكأنها مرافعة نهائية: “لحظة أيها السادة! نحن جميعًا قساة، نحن جميعًا وحوش مفترسة…. ولكنني أنا – أقول هذا جهارًا على رؤوس الأشهاد هنا – أنا أنذل الناس، وأدناهم طرًا. إنني أسلم بهذا. وما من يوم انقضى في حياتي إلا حلفت فيه، وأنا ألطم صدري، لأصلحنّ أمري، ولأقومنّ عوجي، ولكنني كنت أهوى إلى أخطائي منذ الغد. إنني أدرك اليوم أن رجالاً مثلي محتاجون إلى أن يضربهم القدر، حتى يصل إلى قوله: أيها السادة أؤكد لكم آخر مرة: أنني لم أسفح دم أبي! إنني أقبل العقاب لا على قتله، بل على أنني أردت أن أقتله، وربما كنت سأقتله في النهاية …” (الرواية: ج 3، ص 366) وفي أثناء المحاكمة يصفها بأنه “العجوز العدو وأبي”، هكذا “برئ من مقتل العجوز عدوي وأبي(الرواية: ج 4، ص 314).
الأب سارق السعادة
علاقة فرانز كافكا (1933 – 1924) بأبيه علاقة من نوع خاص، فكافكا يُحمِّل والده كل التعاسات والعثرات التي عرقلت حياته، فيعيب عليه أخطاءه في التربية، لذا نراه – في أكثر من موضع – يسرد عن عنفه وقسوته؛ فهو لم ينسَ له في طفولته تلك الحادثة التي كشفتْ له عن غلظته وعدوانيّته. فكافكا الطفل آنذاك في إحدى الليالي، كان قد ألحّ في طلب الماء، وإذا بالأب لم يكتفِ بالتهديد الغليظ، وإنما قام وانتزع الطفل من سريره وقاده إلى الشرفة، وتركه فيها لبرهة من الوقت وحيدًا بقميصه الداخلي. وقد كان لهذه الحادثة تأثيرها الكبير في سنواته اللاحقة، فكما يقول كافكا في رسالته لأبيه “صرتُ أعاني من تصورات مضنية مفادها أن ذلك الرجل الضخم، والدي، مَثَلي الأعلى، كان بإمكانه أن يجرّني من السّرير ويمضي بي نحو الشرفة، وأنني لم أكن بالنسبة إليه سوى نكرة”، لم يكن ذاك حينئذ سوى البداية؛ غير أن ذلك الشعور بالدونيّة واللاشيء، والذي سيستحوذ عليّ كثيراً (وهو شعور مُجْدٍ ومثمر من وجهة نظر مغايرة)، ليس إلا نتاجًا لأثرك عليّ“، وهو ما أكده غوستاف يانوش بسؤاله لكافكا” ألم يكن هو الصرصار التعس في قصة التحول؟”.
الغريب أن كافكا يأخذ من هذه التجربة صورتها الإيجابيّة على ذاته؛ فهو يدين له بأنه بمعاملته القاسية، صَرَفه للكتابة كي يُفرّغ فيها ما لم يستطع أن يُعبّر عنه شفويًّا، حتى إنه يخشى إذا قال “إنني لم أكن سوى ذاك الذي أصبحْتُه من خلالك” يُتهم بالمبالغة.
اللافت أن كافكا لم يكن يُضمر لوالده هذه الصُّورة السّوداوية وفقط، بل هو يرى أنه ضحية العائلة كلها، في إشارة ذات مغزى لأن الشر يكمُنُ في العائلة، وهي الحقيقة التي فطنت إليها الروائية أجاثا كريستي (1890- 1976)، وعبرت عنها في جرائم القتل التي تحدث داخل العائلة في كثير من أعمالها؛ فعندها الشر “محلي داخلي، وليس شيئًا بعيدًا خارجيًّا … (والأكثر فداحة) أن الحب أكثر خطرًا من الكراهية“، وقد نمّى لديه هذا الإحساس المبكر بالعائلة شعور بأنه وسطهم كالغريب “أعيش في أسرتي غريبًا أكثر من غريب، مع والدتي لم أتحدث في السنوات الأخيرة عشرين كلمة في اليوم، ومع والدي لم أتبادل قط أكثر من كلمات التحية، ينقصني كل حسٍّ للمشاركة مع الأسرة”.
غِلظة الأب تجعله يتعالى على أن يُصرِّح له بحبُّه له هكذا “لطالما أحببتك. وإنني إذْ لا أُصارحك بهذا، كما هو شأن بقية الآباء، فما ذاك إلا لأني لا أستطيع أن أكون دَعِيًّا مثلهم“. وهو الأمر الذي كان له تأثير سلبيّ بعلاقته بالعائلة، فقد تنامى في داخله شعور بافتقاد حسّ الانتماء للأسرة، على نحو ما صرّح في رسالته إلى والده.
وقد كان لعلاقة كافكا الملتبسة مع أبيه، أثرها في تحليلات النقاد، سواء في كتاباته أو في علاقاته الشخصيّة، فمثلا لويس غروس – في كتابه “ما لا يُدرك كله” – يقول: “كانت الفتيات عند فرانز كافكا – على ما يظهر – وسيلة شائقة للهرب من تأثير سلطوية الأب، ذاك القاسي والبغيض، هيرمان كافكا، الذي كان يحتقر موهبة ابنه الأدبيّة. فقد بحث الكاتب في العالم الأنثوي عن قوة موازنة للفحولة الأبويّة المستبدِّة. إلا أن هذا الأب قد ساهم لاإراديًّا في تشكيل نتاج أدبي وُظّف على الدوام في مواجهة القيود التي كانت الأقدار تفرضها عليه. كان كافكا يحسُّ دائماً بأنه وحيد، ومذنب من دون حتى أن يعرف ما هي أخطاؤه، مُنتظرًا عقوبات رهيبة على ذنوب كان عليه في نهاية المطاف أن يرتكبها، ليبرّر لاحقًا، تلك السياط التي لا مفرَّ منها. إن نظرته إلى نفسه تشي بإحساس خذلان لا يخلو من التبجح. ويتجلّى هذا الأمر أكثر “عندما يقارن نفسه بالأشخاص الذين يُفترض أنهم واثقون وسعداء ومحققون لذواتهم.”
كشف كافكا عن توتر علاقته بأبيه في رسائله إلى ميلينا، وأرجع سبب تعاسته لهذا الأب، ومن ثم تجاسر وكتب رسالته إلى أبيه بعد صدامه معه بسبب رفضه لزواجه من “يورلي فوريتسك”، وفيها يُفنِّد أسباب الشقاق بين الطرفين. يعمد كافكا إلى وسيط كتابي، بعيدًا عن المواجهة وجهًا لوجه، وكأن الخوف الذي كان سدًّا بينهما ما زال قائمًا، فها هو يُعلن له عن رواسب هذا الخوف التي تركتها معاملته في داخله، بأن لجأ إلى هذه الحيلة للتراسل، فكما يقول: “أبي الحبيب.. لقد سألتني مؤخراً: لماذا أزعم أنني أخاف منك؟ وكالعادة لم أدر بماذا أجيبك. تارة بسبب الخوف الذي يعتريني أمامك، وتارة لأن الكثير من التفاصيل متعّلقة بحيثيات ذلك الخوف، بحيث لا يكون بوسعي لملمة شتاتها في الحديث معك ولو جزئياً. وإنني إذ أحاول هنا أن أجيبك خطيًّا، فإن كل ما أقوم به لن يكون سوى محاولة مبتورة، وذلك لأن الخوف وتبعاته يصدانني عنك حتى في الكتابة، ولأن جسامة الموضوع تتعدّى نطاق ذاكرتي وإدراكي“. وبدلاً من أن يكون هناك امتنان من الابن لأبيه نظير ما يبذله من أجله وأجل أخوته، قابل هذا الابن بانزواء ونفور ، أي أن معاملة الأب خلقت مسافة بينهما، وباعدت بينهما، على عكس ما يجب أن تكون علاقة الأب بابنه، فكما يقول: “رحتُ أنأى بعيداً عنك إلى الغرفة والكتب وأصدقاء معتوهين، وإلى أفكار غريبة الأطوار. لم أصارحك يوماً بحديث، لم أتعهدك مرة في المعبد، لم أزُرْك مطلقًا في Franzensbad) )، بل لم يكن لدي حتى حس الانتماء للأسرة. لم أكترث يومًا لأمرك ولا لشأن من شؤونك. ألقيتُ بكل ثقل المتجر على كاهلك وتركتك وحدك. رحتُ أقف في صف أوتيللا، وعنادها، بينما لم أكن أحرك ساكنًا من أجلك أنت (لم آتك مرةً بتذكرة مسرح)، بينما أفعلُ كل شيء في سبيل الغرباء.
أنهى كافكا رسالته بتوقيع حيادي “فرانز”، وكأنّه بعد هذا العدد من الصفحات انتهى إلى غرضه من الرسالة التي بدأها بـ“أبي العزيز”، ها قد صرتُ أنا بعيدًا عن سطوتك، وقد استقى نقاد كافكا من هذه العلاقة أن أدب كافكا ليس خياليًّا أو كابوسيًّا على نحو ما رددّ الكثير من النقاد، وإنما هو أدب واقعي، فمعظم شخصياته تعود لجذور واقعية، وكأنه يريد أن يقول – حسب تعبير إبراهيم وطفي، مترجم الأعمال الكاملة – على لسان الأب: أنا هرمان كافكا إذا لم تعمل كما أشاء، فأنت حشرة ضخمة. وأنا فرانز يوزف إمبراطور النمسا إذا عارضتني، فأنت جرثومة. هنا يمكن أن نفهم كيف أدبه يصف الواقع عبر صور شعرية”.
حقيبة الولاء
على عكس كافكا تمامًا تأتي رسالة أورهان باموق (1952 -…) لأبيه، فباموق يكشف عن علاقة مثالية وصحيّة بوالده، على عكس علاقته بوالدته “شكورة” التي ظل معها بعد انفصالها هي ووالده، فالعلاقة لم تسودها المحبة بل الجفاء والسخرية، فالأم كانت تسخر من كتابته، وترى أنه يمارس عبثًا، وهو ما كان له انعكاس سلبي عليه، فسخر منها في رواية “اسمي أحمر” (1998)، وبالمثل في رواية “ليالي الطاعون” (2021) جعل بطله (كامل آجاسي قول) يستاء من زواج أمه الثاني بل وينقم عليها. وفي مقابل غياب رسائله لها، نراه يخصُّ الأب بأكثر من رسالة؛ الأولى كانت مرثية للأب بعد وفاته عام 2002، والثانية كانت في حفل خطاب نوبل عام 2006، إذ جعل من حفل التكريم، مناسبةً لتقديم الشكر والامتنان لأبيه الذي غرس فيه حبّ الإطلاع ونهم القراءة، بل خلق في داخله روح الأديب، وآثَره على نفسه.
باموق في المرثية لا يبث شكواه ذاته فحسب، وإنما ما إن يُصادف سائق التاكسي، حتى يبدأ في الحكي عن أبيه، ويبدأ حكايته بجملة تقريرية خالية من أي زخرف وأناقة هكذا “أبي مات“، تذكرنا – مع الفارق -بحياديّة مورسو بطل “الغريب” (1942) لألبير كامو، ثمّ يسرد له عن صفات أبيه بأنه كان “رجلاً طيبًا جدًّا” بل ويعترف له “والأكثر أهمية أنني أحبتته” ويستمر” أبي لم يوجه إليّ أبدًا كلمة تحقير، لم يشتمني أبدًا، لم يضربني أبدًا”.
في مقابل والد كافكا الذي لم يكن داعمًا له، بل وبخه لأنه عرف أنه يكتب في الليل، مُتعلِّلا بأن فاتورة الكهرباء تأتي مرتفعة كل شهر، وعندما فتش عن السبب وجد مصدره الضوء المنبعث من غرفته؛ كان والد باموق داعمًا بأكثر من شكل، ففي طفولته “كان ينظر بإعجاب ملء القلب إلى كل صورة يرسمها، كان يتفحص كل خط وكل نقش وكأنما هي لوحة من اللوحات النادرة“. بل كان للثقة التي منحها له الأب هي السبب الرئيسي ليكون كاتبًا.
وفي كلمة “نوبل” يكون حضور الأب أكثر من حضور الابن الذي يتوارى إلى الهامش مع أنه النجم الذي يتوّج، فيحكي عن الحقيبة التي أعطاها له الأب قبل وفاته، وتلك الحيرة التي كانت بادية على الأب لإخفاء الحقيبة، وكأنه “يريد أن يُريح نفسه من حمل يثقل كاهله” وكيف أنه كان يقاوم فتح هذه الأمانة، لأسباب عدة، لكن أهمها – كما يرى – خشيته من أن يكون ما يكتبه أبوه أدبًا عظيمًا، وهو يريد أن يكون هو أباه فحسب وليس كاتبًا، كما يسرد عن ثقافة أبيه وذائقته الأدبيّة، وأهم كُتّابه المفضلين، وكيف كوّن مكتبته التي أحضر معظم كتبها من باريس وأمريكا.
لم يكن حضور الأب مجرد حضور افتخاري (قيميّ) أو مجرد إشادة بتأثيره عليه، وإنما كان حضورَ امتنانٍ للدور الذي لعبه في حياة ابنه سواء بالمباشرة أو غير المباشرة، فوالد باموق تجاوز صورة الأب الرومانسي في خيال الأبناء، وحتى ذلك الأب البديل في أذهان من يقتلون آبائهم، كان أبًا حقيقيًّا قبل كل شيء، ومُلْهِما بشتى الطرق؛ ملهمّا في تنوّع ثقافته وقراءاته، وملهمًا في التحديق إلى مركز العالم، حيث هناك حياة أكثر ثراءً، ومهلمًا لأن يعرف طريقه نحو الغرب، ومن ثمّ كانت هذه الحفاوة، والاعتراف بفضل الأب الذي تنبّأ له بأن “يكون باشا” ويحصل على جائزة نوبل منذ أن قرأ مخطوطة روايته الأولى “جودت بيه وأبناؤه” (1982).
الأب النص لا يكتب
كتب يوسف رخا نصين عن الأب، الأول بعنوان ” أبي نصٌّ لا يُكتب” ونشره في موقع ثمانية، بتاريخ 13 يونيه، 2021، والثاني نشر تحت عنوان “أبناء الشخصيات” في موقع “مدى مصر” بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والنص الأخير كان بمثابة رسالة إلى الأب بمناسبة ذكرى رحيله الواحد والعشرين. تراوغ يوسف رخا صورة الأب الذي يغافله وتتسلّل – رغمًا عنه – إلى نصوصه – أربعة عشر نصًّا أدبيًّا – على صورة هيئته في حياته: “قارئًا فكِهًا وصديق كتّاب، مؤرِّخًا مغمورًا وسياسيًّا محبطًا، زوجًا باردًا وأبًا تفادى الأبويّة وهو يُمارس أُبُوَّتَه بخفة باهرة”، لكن المفارقة فإنه كلما حضر حسب قوله “أشعر كأني أقتله من جديد وأمشي في جنازته”. لكن مع هذا فهو لا يحضر إلا عبر “إشارات جانبية جبانة”. وهذه الإشارة لا تأتي مباشرة وإنما تأتي عرضًا وهو بصدد معالجة موضوع آخر.
هذه الإشارات الجانبيّة ما هي إلا تأكيد عن حالة اللامواجهة التي يخشاها الابن لأبيه أدبيًّا، ومع بداية عامه الخامس والأربعين أدرك لماذا، فهو في كل مرة يكاد يشرع في الكتابة عنه، حتى تشله المخاوف والأحزان، لا لأن شبحه “يرفض الحلول عليه” أو أنه “يراوغه ويعنفه إذا حلّ“، مخاوف الاستحضار أو الاستدعاء كامنة في ألا يريده أن يتحوّل إلى صورة مزيفة بعيدة عن تلك التي عرفها أو يريدها، أو تكون الصورة مجرد صليب يجلد عليه ذاته، يل يخشى بأن “أشعر أني أمتهنه وأستغل آلامه”.
ومع هذه المخاوف والاحترازات إلا أن صورة الأب كما عاشاه في مرضه أو في حياته تنفلت منه رغمًا عن إرادته، فنرى الأب المريض الذي يبتز عواطف زوجته وابنه بالمرض، واقتراب النهاية، وما سببه هذا من إجهاد لكليهما، حتى إن الابن أحيانًا كان يهرب كي لا يضطر” إلى مساعدتها ورؤيته“ـ وهذا الابتزاز كان له مردوده عند وفاته الحقيقية فموته “لم يكن أمرًا صادمًا، لم يكن مأساة”، ومع هذا فإنه لا يعفى نفسه وأمه مسؤولية قتله “يبدو لي أننا عرفنا يوم موته لأننا تسببنا فيه. بسأمنا ويأسنا. منحنا مَلَك الموت الضوء الأخضر لحظة تبادلنا نظرة يتبعها بكاء. يبدو لي أننا قتلناه.” الإحساس بالقتل يكمن في طلب الابن بأن يستريح من عبئه، فإحساس الضجر لديه يتزايد “لقد مللتُ محاولة إيقاظه أو تنشيطه. مللتُ حتى تعنيفه أملاً في أن ينهض ويفتح عينيه.
تتعدد صورة الأب – المقتول – التي تظهر داخل نصوص الابن، فهو تارة يأتي في شخصية المحامي الماركسي، أو في صورة جنازة مثقف عربي بلغ به الاكتئاب أن فقد الصلة بالأصدقاء والكتب.
تستحضر صورة الأب والكتابة عنها، صورًا رديفًا للتحولات التي مرت بها مصر في النصف الثاني من القرن العشرين في مصر، حيث حياته تعد نقطة تماس بينها، فكما يقول :” أن أكتب عن أبي يعني أن أكتب عن الحركة الشيوعية وعبدالناصر، عن الليبرالية والتنمية، عن الفحولة مقابل دعم تحرير المرأة وما في ذلك وسواه من تناقضات أخلاقية، يستتبعها الانتماء إلى مجتمع محافظ في وجود قناعات فردية وتقدمية. ولو كتبت عن هذه الأشياء، فأين يكون الشخص الذي عرفته؟” وكأنّه يريد أن يستولد صورة أخرى من صورة الفحولة التي كان يرى الأب عليها.
الشر العائلي
يدور فيلم الأب (2021) من بطولة “أنتوني هوبكنز” ومن إخراج فلوريان زيلر (المأخوذ عن مسرحية “الأب” للمخرج ذاته)، يطرح الفيلم سرديّة الشّر العائليّ المستتر بمعنى أوسع، حيث افتقاد شعور البنوّة، فلا يلاقي الآباء سوى الهجر والوحدة من الأبناء عندما يتقدم بهم العمر، بدلاً من أن يكونوا أكثر قربًا وأكثر حنانًا. طرح الفيلم هذه العلاقة الإشكاليّة بطريقة صادمة للجمهور الذي تفاعل مع أحداث الفيلم الذي يدور حول أب مسن مصاب بألزهايمر، يُعاني من افتقاد العناية به من قبل أبنائه، وفي نفس الوقت يفتقد لوجود أبنائه (بناته) إلى جواره، هذا الشعور يفاقم من أزمته الصحيّة، وهو ما يسبب له أزمة داخلية يترجمها برفضه مساعدة أي شخص، بما في ذلك تلك الممرضة التي أحضرتها له ابنته، ثم الجليسة في مرحلة لاحقة.
حالة فوضى الذاكرة والتشتت التي يعيشها الأب تكشف عن حالة افتقاده لمشاعر البنوة، والتي يحتاجها بشدة في هذه الفترة المتأخّرة من العمر، مع اعتلال صحته وتشتت ذاكرته، كمقابل لما منحه لهم في فترة طفولتهم وشبابهم، – وبالتالي – ها هو الدور قد جاء عليهم، ليمارسوا واجبهم/ دور الأبناء الأبرار لصالحه، لكن مع الأسف لا وجود لهم في واقعه. سرديّة الفيلم تكشف عن جحود الأبناء وعقوقهم، في مقابل ضعف الآباء وحاجتهم لعون الأبناء حتى لو لم يُعبِّروا عن ذلك مباشرة، وإنما بالتحايل والمراوغة. لذا نرى الأب (أنتوني) يستعين على ذلك بتخيُّلات مع شخصيات راحلة مثل شخصية ابنته الرسامة، أو الشخصيات الثنائيّة (آن وآن) و(لورا ولورا) كتعويض عن حالة افتقاد لأشخاص حقيقيين، يحتاجهم كسند في هذا السن، وعندما تحضر لورا جليسته (التي تعمل في مساعدة الآخرين) نجد روح المرح؛ الروح الطفوليّة تبزغ منه، فيتخلّى عن وقاره ويبدأ الضحك والرقص، وكذلك يتجلّى هذا في اعترافاته التي يستعيد فيها ابنته الصغيرة الراحلة، فهي المفضّلة عنده، ولما يشعر بالوحدة والافتقاد للأبناء ينفصل عن واقعه بالصوت الأوبرالي العالي.
مع المشهد الأول / الافتتاحي للفيلم، تطارد الكاميرا الابنة وهي في طريقها إلى تفقُّد أبيها، وكأنها في حالة هلع وخوف ما، تصطحبها عدسة الكاميرا (وكأنها عين الراوي) عن قُرب وهي تدخل البيت، تفتش في قلق واضح عن شخص ما، يتضح في الأخير أنه أبوها، حتى تعثر عليه في إحدى الغرف وهو يستمع إلى الموسيفي واضعًا السماعات على أذنيه، وكأنه منفصل عن العالم الخاوي إلا منه، في إشارة قوية إلى الحالة التي يُعاني منها، ورغبته في الانفصال والانعزال أكثر من تلك العزلة التي يعيشها في هذا المنزل وحيدًا، حالة الهلع التي كانت بادية على الابنة، تكشف في الحقيقة عبء المهمة التي تشعر بثقلها عليها، ومن ثم نراها تؤديها ليس كحق لأبيها، وإنما كأداء واجب ليس أكثر.
فما إن تهدأ الابنة بعد فتح ستارة النافذة كي تدخل الشمس التي تضيء وجهه، حتى يدور بينهما حوار ملغز، يتضح منه أنه قام بطرد الممرضة التي أحضرتها الابنة لمساعدته، في إشارة إلى تمرده على هذه الوسائل البديلة، فيرفض وجودها لسبب بسيط، على نحو ما يظهر في دفاعه عن قراره: “أنا لا أعرف مَن هذه المرأة / لم أطلب منها أي شيء” فترد عليه الابنة “إنها هنا لمساعدتك”، فيجيب في غضب، وقد ترك مقعده “لمساعدتي في ماذا؟ أنا لا أحتاج إليها، لا أحتاج إلى أي شخص“، وعندما تهم بمساعدته للنهوض مِن على الكرسي، يشيح لها بيده في إشارة رفض لمساعدتها، ويتجه إلى خارج الغرفة.
هذا المشهد الافتتاحي المجسِّد لطبيعة العلاقة الصراعيّة بين الابنة والأب، يكشف عن جحود الابنة في مقابل حالة الاحتياج التي يعانيها الأب والتحايل على إعلان احتياجه، فالابنة تسعى لاستبدال دورها بممرضة تكون بديلاً عنها في رعاية الأب المسن، والأب المسن يستنكر هذا الجحود، ولا يجد وسيلة للاحتجاج غير إعلان رفضه لهذه البدائل، وعندما تُقدِّم الابنة له عريضة الاتهامات التي ذكرتها الممرضة، والتي تكشف عن سوء معاملته لها معنويًّا (وصفها بأنها ساقطة صغيرة)، كما ادّعت أنه هدّدها جسديًّا، وفي تأكيد لحالة رفضها يقول بأنها سرقتْ ساعته، وإزاء حالة الجدال وإنكار الأب لما فعله كنوع من إبعاد الممرضة، ومراوغته بالإنكار تارة، وعدم التذكُّر تارة ثانية، والإدعاء عليها بالسرقة تارة ثالثة، تستسلم الابنة وتجلس معطية ظهرها له في إشارة ذات مغزى بإعلان الاستسلام والفشل، وكتأكيد لرغبته في التقارب (على الرغم من أن العلاقة بينهما يمكن وصفها بـ”اللاتقارب واللاحب“) واستدرار عاطفتها نحوه، يسألها في صوت واهن حانٍ، يكشف به عن كل مشاعر الأبُوَّة المختزنة داخله: ما الأمر؟ بل يقترب منها ويكون في مواجهتها، لأول مرة منذ لحظة دخولها الشقة.
وعندما تُحدِّثه عن رغبتها في أسى – كما يتخيّل – في الانتقال من لندن للعيش في باريس، لأنها تعرفت على شخص، يقول لها: “إنك تتخلين عني إذا فهمتُ بشكل صحيح: فأنتِ تتركينني، أليس كذلك؟ أنتِ تتخلين عني؟” الفيلم محتشد بالتفاصيل التي تعكس طبيعة العلاقة بين الأب والابنة، وتكشف عن افتقاد الأب في مقابل أنانية الابنة.
الحوار بين الطرفين: الأب والابنة يكشف عن النوايا الداخلية للمتحاورين، وكأننا إزاء علاقة صراعيّة بين أب مُفتقد للحنان، وابنة تشعر بالسّأم من تصرفات الأب وتؤدّي واجبها نحوه بفتور وَسُخْط شديديْن، وهو ما يتحقّق فعليًّا عندما يتعرض الأب للإيذاء البدني من زوج ابنته، لا يكشف لها عن ألمه، وما تعرّض له من عنفٍ، فيكتفي عند سؤالها: ماذا حدث؟ بأن يجيب في يأس “لا شيء“. صمت الابنة وضجرها من حالة الأب تحوّل إلى شرٍّ حتى ولو لم تفعله هي بنفسها، تحقّق بالإيذاء البدني على يد غيرها.
كما ينقل الفيلم إحساس الابنة وحالة الحَيرة من رفض الأب للمساعدات التي تُقدّم له، وتصوراته عن انتقالها واستكمال حياتها في باريس، وفي نفس الوقت تنتابها مشاعر الشّفقة تجاة الأب، بعد مشهد السُّخرية الذي يُقدِّمه الأب مع المعتنيّة به (الجليسة)، وردة فعله العنيفة التي جاءت أشبه بتعرية لما تريده الابنة، وعلاقتها بوالدها، وخشيته بأن ترسله إلى مكان بعيد، وإن كان يربطها بحيلة الاستيلاء على شقته، ومن ثمّ يقف في مواجهتها مُعلنًا أنه لن يترك لها الشّقة، فهو سوف يعيش أطول من عمرهما، بل الأدهى من ذلك أنه هو الذي سيرثها، وفي يوم جنازتها سيقدّم خطابًا قصيرًا، وسيذكر للجميع كم كانتْ قاسية ومتلاعبة، هذه التعرية جعلت من روحها أشبه بفنجان الشّاي الذي سقط بعد أن غسلته وتهشم إثر اصطدامه بالأرض، هكذا تفتت روحها، وتشرذمت بعدما أدركت صورتها المختزنة في لاوعي أبيها، ينتهي المشهد بشرود الابنة آن وتخيلها أنها تدخل الغرفة على الأب وتخنقه بيديها، هذه النوازع الداخلية تكشف عن حالة اليأس المفرط من الابنة تجاه تصرفات أبيها، وترجمتها إلى قتل مادي، حتى ولو كان عبر التهيؤات، إلا أنها مع الأسف صدرت كتعبير عن حالة اللاوفاق بين الابنة والأب!
في الختام
يموت الآباء (مجازيًّا و/أو رمزيًّا)على مستوى الأعمال الروائيّة أو على الورق، أو على الشاشة، بفعل الأبناء / الكُتّاب، لكن موت الأب الفعلي (الفيزيقي) يكون بمثابة الكارثة التي تضع الابن / الأبناء في مواجهة العالم، وقبلها ذاته(هم) واستقلاله(هم) / تمرده (هم) الذي دافع عنه بإسقاط كافة السلطات وصولاً إلى القتل، فوفقًا لقول باموق “إن كل رجل يبدأ موته بموت أبيه”، وربما كان الموت الرمزي / المجازي على الورق بعثًا لصورة الأب التي كان يريدها الأبناء لا في مخيلتهم فحسب، بل على مستوى الواقع الذي عاشوه، وتحديدًا زمن الطفولة، ومن ثمّ فالصّور السلبيّة التي جسدتها الأعمال (المنتخبَة والممثِّلة) لعلاقة الأبناء بالآباء – في واقع الأمر – هي التي يريد أن يقتلها الأبناء، لا الأب الحقيقي، فهو بهذا المعنى يبتعد عن الأب الذي يتعرف عليه الآن ويعود إلى ذلك الأب الذي آمن به في سنوات الطفولة (أي حنين لزمن الطفولة السعيد بتعبير فرويد)، ومع صدق هذه النتائج، لكن التمثيلات التي ذكرناها تشذّ بعض الشيء عن التحليل السّابق؛ فالموت (المجازي والحقيقي) الذي يُكِنُّه الأبناء في مخيلتهم للآباء، هو – في حقيقة الأمر – نتيجة رواسب ذكريات الطفولة، ومعاملة الأب؛ فكافكا لم ينسَ معاملة الأب له، وافتقاده الدعم العائلي، وبالمثل أبطال دوستويفسكي في “الإخوة كارامازوف” تحفظ بعضهم في معاملة الأب، وبالغ البعض في القسوة نتيجة الجحود الأبويّ لهم. وقد يكون دافع القتل لأننا كما يقول أوسكار وايلد “ دائمَا نقتل الشيء الذي نحبه”.
ولئن كان الأمر كما تصوّر دوستويفسكي وكافكا ونجيب محفوظ،… وآخرين، فتبقى حقيقة يجب أخذها في الاعتبار، مهما حدث من تجاوزات من قبل الأب في حقّ أبنائه، والعكس، الآبناء في حق آبائهم، مفادها أن الأب سيبقي رمزًا للأمان، والحماية، وستظل صورة الأب المثاليّة لا يشوبها شائبة، بل يبقى أثره بعد رحيله وكأنّه لم يرحل، فالأب حسب الشاعر الفرنسي فيكتور هوغو «… ذلك البطل ذو الابتسامة العذبة»، وبالأحرى، كيف يرحل وصورته على الجدار، تسند البيت من السقوط، أو كما يقول نزار قباني: (ففي البيت منه روائح ربٍ.. وذكرى نبي / هنا ركنه.. تلك أشياؤه / تفتق عن ألف غصن صبي / جريدته. تبغه. متكاه …)