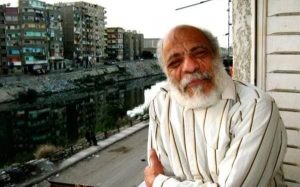طارق إمام
سنواتُ عمرٍ تتجاوز الأربعين، وصفحاتُ روايةٍ تتجاوز الثلاثمئة، ولن ترى “ميمي” وجهها أبداً في مرآة.
كأن كل البيوت التي غادرتها بطلة رواية مريم حسين “السيرة قبل الأخيرة للبيوت”، (دار المرايا، القاهرة)، وكل البيوت التي غادرت إليها، غابت عنها المرايا. فقط، سطح الدرامز المتجعد، في غرفة الموسيقى المدرسية، سيظل مرآةً وحيدة مرتجلة خارج البيوت، تُشوِّه الأبعاد وتُشوِّشها، ورغم ذلك، تلجأ إليه الساردة في لحظاتها الحاسمة والمصيرية التي تحتاج إلى مرآة، وتكون النتيجة: فتاةٌ ذاهبةٌ إلى مواعدةٍ غرامية بهيئة امرأةٍ في حداد، أو الفتاة نفسها، متجهةً إلى مقبرة الأب، بمظهر عروسٍ تخطو إلى كوشة.
المفارقة، أن ميمي، التي تسرد بالضمير الأول حكايتها، أو سيرة بيوتها، مغرمة بالوصف، لا تترك تفصيلةً حتى لو بدت مهملة دون منحها كفايتها من التجسيد المشهدي الدقيق، ومغرمة بالقوة نفسها بإحصاء حبات الأرز ورصد عدد شراشيب السجادة وعدد أعمدة الإنارة، فلماذا لم تجئ على ذكر المرآة في أي بيت؟ هل خلت البيوت من المرايا؟ أم اكتفت برؤية انعكاس وجهها على الجدران، التي كلما وَجهت إليها نظرة، طالعت شقوقاً كالتجاعيد؟
إنه الهروب الأعمق في تقديري في هذه الرواية، والأكثر رمزية، من الهروب الظاهري من بيتٍ إلى آخر: هروب امرأة من وجه طفولتها الذي تسببت يدٌ قاسيةٌ لأم لم تحتضنها مرة، في منحه جبهةً عريضةً غير مرغوب فيها، من أجل صنع كعكة “تشبه الخراء”. إنه الوجه الذي يسيل على جبهته دمٌ وهمي ويظل عالقاً، منذ رأت الطفلة وجه رجلٍ غارق في دمه، حتى كادت تمد يديها لتمسح دم جرحها غير المرئي، إنه الوجه الذي ظل يتدحرج لدورين ونصف بعد تعثرها على السلالم فأفرز جرحه الحقيقي وامتلك عاهته، الوجه الذي لا ينبغي أن تغمض عيناه لدى العودة من نزهة لأنه يخص أختاً كبرى يجب أن تظل مستيقظة، تحرس نوم أختين أصغر.. الوجه الذي ما تزال شفتاه تحملان ذاكرة حبٍ انغرست أسنانه في لحمهما ولم يندمل الجرح. لقد تلقى هذا الوجه بالذات جل الصفعات في هذه الرواية، وبقدر ما تكشفه الساردة وتعريه عبر الحكي، و”تعرضه”، إذ تتحدث لآخرين، فإنها لا تواجهه ذاتياً، إلا لو كان هذا السطح، كمرآة الدرامز، تأكيداً على التشويه.
من يدري، ربما كان هذا النوع من التحريف هو المرآة المثالية للتخييل، وبخاصة أننا أمام نصٍ يحيل دون مواربة لسيرة، أو قدرٍ من سيرة، يمكن تلمس وقائعها الحقيقية من اسم الأب ومهنته، ومن اسم الساردة التي تحضر فقط بكنية تدليل، تحيل ببساطة لاسم المؤلفة من خلفها. ربما تجنُب مرايا البيوت والحقائب والمواصلات العامة هو تجنب النقل الأمين للواقع، ربما كتبت “ميمي” روايتها كلها لتعيد ترميم ذلك الوجه دون النظر إلى مرآةٍ “أمينة”، حيث الحكاية هي المرآة.
طرافةُ الأسى
لا حدث مركزي في “السيرة قبل الأخيرة للبيوت”. الرواية مؤلفة من مجموعة من المحكيات الصغرى، مشدودة للذات، في ضفيرةٍ من حاضرٍ مشهدي واستدعاء للذاكرة معاً. تمسك “ميمي” بالمحكيات بإحكام و”تدوِّرها” بلعبة تباديل غير زمنية، فدائماً تنبعث الذوات ومحكياتها باستحضار المكان أو الحلول فيه، فـ”البيوت تخلق قاطنيها”، حسب تعبير فيلسوف ما بعد الحداثة مصري الأصل “منسي عجرم”.
ستة عشر فصلاً تعلوها لافتات. بيت الهرم _ بيت الشوربجي _ بيت بشتيل: تتوزع هذه البيوت الثلاثة على نواصي الفصول، كأن الرواية مدينة والفصول شوارع والبيوت لافتات. اللافتاتُ (ذات الإحالات المكانية) مشفوعةً بعناوين فرعية (ذات إحالات إنسانية)، تمثل الأفق العام لمناخ الأحداث لكل فصل. لكن هذه البيوت ليست كل الأمكنة المحورية في الرواية، فهناك مكتب المحاماة الخاص بالأب، والذي وإن لم يظهر كثيراً، فإن حضوره كان شديد التأثير، هناك المركز الطبي، والمدرسة، والكنيسة، وهي ليست بيوتاً، لكنها أمكنة مغلقة تنهض بموازاة البيوت، وأحياناً في مواجهتها.
بالاتكاء على الأمكنة كبوصلات للحكي، يتفتت تلقائياً الزمن الخطي للحكاية. نحن أمام نصٍ يتجول فيه الصوت بحرية عابراً جدران الزمن، كأنه انتقامه من عجزه عن اختراق جدران المكان. الحكاية، أو الحكايات المتقاطعة، تتشكل وفق حبكةٍ كولاجية، مزق من هنا وهناك، كل منها تُكمل قصةً صغيرة أو حدثاً فرعياً، ولا طبقية في هذه الرواية تميز حدثاً فرعياً عن آخر رئيسي، فالجميع هنا أبطال، والجميع كومبارس.
تتشكل الرواية وفق هذه البنية كجدارية فسيفسائية، تتشكل من نوياتٍ متجاورة. “التجاور” هو الكلمة المثلى في تقديري لرصد مفاصل المحكية، فالأحداث هنا تتجاور بمنطق البيوت لا تتعاقب بمنطق الزمن، بالضبط كعمل الذاكرة التي تولف بين مشهدين أو زمنين _ أو أكثر _ يجمعها الجذر الدلالي وحده أو الوحدة الشعورية. وفق هذا النمط نواجه موت الأب ثم طفولته، عمل الساردة بالتدريس ثم لهوها طفلةً بين الأطفال.. إلخ.
خلف هذه البنية، بدا لي سؤال “العود الأبدي” مُلحاً كأفقٍ دلالي، فلا أحد يموت في هذه الرواية. من يموت يستيقظ والبيت المتروك يعود، إنها في تقديري طريقةٌ شديدة الرمزية لمواجهة توحش وقهرية الزمن الكرونولوجي الذي لا سبيل فيه للالتفات من أجل ابتعاث ما مَر. عالمٌ كهذا يليق به تماماً حضور العفاريت والأشباح بسلاسة لتصبح شريكةً للساردة، أليست الأشباح في جوهرها تجسيداً استعادياً لمن فقد تجسّده؟
نحن إذن في “السيرة قبل الأخيرة للبيوت” أمام تصور عن الزمن، أداته المكان، الزمن بوصفه مكاناً سائلاً إذا ما استعرنا تعبير محيي الدين بن عربي. هذا الفتاتُ الزمني المتروك في قيعان الذاكرة، الأكثر عرضة للنسيان والمحو، هو ما تلتقطه الساردة، داعمةً بنيتها في التعامل مع الزمن بخطابٍ يغور كثيراً في “المونولوج الداخلي”، وهي خصيصة أخرى مهمة، حيث يغدو فعل الرصد _ ونحن أمام رواية شديدة المشهدية والاحتفاء بالرصد البصري والمقاربة السلوكية الخارجية للذوات _ أقول، يغدو فعل الرصد نفسه، الذي يعتمد الفعل المضارع بوضوح، هو فعل التذكر، الذي يطعم المضارع بالماضي على مستوى الجملة الواحدة، وهما معاً يغذيان فعل الاستبطان، فلا مسافة بين المرئي والحدسي، بين الخارجي والداخلي، بين السردي الراكض في الزمن والتأملي الذي يحوم حول مرويته ليُجرِّدها في زمنٍ صفري. وربما هذا أحد أسباب الحيوية الشديدة في العمل رغم أنه يتحرك في دوائر ضيقة وبين سرديات صغيرة، تنتشلها من عاديتها قدرة واضحة على “نزع المألوفية” بحيث يغدو كلُ عادي غريباً، واستثنائياً.
ثمة عنصرٌ يستحيل إغفاله، هو التجذر العميق للسخرية في هذا النص، بحيث يقدم الأسى في طرافته وكوميدياه السوداء، وهو ملمح نادر الوجود في النص الروائي للكاتبة المصرية وربما العربية. تفعل “ميمي” ذلك خائضةً، في الوقت نفسه، في عالمٍ ذكوري خالص، بكل عنفه ونبضه القاسي الدموي، وبنقل مفرداته بكل جرأة وإدراك وحرية، وهو ملمحٌ ثانٍ متفرد في رواية كتبتها امرأة، بل واختارت أن تسردها عبر الضمير الأول لامرأة.
لغةٌ مُراوِحة
تستعين الساردة على تحقيق خطابها بلغةٍ خاصة، تقع بين لغة التدوين “الفصيحة” ولغة الكلام “الدارجة”. إنه نمط يمسك بالرواية كلها، وهو يتجاوز تطعيم جملة السرد الفصيحة بما يلزم من مفردات عامية (الخصيصة الحاضرة بكثرة في الرواية)، إلى تحويل العبارة الفصيحة نفسها إلى عبارة عامية البنية، تبدو كما لو جرى التفكير فيها شفاهةً ثم تدوينها. “أكسر يميناً في يمين وأدخل حارتنا”، “إذا لم تكن الظروف قد ساعدتنا أكانت ستعمل فينا أم أشرف محاضر؟”، “أحضرنا ثلاجة آخر سنتين فقط”، “غسلوا شبابيكهم على غسيلنا”، “على أذان الظهر يستيقظ الجميع”، كرسي أبي كان كبيراً وعريضاً حتى يأخذ الرجل راحته”، “تمسك بمنديل أخضر في برتقالي”، “كان الوحيد في المنطقة الذي نعرفه عنده تليفون”. هذه العبارات ليست إلا نماذج دالة على المستوى اللغوي السادر على النص، والذي إن لم يُقرأ برهافة ووعي وفق الفلسفة التي تحركه، فقد يعتبره البعض ركيكاً.
الأهم هو دلالة اعتماد هذه الطريقة الواعية في تخليق اللغة السردية، على ما في ذلك من مغامرة، أراها نجحت حد الإدهاش. تأويلي الشخصي، أن الساردة لا تريد لمرويتها أن تكون تدويناً كأن الصوت نابع من فعل الكتابة وأرضها الخالصة، لا تريد إفساد الصوت “المسموع” لشخصٍ يتكلم، وبالقدر نفسه لا تريد لخطابها أن يكون منتجاً ينتمي بنقاء للتلفظ ما يمنح الحكاية، القريبة أصلاً من الواقع، درجةً أكبر من التطابق باعتبارها “سيرة”، لا سيما وأننا نواجه ساردةً أزاحت الذوات الإنسانية عن العنوان لتصبح السيرة خاصة بالمكان. أنتجت هذه المراوحة على مستوى الرؤية نظيرتها على مستوى اللغة، لتفرز تراوحاً أعمق، بين النص في إجماله كنصٍ موجه للآخرين، وبينه كنصٍ ذاتي، لا يخلو حتى من فكرة التطهر عبر مواجهة الذات.
الملحوظة الثانية المهمة، هي قدرة الساردة على خلق نوعين من الوصف. ثمة الوصف الأيقوني الدقيق، المعني بتجسيد البشر والموجودات بصرياً، لكن على جانب آخر هناك منحى آخر من الوصف، يخرج بالموصوف إلى أفق “تأويلي”: “صب سوكا لنا الشاي، ظهرت ضحكته ساطعة في أسطح الأكواب”، ” شعر أسود ناعم متوسط الطول مموج بمنبت يشبه القلب”، “طلاء الحائط مقشر على شكل رجل أصلع غاضب بشدة”، “حمل الهم والغضب، كمن يكتم فمه بكفه ويبتلع ألمه مرغماً على مضض دون مضغ”. هذه أيضاً ليست إلا نماذج لنمط من الوصف يمنح الرصد الخارجي عمقاً شعورياً وإحالات وجدانية، دون تدخل “عاطفي” من الساردة، وهنا تكمن فرادته.
“متى أقدر على القول بأن البيت الذي أتواجد فيه هو بيتي؟ فقد عندما أقرر هدم حائطٍ فيه ولا يعترض أحد”. هكذا تقرر الساردة، أو تقر، أخيراً، في الفصل الأخير، وهو ليس فصلاً أخيراً في حقيقة الأمر، إذ يشهد تأهبها لمغادرة “بيت الهرم” إلى بيتٍ جديد. في هذا الفصل الأخير، يسيطر “الفوتومونتاج” فيدوّر كل ما فات في طاحونة، فيما نرى النهايات، أو ما يشبه النهايات، أو ما يليق به أن يكون نهايات، مؤقتةً أو مفتوحة، لدوائر البشر والأمكنة.. وبلغةٍ أشد صوفية، أكثر غوراً في الذاتي، وانفتاحاً على مناجاة الغائبين بضمير المخاطب.. تتوج “ميمي” سرديتها بنشيجٍ يكافح كي لا يغرق في البكاء، وتمنح سيرتها، النهائية، أفق عودٍ أبديٍ جديد، يجعل منها سيرتها الأولى.