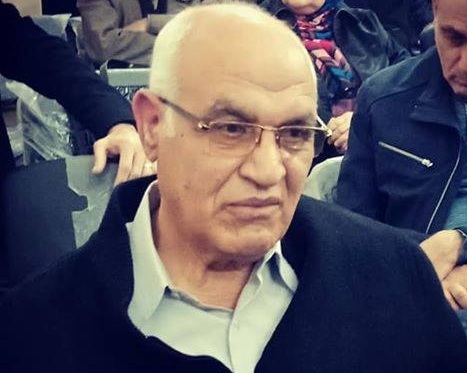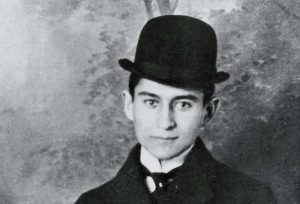شوقى عبد الحميد يحيى
التغيير سنة الحياة، مبدأ لا أحد يُنكره، حتى اللغة قابلة للتغيير والتطوير. إلا أن البعض لا زال يُنكر أن الرواية أصبحت هي ديوان العصر، لا الشعر، رغم كل ما يعانيه من قصور عن مسايرة الزمن. حقيقة أن الشعر كان هو ديوان العرب، في العصر القديم، عندما كان الشعر يقوم على المديح والهجاء، فكان سلاح العرب في مواجهة العدو، أو التنافس في ميدان التفاخر، او الهجاء. وكان مولد شاعر في القبيلة، تقام له الأفراح والاحتفالات، فقد ضمنوا مدافعا عن القلبية، مثلما قال عباس محمود العقاد في كتابه “اللغة الشاعرة” -مؤسسة هنداوى:
{ومن البديه أن العربي لا يرجع إلى الشاعر ليسأله عن المذاهب الفلسفية ذات الشروح والحواشي وذات العلل والنتائج، ولكنه يرجع إليه ليجد عنده شيئًا أصح وأقرب إلى حسه وفهمه وعمله: يجد عنده «شخصيات حية» تتمثل في كل منها صورة من صور الحياة كما هي: وكما يتمناها}. فكان الشعر كما نعرفه الآن بأنه أقرب للحياة الشخصية، منه للعقل والمنطق.
فإذا كانت الحياة في ذلك الزمن، تقوم على النظام القبلى الذى معه تصبح كلمة شيخ القبيلة هي الكلمة الفصل، ولم تكن الديمقراطية أو الشورى قد ظهرت بعد، وأن هذه الأمور قد ظهرت وعلمها الإنسان، كان للأمور ان تتغير، وكما انتقلت السيادة من شيخ القبيلة، كان يجب أن تنتقل أيضا من الصوت المنفرد، إلى الصوت الجمعى، وما يملك تلك الخاصية غير الرواية.
وفي ظل عدد من المستجدات التي تنحي الأنواع الأدبية الأخرى مفسحة لها مكان الصدارة ولتظل في خدمتها، لا خدمة السيد للعبد، ولكن خدمة المرؤوس للرئيس. وليس ذلك تحيزا إلي الرواية، أو تجنيا علي الأنواع الأخرى، وإنما نظرة إلي تقنيات الرواية بصفة عامة والرواية الحديثة بصفة خاصة نجد أن الرواية قد استخدمت الأنواع الأدبية الأخرى فمن اليسير جدا الاستدلال من عديد الروايات التي استعانت بالشعر، سواء في استخدام خواص الشعر في التعبير أو الاستعانة بنصوص شعرية لشعراء آخرين إبرازا للمعني أو إيجازا في التعبير أو تعميقا لإحساس معين، وبالمثل يمكن الاستدلال أيضا علي استخدام الرواية للطرائق الموسيقية سواء في استخدام العلاقات الزمنية وتأثيرها علي إيقاع الأحداث، أو في تقنية الكتابة الموسيقية ذاتها والسيمفونية منها خاصة والتي تتحدد في السريع فالبطيء فالسريع ويستعيض الكاتب الكلمات عوضا عن اللحن، في استخدام الجمل القصيرة المتسارعة، فالجمل الطويلة البطيئة فالقصيرة السريعة ونستطيع أن نجد ذلك في روايات بهاء طاهر علي سبيل المثال وإن كنا نستطيع أن نجد مثل ذلك في القصة القصيرة أيضا مثلما نجد في قصص محمد مستجاب علي سبيل المثال أيضا. وإلي جانب استفادة الرواية من الفنون التشكيلية واستخدام العلاقات المكانية وعلاقة الأضواء والظلال، نستطيع كذلك العثور علي المقال داخل الرواية كما في بعض أعمال ماركيز.
وإن كان يمكن القول بتواجد هذه العناصر في القصة القصيرة أيضا إلا أن استخدام الرواية للقصة القصيرة ذاتها هو ما لا يمكن إيجاده في الاتجاه العكسي، حيث يمكن تواجد القصة القصيرة بكاملها داخل الرواية، ولكننا لا نستطيع أن نجد الرواية داخل القصة القصيرة، فنستطيع تعداد الكثير من الروايات، يمكن قراءة فصولها علي أنها قصص قصيرة كاملة العناصر، وفي مجملها تشكل رواية متكاملة العناصر. كما يمكن ذكر العديد من الروايات التي بدأت بذرتها كقصة قصيرة لكن بعد البداية يكتشف أن جدران القصة القصيرة تتفسخ أمام تنامي الكتابة وانطلاقها إلي الأفق الأوسع زاحفة إلي خارج حدودها وداهسة لقواعدها، وكأننا أمام قطعة ملابس فصلناها لتصلح لطفل في الرابعة من عمره، لكنها لا تصلح له عندما يصير في الرابعة عشرة.
كما أن هناك العديد من الأسباب التي ساعدت علي تسيد جنس الرواية في الزمن الحاضر وجعلت كل كتاب القصة القصيرة ذاتها يتحولون إلي كتابة الرواية ـكما سبق أن أشرنا إلا قليلا منهم. منها:
أن المبدع في بداية عهده بالكتابة ربما لا يكون قد تمرس بالكتابة بعد، ولا يملك النفس الطويل الذي تتطلبه كتابة الرواية.
لا يكون ما لديه من خبرات وتجارب كافيا لخلق رؤية كلية للأشياء، ولا كاف لخلق عالم متباعد الأطراف زمانيا ومكانيا.
ـ عند بداية التجربة يكون الكاتب لا زال مرتبطا بذاته ويرغب في التعبير عنها، وتكون الفطرة هي التي لا زالت تحكمه ولذلك نجد العديد قد بدأ بكتابة الشعر، حتى لو كانت الكتابة ساذجة، والقصة القصيرة أقرب لهذا أيضا من الرواية بالطبع في حمل همومه، علاوة علي ما قد يكون لدى المبدع في هذه المرحلة من العمر من الرغبة في الظهور وتقديم نفسه للآخرين حيث يكون مجال النشر في القصة القصيرة أيسر منه في حال الرواية. كما أنه لا أحد يستطيع إنكار السبب وراء تحول الغالبية العظمي من كتاب القصة القصيرة إلي الرواية من الرغبة في الانتشار الأوسع حيث إمكانية تحويل الرواية إلي الصورة المرئية علي الشاشتين الصغيرة والكبيرة، بينما فرصة القصة القصيرة في ذلك لا شك أنها نادرة.
وهو ما أكده د. محمد براده حين قال: –
{أن ما يميز الرواية ويستلزمها، هو أنها جنس تعبيري يتيح لنا أن نقول من خلاله ” كل شيء ” وهذه خاصية لا تتوفر في أجناس أخرى}. فضلا عما قاله نجيب محفوظ منذ عام 1945 من أن الرواية-أو السرد عموما {أنه شعر الدنيا الحديثة، فهو فن يواكب عصر العلم والصناعة. حيث كان الاتجاه إلى أولوية العقل، على النقل لإدراك المعرفة}. على إعتبار أن السرد هو الواقع، والشعر هو الخيال.
و أيضا يقول د على الراعى أن الرواية هى ديوان العرب المحدثين فى كتابه “الرواية من المحيط إلى الخليج” { إن الرواية العربية الآن هي أهم قنوات الإبداع العربي, وأكثرها حساً بهموم الناس, وأجدرها بأن تجمع حولها حشوداً من القرَّاء يجدون فيها بحق الديوان الجديد للعرب}.
ومن كل ذلك يتضح أن الرواية أكثر قربا واحتكاكا بالمجتمع ومشاكله وأكثر تعبيرا عن صراعاته وتقلباته، فإذا كان المبدع إنسانا أولاً يعيش في بيئة ومجتمع يتفاعل به و معه، في أفراحه وأتراحه، ينفعل به وله، يأخذ منه ويحاول أن يعطيه، وعلي صعيد العالم الأكبر وما أصبح يسوده من صراعات تبدو علي السطح ويخفي أسفل منها مجموعة من التشابكات والتداخلات التي يحتاج الأمر إلي كثير مجهود لحل خيوطها والوصول إلي أطرافها، خاصة بعد سهولة الترابط بين البلدان وما أصبح علي الإنسان معه ضرورة التشابك مع الآخر وترابط المصالح وتعدد العلاقات، وعلي الصعيد المحلي ووسط مجموعة من التحولات التي ترتبط بطبيعة الشخص الحاكم حيث يرتبط النظام بالفرد، يحكمه توجهات ورؤى هذا الشخص الحاكم، فإذا ما ذهب الشخص وجاء آخر كان هناك تغيير في السياسة وما يستتبعها من تغييرات اقتصادية واجتماعية وثقافية حتى أصبح تاريخ مصر والتاريخ العربي مجموعة من الكتل المتجاورة تمتد في الزمان أفقيا بدلا من أن تمتد في المكان رأسيا.
وبعد الهزات العنيفة التي حدثت في الوطن العربي عامة وفي مصر خاصة بعد ما حدث في يونيو 1967 وانهيار العديد من القيم واختلال الكثير من المفاهيم والمعايير وانكسار الروح المصرية والعربية، تشرنق الكتاب والمبدعون داخل أنفسهم، يحطمهم اليأس وتدور برؤوسهم التساؤلات، يجترون ذواتهم ويتمردون علي خيباتهم، اتخذوا من إبداعاتهم مادة لإخراج مكنوناتهم المتداخلة الضبابية، فكان التغريب وكان التداخل، وانفرط عقد التسلسل المتصاعد في الحدث داخل العمل وغاب التنامي فيه، وغابت الشخصيات التي كانت أقرب إلي الشخصيات الحية في الوجود المعاش، وأصبح البطل أو المحور هو الذات وهو اللحظة وهو المكان وهو الحالة. بينما توقف الشعر عند التعبير عن هواجس النفس، واللوعة، دون أن تقدم تلك الرؤية البانورامية التي تأتي بها الرواية. إلا أن الاستسلام لا يمكن أن يدوم طويلا، فما أن أفاق المبدع حتى راح يتساءل ويلهث وراء الحقيقة، يريد أن يصل إلي الأصل وإلي الجذور، يريد أن يحاكم ويريد أن يستوعب ما فات ويحذر مما هو آت، فكان لا بد أن يتتبع الحدث ويتتبع تناميه وتصاعده، وكان حتما أن تتعدد الجهات وتتعدد الأشخاص، وهو ما لا تستطيع القصة القصيرة أن تستوعبه ولا القصيدة أن تلم أطرافه، وكانت الرواية بما تمنحه من حرية في الزمان والمكان لا يحدها حدود ولا تمنعها قيود هي الوعاء الأرحب والأنسب ليشكل المبدع رؤيته ويضمنها رسالته. فضلا عن أن الرواية تمنح فرصة البوح التي تنتاب كل مبدع والإفاضة فيه حين تقترب وتمتزج بالسيرة الذاتية دون التوقف عندها، ففي الوقت الذي يوزن فيه كل من الشعر والقصة القصيرة بالدرهم يمكن أن توزن الرواية بما هو أكبر من ذلك.
وقد أوضح د. جابر عصفور هذه الفوارق وتلك الطبائع والخصائص في كتابه ” زمن الرواية ” {وإذا كان الشعر كالقصة القصيرة ابن اللحظة الآنية التي تومض كالبرق، تقتنصها الصورة الشعرية لتديم حضورها وتبسطها أمام العين كي تتأملها، فتأسرها القصيدة كأنها تأسر بوارق الحدس ولمعة الكشف في العمق الرأسي لحضور آني، ما بين المبدع والمتلقي، فإن الرواية ابنة اللحظات المتعاقبة كالنهر، حيث الامتداد الأفقي للمنظور، والمتابعة المتعاقبة حتى لو تقطعت وتذبذبت للتحولات، والحركة الصاعدة مع تتابع اللحظات لا الوامضة الواحدة من اللحظة. وإذا كان الشعر ابن للحظات الحدية من التاريخ، حيث تنطوي اللحظة علي شعور حدي بالأشياء، والكائنات، في مواجهة حدية اللحظة الزمنية، فإن الرواية ابنة اللحظات الرمادية من التحول، حيث تتولد ” حركة لا شرقية ولا غربية ” تمزج النقائص وتجاور ما بين الأضداد» ص42. وعلي هذا كانت الرواية هي التي استطاعت أن تسجل وترصد وتتعامل مع الفترات التاريخية علي مدار القرن العشرين بأكمله.
ولا أظنه بخاف عن كل متتبع ما قدمه نجيب محفوظ عبر رواياته ما يمكن أن نعرف منه كيف كانت الحياة الاجتماعية في مصر منذ قبيل ثورة 1919 وإلي ما بعد نكسة يونيو 1967، وكيف استقرأ في العديد من أعماله ما سوف تؤل إليه البلاد في ظل ما كان يسودها قبلها، وكيف عبر عن مقدمات وتوابع ما حدث في يونيو وهو ما أوضحناه تفصيلا في كتابنا ” يونيو 67 وأثره في الرواية المصرية “. وكيف عبرت روايات يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وفتحي غانم وخيري شلبي وبهاء طاهر وجميل عطية إبراهيم وجمال الغيطاني وغيرهم مما عبرت وتناولت الأحداث التي مرت بالبلاد خلال الفترة من بداية القرن العشرين وحتى ما قبل انتصارات أكتوبر 1973.
شئ آخر يضاف لإثبات مقولة زمن الرواية. فإذا كنا فى زمن المعارف والمعلومات، فسنجد أن الرواية، ومنذ زمن ليس بالبعيد، أخذت منحى المعلوماتية (ونجد ذلك واضحا فى روايات سهير المصادفة وصبحى موسى وهالة البدرى وغيرهم كثر)، حتى أصبح عاملا مشتركا فى معظم الروايات-عامة-، حتى أصبح ملمحا أساسيا فيها، وعنصرا متجددا لها، ألا يعتبر ذلك دليلا على صدق المقولة؟
لكل تلك الأسباب، ولكون الشعر الجاهلى –النمطى-كما يقول دجابر عصفور، يقوم على عنصرين أساسيين، هما الفخر والرثاء. أو المدح والذم. وحينما خطى خطوة أخرى كان الوصف، والتعبير عن الحالة الوجدانية، أى أنه كان أقرب للذاتية، بينما تَغيُر المجتمع، وظهور الديمقراطية، التى تتطلب المشاركة، كانت الحياة الاجتماعية، أى حديث الذات مع الآخر، وهو ما يتطلب العقلانية، والتتبع والحوار. فكان السرد أقرب لروح العصر من الشعر، فى التعبير عن روح العصر. وكان الاهتمام بالرواية-عالميا-يتنامى بصورة ملحوظة، حيث نجد أن جائزة نوبل العالمية، والتي أنشئت منذ العام 1900. كان عدد ما منح من الجائزة (122) ، يخصم سنوات لم تمنح الجائزة فيها( 6) ست سنوات، فيكن ما منح منها فعليا ( 116) جائزة. وكان عدد السنوات التي منحت فيها الجائزة للرواية( سواء كان المبدع ممارسا للرواية فقط أو مع غيرها كالشعر أو القصة القصيرة) هو (76) مرة، أي بنسبة 65.5% والباقى – كالشعر أو غيره- 34.5% فقط. فما كان للعرب إلا ان يحفزوا كتابهم في عالم الرواية، فكانت جائزة كتارا التي تقدمها قطر، وكانت جائزة نجيب محفوظ التي تقدمها مصر. وكانت جائزة البوكر التي تقدمها أبو ظبى في دولة الإمارات العربية، والتي تعتبر اكبر جائزة عربية عالمية تُمنح للروائيين، المعاصرين، تشجيعا لذلك الفن الآخذ في التنوع والتطور الدائم.