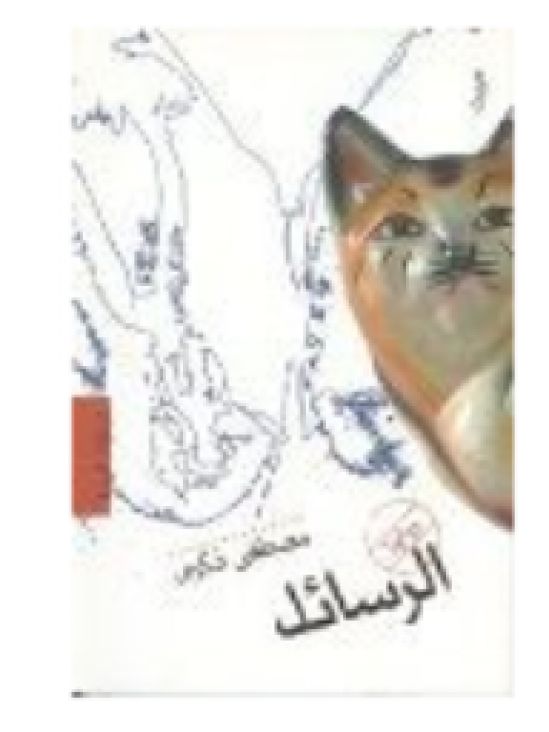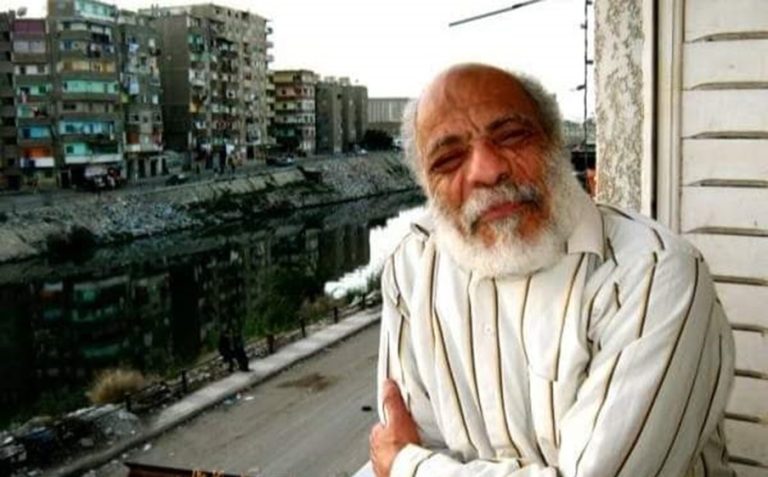في الصفحة (56) تنبعث بغتة رائحة أدب ما في اللغة ـ الرواية كلها (62) صفحة ـ ، لكن ما الشيء الذي كان ينبعث من بقية الأوراق؟.. هنا تُبطل أحكامك، ففي دخيلتك رغم كل شيء اعتزاز ما بالنص، انحناءة ما من رأسك لهذه الكتابة، التي أضجرتك حتى التخوم، لكنها احترمت بك ما يمكن أن نسميه «السوية» والسوية هنا، هذه الطريقة الفذة في الاشتغال النصي الروائي.
وبالطبع فإن هذا ما كان له أن يتصيّر لولا أن الثقافة هنا كمحول أساسي، بدت كأنها استبدلت كل شيء خارج عنها بها… وأضمرته على أنه شيء موجود بقوة.. بمعنى أن الثقافة أخذت رطانتها من تجربة إنسانية بدت غائبة بذاتها، لكن اللغة الثقافية الخالصة للنص، بدت وكأنما تحملها بقوة، وهنا باعتقادي تكمن قوة النص ومفارقته.
السرد تحمله الثقافة التي تضمر تجربة ما، لا تحملها، أو تقوله. إن التقانة هنا، ربما هي هذا التفكيك، والتداخل للزمن «والأحداث» لم تفض بحد ذاتها إلى هذه الصعوبة اللغوية السردية، بل ساهمت ـ التقانة ـ بفرادتها الآسرة في تليين، وتقبل الصعوبة السردية اللغوية، التي كانت تشتكي من عيب جوهري افتقارها للأدب كما ذكرت، ولعلني أستطيع أن أؤكد هنا أن روح الكاتب نفسه تشح فيها الغنائية على نحو واضح تماماً، وهذا ما أفقد النص، الصفاء، والإيغال، والاستبطان، ما جعل اللغة السردية خالية من السلاسة إذ أن الصفاء كما الوصول للجوهر لا يتأتى إلا ركوباً على روح غنائية للكاتب أصلاً.
لكنننا ببساطة سنتجاوز ذلك بسبب فرادة النص التي ذكرتها، والتي كانت بمنزلة مجذاف تعويضي هائل لهذا الانتكاس الغنائي.
انطلاقاً مما سبق يصبح من العيب الحديث عن حكاية ما للرواية، رغم أن الحكاية واضحة، وهي حكاية مثقف متشظ، يعيش أو كان يعيش حياة غير واضحة البتّة من شدة الانخلاع وغير مقدر لها أيضاً أن تُرى أبداً.. إنها مجرد إشارة ما لكائن نوعي.. كائن نوعي محوط بكل مفردات نوعه: البارانويا.. الربو، البروزياك، الفاليوم، الزانك، النوم المتقطع، السوداوية.. نيتشه، هيغل، محاولة صناعة بعض الأفلام، الاستمناء و«اللؤم الذكي».. ثم الكتابة «فما الكتابة إلا عرض مرضي للحياة».
وأيضاً المعشوقة كشيء غير ممسوك بدوره، تنوس كحقيقة، حولها تدور الأشياء أو ربما الوهم.
إذاً كما أسلفت فإن الرواية تكمن فرادتها، في أنها جسدت ذاتاً إنسانية من شدة كثافتها، نَحَتْ إلى الإشارة تقريباً بدل القول، وبالإشارة فقط استكملت عالمها، الذي يمكن استدلاله بمشهد يظل غامضاً بدرجة الوضوح نفسها، وواضحاً بدرجة الغموض نفسها، لمأساة الكائن النوعي.
ثم إنني قبل أن أختم تجبرني معاودة القول، إن الرواية خَلَت من أي صفاء، ومن هذا الخلو جاء افتقارها إلى أيما شيء جواني، امتحاء ما لأصلية كائن نوعي.
إنها بحق ظلت خارجية، تحتاج معونة المتلقي على تخييل ما ظل مبطناً.