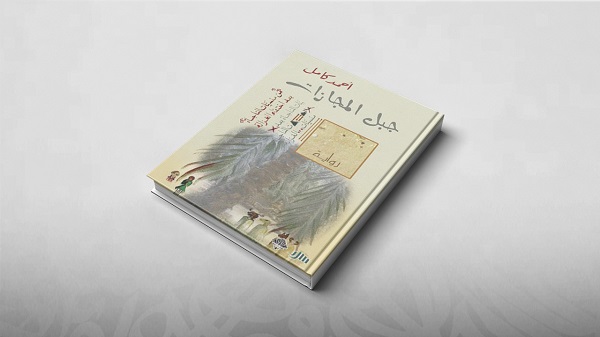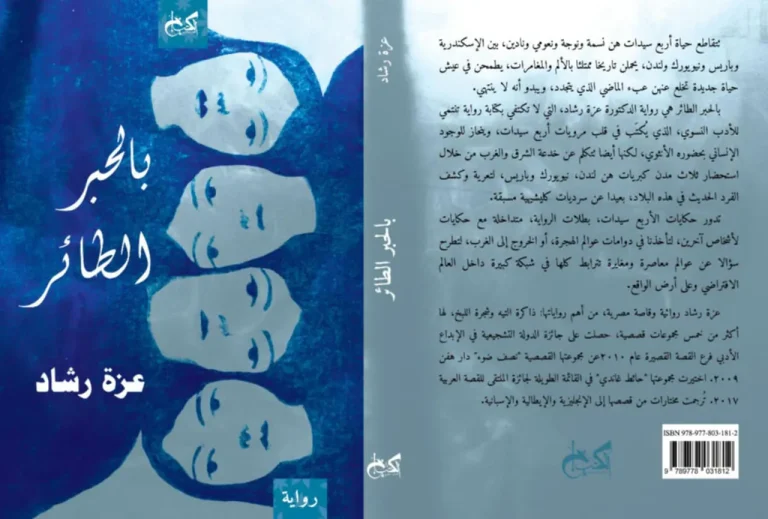طارق إمام
لا تمنحك القصيدة أبداً قمراً مكتملاً، لكن محمود خير الله، في مجموعته الشعرية الجديدة “الأيام حين تعبر خائفة” (سلسلة الإبداع الشعري، الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة) يُشرع نافذته ليهب الوجود كله مزدحماً في غرفة، ولتجتمع “الأغراض” الشعرية، بطريقة قصيدة النثر في إعادة قراءة إرثها وإنتاجه كشك وليس كيقين، جنباً إلى جنب. هنا يحضر الرثاء، يحضر البكاء على الأطلال، يحضر الحب والهجاء، لكن ببحور جديدة، وفق أوزانٍ أخرى، وبقوافٍ مفارقة.
تشبه قصيدة خير الله في هذا الديوان سحابةً معبأة، ينتظر الرائي أن تغرقه، لكنها تكتفي بزخات قليلة، تختار أن تبقى مُنذرة بدل أن تفصح عما تخبئ. أليس هذا هو الشعر؟ هنا قدرٌ من الحب، قدر من الوحدة، قدر من التأمل، قدر من الغضب، قدر من استبطان العالم في وجوديته المتجاوزة، وقدرٌ من ألم الطبقة، ذلك السؤال الكبير الملح على خير الله، الذي يعرف أن ثمة مطراً في عرق الفقراء.
قدرٌ من كل شيء، غالباً يستحضره الشاعر ولا يعود “لاجتراره”، ربما لهذا السبب تفي هذه المجموعة بمسماها بامتياز، تشبه أنفاساً متلاحقة من كل شيء، شهيق وزفير يتبادلان الأدوار بلا هواد. تخاصم “الأيام حين تعبر خائفة” فكرة الانسجام لصالح الاعتداد بالمزق، بالبؤر المتفرق دمها، حيث لا مركز، ولا الذات نفسها، الذات التي يُفضِّل خير الله منذ ديوانه الأول ألا تصبح بطلاً لعنوان كتاب شعري، يُفضّل المعاني كـ”الرجولة”، أو العلامات من قبيل “نافذة” أو “ظل شجرة” أو “أيام”، حيث “الإنساني” لا “الإنسان” هو البطل، ومن ورائه تُلوِّح الذات بوجودها، الذات التي تقمع غنائيتها لأنها لا ترى في الشعر مونولوجها الأناني، لأنها تعترف بوجودها ضمن “لغة” هي فيها محض مفردة.
نص المراقبة
“النافذة”: إنها ليست فحسب المفردة/ البطل في أولى قصائد الديوان المعنونة “عارياً يتغطى بنافذة”، لكنها أيضاً، في ظني، العلامة الكبرى لهذه التجربة. النافذة فرجة، جرح في جدار الغرفة يطمح هنا أن يصبح جرحاً في حائط العالم.
تصل النافذةُ الداخل بالخارج وتنتمي لهما معاً، تُرى من الداخل ومن الخارج أيضاً، إنها علامة يتقاسمها المقيم والغريب معاً، فلا تستطيع منع عابرٍ من التطلع إليك في نافذتك، ولا يستطيع عابر أن يطلب منك غض بصرك عن مراقبته في شارعه. هنا، ذاتٌ قررت أن تراقب العالم، مستعينة على ذلك بهذه النافذة المشرعة بامتداد نصوص الكتاب الستة عشر. العالم: إنه موضوع هذه التجربة الشعرية، دون خوفٍ من رهبة الكلمة واتساع ظلالها. العالم، طفل هذه القصيدة اليتيم، والشعر رصاصة رحمته.
تتصل النافذة بالشرفة، الشرفة التي، للمفارقة، تمثل هنا موطن إقامة، تتصالح الذات الشاعرة مع وضعها فيه كعالقة: “طول إقامتي في الشرفة/ كان لا يعني في الحقيقة/ سوى أنني موجود/ معلقٌ كالرضا”. الشرفة أيضاً “حفرة في الجدار”: “حتى حين يكون العالم من حولك/ محض شرفات جميلة/ ومغلقة على أحزانها/ ساعتها/ قد يأتيك لهاث عاشقين/ يدخلان الحديقة بكفين ملتصقين/ ويبدآن العناق الطويل/ ساعتها/ صدقني/ لن تجد لديك القدرة على الصراخ”.
باكتمال عناق النافذة والشرفة، يتجسد فعل المراقبة: شجار هذه التجربة الحقيقي مع العالم، ومسافتها اللازمة لشاعرٍ “يخوض خمسينه” وقد صار، هو نفسه، حرباً أخيرة: “أعرف رجلاً يخوض في الخمسين/ واقفاً كل يوم/ – أمام نفسه_ / عارياً،/ لا يتغطى سوى بنافذة”. إنه الشاعر نفسه وليس فقط الذات الشاعرة التي يتقنّع بها شعرياً، حتى لو أشار إلى نفسه بضمير الغائب كمن يتحدث عن جار. هو الشاعرُ لحظة إدراكه أن كافة الحروب التي سالت فيها دماءه أفسحت مكاناً لحربه الحقيقية، حرب وجوده، تلك الحرب التي لا دماء فيها. نفس الشاعر الذي يخوض خمسينه، سيلتفت، ليمنحنا قدراً من “أربعينه” التي أصبحت خلف ظهره، ليطلعنا (بنفسه) على ما فعلته المسافة بشخصين يحملان الاسم نفسه: “المجد للطريقة التي نتسلل بها/ حين نبلغ الأربعين/ خارجين من البيوت الدافئة/ دون أن يلحظنا أحد/ المجد للأشباح التي نرتديها/ ونحن ذاهبون/ إلى الخديعة/ وحين نعود/ نخلعها على الأبواب بسرعة/ لنشم بعمق/ هواء البيت”. بين خروج الأربعيني من البيت وعودة الخمسيني إليه، تقع هذه القصائد، طارحةً، دون مواربة، سؤال الزمن.
إنه التحوّل الشعري نفسه ملتبساً بالتحوّل الزمني. هذه المرة، تتحوّل النافذة من مكان “للعنة” تسقط على رؤوس الماشين، إلى حيزٍ يأتي بالعالم حيث نقف. هذه المرة يغادر الفقراء ملابس الكدح بينما يصوبون نظراتهم “إلى تراب العالم” ليصير العالم كله، وليس زنزانة الجلاد، سفينة عبيد، وحيث كل إنسان شحاذ. “كل ما صنع الحداد” في الماضي فقد ضجة صوته مكتفياً برائحة الكير. نص محمود خير الله الجديد هو نص الرائحة، هو نص الأثر، وقص الأثر.
قصيدةٌ في قبضة الحكاية
“المفارقة الزمنية” حاضرة إذن في هذه التجربة التي لا تتنكر “لسرديتها”، حيث ثمة، دائماً، تلك “الحكاية” التي تلوّح بكفٍ ضائعة من خلف الزجاج، وحيث الشاعر “رجلٌ مزقه الزمن”. أليست “الأيام حين تعبر خائفة”، التي اختارها الشاعرُ لافتةً أشمل لديوانه، عبارة سردية بامتياز تحيل للبطل السردي المطلق: الزمن؟ أوليس التأكيد على أن “لاشيء يدوم” (وهو للمفارقة العنوان السابق لهذا الديوان في صيغته المبكرة كمخطوط) هو أيضاً تأكيد على صيرورة الزمن ولعبة التحوّلات؟ إنها القصيدة قبل الأخيرة في ترتيب القصائد، وهو ترتيبٌ ملائم، حيث أنها قصيدة نهايات، قصيدةٌ تدوِّر الذاكرةُ مقدراتها وقد نهضت منفردة لتبحث عن جوهرة الشعري في ركام المحكيات. إنها قصيدة أخرى في مديح الشرفات، لكن باختبارٍ مختلف، حيث الشرفة هذه المرة “شاهد” على التحوّل، يبعث الرفات لترديد أصداء أصواتها البائدة، مؤرخ صامت لا يملك يداً ليكتب: “سمعت شيوخاً من الماضي/ يئنون تحت شرفتي/ ورأيت العانسات/ يسحبن النحيب من آخره”. الشرفة تتحول بدورها من موطن “رؤية” لأداة استرجاع وكأنها صنو الذاكرة.
“علق ابتسامته في الشرفة ومات”، إنها قصيدة “مفتش آثار” مات وهو يلم الغسيل. هي في جوهرها “حكاية صغرى” (سمعتها شخصياً من محمود في مادتها الخام كواقعةٍ حقيقية) مثلما عشتُ مع محمود “حكاية كبرى” اسمها الثورة، تحولت بدورها إلى قصيدة طويلة أغلقت قوس هذا الديوان بصرخة. حكاية صغرى وحكاية كبرى وبينهما القصيدة: إنه ثالوث هذه التجربة الشعرية الثرية، وفلسفته في إذابة الثنائيات.
“أريد أن أحكي حكايةً عن أبي”. هل ثمة اعترافٍ أكثر فداحة بحضور “المحكي”، بينما يقدم الشاعر قصيدة هذا الديوان الكبرى في رثاء الأب، في رثاء نفسه، وفي رثاء العالم “اليتيم من دوننا” كما سيقترح في قصيدةٍ أخرى؟
أليس “الأب” حكاية؟ ( حكاية صغرى وكبرى معاً، فهو الذات العابرة كعادي وهو أيضاً الإله والبطريرك). إنها مرثية هذا الديوان الكُبرى، وهي جرحه المفتوح وقد توسط القصائد تماماً. وأليس وجوده بجانب “الرضيع” قصة أخرى؟ إنهما هنا قصيدتان تمسكان بالشعر من طرف حكايتين تختصران معنى الحياة والموت: “حدث هذا فجأةً/ ذات ليلة/ بعد أن بلغت سن الأربعين/ صرتُ أحمل وجهك يا أبي/ أغلق الأبواب بهدوء/ كأنني أودّعها”.
تلك الذات الباحثة عن قصيدتها على أنقاض محكيتها، الذات التي ما تزال تركض من طفولتها إلى الآن هاربةّ من سرقةٍ طفولية (وهو أيضاً أفق سردي)، تحاول تجريب نفسها في لعبة الضمائر، عسى أن تعثر على “طفلها” الضائع.
هكذا، ومن قصيدةٍ غير معنونة، تنطلق التجربة، مقدمة الذات باعتبارها اثنتين (أنا/ أنتِ)، وبضمير المخاطب الذي يضعنا مباشرةً أمام فكرة “الرسالة”. إنها قصيدة تنهض بلاغياً بالكامل على ألق التشبيه، حيث يجلو المجاز معنى الواقع القريب والمتاح (وليس العكس كما علمتنا كتب البلاغة): “كقبلة وداع/ مزقتها صافرة القطار/ كحافلةٍ سقطت في النهر عنوةً/ فتبللت جيوبُ الموت/ فجأةً/ كاذنوب والخطايا/ كسنٍ معدنيةٍ تلمع،/ فوق شفاه قاتلٍ/ كشمعةٍ/ كطلقةٍ في الميدان،/ مصوبةٍ منذ أعوام،/ لكنها لم تصل/ بعد/ إلى سويداء القلب/ كطريقٍ فرشناه معاً/ بالأسى والحنين/ كسمكتين وحيدتين/ في “حوضٍ” ضائع/ أحبّكِ../ كندبة..”
متتالية من التشبيهات، تمنح القصيدة أداتها الاستعارية الرئيسية، لتفصح عن مفردتها البطلة، فقط مع الكلمة الأخيرة، حيث “الحب ندبة”. إنها قصيدة بلا عنوان، وهي جسرُ بين امرأة الإهداء المسماة، والموصوفة بالحبيبة، وامرأة القصيدة غير المسماة، والتي يبدو أنها كانت بحاجةٍ لقصيدة غير معنونةٍ بدورها.
تلتقط “عارياً يتغطى بنافذة”، القصيدة التالية مباشرةً، وأولى قصائد الديوان المعنونة، الذات الشاعرة وقد صار “الوجود” موضوعاً شعرياً. هنا تقلب الذاتُ الشاعرة معنى اتفاقياً متعارفاً يقضي بأن الإنسان هو من يأتي بالمعنى، إذ تقدم طرحها العكسي، بجرأةٍ كاملة: “احصل على النافذة أولاً/ وأنا أضمن لك/ أن القمر سيأتي صاغراً معها/ والنجوم/ والشجر سوف يأتي/ وإذا جاءك هؤلاء جميعاً/ مرة،/ صدقني،/ سيأتي النهرُ معهم/ دائماً/ من تلقاء نفسه”. كأن النافذة هي “آدم” هذا النص، رغم أنها محض علامةٍ ثقافية لا ذاتاً إنسانية (العلامة تختلف عن الشيء، فالعلامة تتجاوز الموجود الغفل كونها ابنة الثقافة وليس الطبيعة). إنه المخاطب مرة أخرى، وهو يراوح “الأنا” ليقسمها، مجدداً، إلى ذاتين. إن الذات الشاعرة تنهي القصيدة وقد تحولّت هي نفسها إلى علامة، وكأنها عبرت حدودها كذات لتصبح “موجوداً”: “كل الملاءات الندية المعلّقة في الشوارع/ أخواتي،/ وإخوتي/ الشبابيك”.
ان تلبث الذات الشاعرة أن تتبني الضمير الجمعي “نحن”، والذي يقبض على قصيدة “العالم من دوننا يتيم”. هنا، ينسحب صوت الفرد كأنا أو كمخاطِب، لصالح صوت الذات الإنسانية كمفردٍ بصيغة الجمع. “العالم”، مجدداً، هو الموضوع الشعري. العالم نفسه، برمته، موضوعٌ لـ”النافذة” حيث: “يسقط حياً من النافذة/ على أكتاف العابرين/ لو تخلى العاطلون عن الكذب”. العالم عرضة للانتحار (متقمصاً سلوكاً إنسانياً بامتياز). إنه فعل “أنسنة” كامل بإضفاء ما هو إنساني على ما هو وجودي لتحويله، من ثم، إلى ذاتٍ ما.
ومن تبني الضمير الجماعي لذات منضويةٍ في سؤال الجماعة، لتبني ضمير المخاطب بصيغة الجمع أيضاً، وبنبرة التحذير “انتبهوا”، التي تنطلق منها قصيدة “حيث لا تنتهي الحرب أبداً”، إذ تنشئ خصامها الحاد مع القصيدة الرومنسية، لتمنح دوالاً جاهزة “كالقمر والمطر والنهر” مدلولات جديدة، تجافي الإحالة الجاهزة لوجه الحبيبة أو لضوء العالم، لتغدو علامات قهر وشواهد على تاريخٍ من العبودية والسُخرة: “هذا الشاطئ/ الذي يتمدد كمخدع للأشجار والعصافير/ وتلك المياه التي تجري منسابةً إلى الجحيم/ ليست نهراً/ بل دموع أمهات فقدن أبناءهن في الحرب”. إنها الحرب نفسها “التي لا تريد أبداً أن تنتهي”.
اختباراتُ متتالية، تتنقل فيها الذات من الرؤية حيث الرصد البصري للرؤيا حيث القراءة الجوانية، ومن الاستباق حيث يرقد العالم في نقطةٍ لم تأت بعد، للاسترجاع حيث الذاكرة طوق نجاة أخير من الغرق في المحو. هنا، ذاتٌ حائرة لا تملك إجابةً سوى السؤال، ذاتٌ تلوذ بتلك النافذة التي لا تمنحك فقط قمراً يخصك وحدك، أو حبيبةً في النافذة المقابلة ترى فيها وجهك، بل تمنحك قبل كل شيء شخصاً لم تكن تعرفه، شخصاً جديداً هو أنت.