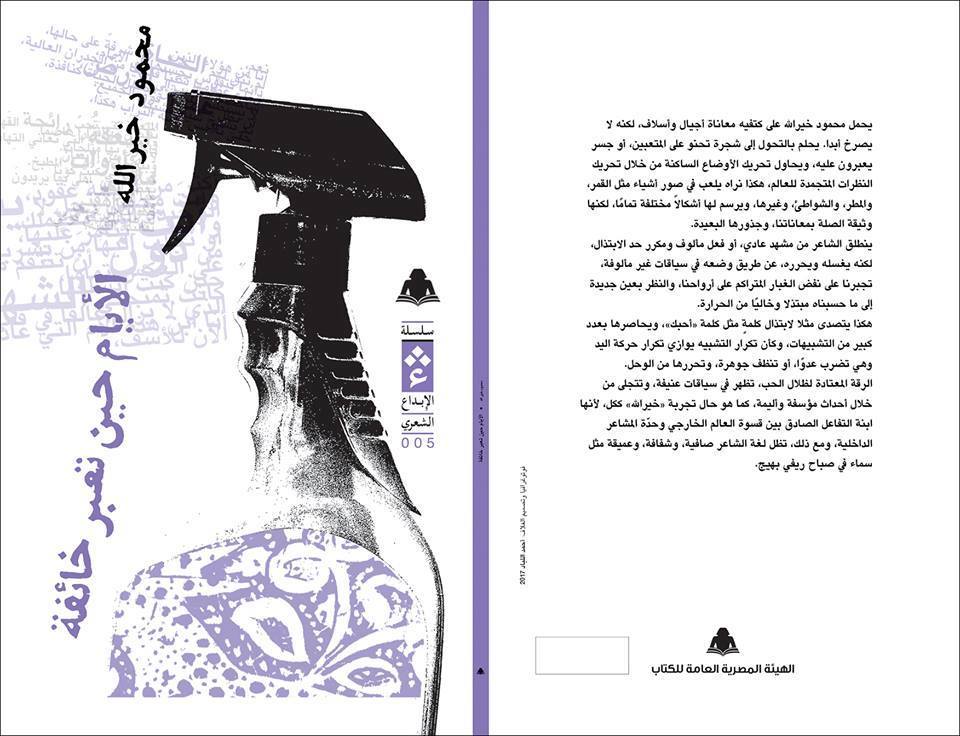محمود خيرالله
إلى آمال شحاته .. حبيبتي
………….
كقُبلةِ وداعٍ
مذَّقتها صافرةُ القطار،
كحافلةٍ سقطت في النهر عنوةً
فتبللت جيوبُ الموتِ
فجأةً.
كالذنوبْ والخطايا.
كسنٍّ مَعدنيةٍ تلمع،
فوق شفاه قاتل.
كشمعةٍ.
كطلقةٍ في الميدان،
مُصوَّبةٍ منذ أعوامٍ،
لكنها لم تصل
ـ بَعْد ـ
إلى سويداء القلب،
كطريقٍ فرشناه معاً
بالأسى والحنين،
كسمكتيْن وحيدتيْن
في “حوض” ضائع
أحبٌّك..
كنُدبةٍ.
عارياً يتغطى بنافذة
احصل على النافذة أولاً
وأنا أضمن لك
أن القمر سيأتي صاغراً معها،
والنجوم،
والشجر سوف يأتي،
وإذا جاءك هؤلاء جميعاً،
مرة،
صدقني،
سيأتي النهرُ معهم
دائماً
من تلقاء نفسه.
أعرفُ رجلاً يخوضُ في الخمسين،
واقفاً كل يوم
ـ أمام نفسه ـ
عارياً،
لا يتغطى سوى بنافذة.
أنا لا أملك
ـ من حطام الدنيا ـ
سوى عينين ونافذة،
أرى بهما العالم
الذي يدور في رأسي،
لا بيت لي،
ولا أصدقاء،
أهلي كلهم هجروني،
لم يبقَ معي ـ دائماً ـ
وإلى النهاية،
سوى الشرفات،
كانت تعويضاً كافياً عن العالم،
ـ ذلك الملعون الذي لا أم له ولا نافذة ـ
يمنحُ الحبَ بيدٍ
ويأكل بالأخرى خُبز العاشقين.
نعم،
أنا من هؤلاء الذين
لم تبق لهم الحياة شرفةً على حالها،
دائماً تتقوس بجسدها إلى الأمام،
تخلع عظامها شيئا فشئيا من الجدران العالية،
شاخصة بغضب إلى الأرض،
لا يستطيع المرء أن يحتمل الحياةَ كنافذة،
أن يظل عُمراً فوق الجميع،
ثم يشيخ شيئا فشيئا
حتى تلامس رأسه التراب هكذا،
ليس سهلاً،
أن يخلع البناؤن عظامك
ـ قطعة قطعة ـ أمام الناس
لتصير أرجوحة للصغار.
بعض الشرفات تودّع حياتها التليدةَ في البناية،
وتهوي على الأرض
مرة واحدة،
كأنّها قررت
فجأة
أن تنتحر.
بعض الشرفات تفعل ذلك،
لأنها تلعن قصص الحب
التي انمحت من جدارها،
تلعن الندوبَ الثقيلة
التي تحفرها الأيدي
على خشب النوافذ.
تلعن الدموع التي هطلت
والشرايين التي تمزّقت
على سور قلبها.
بعض النوافذ تسقط كالثورات الزائفة،
وتتكوم كالروث
في جانب الميدان.
أنا من هؤلاء الذين يعتقدون
أن الحبَ نافذة،
حيث لابد له أن يعيشَ
وأن يتألم،
لدرجة أنني حين كنت صغيراً
كنتُ أعشق النافذة أولاً،
وقد لا يبقى لدي وقت لأعشق
الفتاة التي أطلت منها
مصادفة،
بعض الفتيات ظهرن مرة واختفين،
في شرفات لا أزال أحبها إلى اليوم.
خسرتُ عشيقاتٍ كثيرات،
لأن نوافذهن كانت أقل جمالاً
من سيقانهن.
تفهمني النوافذ أكثر
حين أحلّ ضيفاً عليها،
تعاملني بأخوَّة وصبر،
تعلمني كيف أفتحها لتكشف البحر لي،
وكيف أغلقها لأبكي.
أنا صديقُ النوافذ المفتوحة
في أواخر المدن،
المضاءةِ بمصباحٍ وحيد،
صديق الحب الذي يترعشُ تحت الضلف،
وصاحب كل الشرفات
التي تُغلق،
كل يوم
بلا تلويحةٍ للوداع.
كل الملاءاتِ النديَّة المُعلقة في الشوارع
أخواتي،
وإخوتي
الشبابيك.
حيث لا تنتهي الحرب أبداً
انتبهوا..
هذا الرغيفُ الأبيض الفاخر،
الذي يظهر كل ليلة،
في السماء،
ويبدو نحيلاً ـ أحياناً ـ
كعودِ قَصب،
ومستديراً
ـ أحياناً ـ
كقُرطٍ في أذنِ الغيم،
ليس قمراً،
صدِّقوني،
إنه آخر ما تبقى من دموعِ أجدادِنا،
الذين ماتوا في سالفِ الأزمان،
ببطونٍ خاوية.
هذا الرزازُ الخفيفُ،
الذي يسقط في الخارج،
ـ الآن ـ
فيوحِل الأرضَ،
تحت أقدامنا،
ليس مَطراً
ـ ولا يَحزنونْ ـ
إنه عرقُ أجدادِنا،
الذي جمَعَه ملوكُ الأزمنة الغابرة،
وخبَّأوه ـ كالعادةِ ـ
في عَباءةِ السماء،
ليروي الأرضَ التي يحرسُها الأحفادُ
إلى الأبدْ.
هذا الشاطيء،
الذي يتمدد كمَخدعٍ للأشجار والعصافير،
وتلك المياه التي تجري منسابةً
إلى الجحيم،
ليست نهراً،
بل دموعُ أمهاتٍ فقدنَ أبناءهنّ في الحرب،
وبعد عصورٍ سَحيقة،
قرَّرت هذه الدموع،
أن تلقي نفسَها في البحر،
بسببِ هذه الحرب،
التي لا تُريدُ
ـ أبداً ـ
أن تنتهي.
ليتني شَجَرَة
ليتني..
بعد أن أموتَ
وتصير العظامُ تراباً،
أن أتحوَّل ـ ذاتَ مرَّة ـ
إلى شَجَرة،
ينامُ الناسُ تحتَها،
يبتسمون ويأكلون كلَّما شاءوا،
وحين تجف الحياةُ في بدني،
وتصير القامة يابسةً،
تماماً،
من كثرةِ الحنين إلى الثمار،
أصيرُ جِسْراً ميتاً بين ضفتيْن،
لا يُمكنني أن أصحو،
إلا كلما مرَّت أحذيةُ الفقراء على رأسي.
علَّق ابتسامتَه في الشرفةِ .. وما
لم يمُت “مفتش الآثار” التعيس،
أبداً،
بهذه الطريقة العجيبة،
لأنَّ روحه المرحة،
لاتزال تلوِّح لليمام في السماء،
رغم أنهم كفنوه
قبل خمسة عشر عاماً،
في تلك المدينة القديمة،
التي تدفنُ رأسَها في البحر،
بينما كان وجهُه يبتسم
تحت “فيونكة” الكَفن،
كما لو كان،
وجه رجلٍ سَعيد،
يبتسم بخُبثٍ للدود
الذي يأكل ابتسامَته،
كرجل من يُناكف خطاياه
إلى الأبد.
يبتسم “المفتش” مُضطراً،
لأنَّ الموتَ يأتي
حين لا يكونُ المرءُ جاهزاً،
لقد خرج السرُ الإلهي،
بينما كان العجوز يجمع الغسيل،
ساعة العصاري
في “بالكونة” عرجاء،
مرتدياً ملابسَه الداخلية
ماداً يديه الطويلتين
فوق الحَبل،
ضاحكاً من كل قلبه،
على هذا العالم،
الذي جفَّفته الأيامُ،
بين يديه.
شجرة «توت»
وأنت تجوبُ الشوارع جائعاً،
لن تنسى أبداً،
شجرة “التوت” النبيلة،
التي أرضعتك ـ دائماً ـ الشهد
وأنت صغير،
والتي تتحوَّل مع الأيام لتصبح دليلاً عليك،
فقد لا يجد المرءُ غيرَها،
ليعرفَ
ـ أخيراً ـ
نفسَه.
لن تجد ـ في أي مكان آخر ـ
شجرةً صابرةً مثلها،
تحتمل فروعُها الضرب والصفع
هكذا،
أكثر من أربعة عقود،
وأنتَ محض رجلٍ لا يشبع.
الوحيدة التي تحتملك،
وأنت تتآمر عليها،
أوتجلب إليها مَن يشربون دمها،
من دون أن تنتقمَ منك،
على العكس تماماً،
حين كنتُ أتسلَقها
كانت تمنحني الشهد،
الذي لا يزال عالقاً في فمي.
أنا ابن هذه الأم التي غادرت مِقعدها
الآن للأسف،
بعدما صار لابد من إزاحتها،
لتوسيع الطريق الذي يمرّ
أمام بيتِنا القديم.
اللص
حاولتُ مراراً أن أكونَ لصاً،
وفشلتْ،
مرة واحدة نجحتْ،
خطفتُ برتقالةً من السوق،
وأخذتُ أجري،
كان خصمي فلاحاً عجوزاً،
لو كنتُ أخذتُ قلبهَ
من بين ضلوعه،
ما كان جرى ورائي،
كل هذه السنوات،
وهو لا يزال يجري،
إلى اليومْ.
رَضـــيع
في هذا الشارعِ الطويل،
المليء بالبكاء والعويل،
حيث عُلقت صورة كبير العائلة
في مكانٍ بارز،
فوق كل رؤوس النساء الثكلى
والرجال الواجمين،
وسط كل هذه الموجات الهادرة من النواح،
لم أرَ أصدق من دموع هذا الرضيع،
الذي يعصر ثدي أمّه
ـ غاضباً ـ
بكفّ يده،
بينما يسيل من عينيه خيطٌ من اللؤلؤ.
وجه أبي
1
حَدَثَ هذا فجأة،
ذات ليلة،
بعد أن بلغتُ سنَّ الأربعين،
صرتُ أحمل وجهَك يا أبي،
أغلقُ الأبوابَ بهدوء،
كأنني أودِّعها،
أنسلُ خارجاً إلى العالم،
هكذا،
سُمرة تعيشُ آمنة
تحت شعرٍ أبيض،
تتكلَّم عن الله الذي تعرفه،
والذي يحمله قلبُ كل زنجيِّ،
مثلك،
يا أبي.
2
الرجل ذو الحقيبة الصفراء والقلب الضعيف،
الذي خسر أهله،
بمُناسبة أحياناً
ومن دون مناسبة دائماً،
كان يزرع ورداً في حديقةِ البيت،
الذي يمر أمامه القطار،
عشر مرات كل يوم،
أنا،
ذلك الصغير الذي يقف هناك،
ينظِفُ الأوراق الذابلة،
التي يزرعها أبوه،
ويمكن أن تراه من شرفة القطار،
وهو يطارد الفراشات،
في حديقةِ البيت.
3
أظنّك الوحيد في هذا العالم،
يا أبي،
الذي كان يعرف أنني شاعر،
الجيران يعتقدون
أن شاربي جديرٌ بضابط،
أمي تراني دائماً
ذلك الولد الذي يحملُ عينيْن مائلتيْن،
ابني الصغير،
صار يظن أنني أعملُ في الليل سائقاً،
أدور به على السينمات والمشافي،
بمنتهى العدل،
ابني الأكبر يعتقد أنني لص،
أجدُ مَن يدفع لي،
مُقابلَ أن أكتبَ له،
وأنا..
لا أهتمّ،
ما دام واحدٌ من هؤلاء،
لا يعرف
ـ والحمدُ لله ـ
أنني شاعر.
4
البار هو اللحظات الأخيرة،
يا أبي،
حين تُنفق آخر ما في جيبك،
على آخر ما في رأسك،
وحين يُغلق عاملٌ كسول البابَ
بضربةٍ واحدة.
البار،
هو الجنة التي يلوذُ بها،
مَن كان زاهداً فيها،
مَن يحاول العودة إلى البيت
وهو لا يستطيع أن يعودَ إلى نفسه،
البار،
قُبلة،
ليس بالإمكانِ أن تردَّها،
تماماً،
مثل الزجاجة التي أخطأت طريقَها إليكَ
ذات مرَّة،
ولن تعيش متعتها أبداً،
يا أبي.
5
في البداية،
كان ورماً صغيراً تحت إبطك،
تحول لسبب ما إلى حجرٍ صلب،
لا يزيد حجمه كثيراً،
عن ذلك الذي هددتني به
ذات نهار،
ونحن نسير معاً في الصحراء،
في الطريق إلى مسجدٍ ما،
لأنني تعثَّرتُ في:
“ويلٌ للمُطفِّفين”.
6
يذهب الفلاحون بـ “الجلاليب”،
إلى المساجد،
بينما أقدامهم المتربة
لا تزال ملطخةً بطين الأرض،
وبينما يتبتلون في الصلوات،
يفوحُ الغبار من ملابسهم،
كي يعيدوه إلى الله،
هشَّاً ..
ومألوفَ الرائحة.
7
أريدُ أن أحكي حكاية عن أبي
ولا يموتُ فيها البطل
ـ كالعادة ـ
بسرطان “الغدد الليمفاوية”،
أريد أن أرسمَ قمراً صغيراً،
فوق نافذةٍ،
ولا يتحوَّل بين أصابعي،
إلى رغيفْ.
.. يُرفرفُ عارياً
1 ـ
ما مِن قلبٍ يُرفرفُ عالياَ
مُتكِئاً ـ هكذا ـ
على ظهرِ طائرةٍ ورقيَّة،
تميلُ وترتفِع،
تحتَ سماءِ الله رائقةً
بين السُحُب،
إلا وكان طرفُ خيطِهِ ينتهي
ـ مُتَعرِّقاً ـ
في قبضةِ
صَبيّ،
جائع.
2 ـ
ما من قلبٍ يُحَلّقُ
ـ عنيداً هكذا ـ
مثلَ الخرائب،
إلا إذا كانَ قادراً على الحماقة،
أنا صانعُ “الطائرات الورقيَّة” الفاشل،
حينما تدهور الحالُ بي،
كنتُ أرسمُ قلوبَ الأصدقاءِ الحمراء،
على طائراتٍ ورقيَّة،
تشمخُ في السماء،
مثل نسرٍ
احمرّ منقارُه المَعقُوفُ،
من دِماءِ الأبرياء.
3 ـ
حين يئست من قلبي تماماً،
جعلتُ يدي طائرةً
وأطلقتُها في الريح،
ليس سهلاً،
أن ترى السماء مزروعةً
بقلوبِ رسمَتْها يداك،
وأنتَ عاجزُ عن إطلاق روحِك،
لا شيء في هذه الدينا،
يُمكن أن يساوي:
إطلاقُ طائرةٍ في السماء،
وعلى متنها
….
أروع القصائد.
حُفرةٍ في الجدار
تَحتَ الشُرفة
..وحتَّى حين تتقاعد تماماً،
كرجلٍ مزّقه الزمن،
بوجهٍ عابسٍ،
وأبناء هاربين
من غضبِك
بين القارات،
ويكون عليكَ أن تحيا
كل مساء،
في شرفة مظلمة،
وحيداً..
مع الدموعِ والأشجارٍ،
ونصف دستة من العصافير،
تنام هادئةً في قلبك.
حتَّى حين يكون العالم من حولك:
محضُ شرفات جميلة
ومغلقة على أحزانها،
ساعتَها،
قد يأتيكَ لهاثُ عاشقيْن،
يدخلان الحديقة بكفين مُلتصقين،
ويبدآن العناقَ الطويل،
ساعتَها،
صدِّقني،
لن تجدَ لديكَ القدرة على الصراخ،
في هذه الآهاتٍ الضعيفة والمُتقطّعة،
التي تقول رأيها على الملأ،
في هذا الرجل العجوزٍ
الذي ينام كل ليلة في الشرفة حزيناً،
بعدما طردته الدولةُ من العَمل،
بحجَّة أنها تخلصت
ـ مؤخراً ـ
من الحاجة إلى الصُحُف.
صرخة
أحلمُ
ـ أنا وزوجتي ـ
دائماً
بطفلٍ صغير،
ينفث الحياةَ بيننا
كل ليلة في السرير.
إذا شعر بالجوع،
وهو يغطُ في النوم،
قبض على صدر أمه،
بأصابعه الصغيرة،
كمن يُحارب أعداءه،
في ليلِ الغابة.
إذا أرادَ ضَحك،
وسمعت الدنيا كلها
صوتَ قلبه،
وإذا غضب بكى،
فيوقظني عمراً كاملاً
بصرخةٍ واحدة،
تكفي لأذهبَ كل يوم،
مندفعاً،
إلى العمل.
“عيدُ الحب”
حتى اليمامة،
تأتي كل ليلةٍ مع عشيقها،
إلى حُفرةٍ في الجدار،
حيث يعبُر سِلك “التكييف”
الخاص بغرفةِ نومي.
تُراب
أريدُ قبل أن أموت،
أن أشتري مقبرةً واسعة
ذات قبة عالية
أموتُ فيها بمفردي،
وينقشُ أبنائي فوق رخامها اسمي،
بخَطٍ أنيق،
أُريدُها معزولةً في الرِّيف،
هناك،
تحتَ شَجرٍ هاديء،
حيث يفزع الجميع وهو يمر بجواري،
إلاّ العشاق،
الذين اعتادوا الاعتراف بحبِّهم،
هنا،
كلما مرَّوا بجوار حَجرٍ،
يخفقُ تحتُه
تُرابُ قلبي.
كثورةٍ تتدحرجُ فوق السلالم
(1)
لا..
لم تسقط الثورة ـ هكذا ـ
من “البلكون”،
ككتابٍ ملعون،
ولم تكن تطير بمُعجزة،
كدكرِ البط،
الثورةُ تدحرجت
ذات ليلة ـ كقطِ عجوز ـ
يكمن أحياناً بين السلالم،
فتطيحه ضربة بنعلِ حذائك،
وأنتَ تمر،
الثورة غالباً سوف تعود،
في لحظةٍ عمياء كهذه،
وأنت تتسلل مَهزوماً إلى بيتك
ـ ذات مرّة ـ
لأنّها كالقطط،
بسبعةِ أرواح.
(2)
يبدو أننا في حقيقة الأمر،
لم نكن نعرف،
أن الثورات أيضاً،
يُمكنها أن تذبلَ
ـ أيَّها السادة ـ
كفاكهة الخريف،
أن تبكي أياماً ـ كالأرامل ـ
على الأكفان القذرة،
لشهداء “جُمعة الخلاص”،
لم نكن نعرف
أن الثورة تنسى نفسها
حزينة،
في غرفِ العمليات،
تماماً كهؤلاءِ الذين يكتئبون
ثلاثة وعشرين ساعة متواصلة،
أمام “المشرحة”،
من أجل قُبلة باردة،
على جبين مَيّت.
(3)
خرج حالماً مع التائهين،
وحين قُتل،
ظلت ابتسامتُه تخطف الأبصار
في “ثلاجة الموتى”،
ثلاثة أشهر ونصف،
اتضح خلالها أنه
لم يكن له أم،
منذ سنوات طويلة،
وأن أحداً لا يسأل عنه،
سمّوه: “الشهيدُ المبتسم”،
لأنّ الرصاصة التي اختارت قلبَه،
وهو يجري سعيداً وسطَ الجموع،
نستْ أن تصيبَ شبح ابتسامةٍ خافتة،
كشاهدٍ ميِّتٍ،
على نجاحِ ثورة.
(4)
كان الدخانُ كثيفاً جداً،
يومَها،
لدرجة أن الثوارَ جميعاً
لم يروا هذه القبلة،
التي لم تخجل الفتاة
وهي تمطِّها طويلاً،
حتى أخوها،
الذي نزل معها من بطنٍ واحدة،
لم يرها،
العساكر الذين يقفون على البعد،
لم يروا شيئا،
حتى الكراهية..
التي كانت تلطخ الجدران،
ساعتَها،
لم تمنعْ قبلةً حارة أبداً،
في الميدان.
(5)
الثورةُ هي:
أن تتلطّخ الجدران برسوم الحرية،
كلما سقط الشهداء،
على بعد خطوة من طوابير البنوك،
أن ينصرفَ المرء مسرعاً
من مكانٍ ما،
ليلحق الآخرين في تظاهرات “حظر التجول”.
أن يقدم الأحياء حياتهم،
عرابين ولاء للأموات،
أن يسقطَ الشهداء
في كل ذكرى،
تحيَّة لشهداء المرة الأولى.
أن تخاطر بابتسامة في الطريق العام،
فتُسحب “الأجزاء” إلى موتك.
أن تضحك السماء بالمطر
ذات مرة،
فتختفي “الشموع” من الأسواق
فجأة.
أن نموتَ جميعاً في “أتوبيس عام”،
محترقين،
فنشيّع كالعجين المُحترق،
إلى مخابز الحكومة.
(6)
لا تيأسوا من رحمة الفقراء،
الذين ينزلون إلى الثورات مندهشين،
على أمل أن تقودَهم إلى ظلِّ ابتسامة،
رأيتُهم يدخلون الميدان في الصباح،
بعد ستة وعشرين ساعة في الطريق،
وصلوا،
تمددوا مُنهكين على الأرض،
وبدأت دموعُهم تَهطل.
(7)
اجمعوا تبرعاتكم
للمشافي،
للخُطبِ،
اجمعوها للغارمين،
للصبية الذين قطعت رؤوسهم
بسكاكين صبية آخرين،
للطلبة،
جمعوا التبرعاتِ لأنفسكم،
كي تعيشوا…
لكن السجون،
تبنيها “الموازنة العامة للدولة”.
………………….
* كُتبت قصائد هذا الديوان بين عامي 2009 ـ 2018