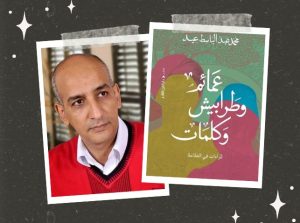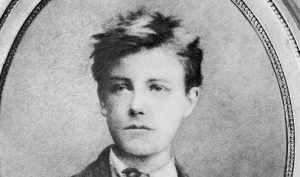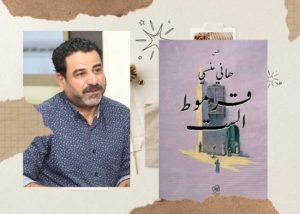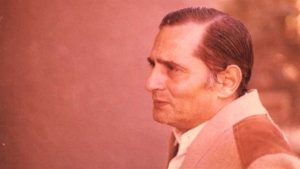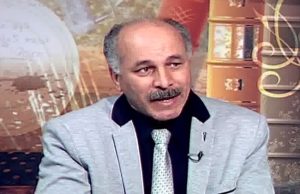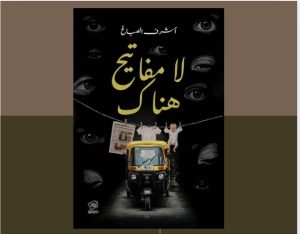بولص آدم
الصورة الفوتوغرافية كزمن مؤجّل والشعر ككشفٍ للغياب
في لحظةٍ ما، حين يتأمل الإنسان صورةً قديمة، لا يرى فقط ما التُقط، بل ما فاته، ما غاب عن الإطار، وما غادر الذاكرة. ليست الصورة الفوتوغرافية سجلًا محايدًا، بل كما وصفها رولان بارت في كتابه “الغرفة المضيئة” نوعٌ من الشبحية العاطفية، إذ يقول:
“كل صورة فوتوغرافية هي شهادة على موتٍ مؤجل.”
بهذا المعنى، تصبح الصورة أكثر من تمثيلٍ بصري: إنها أثر، زمن مكثّف، وشهادة صامتة على حضورٍ غادر.
وحين يُقارب الشعر الصورة الفوتوغرافية، لا يفعل ذلك بوصفها مادة للحنين فقط، بل بوصفها فضاءً للكشف والتمزيق؛ إذ لا يهتمّ بما تقوله الصورة بقدر ما يُنصت إلى ما لم تقله: إلى الأطراف المبتورة، الظلال المحذوفة، الغائبين بلا أسماء، والحكايات التي لم تُطبع.
هذا ما نلمسه بعمق في نص «صور» للشاعرة نورهان أبو عوف، حيث تلتقي الصورة الفوتوغرافية مع الذاكرة المتآكلة، في نصّ لا يحتفي بالماضي، بل يشتبه فيه، ولا يتأمل الصور بطمأنينة، بل بتوتّرٍ وخشية. القصيدة لا تتعامل مع الصورة كمجرد سجلّ شخصي، بل كأداة لتمزيق الستائر عن الذاكرة الجمعية، وفضح أفعال النسيان والطمس المتعمد.
بين الظاهر والمقصيّ: تأملٌ في انفتاح القصيدة على الغياب
في درج المكتب،
تنام صورٌ بحوافٍّ متآكلة،
كأنّ الذاكرةَ
كانت تمضغها على مهلٍ
ثم تبصقها دون اكتراث.
بهذه الاستعارة الجريئة، تمنح الشاعرة الصورة الفوتوغرافية طابعًا حيًا ومؤلمًا في آن. الذاكرة ليست هنا خزانًا مُطمئنًا، بل كائنٌ عضوي مفترس، يمضغ الصور ويمجّها حين يفقد الحاجة إليها. إن “الدرج” الذي تنام فيه الصور ليس حيّزًا منزليًا عاديًا، بل خزانة للمنسيّ، للمهمل، لما تمّ طيّه وإخفاؤه.
إنّ «الحوافّ المتآكلة» لا تشير فقط إلى تآكل الورق، بل إلى ما هو أعمق: تآكل المعنى، الهوية، وربما الروابط نفسها. فالصورة، التي يُفترض أن تحفظ اللحظة، تظهر هنا وقد نُهشت من أطرافها، كأن شيئًا داخليًا قاومها.
الوجوه الناقصة والأجساد المنسحبة: الشعر بوصفه كشفًا بصريًا ثانيًا
أُحدّق في الوجوه،
فأجد ملامحَ ناقصة،
كأنّ أحدهم قام،
وانسحب من الورق
قبل أن يُلتقط الضوء.
في هذا المقطع، تتعمّق القصيدة أكثر في بعدٍ سريالي واقعي: حضور غامض لمن قام من الصورة وانسحب منها، كما لو أن الوجوه لا تنتمي للورق، بل هي كائنات قرّرت الانفصال. الضوء، الذي يُفترض أن يثبت اللحظة، أخفق هنا في الإمساك بالغائب. وما تبقى للعين هو فراغ: ملامح ناقصة، كأن العدسة لم تقبض إلا على ما سمح الزمن أن يُرى.
الشعر هنا لا يُبالي بالوضوح، بل ينظر في التشققات، كأن النص كله تحقيق بصريّ – نفسيّ في ألبوم لا يروي الحقيقة، بل يُخفيها.
تفكيك الطقوس العائلية: صورة العيد وزفاف الخالة
في صورة العيد ـ مثلًا ـ
كانت هناك يدٌ سمراء
تُمسكُ بكتف أمي،
لكن الجسدَ الذي يخصُّها
غائبٌ
كمن أدار ظهره فجأةً للزمن.
هذه الصورة ليست عابرة، إنها لحظة عيد، لحظة يُفترض أن تكتمل فيها العائلة، أن تُلتقط الجماعة. ومع ذلك، ما نراه هو يدٌ دون جسد، يدٌ تؤكد حضورًا لا يُعترف به. الجسد غائب، ليس لأنه لم يكن، بل لأنه انسحب فجأة من الزمن. وكأن القصيدة تسائل فعل الحذف الجماعي، ذاك الذي يجعل من اليد الملتصقة بالأم دليلاً على وجودٍ تمّ محوه.
وفي صورة زفاف خالتي،
طفلٌ ينظر للعدسة
بعينين مندهشتين،
لا أحد يتذكّر اسمه الآن،
ولا لماذا اختفى من الروايات…
الصورة هنا ترثي غيابًا مزدوجًا: الطفل الذي لم يبقَ له اسم، والمحيطون الذين لم يحتفظوا له بسرد. النص لا يبكي الطفل بقدر ما يُعرّي المجتمع الذي “ينسى أطفاله سريعًا”، ربما لأنهم لا يخدمون السردية الجمعية، أو لأنهم لم يصمدوا طويلًا أمام قسوة التاريخ الشخصي.
الرجل الذي غاب… وظلّه الذي لا يزول
هناك رجلٌ
مسحتْه يدُ الزمن من كل الصور،
لا يظهر في أيّ إطار،
لكن ظلّه باقٍ
على طرف الفوطة المطرّزة،
وفي انحناءة أمي حين تُوزّع الشاي.
هذا المقطع هو قلب النص النابض. إننا أمام شخصية غائبة جسديًا، حاضرة كثقل، كرائحة، كظلّ. هذا الرجل لا نعرف اسمه، ولا مكانه، لكن حضوره يسكن التفاصيل اليومية، يطفو فوق المطرّزات، ويُثقّل جسد الأم وهي توزّع الشاي.
هكذا يعيد النص تشكيل الأم كمرآةٍ لرجلٍ لم يعد. لكنها، بعاداتها اليومية، بحركتها المكررة، تحمل أثره، كأن الزمن لم ينهِه تمامًا.
النسيان بوصفه قرارًا: مقاومة التوثيق
أحيانًا أظنّ أن النسيان
ليس فعلًا،
بل قرارٌ جماعيّ
يُتخذ في ليالٍ مُتعبة…
هذا التصور للنسيان كقرار لا كزوال، هو ذروة النقد الاجتماعي الهادئ في القصيدة. النسيان لم يعد تلقائيًا، بل إقصاءً مُدبّرًا. النص لا يتحدث عن الذاكرة فقط، بل عن آليات حذف الوجوه من الصور، والحكايات من الروايات، والأشخاص من العائلة.
من لم يعودوا في الصور… صاروا في الجدران
من ضاعوا من الصور
لم يختفوا تمامًا،
بل صاروا ظلالًا
تتمشى على الجدران
حين يُطفأ الضوء…
هنا تصل القصيدة إلى بعدها الأكثر حلميةً وتأملًا. إن من تمّ حذفهم لم يختفوا، بل تحوّلوا إلى كائنات رمادية، تتسكع في الذاكرة البصرية الليلية. وكأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن إلا محاولة فاشلة لتثبيتهم، في حين أن الشعر هو من منحهم حياة ثانية، خافتة، لكنها مستمرة.
خاتمة: قصيدة ضد المحو، وضد الطمأنينة
في قصيدة «صور»، لا تكتب نورهان أبو عوف عن الحنين بقدر ما تكتب عن الإقصاء، والحذف، والنسيان العائلي المتواطئ. الأم ليست فقط ركنًا عاطفيًا، بل مرآة للغياب، جسد يحمل في حركته آثار من غادر.
والرجل الغائب، رغم شطبه من الإطارات، لا يزال يترك ظلّه على المطرّزات، وفي الانحناءات اليومية.
إنها قصيدة تقف ضدّ التوثيق الساذج، وتُعيد توجيه العدسة الشعرية نحو الظلال، الفُتات، والمهمّشين.
وحين تنظر القصيدة إلى الصور، لا تفعل ذلك بعين نوستالجية، بل بعين نقدية حاذقة، تسأل: من حذف من؟ ولماذا؟ ومن يملك قرار الإبقاء والإقصاء؟
هكذا تُمارس نورهان أبو عوف فعلًا شعريًا يوازي التصوير المعكوس: لا تلتقط من يقف في المنتصف، بل من غادر الإطار قبل أن يُلتقط الضوء.
اقرأ أيضاً: