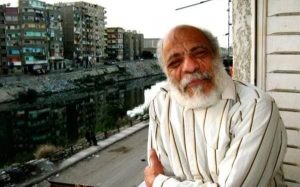طارق إمام
ثمة حي قاهري، عالقٌ بين الواقع والأسطورة، بقدر ما هو مراوٍحٌ بين خرائط الواقع ووهم الخرائط، يُدعى “حي الغايبين”، تختفي نساؤه، لأسباب مختلفة. عشرُ نساءٍ ـ ملتبساتٍ أحياناً برجال غائبين ـ تلتقطهن آية طنطاوي، في متتاليةٍ من الهروب، لتُحاور سؤال الغياب، في احتمالاته “اللانهائية”، حيث لا إجابة شافية على السؤال المر: لماذا يذهب الناس ولا يعودون؟
الكتاب القصصي الصادر عن دار العين بالقاهرة، بمنحة إنتاجية من مؤسسة المورد الثقافي، يؤسس فنياً تصوّره عن ثنائية الحضور والغياب، وهي ثنائية فلسفية بالأساس، أوجدت لنفسها مكاناً في كافة مناحي مقاربة الوجود الإنساني، ومن بينها الفن. المفارقة الأهم التي تتجسد بقراءة الكتاب، هي أن الحاضرين فنياً في القصص هم أنفسهم الغائبين في الواقعة الخارجية المفترضة، فالحضور المبهر يتركز على أولئك الذين بدأ السرد وقد اختفوا، وهنا تذوب الثنائية بتبديل المواقع، فكل من لا يزالوا موجودين هم الغائبون، بينما كل من ذهبوا هم الحاضرون.
“جمال الرحيل”: تعبير مجتزأ من التصدير، المجتزأ بدوره، من قصيدة “جمال العابر” لوديع سعادة. تصدير ليس بحاجة إلى شرح، في انحيازه للعابر، المغادر، المودِّع، وهو يؤسس لفضاء الكتاب بنصوصه العشر، ضارباً حسرة الوداع في مقتل، بتأسيس انزياحٍ دلالي عن القار والمكرس.
ينطلق الكتاب من نصٍ مشهدي، يتحقق عبر الضمير الثالث، لسجينات يتلصصن على المدينة من خلف نافذة عربة ترحيلات. إنهن يتفرجن على المدينة ويصفن ما يرين لبعضهن كأنهن لم يعشن فيها يوماً.
ستظل المدينة في هذا الكتاب فضاءً مفتوحاً تقطعه، للمفارقة الفادحة، قضبان نافذة تتوسط العتمة، وكأن التعرف على الحرية مشروطٌ بالمكوث في السجن. وستظل المدينة (العالقة بين الحقيقة والوهم، اليقظة والحلم، الحاضر والتاريخ) تنسحب كأن الذوات تطل عليها من عربة متعجلة، كلما انسحبت بقعة بعبورها لها، لا تعود مجدداً للظهور. لن تُرى المدينة سوى من ثقب إبرة، لحظة إفلاتها، وكأن الغائب الحقيقي في النصوص العشرة هو المدينة نفسها، التي ودعت ذواتها، تحررت منهم،
المدينة هنا أثرٌ بعد عين، نهر كان يقطع الحي فغاض وجف، بيتٌ أسقطه الزلزال، ليلٌ لا يُرى ويبحث عنه الأطفال ليعرفوه لأول مرة، بلاتوه زائف في فيلم، يحاكي مكاناً بعد اختفائه، لتبتلع الصورة الواقع وتحل محله،
حتى صارت كلُ ذوات الكتاب الغائبة، بالكاد، انعكاساً للمكان الذي ودّع أبواب الواقع والحلم معاً، دون أن يترك أثراً أو يلوح بأملٍ في عودته.
×××
لستُ بصدد استعراض القصص أو تلخيص حبكاتها، فهو في تقديري موضوعٌ شحيح الجدوي، وأرى أن الأهم استخلاص عدد من القوانين الحاكمة، أو التقنيات التي توسلت إلى تحقيق فضاءٍ دلالي عبر مقارباتٍ أسلوبية وجماليةٍ متباينة، تتوزع على عشرة مفاصل هي محكيات هذا الكتاب.
الملمح الواضح الأول، هو التنوع الأسلوبي الفادح بين قصص الكتاب، فليس من طريقةٍ بعينها تتسيد إنتاج النصوص. يكفي أن يتأمل القارئ أول نصين ليعي ذلك فوراً، ففيما النص الأول (عربة ترحيلات) يتبنى نسقاً مشهدياً، يقربه من مشهدٍ سينمائي، مع غياب لمحكيةٍ مركزية مقابل استعراض أبعاد اللحظة، براوٍ مصاحب (رؤية مع) يرافق شخوص النص، سنجد أن النص الثاني (باب الأساطير: فصل موّال النهر) يمتح بوضوح من موروث الحكي غنائي الطابع، عبر راوٍ يتموضع في صيغة المتكلم الجمعي (صوت الجماعة) مستعيراً صوت الحكَّاء المتجول، أو الراوي الشعبي المُغني، في نسقٍ يُقرب النص كله من بنية الموال الشعرية الغنائية التي تُمرر السرد عبر التداعي الوجداني، وبالتحديد “الموال الأحمر” الذي يقارب المأساة. بل إن الراوي يتعرض بدوره للعبةٍ جريئة، حين يتم تفكيك ألوهيته، بصوتٍ يأتي من خلفه، وكأن هناك راوٍ خلف الراوي، ليتساءل عنه أو يشكك فيه: “هل هذا انعكاس وجهها أم خيالات الراوي من زمن بعيد؟، هذا الراوي يسلب من الراوي إطلاقيته نفسها حين يصرح بوجود “مشهد لم يحكه الراوي الذي اختار أن يصمت أمام جمال النساء البهيج”.
وفيما اللغة في النص الأول محايدة، ترصد المشاعر عبر النسق السلوكي الظاهري للشخصيات، فإنها في الثانية مترعةٌ بلاغياً ولا تخلو من إيقاعية مستلهمة من طرائق النص الشفاهي في أنساق تكرارية تبني النص على التدوير الشعري، وبينما النص الأول متموقع في الحاضر، حيث السلطة هي “عربة الترحيلات”، فإن النص الثاني يشير للسلطة بـ “والي”، في إحالةٍ تاريخية لزمنٍ مفارق لم يعد له وجود. هذا التنوع الشديد في الأساليب اللغوية ملتبسةً بمواقع الرواة (وجهات النظر) يضعنا أمام كتابٍ نابض إيقاعياً إلى أقصى حد.
مواقع وجهة النظر ستتنوع، بلا هوادة، مُغطِّيةً تقريباً كافة الزوايا في إنتاج المروية، فيحضر ضمير المتكلم الفرد، على لسان أنثى، في “مقام خضرا عطية”، قبل أن ينبدل لراويين اثنيين في “أبناء الليل”، يتبادلان سرد الحكاية، بين ضمير متكلم جمعي “كان النهار أول عهدنا بالحياة خارج البيوت”، إلى ضمير متكلم مفرد، مذكَّر هذه المرة: “كنتُ مندوباً لعصابة العسكر”، ولتتشكل المروية من هذا التراوح بين الوعي الجمعي بالحكاية والوعي الفردي بها، أو بين السرد الموضوعي ومقابله الذاتي. ثم تعود وجهة النظر إلى المتكلم الأنثى في “رمشة عين”، ليهيمن الضمير الثالث في “يموت مرتين”، أما قصة “يقظة من حلم”، فمقسومة بين السرد بالضمير الثالث والضمير المتكلم لساردٍ رجل؛ انقسامٌ له إحالته الدلالية العميقة أيضاً بين نص الواقع الخارجي الموضوعي ونص الاستبطان الذي يجعل من السرد مونولوجاً داخلياً يرى الخارج عبر شفرات الداخل. الإيقاع يكتمل بعودة الضمير الثالث في “ساعة من الزمن”، يعقبه ضمير المتكلم لساردة في “انحصار”، وأخيراً، يُختتم الكتاب بضمير المتكلم الجمعي، في نص “حكلية لا نعرفها”، المتمم فعلاً لكل النصوص، والذي رأيته يتصادى مع النص الثاني، “باب الأساطير”، كانعكاسٍ مرآوي له، وبشكلٍ شخصي رأيت أن هذا النص الثاني كان الأجدر بأن يكون النص الافتتاحي في الكتاب، كونه نصاً مؤسساً لعالم الكتاب كله.
×××
أنواعٌ مختلفة من الرواة إذاً يتولون تقديم المحكيات من زوايا مختلفة، وبتبادل محسوب في ترتيب القصص، يوازي مراوحةً أخرى واضحة، بين نصٍ واقعي بالكامل، وآخر فانتازي يمتح من الموروث والأسطورة، وثالث ذاهب للحلم وهو يعيد تفسير الواقع (رمشة عين)، ورابع يمزج الواقع بأحلام اليقظة (يقظة من حلم، ساعةٌ من الزمن). هذا ما يمنح كتاب آية “ديالوجيته”، إذ يبدو في كُليِّته كحواريةٍ بين أنماط وجهات النظر، والأصوات، والتيارات التي تقارب الواقع سواء عبر المحاكاة الكنائية أو الرؤى الاستعارية النابعة من السرديات فوق الواقعية، ما يجعلنا أمام تجربةٍ سردية متململة من “النسق”. وفي تقديري، فأهم ما يفككه الكتاب، هو نسق الحكاية “المعتمدة” نفسه، ففي نصوصٍ عديدة نجد تقابلاً بين حكايتين، واحدة موروثة وأخرى يجري تشكيلها “الآن”، بحيث تلوح في الأفق طيلة الوقت حكايةٌ ثالثة، حكاية “غائبة” بدورها، تمنح سؤال الغياب كله بعدَه الأكثر استعارية.
في القلب من هذه المراوحات الشكلانية، تتخلق النويات الدلالية التي تُشيِّد أفق المعنى. القمع حاضر طيلة الوقت، لكن التعبير عنه يبتعد عن الكليات المجردة، لينفذ عبر السلوكيات البسيطة. “الإقدام على النظر”، تعبيرٌ يتكرر بصيغ متعددة، وكأن فعل الرؤية في ذاته سلوك خطر، يحتاج إلى شجاعةٍ خاصة، ولا تُضمن تبعاته. بالمقابل، فالشبابيك والشرفات تارة “ترى”، وتارة هي نفسها “العيون”، كأنها استعارت هذه القدرة الإنسانية التي جُردت منها الذوات الحية. بالمقابل، فخلف غياب الأشخاص، تغيب موجودات أكبر، تغيب المدينة والنهر والليل كما أسلفت، يغيب الواقع نفسه تحت سطوة الأحلام، يغيب الزمن بجدرانه الثلاث، أو يسيل مضغوطاً، وأحد الملامح المهمة في كتاب آية القطعات الزمنية الواسعة بين فصول السنة، أو بين سنوات متباعدة، وهو عنصر مهيمن هنا، يجعل مواد بعض القصص ممتدة زمنياً لسنوات. دائماً هناك الزمن الهارب (والغائب بدوره) في فجوات وهوات واسعة تسم عدداً غير قليل من النصوص.
في المجمل، يبدو غياب الذات الإنسانية في “احتمالات لا نهائية للغياب”، محض طعمٍ في صنارة الوجود، كي يشير ـ الوجود ـ إلى غيابه، إلى رحيله وانفلاته، ولتقف الذاتُ عاريةً وقد فقدت موضوعها، حيث ينهض السجن الأخير، سجن الجسد، الذي يتحوّل إلى زنزانة نفسه، وقد فقد حتى مزية العثور على زنزانةٍ خارجية تسلبه حريته.