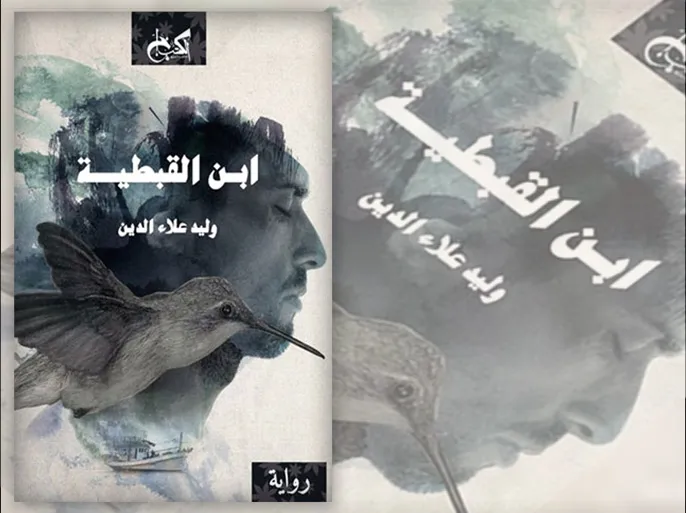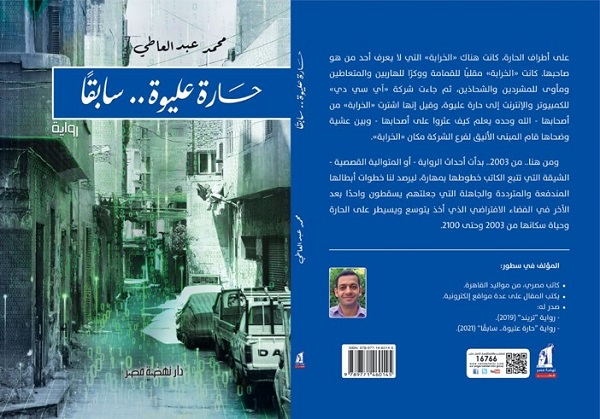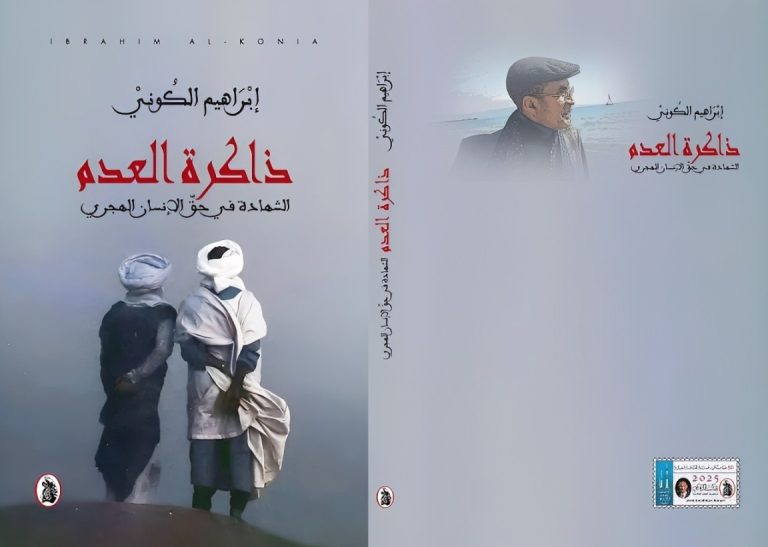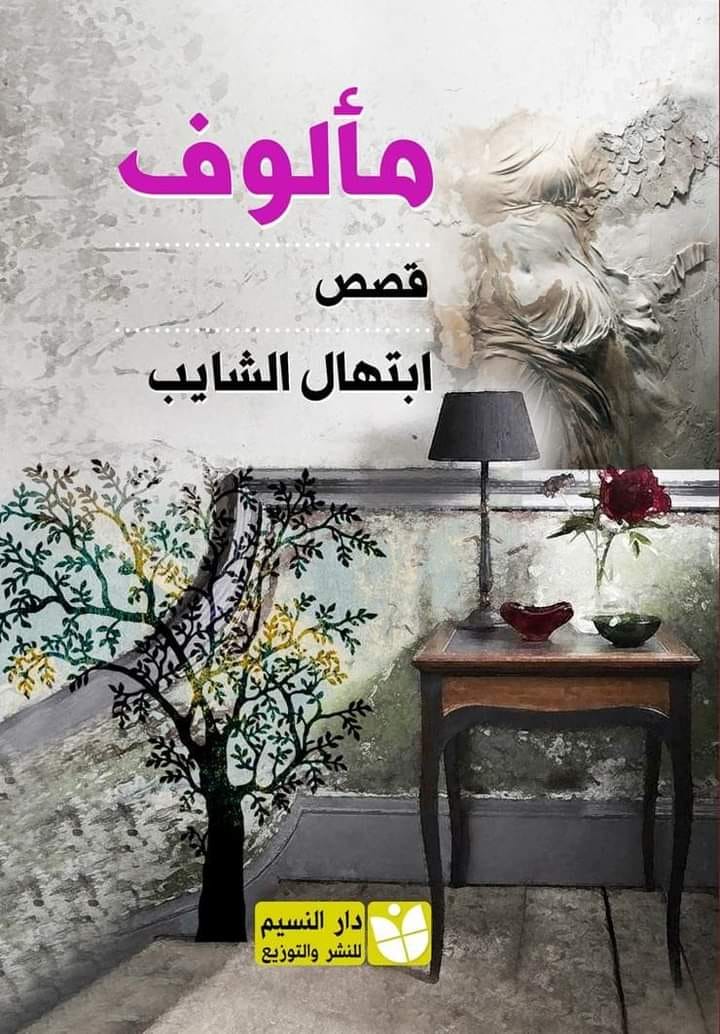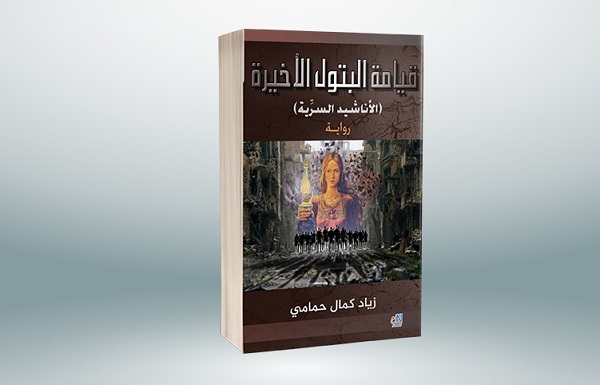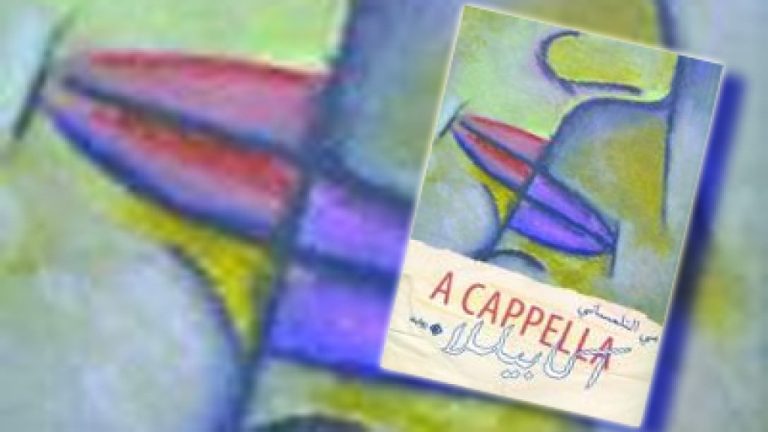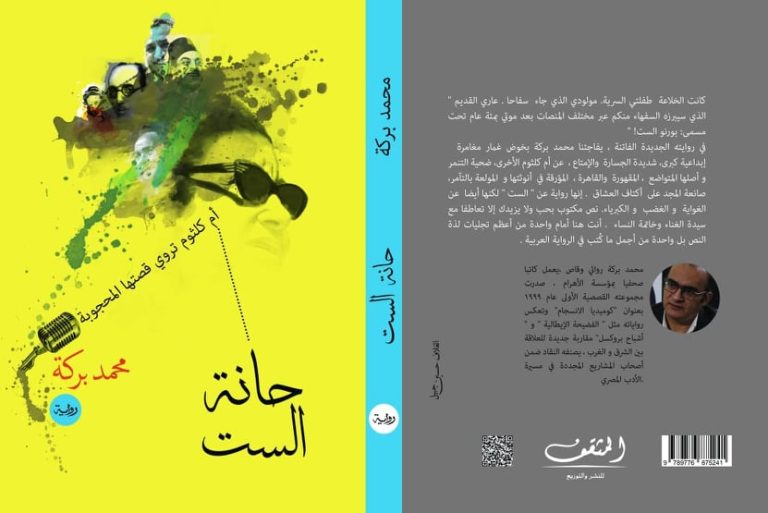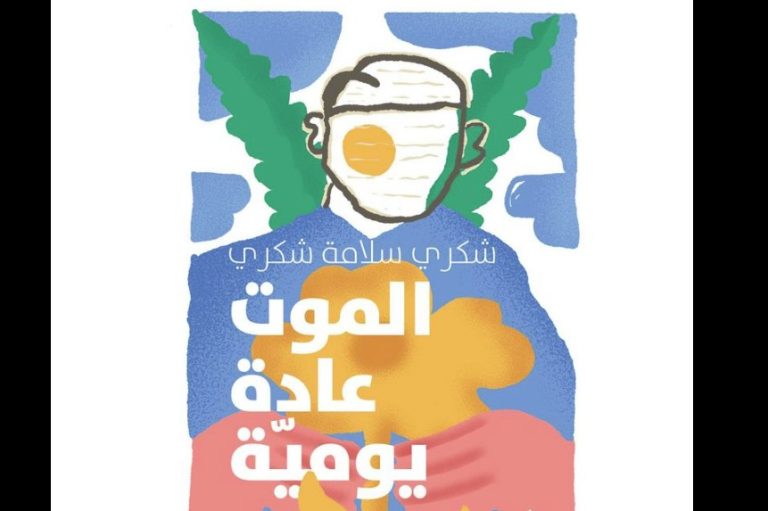د. سيد ضيف الله
عندما يبدأ شاعر أو كاتب مسرحي في كتابة روايته الأولى يصبح من المتوقع أن يكون المدخل النقدي لروايته محاولة البحث عن ملامح شعرية الرواية أو مسرحتها لتأكيد تأثير ماضي الكاتب على حاضره أو حرفته القديمة على حرفته الجديدة، لكن قليلا ما يكون ذلك مدعاة لطرح سؤال لماذا يلجأ شاعر أو كاتب مسرحي لكتابة رواية؟ وإلى أي مدى كان يمكنه أن ينتج تجربته الجديدة في شكل الشعر أو المسرحية؟ وإذا ما طرح مثل هذا السؤال يكون الرد الجاهز أن الموضوع أو التجربة اختارت شكل الرواية دون بقية الأشكال التي يجيدها المؤلف. فهل الموضوع أو التجربة ما جعل الشاعر والكاتب المسرحي وليد علاء الدين يقدم على كتابة روايته الأولى “ابن القبطية” (الكتب خان2016)؟ وإلى مدى يمكن أن يكون للموضوع علاقة ببناء الرواية؟!
يمكن الزعم أن رواية “ابن القبطية” تتفرد – في حدود ما أعلم- بتناولها لوضعية الهوية الهجينة الناتجة عن زواج المسلم بغير مسلمة/قبطية؛ ذلك الزواج الذي تقره الديانة الإسلامية التي هي ديانة الأغلبية في العالم العربي، ومن المهم أن نميز هنا بين هذه الوضعية الهجينة المعترف بها دينيا وبين أعمال أدبية أخرى انشغلت بغير المسموح دينيا، فطرحت زواج المسلمة بغير المسلم مثلما فعل على سبيل المثال إحسان عبد القدوس. ذلك أن معالجة وليد علاء الدين للهوية الهجينة المعترف بها دينيا تكشف عن فجوتين؛ الأولى فجوة بين المسموح به دينيا وحياة هؤلاء المتدينين، والثانية الفجوة بين ماض شبه تعددي وحاضر أصولي إقصائي بامتياز! وذلك بوضع “يوسف حسين” الذي يطلق عليه الناس “ابن القبطية” منذ الصفحة الأولى في الرواية في وضع المريض النفسي المُصاب بالفصام الذي من أعراضه بحسب التقرير الطبي الذي يفتتح به الكاتب الرواية، التوهمات الاضطهادية والهلوسات السمعية والبصرية؛ ونظرا لحب يوسف للكتابة فإن الطبيب يستفيد من ذلك بأن يجعله يكتب كل ما يشعر به في كراسته الزرقاء ليساعده على العلاج. إن بناء الرواية يتحدد من الصفحة الأولى بأنها ستكون رواية تفتتح بتقرير طبي وتكون كتابة المريض المصاب بالهلوسات السمعية والبصرية هي الرواية ذاتها، وأن هذا البناء يتماشى مع توقعات القارئ بأن الرواية رواية بوح من شخصية مضطهدة في وضع الهوية الهجينة بسبب تعصب المجتمع المحيط بها مما أفضى لإصابتها بأمراض نفسية! هذا حقيقي إلى حد ما. ذلك أن الرواية إلى جانب تقرير الطبيب وشهادة “يوسف حسين” على نفسه وعلى عالمه التى امتدت لأحد وعشرين فصلا (ص9 – ص 154) وهي كل فصول الرواية، اشتملت على ملحق ثان يحمل عنوان “من كراسة يوسف الزرقاء”!
ثمة أمور تدحض التلقي المبدئي للرواية باعتبارها مجرد رواية مونولوجية بتعبير ميخائيل باختين ليبوح فيها ويشكو مضطهد مأزوم بسبب هويته الهجينة، من هذه الأمور أننا أمام ملحقين وليس ملحقًا واحدًا مثلما وعد الطبيب المعالج في تقريره الذي تصدر الرواية، ونسبة الملحقين ليوسف يعني أن ثمة تدليسا فنيًا متعمدًا في بناء الرواية. والأمر الثاني أن الراوي (يوسف حسين) المصاب بالهلوسات السمعية والبصرية بنى المؤلف عليه روايته وهو يريده أن يكون راويًا غير جدير بالثقة!
الراوي غير الجدير بالثقة مصطلح نقدي وضعه واين بوث Wayne Boothe في السبعينيات ليقول لنا من خلاله إن الخصال الثقافية والأخلاقية للراوي تهمنا أكثر من تلك التصنيفات التي تنشغل بما إذا كانت الإشارة إلى الراوي بضمير المتكلم أم الغائب. وإذا كان لا يمكن لرواية أن تقوم لها قائمة دون راوٍ، فإن رواية “ابن القبطية” اختار لها مؤلفها أن يقيمها على راوٍ غير جدير بالثقة على أكثر من مستوى؛ الأول أنه راوٍ ابن هوية هجينة لا يثق بها عموم الناس من حوله، رغم وربما بسبب أنه ينتمي إلى كل منهم إلى حد ما، إنه ليس منهم بمعنى الكلمة! أما المستوى الثاني أنه راوٍ غير جدير بالثقة لأنه مصاب بالهلوسات السمعية والبصرية مما يفقد القارئ الثقة في مروياته عن نفسه وعن الآخرين، وهو ما يؤكده يوسف بنفسه!
“لم أخف عنكم أنني كذاب، لم أخدعكم، قلت لكم إنني أكتب بتحريض من طبيبي النفسي(…) فقط عندما عرف أنني أحب الكتابة طلب مني أن أكتب كل ما أشعر به، لكنه أبدا لن يحظى مني بذلك، ما أشعر به أخطر من أن أكتبه في كلمات، لقد زيفت الحقائق وقلبت الأفكار ونسبت لنفسي ما فعله آخرون، ونسبت للآخرين أفعالاً سيئة قمت بها بنفسي” (ص147).
إن هدف الراوي غير الجدير بالثقة دحض الإيهام بصدق ما يكتب بل وتأكيد كذبه لإبعاده عن مجال الشهادة التي يكتبها مريض لطبيب بقدر ما يقربه من مجال الأدب قرين الهلوسات أو الخيال المريض!
“قلت لكم يمكنكم التشكيك في كل ما كتبت، فقد كنت أدسُّ ما يوحى إلىَّ به، وسط هلوسات تشبه ما تكتبون وتسمونه مسرحًا وشعرًا ورواية! (ص148).
إن عدم الانتباه لاعتماد المؤلف على تقنية الراوي غير الجدير بالثقة قد يفضي بالقارئ إلى الإحساس بالارتباك الناتج عن عدم القدرة على التمييز بين الأصوات داخل الرواية، فالتمييز بين الأصوات ليس غاية المخطط السردي لهذه الرواية بقدر ما أن الغاية -فيما أظن- تأكيد حالة الالتباس والهجنة والزيف المتعمد على مستوى الصوت السردي وعلى مستوى الهوية التي يحملها هذا الصوت، بل إن الرواية تعتمد على ظلال تتراءى للراوي المريض نفسيًا فيستنطقها مرة بضمير المتكلم وأخرى بضمير الغائب مثلما فعل مع حكاية (أمل) حبيبته، وحكاية أمه وحلمها بعد أن كان هو الراوي الوحيد الذي يستخدم ضمير المتكلم!
وهنا يكون التمييز الطباعي في الملحق الأول بين سرد الراوي(يوسف) وكلام الشخصيات(أمل- الأم- راحيل…إلخ) حيلة فنية للإيهام بالتمييز بين الأصوات، لكنها تؤطرها حيلة فنية أشمل وهي تقنية الراوي غير الجدير بالثقة.
إن اعتراف الراوي بكذبه وعدم جدارته بالثقة لا يعني أنه بنى عالمًا روائيًا بلا حقائق، وإنما يعني بحسب إشارته كذلك أن “الحقائق منثورة بين أكاذيبه باعتبارها موحى إليه بها”(ص148).ومن ثم لا حقائق يتم بناؤها إلا بنسج محكم بين أكاذيب! وهو ما فعله الراوي ابن الهوية الهجينة حين نسج بين مجموعة أكاذيب وهلوسات سمعية وبصرية ليكشف عن عدد من الحقائق السردية التي يمكن لمن يهوى استخلاص الحقائق وتمجيدها أن يجدها عند الربط بين الملحقين المنسوبين للراوي يوسف حسين غير الجدير بالثقة! فربما نكتشف معه أن أجسادنا ثمن هوياتنا الغائبة التي نسعى إليها مثلما كان جسدا كل من يوسف وراحيل- تلك الفتاة اليهوية التي سعت لتنجب من يوسف فتاة ذات رحم اشتركت فيه الأديان الإبراهيمية الثلاث (الإسلام- المسيحية- اليهودية)حتى لا يرث ابنٌ لها كراهية العالم له لكونه يهوديا- قربانين لهوية غائبة، بينما راحيل نفسها تهرب الآثار المصرية، او قد نكتشف أن هوياتنا ليست سوى صفقة مثلما بادل الراوي شيئًا في ضلوعه بحقيبة بينما هو يشكو مجتمعًا رفض زواجه من “أمل” المسلمة، أو قد نكتشف أننا نحتاج لنصعد لهوياتنا الغائبة أو أنه “لا يفنى في الله من لم يعرف قوة الرقص” كما كان يردد يوسف المريد لمولانا جلال الدين الرومي!