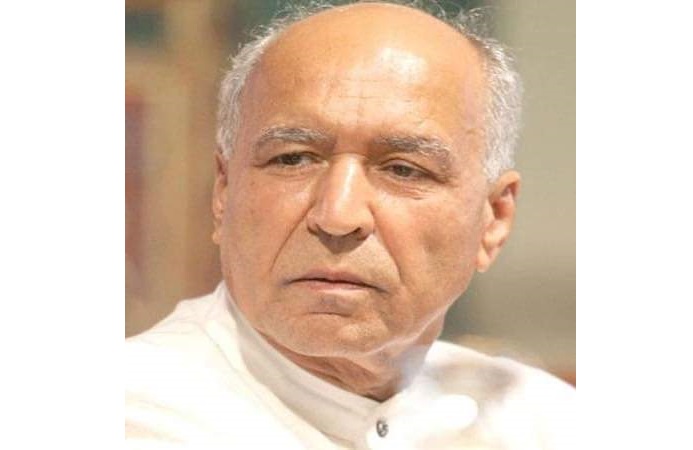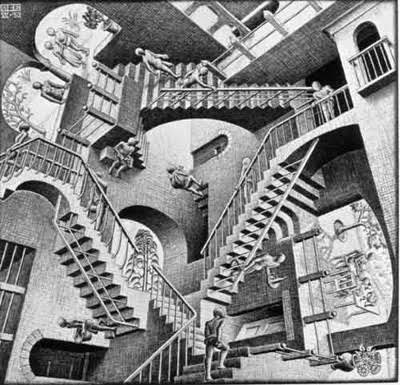عادل زيادة
بعد أن اصطحبتكم في جولة سريعة حول موقف الشريعة الإسلامية من دخول حمَّامات السوق، وبعد أن لفت نظرنا ما ذكره المؤرخون عن وجود أعداد كبيرة من هذه الحمَّامات في المدن الإسلامية وانتشارها بشكل مبالغ فيه خاصة خلال العصريْن المملوكي والعثماني بالقاهرة والشام على السواء .. فقد تبادر لنا عدة تساؤلات، أهمها: كيف كان حال المجتمع في ظل الأحكام الشرعية التي أقرها الفقهاء والعلماء الخاصة بدخول حمَّامات السوق؟ .. فقد حَرَّمت الشريعة دخولها ثم أباحت ذلك بشروط، مما يدفع المسلمين إلى الحذر الذي يصل إلى حد الابتعاد عن دخولها خوفاً من ارتكاب الآثام؛ في الوقت الذي أقبلت فيه فئات مختلفة من المجتمع منها الأمراء والأعيان وكبار رجال الدولة على بناء الحمَّامات بتلك الأعداد الكبيرة بما يشجع كافة فئات المجتمع على ارتيادها والإقبال عليها..! وبالتأكيد لو لم يكن الإقبال عليها كبيراً ما وصل عددها إلى تلك الأرقام الضخمة التي أشار إليها المؤرخون. والتساؤل الثاني وهو جانب هام من موضوع الحديث: هل اِلْتَزَمَ المجتمع القاهري في هذين العصرين بما نادت به الشريعة الإسلامية وبما وضعته من شروط تجاه دخول الحمَّامات؟ بالتأكيد يمكننا بداهة أنْ نَصِف أي مجتمع بالتَّدَيُّن في حالة الْتزامه بتطبيق ما تنادي به الشريعة الإسلامية، فهل كان مجتمع القاهرة في العصرين المملوكي والعثماني مجتمعاً متديناً؟ خاصة وقد تغلغل في أفكارنا من خلال مأثوراتنا الشعبية المتوارثة: “أن الأقدمين كانوا دائماً أكثر تديناً من مجتمعاتنا المعاصرة” .. فهل صدقت هذه المقولة على المجتمع القاهري في ذلكم العصرين؟ تعالوا معي أصطحبكم في إطلالة سريعة على أحوال المجتمع القاهري في تلك الحقبة الزمنية لعلنا نجد إجابات على التساؤلات السابقة، واستنتاج ما كان عليه حال هذا المجتمع من خلال علاقته بحمَّامات السوق في ظل تعدادها الكبير ودلالاته، خاصة وأن هذا النوع من المباني المدنية يعكس بشكل مباشر حالة المجتمع الإسلامي بكل طبقاته وفئاته حيث يُظهر الكثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة وبالتالي أوضاع المجتمع .. وخشية من الإطالة أتمنى أن تتابعوا معي هذا الموضوع حتى النهاية حيث سيحتاج الكلام إلى مقال تالٍ …
أقول: أولاً .. كانت القاهرة خلال العصرين المملوكي والعثماني تضم مجموعة من الأحياء عُرفت بالحارات، وكان المجتمع مبني على عوامل مختلفة في أحياء المسلمين حيث تتلاقى الأصول العرقية من تركمان وأكراد وفرس ومغاربة وغيرهم مع الأصول الريفية المصرية.
كان النسيج الاجتماعي في القاهرة في العصر المملوكي يتكون من المسلمين الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم في المجتمع إلى جانب أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين كانوا يتمتعون بحماية السلطان المباشرة، فكثيراً ما كان ينادَى على لسان السلطان بأنه من يتعرض لظُلمٍ من اليهود والنصارى فعليه بالأبواب الشريفة، كما صدرت الأوامر السلطانية بأخذ الجزية منهم بالمعروف وبدون إجحاف. وفي العصر العثماني تغير الحال عندما حلَّ بالنصارى مثل ما حلَّ بالمسلمين، حيث سُلبت الحريات والحقوق من الجميع، بينما ظل اليهود خلال ذلك العصر سادة المجتمع بسيطرتهم على أهم موارده. ومع ذلك ظلت الأحكام الفقهية بمثابة القانون الذي يُحتكم إليه في كل ما يتصل بالمجتمع خلال هذين العصرين، وكانت سلطات المدينة القضائية هي التي تقوم بتطبيقها، وتعاونها في ذلك السلطة التنفيذية وفق ما تنص عليه تلك الأحكام التي سايرت بدورها عجلة التطور الحضاري.
كانت تقابل الفئة الحاكمة في القاهرة فئة المحكومين الذين كانوا من التجار والصناع ومن لا عمل لهم المعروفين بــ “العواطلية”، وكان لهذه الفئة طليعة تدافع عن حقوقهم وترفع أصواتهم إلى الحكام عُرفت بــ “العامة أو العوام”، كانت أساليبهم وأهدافهم دائماً شرعية وشريفة وعادلة، كما كان عددهم كبيراً بحيث كانوا يمثلون الشعب خير تمثيل في مكافحة ظلم الحكام واستبدادهم. وإلى جانب العوام كانت هناك فئات شعبية أخرى منها: “العَوَانِيَّة” وهي الفئة التي تعمل في التجسس على الشعب لصالح الحكام، و”البَلَاصِيَّة” وهم الذين يأخذون أموال الناس غصباً وبشتى الحجج والأساليب، و”الغوغاء” وهم فئة من الناس مندفعون دائماً بلا روية ولا تفكير ويمثلون القاعدة الشعبية للأشقياء والبلطجية، و”مشايخ الحارات” وهم رجال سلطوا أنفسهم على سكان الحارات وصاروا يتكلمون باسمهم أمام الحكام، و “العرفاء” وهم المسئولون عن الحارة نفسها ويختلفون عن المشايخ بأنهم لا يمثلون الحارة ولا يتكلمون باسمها وإنما يفرضوا سيطرتهم على أهلها. ولكن كانت فئة “الزُّعْرَان” هي أهم الفئات الشعبية المتدنِّية في القاهرة وهي فئة نشأت أصلاً في دمشق وامتد تأثيرها إلى المجتمع المصري بالقاهرة بكل ماتتصف به من الاندفاع في الغَيِّ والظلم ومزاولة أعمال السلب والقتل، والاستيلاء على أموال الناس، وممارسة الزنا واللواط وعدم الاغتسال أوالتطهر، ومن الواضح أنهم كانوا يمثلون عبئاً ثقيلاً على المجتمع الذي تمنى زوالهم من الوجود، حيث لم يكن مرغوباً في وجودهم من جانب الشعب أوالحكام على السواء فلم يكن لهم ولاء لأي من الفريقين، وغالباً ما كانوا عالة على الشعب والحكام.
كان يشرف على القاهرة في العصر المملوكي اثنان من المشرفين: الأول هو المحتسب والثاني هو والي المدينة، وكان المحتسب من أكبر الموظفين في ذلك الوقت إذ كان يتمتع بسلطات واسعة كمراقب عام على السلوك داخل طبقات المجتمع المختلفة.
وبسبب الدور المؤثر للعلماء وخاصة كبار القضاة في حياة المجتمع المملوكي بالقاهرة، مارست السلطة السياسية إشرافاً دقيقاً عليهم ليكونوا ملتزمين بالطاعة والانقياد، وجدير أن نذكر أن القضاء في بداية العصر المملوكي كان سلطة مستقلة قائمة بذاتها لها حرمتها وقدسيتها وحصانتها، فقد كان السلطان أو النائب يتروى كثيراً قبل أن ينتقض حكماً شرعياً أو مخالفة أصل من أصول الشريعة، وترتب على ذلك أن تمتع المجتمع بحرية واسعة، وبذلك كان القضاة بمثابة الحصن الذي يلجأ إليه المجتمع بصفة عامة في حالة تعدي الأمراء المماليك عليهم. ولكن لم يستمر الحال على هذا المنوال طوال العصر المملوكي عندما وجد العلماء والقضاة أنهم في كثير من الأحيان في موقف صعب ما بين الحكام والمحكومين، فالشعب من ناحية حيث من المفترض أن يدافعوا عن حقوقه، والطبقة العسكرية الحاكمة من ناحية أخرى لتأكيد ونشر السلطة والهيمنة على جميع طبقات المجتمع، وكانوا يخضعون لضغوط مختلفة لإرضاء السلطان والأمراء حتى لا يُحْرَموا من أموالهم ولا لشرف التقرب إليهم. ولكن كان من الطبيعي أن يتغير حال القضاة في بعض الفترات، فعلى سبيل المثال أَعلنت مجموعة من القضاة وعلماء الدين عام 711هـ/1311م سخطهم وعدم رضاهم لفرض الضرائب الجائرة، وقد كان لتدخلهم هذا أثره الكبير لصالح المجتمع بأسره. ولكن لم يتمكن العلماء في أحيان أخرى من فرض آرائهم الشرعية على الحكام بشكل عام، بسبب ضعف نفوسهم في ظل ظروفهم الاقتصادية التي كانوا يعيشوها، فالقليل منهم كان على قدر كبير من الثراء، بينما كانت الأغلبية من الفقراء الذين ينتظرون دائماً إنفاق السلطة عليهم، ومن هنا جاء ضعف نفوذهم. وفي الغالب عاش أهل القاهرة خاضعين للضريبة وللسخرة رغم مبادئ العدل التي تنادي بها الشريعة الإسلامية، بينما عاشت طبقة السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة حياة ترف وبذخ وفساد … وللحديث بقية ،،،