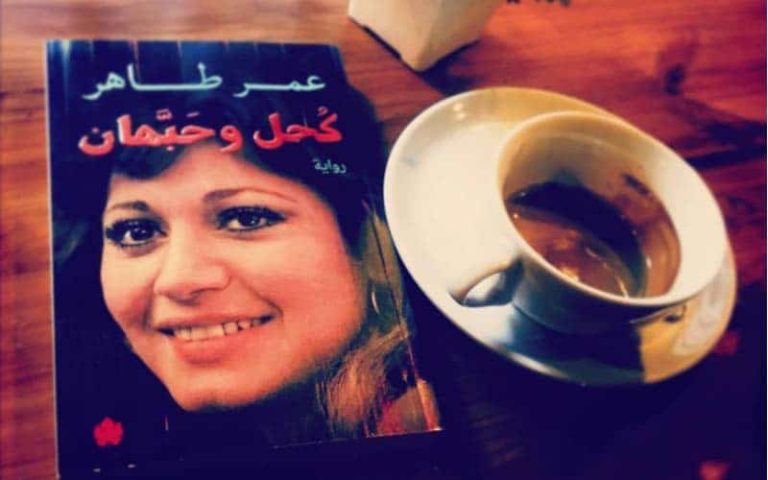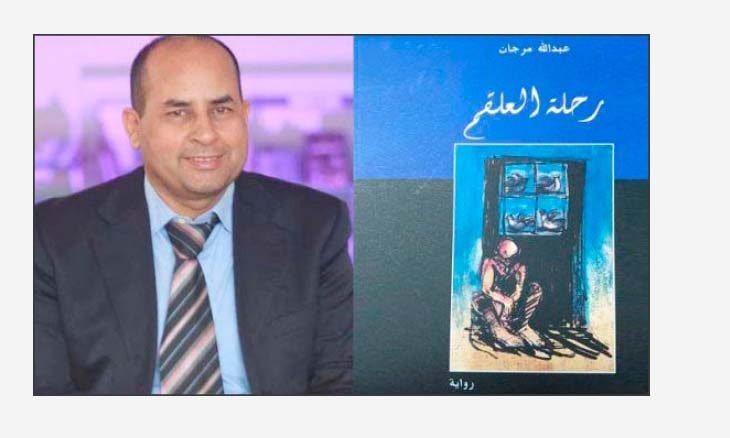يبدو البحث في مكنون اللاوعى هاجس أدبي انساني يتملك الكتاب بشكل عام، لكن القليل منهم هو الذي يتمكن من طرح مفرداته للقارىء بسلاسة عبر بنية روائية محكمة تنهل من كل عناصر العمل بشغف حتى يستحيل فصل مفردات اللاوعى المطروحة عن تلك الشخصيات في تلك الأماكن بتلك الأفعال. فتتحول الشخصيات في حركتها داخل النص، وبالتالي السرد، إلى منظومة ترمز إلى حركة اللاوعى الدائمة وتفاعله مع الواقع الثقيل. بذلك يأتي المشهد الأول محملا برمزية تؤطر الرواية بأكملها، في قرية بدلتا النيل قريبة من مدينة طنطا تنزل سلمى رشيد سلالم البيت “كنمرة هائجة”، “يتبعها خادم يرزح تحت ثقل الصندوق الخشبي الضخم الذي يحمله” (ص 7)، ثم “سكبت قليلا من الكيروسين على الصندوق، وأضرمت فيه النيران دون ذرة من تردد” (ص 8). قررت سلمى حرق الصندوق الذي يحوي كل الأوراق التي تركها الأب رشيد اعتقادا منها أن الهدم الكامل يولد بناء جديدا فقد “كانت تراقب الصندوق وهو يتآكل كأن حياتها هى معلقة بفنائه وتآكله.. يتآكل أمامها رشيد، سميح، جابر، رحمة، ثريا، جميلة، هشام، ولولا ويحترقون. تحترق هى معهم كى تبدأ من جديد بروح شابة وذكريات أقل ألما” (ص 8).
يؤسس هذا المشهد للسردية كاملة بشكل مفارق تماما، في حين تحاول سلمى التخلص من ماض طويل محمل بذكريات أليمة وبصور سلبية عن الذات في مواطن الاخفاق يتحول الصندوق المحترق إلى صندوق باندورا الذي يخرج منه التاريخ كاملا: تاريخ العائلة، تاريخ الحب، تاريخ الجسد، تاريخ الحراك الطبقي داخل القرية ومن القرية إلى المدينة، تاريخ تحول تلك القرية من الزراعة إلى الصناعة، تاريخ التربة الزراعية التي تم تجريفها لصالح الثروة السريعة، تاريخ الجنون، تاريخ الكتابة…كل التاريخ الذي تحاول سلمى أن تتخلص منه عبر انشاء الفردوس الخاص بها. ينفتح الصندوق على كل الذكريات، وهو ما يحوله إلى تقنية موظفة بشكل بارع تدفع كل اللاوعى إلى الاعلان عن نفسه، وهو الاعلان الذي يضع سلمى على الحافة بين الواقع والحلم. تتخذ تيمة الحلم مكانا رئيسا أيضا في الرواية، إذ تحاول سلمى التحرر من الذكريات عبر الأحلام، وتحاول تعويض الواقع الثقيل في الأحلام كذلك الحلم الذي رأت نفسها فيه تقتل جميلة صديقة الطفولة بدم بارد، لتجد جميلة تقف أمامها في الواقع بعد فترة وجيزة، وهى تستشف ما سوف يحدث في الأحلام أيضا كالحلم الذي فسرته لها عمتها نظلة فيما يخص ضياء زوجها.
تعيش سلمى بكل وجدانها في الأحلام، وتستعين على تفسيرها بأشخاص عارفين أو بكتب متخصصة، وهو الانغماس الذي يرمز إلى طرد للواقع سعيا لانشاء ماوراء الفردوس. الا أن هذا الانغماس في الحلم الذي يجعلها منفصلة تماما عمن حولها (تزداد حدة الانفصال بسبب شعور البارانويا الذي يوهمها أنها خارج المنظومة الاجتماعية والعائلية) مع تعملق الذكريات التي لم تحترق مع الصندوق يجعل سلمى تكتب في خواطرها: “أسير في الشوارع المكدسة فلا أرى شيئا. لا أبصر البلد التي شابت فجأة لأنني مشغولة فقط بذلك الجنون الذي ينمو بداخلي ومتوحدة تماما معه. أشعر أني أعيش يوما واحدا يتكرر بلا نهاية، أنا في حالة dejà vu دائمة…..أغمض عيني فأرى عوالم أخرى، أبصر عالما متوهجا، أشجاره حمراء ونباتاته كذلك، بحاره وسماواته خضراء بدرجات متفاوتة، اللون الأزرق فيه هو مجرد ظلال للونين السابقين. هو فردوس ملون كما أسميه، أهرب إليه فأخرج من ذاتي وخيباتي، أصير أخرى، لا يربط بينها وبين شخصيتي الحقيقية أقل القليل” (81 ـ 82).
يزداد هروب سلمى عبر تركها لذاتها في الفردوس ومحاولة إعادة صياغة الآخر. مرة أخرى تنجح الكاتبة في دمج الرمز بالسرد. تعمل سلمى محررة في جريدة أدبية، و “كانت لا تجد أى صعوبة في التدخل في نصوص الآخرين، غير أنها حين حاولت فجأة أن تشرع في كتابة رواية خاصة بها، وجدت نفسها في مأزق حقيقي” (86). بدأت تسلي نفسها “بتحريف وتشويه قصص الآحرين” (87)، فأرادت أن تكتب رواية عن عائلتها من هذا المنظور: منظور فني يراقب. كانت هذه هى مشكلة سلمى، ترى الأشياء والبشر من منظورأحادي البعد، منظور يصور لها ما تريد، وهو ما يظهر بعد ذلك في حكى جميلة عن نفسها.
للوهلة الأولى تبدو جميلة وكأنها الصورة المناقضة لسلمى، الا أنه بالتمعن في لاوعى جميلة يدرك القارىء أنها تنويعة مختلفة على شخصية سلمى، ربما تكون كل الشخصيات في العمل ليست الا تنويعات لنفس الفكرة: الهروب أو البحث عن الفردوس المفقود. جميلة هى ابنة صابر العامل الذي وهب حياته اخلاصا لرشيد وجابر في مصنع الطوب، وهى صديقة سلمى الحميمة، وهى أيضا ابنة بشرى التي شقت ملابسها يوم علمت بخبر موت زوجها فاشتهاها جابر وتزوجها، مفضلا إياها على زوجته حكمت التي طلبت الطلاق إثر هذه الزيجة. وهى أيضا جميلة التي وقعت في حب هشام ابن جابر ثم اكتشفت أنها لم تكن سوى علاقة عابرة في حياته مما ساهم في احساسها بالدونية. أرادت أن تهرب من حياتها السابقة، لم تبحث عن ما وراء الفردوس مثل سلمى، ولم تنغمس في الحلم، بالرغم من أنها “كانت ترغب فيما يشبه الانتقام، غير أن انتقامها لم يكن يعني الحاق الضرر بالآخرين، إنما فقط الارتقاء بنفسها، كى تصبح أفضل منهم. كانت غاضبة ومهانة. وعرفت جيدا كيف تحول غضبها إلى طاقة دفع للأمام” (214 ـ 215). أرادت جميلة أن تنسى ما فعلته بها الفروقات الطبقية، التي جعلتها “شخص غير مرئي، فائض عن الحاجة، ودخيل على عائلة قوية مترابطة”، عكس سلمى التي “لم تكن في حاجة لاثبات شىء سواء لنفسها أو للعالم المحيط بها” (214). انطلقت جميلة إلى الأمام مخلفة ورائها كل الماضي ـ الذي لم تنساه ـ وأنجزت كل ما كان يتعين على سلمى فعله. في حين هربت جميلة في تحقيق الذات هربت سلمى في الهوس بالذات ومحاولة تصوير الآخر، أو بالأحرى تشويهه.
كل نساء “وراء الفروس” يبتدعن وسائل للهروب (أم مقاومة؟) من ذواتهن أو من أجسادهن، طبقا لما يلائم المنظومة الذكورية التي يترأسها رمز الأب. وإذا كانت سلمى قد أخفقت في هذه المحاولة بكل الأشكال ـ حتى أن جسدها فرض ارادته ودمر زواجها ـ و “في أعماقها لم هناك سوى جحيم من الأفكار المتضاربة، والتخيلات والهواجس التي لا تستطيع التفريق بينها وبين حياتها الواقعية” (219)، فإن بعض الأخريات قد نجحن في الهروب ووجدن لهن موقعا مرضيا عنه في عالم العائلة الصغير عبر توظيف كافة وسائل التعايش والتواطؤ. فالعمة نظلة مثلا التي لم تدع زوجها يقترب منها هربت إلى عالم الشيخة شمس وحفظت القرآن وهو ما وفر لها مكانة اجتماعية، أما بشرى ـ والدة جميلة ـ التي اعتقدت يقينا أن صابر ـ زوجها الذي قضى في مصنع الطوب الأحمر ـ يأتيها مع كل قمر مكتمل، كان من الطبيعي أن يحل جابر محله في ليلة مشابهة، وإن ظل طيف زوجها يظهر بين الحين والآخر، حتى أنه توقف عن الظهور لجميلة التي أسلمت جسدها لهشام ولم تبال بسطوة الأب، أما لولا ـ شقيقة ثريا وخالة سلمى ـ فقد انتحرت بشرب الزرنيخ بعد أن ظهر بطنها ولم تعلن اسم الرجل (تلمح الكاتبة أنه قد يكون رشيد والد سلمى)، وفيما يتعلق بهيام ـ شقيقة سلمى ـ فقد أعادت انتاج المنظومة الذكورية عبر التنكر لذاتها الأنثوية التي كانت عليها وفقا لرغبة الآخرين، كانت تمثل صورة المرأة الملاك الشهيرة في الأدب الفيكتوري. يرتبط فعل ورد الفعل الجسد الأنثوي بالأب الحاضر الغائب، وفي حين تتوافق كل النسوة معه ـ كل بطريقتها ـ تبقى سلمى خارج المنظومة تماما: جامحة مثل والدها رشيد.
سلمى “لم تعد راغبة في الحكى أو الكلام الذي طالما أحبته وانحازت له ضد الصمت. تكتفي فقط باغماض عينيها والتحليق في ملكوت خاص. صارت تغمض عينيها كثيرا. تغمضهما فتغرق في فردوسها الملون بألوان قوس قزح” (218). الا أنها في هذا الملكوت ـ وراء الفردوس ـ لم تتمكن من التخلص من آثار انفتاح صندوق باندورا، فمع كل تلك الأحكام التي أصدرتها على الآخرين، ومع كل ذلك الاستسلام لرثاء الذات، ومع كل هذا الجنون الكامل الذي يسعى إلى الانسلاخ عن كل ما حوله اعتقادا أنه طريق النسيان، تبقى سلمى أسيرة نفس الفكرة: الهروب.
في كل ما حكته سلمى لطبيبتها النفسية (وربما لذاتها) لم تذكر حكاية “بدر الهبلة” (وهى نموذج متوافر في كل قرية مصرية تقريبا) المتخلفة عقليا، والتي يقيدها والدها بالجنزير الحديد في السرير الضخم خوفا عليها من أى اعتداء جنسي من هؤلاء الذين قد يستغلون جنونها. كان جل هم بدر هو أن تغافل والدها وتفك الأصفاد الحديدية بمساعدة جابر، وهو ما كانت تنجح في فعله حتى اختفت تماما عند زواج بدر ببشرى، الفعل الذي اعتبرته خيانة لها. من كل هذه الذكريات المزدحمة لا يبقى الا قصة بدر الهبلة على لسان سلمى حين تفيق من الحادث الذي وقع لها. وبالرغم من أنها كتبت الرواية التي كانت تسعى جاهدة لانجازها، وسلمت نسخة منها لجميلة، الا أن الأصفاد الحديدية التي تكبل عقل وروح سلمى تبقى مستعصية على كل تلك المراوغات، فلا يبقى بعد الحادث الا ذكرى “بدر الهبلة” ومحاولتها الدؤوب في التخلص من قيودها وهو ما يتوازى مع محاولة سلمى أن تكتب عن عائلتها وأن تنأى بعقلها عن الذكريات.
تبدأ “وراء الفردوس” من الذات التي تحاول أن تنسلخ وتنفصل عن واقعها (ماضيها وحاضرها) وتنتهي بالذات الراقدة بدون حراك في سرير بمستشفى وهى لا تزال غارقة في هوس التخلص من القيود، “وجدت نفسها مشدودة إلى سرير معدني بارد في غرفة ضيقة مشبعة برائحة الأدوية والمطهرات” (221). تبدو سلمى في النهاية وكأنها تنويعة أخرى على شخصية “بدر الهبلة”، مما يجعل الرواية تنتهي بشكل مفارق، وبشك عما إذا كان ذلك المكان وراء الفردوس هو النعيم أم النار. فمحاولة الوصول إلى ما وراء الفردوس تشبه محاولة العودة إلى مرحلة العقل الخالي من أى انطباعات أو ذكريات أو تاريخ أو حتى معرفة، وهو المعروف فلسفيا باسم “تابيولا رازا”، ولم يكن سوى افتراض فلسفي بحت. ربما يتجلى جنون سلمى في سيطرة هذه الفكرة عليها، وقيامها بتطوير صورة ذلك الفردوس المنعزل، وهو ما يجعل النهاية ـ “عندما فوجئت بجسدها كأنما يطير في الهواء قبل أن يسقط مرتطما بالأرض” (221) ـ مشهدا حرفيا. فسلمى التي ظلت تحلق في ملكوتها الخاص كان لابد أن عود للأرض ولو بهذه القسوة، وهو ما يجعل وراء الفردوس مكانا وهميا يتخذ منه العقل تكئة للهروب من المواجهة: مواجهة الواقع المادي الثقيل وقبول وخز الألم.
*نُشِرَت المقالة في مجلة “الكلمة” في سبتمبر 2009