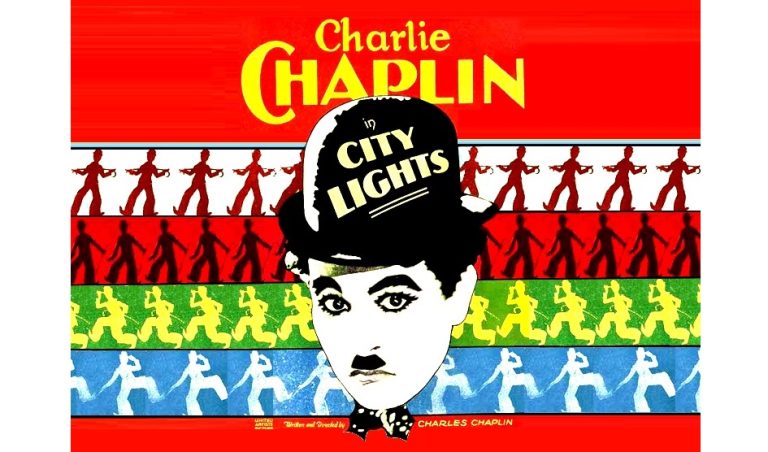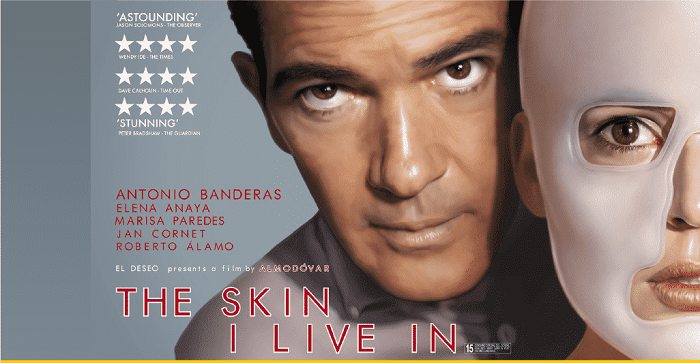إن لغة كوريسماكي السينمائية شديدة البساطة، الكاميرا الثابتة التي تشاهد معنا الأحداث بمنتهى الهدوء والحياد، الموسيقى وأغاني الستينات وأزيائها وديكوراتها التي تنقلنا إلى زمن أخر لبلدة تعيش خارج الزمن وتغيب عن ملامحها الروح المعاصرة، هو لا يحتاج إلى التعقيد من أجل إبهارك بأفكاره، فمفرداته واضحة، واختياراته الإنسانية هي التي تخلق شخصياته اللتي -في نهاية الأمر- لا تطمح سوى في الحياة. يقول أحد اللاجئين العراقيين إلى بطل الفيلم اللاجئ السوري أنه مازال صغير ليموت، الموت هو الهاجس الذي يخشى هذا الشاب أن يقضي عليه لأنه لم يحصل بعد على عمل، والموت أيضًا هو ما دفع خالد للهروب إلى فللندا، والموت هو ما يخشى أن يكون مصير أخته مثلما كان مصير حبيبته. الخوف يطارد الشباب، لكنه لا يطارد عجائز فللندا.
هنا لا يتخلى كوريسماكي عن إنتماؤه الوطني، لكنه ينحاز دون تفكير إلى إنسانيته التي تقف في صف “الإنسان” مهما كان اختلافه العرقي أو الجنسي أو الديني أو حتى الأيديولوجي، فالللاجئ عند الفلندي المتعصب -الذي يعتدي على خالد في نهاية الفيلم- هو مجرد “آخر”، هذا الآخر غير مرغوب فيه، يشكل عبئًا يجب أن يزاح، واللاجئ عند “ويكستروم” هو مجرد إنسان يجب أن يعطيه فرصة للنجاة. هنا يستدعي المخرج الأمل في قدوم اللاجئين، ويذكر المجتمع الفللندي بصورة أو بآخرى بما حدث له في فترة الحرب التي أدت إلى هروب الكثيرين في الماضي وتحولهم إلى لاجئين، فلماذا لا نفتح صدورنا للوافدين الجدد؟ ولماذا ننسى إنسانيتنا عند مواجهة الآخرين؟ ولماذ لا نعطيهم أبسط ما يمكن أن يتمنوه؟ نعطيهم الفرصة في الحياة.