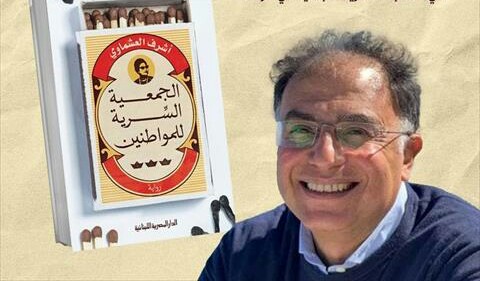حسن عبد الموجود
أول انطباع يخرج به القارئ من رواية أشرف العشماوى «الجمعية السرية للمواطنين» أن الشخص العادى، قد يصلح بطلاً لرواية، ويبدو أن تلك الرواية وضعت لنفسها تحدياً، بأن تجمع عدداً هائلاً من الأشخاص ذوى الملامح الباهتة والهيئات البسيطة، والصفات العادية، وتحولهم إلى أبطال لديهم حكايات صغيرة، لا تنقصها الغرابة، حتى أنهم يتحولون بمرور الوقت -وأنت تقلب الصفحات وتقابلهم المرة تلو المرة- إلى كائنات أسطورية.
رجال ونساء لديهم فلسفة خاصة عن الحياة، قد يخطئون مرات لكنهم يعرفون جيداً كيف يرمِّمون أنفسهم وأرواحهم، كأنهم أبطال فى لعبة يمتلكون أكثر من روح، وبالتالى يستطيعون العودة من الموت، لتجربة الحياة من جديد، وهكذا تنحرف الرواية قليلاً عن الواقع الصعب والخانق، إلى أفق من الفن يستوعب ذلك الواقع، أو يجعل ثمة سهولة فى تقبله، أو بمعنى أدق سهولة فى فهمه وهضمه، كأن تلك الغرابة المخلوطة بسخرية خفيفة أقرب إلى «قشرة السكر التى تحيط بكبسولة الدواء المر» بتعبير عزت القمحاوى.
حينما تفتح أول صفحة من الرواية، يبدو كأنك فتحت بوابة أسطورية، لمكان لا يعرف الأحلام، ولا يخطط للمستقبل، مكان أشبه بجرح فى جسد القاهرة، جرح انفتح فى حلوان، أو على تخومها، اسمه «عزبة الوالدة»، وكما لفظته القاهرة بحيواناته وناسه إلى أبعد مكان منها، لفظته الحكومة، ولم تعد تتذكره إلا حينما تأتيها منح من أوروبا للارتقاء به، أو حينما تشعر بأن ساكنيه يلعبون من ورائها لعبة لا تفهمها، أو حين لا يرضون بما قسمته لهم، أو يخبئون عنها شيئاً، أو يشاركونها سلطتها فى طبع الأوراق المالية، فى لحظة تجل جماعية، رأى فيها سكان عالم القاع أن بإمكانهم إنشاء دولتهم الخاصة، ولا يضير أن تكون عملتها شبيهة، أو فلنقل منسوخة من عملة الحكومة.
يلعب العشماوى لعبة فنية، تذكرنا بلوحة العشاء الأخير، إذ يجمع بطله «معتوق» كل شخصيات الحى فى لوحة ضخمة علقها إلى حائط فى غرفته المتهالكة، جيرانه، وأصدقاءه، وحتى من جلبهم فى أسفاره الغريبة والمفاجئة والإجبارية أحياناً إلى قسم أو مستشفى للمجانين أو مقهى للشهود إلى حيه أو جمعيته السرية. لا ينقلهم كما هم فى الواقع، لكنه يضفى عليهم من خياله، صفات رآها فى تصرفاتهم، ومشاعر لمسها فى قلوبهم، يلعب العشماوى لعبته، ليسيطر فيما يبدو على كم هائل من الأشخاص، يكادون أن يقفزوا باتجاهك من صفحات الرواية، كأن تلك اللوحة هى مركز العمل الفنى، وكأن البطل «معتوق» هو مساعد العشماوى فى كتابة الرواية أو رسمها، وبالتالى يمكن لهؤلاء الأبطال أن يتحركوا بعيداً كيفما شاؤوا، فها هى اللوحة تتحدث بالنيابة عنهم، وتذكرنا بتصرفاتهم وعلاقاتهم، وانكساراتهم، ولحظات ضعفهم، وخنوعهم، وحتى ثورتهم على مصائرهم فى النهاية، وانتصارهم لقيمة الجيرة والصداقة ومحبة الأرض والبيوت القديمة فى «عزبة الوالدة»، وبالتالى قد يموت الأبطال، أو يتوهون، أو تبتلعهم الشوارع، لكن اللوحة تضمن لهم حياة أخرى، ربما أكثر جمالاً من حياتهم.
وبقدر تنوع الأشخاص تتنوع أسماؤهم، فالأسماء مفاتيح متناثرة قد تقول الكثير عن أحدهم أو قد لا تقول شيئاً. البطل «معتوق» -على سبيل المثال- لديه نصيب كبير من اسمه. عاش طوال عمره خيبة عدم التحقق، يسطو صديقه «غريب» على لوحاته، ويضع توقيعه عليها، ويستخدمها فى سلم الصعود الفنى والاجتماعى والسياسى، برضاه أحياناً، وبعدم موافقته غالباً، و«زهرة» ابنته، التى رباها فى كنفه حتى أينعت فاختطفتها الحياة ليقتطفها الغرباء وينعموا بالقرب منها وبشم رائحتها وتذوق رحيقها، وهى زهرته الثانية إذ رسم «زهرة الخشخاش» أو قلدها، ووضعها مكان لوحة فان جوخ، فظنها الناس اللوحة الأصلية، و«راوية» عشيقته، راوية التاريخ المحذوف من المناهج المدرسية، ورواية التاريخ الحقيقى لـ«عزبة الوالدة»، والمعلم «غالى» القبطى الشهم الغالى الذى يحبه الجميع ويحب الجميع، ويصرف على الأرامل والمطلقات وزوجات المساجين حتى خروجهم، وفتحى السماوى قاتل الكلاب، وغيرهم وغيرهن.
كتب العشماوى، وهو يتحرك خلف بطله معتوق، ما يشبه سيرة للقاهرة وتقلباتها على مدار ثلاثة عهود سياسية، وقد تسلق الكاتب صعوبات فنية كالجبل، إذ أن الرقعة المكانية أو الجغرافية للرواية ضخمة جداً، تتجاوز عزبة الوالدة إلى أحياء القاهرة المختلفة، وزمنها ممتد حتى زمن الملك، وشخصياتها متنوعة وكثيرة، وحكاياتها دوائر متداخلة، مثل دوائر ألف ليلة وليلة، قد تعرف بدايتها لكنك لا تصل أبداً إلى نهايتها، وقد نجح العشماوى فى تضفير ذلك العالم الواسع، فى وشائج مركزها اللوحة فى غرفة بطله «معتوق»، وأطرافها فى مبنى الأهرام، أو مستشفى العباسية، أو قصر العينى، أو متحف محمود خليل، أو مقهى الشهود، أو المحكمة، أو شوارع القاهرة، أو حتى مجاريها.
نجح العشماوى فى إبقائنا مشدودين إلى كل حكاية، وما إن نأخذ موقفاً من أحد الأبطال، حتى تأتينا دفوعه لنتعاطف معه، وفى اللحظة التى ننفر فيها من هذا العالم السرطانى، يصبح ذلك العالم تسليتنا، ومصدر بهجتنا، وتوقنا إلى الانعتاق بدورنا من كل ما يكبلنا عن الاستمتاع بالحياة، حتى وإن كنا بتعبير بطله الثانى شاهين قد «أخذنا من الدنيا أقل مما نستحق وأكثر مما توقعنا».