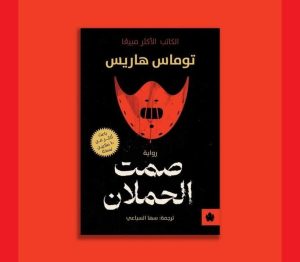د. رضا عطية
يظل الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف بتجربته الثرية.. محل أنظار الباحثين، فأعماله قابلة لقراءة متعددة، نظرًا لثراء تجربته وعمقها..
من هنا اختار الناقد رضا عطية أن يكون موضوعه لنيل درجة الدكتوراه بعنوان “الاغتراب في شعر سعدي يوسف.. دراسة في النقد الثقافي” تحت إشراف الدكتور صلاح فضل والدكتور عبد الناصر حسن، وقد شاركهما في المناقشة د. محمد بريري، د. محمد الطاووس، ونال عنها درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة.
في هذا البستان اخترنا المبحث الخاص بـ”استعادة المكان الأول في شعر سعدي يوسف” لما يمثله من قراءة دقيقة لرحلة الشاعر عبر الأمكنة والأزمنة.
استعادة المكان الأول في شعر سعدي يوسف
د. رضا عطية
توطئة
مع معيش الذات بمكان آخر، كالمهجر أو المنفى، مكان غير الوطن، مكانها الأول، ومع إحساسها بالاغتراب في المكان الآخر ينبثق بداخلها إحساس ما بالفقد المشمول بالحنين إزاء مكانها الأول، فيبقى ذلك المكان الأول يشاغل الذات ويراود وعيها ويلحُّ على ذاكرتها ناكئًا جراح الفقد ومجترًا مواجد الغياب.
إنّ المنفي عن وطنه والمغترِب في مكان آخر لا يُمكنه الانقطاع عن جذوره ومنبته الأصلي، فكما يرى إدوارد سعيد بأنّه “ثمة افتراض رائج، لكنه مخطئ كليًّا، وهو أنَّ كونك منفيًّا معناه أن تكون معزولاً تمامًا عن موطنك الأصلي، منقطع الاتصال به، مُفرَّقًا بينك وبينه على نحو ميئوسٍ منه. ألا ليت هذا الانفصال الكامل القاطع صحيحٌ، لأنّك ستجد عندئذٍ العزاء في معرفة أنَّ ما تركته وراءك هو، إلى حدٍّ ما، شأنٌ لا مجال للتفكير فيه وغير قابل بتاتًا للتغيير. وحقيقة الأمر أنَّ الصعوبة بالنسبة إلى معظم المنفيين تكمن لا في مجرد الاضطرار إلى العيش بعيدًا عن الأوطان. وإنّما إذا أُخذ عالمُ اليوم بالاعتبار، في تحمُّل العيش مع الأمور العديدة التي تُذكِّرك بأنّك في المنفى، وبأنّ موطنك بالفعل ليس بعيدًا جدًا، وبأنّ الحركة العادية للحياة اليومية العصرية تُبقيك على اتصال متواصل بالموطن السابق لكنّه مُعذَّب لصعوبة بلوغه ولا يُنجز. وبالتالي، فإنَّ المنفيَّ بعيش في حالة وسيطة، لا ينسجم تمامًا مع المحيط الجديد ولا يتخلّص كليًّا من عبء البيئة الماضية، تضايقه أنصاف التّداخلات وأنصاف الانفصالات؛ وهو نُوستلجيٌّ وعاطفيّ من ناحية، ومُقلِّد حاذق، أو منبوذ لا يعلم به أحد، من ناحية أحدٌ من ناحية أخرى”([1])، فإدوار سعيد قد وضع يده على حالة الشتات الوجودي والتشتت النفسي والعلو التي يقع المنفي فيها، ما بين حالة اللاانتماء للمكان الآخر الذي يعيش فيها المنفي، وحالة الحنين المعذّب لمكانه الأول، كذلك فإنّ تيسير وسائل الاتصال الإعلامي والمعلوماتي بالوطن يزيد من إحساس المنفي بوطنه ويُفاقم عذابات اغترابه عنه.
وقد يُمثِّل المكان الأول- بالنسبة للذات المغتربة عنه- معنى المكان في حد ذاته بوصفه معنى مجردًا وتعيينًا رمزيًّا، إذ إنَّ “حس المكان بالمعنى الأول، أي المكان الفعلي، حسٌ أصيل وعميق في الوجدان البشري، وخصوصًا إذا كان المكان هو وطن الألفة والانتماء الذي يُمثِّل حالة الارتباط البدئي المشيمي برحم الأرض- الأم، ويرتبط بهناءة الطفولة وصبابات الصبا، ويزداد هذا الحس شحذًا إذا ما تعرّض المكان للفقد أو الضياع، وأكثر ما يشحذ هذا الحس، هو الكتابة عن الوطن في المنفى”([2])، فتكون معاودة الذات، وطنها، مكانها الأول، واستعادتها له، بينما هي تعيش بمكان آخر، كالعودة إلى الرحم بالمعنى “اللاكاني”، حيث المهد التكويني الأول.
إنّ استعادة الذات مكانها الأول هو فعل تعويضي تقيمه الذات في داخلها وتنشئه في خيالها مكانًا تؤسسه عبر اللغة تعويضًا عن مكانها الأول الضائع وفردوسها المفقود، حيث إن “الوجود في المنفى يعني الانقطاع عن الوجود الفعلي في الوطن، كما يعني في الوقت نفسه تمددًا داخليًّا لهذا الوجود ذاته. وحين يصبح وجود الوطن داخليًّا تنشط حركة الخيال وتظهر مستويات متعددة للحلم والذاكرة، فيتفرق المكان الواحد في أمكنة عدة، ويتحول زمن الحياة تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية.
وتشكِّل هذه العناصر مجتمعة بناءً لغويًّا يُعَدُّ بديلًا عن الانفصال الخارجي عن الوطن. ومن ثم، لا يكون الانسحاب الاختياري، أو الاقتلاع القسري من المكان الذي يُحدِث في الواقع، موتًا لفكرة الوطن، وإنّما تظل الفكرة قادرة على النمو في الغربة، فالشعراء في المنفى يعيشون وطنًا لغويًّا يبنونه في ديوان أو في قصيدة شعر”([3])، فالذات تستعيد وطنها المفقود ومكانها الأول في فضاء القصيدة.
ولقد استحال العراق هاجسًا يشغل الشاعر، وهمًّا يساكنه ويؤرقه أينما حلّ، فيقول سعدي يوسف عن انشغاله بعراقه وانهمامه به:
أُفكِّرُ في العراقِ …
كأنّ وحْلًا على جَفني يحِطُّ
كأنّ طيرًا على طرفِ الـمُلاءةِ؛
أهْوَ نَسْرٌ، أم الثورُ السماويُّ؟
العراقُ مخضّبٌ بدمٍ …
سَآوي إلى كهفٍ، سآوي إلى نفسي
وأسألُ عن شبابي.
أفكِّرُ في العراقِ …
كأنّ صِلًا على جفني يَحِفُّ
كأنّ مِعزى على طرفِ الـمُـلاءةِ؛
كيفَ أسري وهذا الليلَ؟
كيف أقولُ: إني أنا؟
كيفَ أدخلُ في العراقِ؟
وكيف أدخلُ في ثيابي؟([4]).
يُفكّر الشاعر بالمكان الأول، الوطن، لا سيما في محنة الوطن؛ فيمسي تجلي المكان الأول على مرايا وعي الذات كالوحل على جفنها أو هو كالطير منبهم الهوية غير محسوم التحديد: أهو نسر أم الثور السماوي؟ وهو ما يستدعي نصًا غائبًا هو ملحمة جلجامش؛ حيث طلبت عشتار من الإله آنو أن يرسل ثور السماء ليهلك جلجامش الذي أهانها، وهو ما يشي بإدانة الذاتِ الشاعرة المقدسَ أو بالأحرى إساءة استغلال الديني والمقدس في إفشاء القتل في الوطن المُخَضَّب بالدم الذي تُفكِّر الذات فيه. فيكون استعمال الذات للأسطورة الشعبية كما في استدعائها ملحمة جلجامش بغرض الموازاة الاستعارية مع الحاضر وما يئن منه العراق من صراعات دموية بسبب إساءة الناس فهم المقدس والقتل باسم هذا المقدس.
ومن ثنايا النص تتفجر الأسئلة التي تُعبِر عن حيرة الذات وارتيابها الوجودي، ففي استعادات الذات لمكانها الأول، وطنها، العراق، تبزغ التساؤلات لتُنازِع الحمولات الخبرية، ولا يأتي السؤال- عند سعدي يوسف- بريئًا لمجرد الاستفهام أو طلبًا للمعرفة؛ ذلك أنّ “شطرًا هامًا من المعرفة يكمن في القدرة على التساؤل. فالسؤال تناقض ورفض لثبات الأشياء، وكشف عما تنطوي عليه من مفارقة لا تتضح إلا بالسؤال… التساؤل في أرفع أشكاله محاولة صياغة جديدة لمعرفة متناثرة مُبددة عن العالم والأشياء. في هذا الإطار لا يصبح محض جهل بالأشياء أو تخبُّط في تبين علاقاتها بقدر ما يضحي تجاوزًا لإجابة قديمة سهلة، تكمن قوتها في تلفُّعها بثوب من القداسة الهشة”([5])؛ فيُعبِّر الاستفهام الأول (أهْوَ نَسْرٌ، أم الثورُ السماويُّ؟) عن حالة تردد إزاء المدركات التي تعاينها الذات في رؤياها التهويمية في تجلٍّ سوريالي، فما تعاينه يبدو عصيًّا على التحديد، وكأنّ ثمة تراكبًا للصور التي تتداعى على وعي الذات أو التي تنبثق من لاوعيها في استدعائها لمكانها الأول.
ومن فرط التياع الذات انهمامًا بحال وطنها تتذبذب في وجودها وتتشكك في كينونتها: (كيف أقولُ: إنّي أنا؟) فهذا التساؤل يعبر عن إحساس الذات بضياع هويتها وانمحاء كينونتها في منفاها وابتعادها عن مكانها الأول، العراق، إذ تبدو استعادة الذات مكانها الأول وتفكيرها بوطنها، العراق، كتهويم منبهم وكرؤية سوريالية تهفو الذات فيها إلى معجزة وفعل خارق كالإسراء لتبلغ مكانها الأول، العراق، بليلٍ. فيكون العراق، الوطن، المكان الأول بالنسبة إلى الذات كثيابها، أي رداء وغطاء لها، يحتويها، حيث يبرز السؤالان المتتابعان (كيفَ أدخلُ في العراقِ؟/ وكيف أدخلُ في ثيابي) تلبُّس الذات بالعراق مكانها الأول كالثياب وكأنّ الوطن بمثابة ثياب تغطي الذات وتسترها، ما يعني التصاق الذات الشديد بوطنها وما يعني ضمنًا إحساس الذات بالعري في منفاها بعيدًا عن الوطن.
وإذا كان الشعراء السورياليون ورثة رمبو ولوتريامون يرون أنّ “سرّ كل عملية خلق، كامنٌ في حالة الحلم التي تُمثِّل أكمل نقطة في التجرّد الممكن أن يتوصل إليه الفكر البشري. من هنا قول لويس أراغون إنّ الإلهام هو «قابلية الفكر والعاطفة للفوواقع»”([6])؛ حيث “يبتعد السورياليون عن العالم الواقعي، ليتوغلوا في عالم التجليات والأشباح، لأنهم لا يستطيعون التعبير عن أعمق انفعال في الكائن، إلا بالاقتراب من المدهش، حيث المنطق البشري يفقد فاعليته”([7])، وإذا كان بول فاليري يذهب إلى أنّ “الشرط الصحيح للشاعر الصحيح، هو ما يتميّز لديه عن حالة الحلم”([8]) فإنّ استعادة سعدي يوسف لمكانه الأول، العراق، من منافيه بمكانه الآخر تبدو كفعل سوريالي أو كحلم تهويمي يجاوز الواقع.
وفيما يتبدى من الصورة (كأنّ طيرًا على طرفِ الـمُلاءةِ؛/ أهْوَ نَسْرٌ، أم الثورُ السماويُّ)، و(كأنّ صِلًا على جفني يَحِفُّ/ كأنّ مِعزى على طرفِ الـمُـلاءةِ) فاعلية التخييل السوريالي، إذ سعت السوريالية إلى بثّ “روح جديدة متجاوزة للمنطق في الفنون… حيث وُصفَت السوريالية بأنّها «قائمة على الإيمان بالحقيقة الأسمى لارتباطات مهملة مسبقًا بعينها، وبالقدرة الكلية على الأحلام، وبالتلاعب العقلي بالأشياء بلا مبالاة»”([9])، إذ “اعتمد التوجُّه السوريالي نحو الصورة على مبدأ التلاقي بين الوقائع غير المتوافقة”([10])، فالصورة السوريالية تجافي الوضوح إذ “في هالة الفوواقع، لا مكان للأفكار الواضحة والمعطيات المعروفة. لكنّ تغايرَ الصور يصدم اعتيادنا على تصنيفها في سبيل الانتفاع منها في كلام مباشر”([11])، باعتبار أنّ الأداء السوريالي “هو استعمال خاص للصورة، أو هو إثارة الصورة لذاتها، فيما توحي به من هيولات. فكل صورة، كل لحظة، تحث على إعادة النظر في الكون كله”([12])؛ فالتشكيل السوريالي للصورة يعمل على مباغتة حس المتلقي بتراكيب تتجاوز التصور المنطقي العقلي للأشياء والعناصر.
وفي تصنيفه وشرحه لتكوينات الصور السوريالية يقول بريتون بفكرة “الجمال الاختلاجي” حيث “تحدَّثَ عن تجربة الجمال باعتبارها مقاربةً لشكل من أشكال الاختلاج الجسماني المشوب بتيار قوي وشبقي. عرَّف بريتون، بغموض نوعًا ما، ثلاثة أنواع من «الجمال الاختلاجي» السوريالي: «الشبقي المستتر» الذي نشأ بشكل مميز من المزج بين المتحرك والثابت (كما في المرجان)، و«الثابت- الانفجاري» الذي ينبع عندما تُتَرجم الحركة إلى سكون (كما في صورة فوتوغرافية لعربة تنمو فوقها النباتاتُ بشكل مفرط)، و«السحري- الظرفي» الذي انبثق من «مواجهة سحرية» مع عبارة أو موضوع عجيب ظاهريًّا”([13]) وما تتأسس عليه الصورة السوريالية التي نحن بصددها في “جمالها الاختلاجي” هي من النوع الثالث “السحري- الظرفي” حيث الثور السماوي بتكوينه السحري والملاءة التي في السماء.
وربما يكون تجاوزيةُ الصور السوريالية في تكويناتها الغريبة المنطقَ راجعًا لربط السوريالية الصورة والفن عمومًا باللاوعي؛ حيث أفاد الشعراء السورياليون بدءًا من بريتون من نظريات فرويد بشأن اللاوعي وما قال به من “التداعي الحر للمعاني” في تطوير تقنيات “الكتابة التلقائية”([14]) باعتبار أنّ الفن السوريالي عمومًا يبدو نابعًا من اللاوعي، سواء الفردي أو الجمعي بالمفهوم اليونجي [نسبة إلى يونج]، فالسورياليون يعتبرون أنّ اللغة الشعرية قد نشأت وتولَّدت في اللاوعي([15]). كما يتبدى- هنا- من تشكيل سعدي صوره من عناصر لاوعي متصل بالنص الغائب فيما يرتبط بعناصر ملحمة جلجامش كالثور السماوي.
ويستدعي مسعى الذات ارتداء ثيابها ما فعله جلجامش بارتدائه ثيابه الملكية بعد انتصاره على “خمبابا” الكائن الشيطاني رمز الشر وعودته إلى مدينة “أوروك” في تأكيد على قيمة الفعل الإنساني إزاء عمل الآلهة، حيث سعى جلجامش كما في ملحمة جلجامش إلى بيان أنَّ “ما تتخذه الآلهة من قرارات ومنح الآلهة هي باطلة ولا تتوافق مع الواقع الإنساني”([16]). وكأنّ رؤية الذات للعالم، لدى سعدي يوسف، تنبني على تقديس الفعل الإنساني، فكأنّ الذات في علاقتها بوطنها تمسي كجلجامش في مواجهة الشرور التي تبثها القوى الراديكالية التي تستعمل أقنعة المقدس وتلعب بورقة الدين في إفشائها القتل بين الأبرياء، فتتأسس رؤية سعدي على تقديس الذات الإنسانية والمكان الذي ترتبط به.
ولمحاولات الذات استعادة مكانها الأول في ظل اغترابها بالمكان الآخر تجليات متنوعة وتمظهرات متعددة تتبدى في عديد من الحالات والآليات:
1- الصراع الهوياتي ومغالبة المكان الأول للمكان الآخر
نتيجة حياة الذات بمكان آخر يحمل ثقافة أخرى غير المكان الأول وثقافته، ونتيجة ارتباط الذات جذريًّا بالمكان الأول فقد ينشأ صراع هوياتي بين المكانين في وعي الذات ووجدانها، مكان آخر تضطر الذات للإقامة به ويتحتم عليها محاولة التواؤم معه والتكيف- ولو بمقدار- مع نظام العيش فيه رغم التمايزات الهوياتية والثقافية عن موطنها، ومكان أوَّل يبقى عالقًا بوعي الذات ووجدانها يظلُّ يغالب الذات في مكانها الآخر. فالذات تتراوح بين مكان آخر تقيم فيه ولكن قد تشعر بأنّه ليس مكانها ومكان أوِّل غادرته الذات ولم يغادرها، فيظل يساكن وعيها وتظل الذات تهفو إليه.
ويبدو أنّ عدم الألفة مع تلك البلاد (المكان الآخر) رغم طول العيش بها نتيجة لانتماءات الذات للوطن، انتماءً للمكان الأول يتجاوز البعد المكاني:
أنتَ
حفيد كِندةَ
وامرئ القيس… النبيّ
أفق
لماذا أنت في أرض لقيصرَ؟
أي معنى أن تكون بلندن الصغرى؟
أو الكبرى…
أقول لك النصيحة يا رفيقي:
غادر الآنَ…
امرؤ القيس الذي قد جاء، لا تتركه ينتظرُ!([17]).
ما يزال الشاعر يتذكر أصوله العربية الضاربة بجذور التاريخ السحيق، انتسابًا لقبيلة كندة العربية اليمانية وامرئ القيس الملك وشاعر العربية العظيم الذي بلغ بإبداعه الشعري منزلة النبوة، وكأنّ صوت الهوية بذات الشاعر يستنهضه من غيبوبة، وكأنّ الذات لا تصدق ما هي فيه، فيحل قيصر برمزيته التاريخية في مواجهة امرئ القيس، ملك مقارنة بملك، ولكن، يتجاوز امرؤ القيس الملك العربي وجوده السياسي ليطغى عليه كونه ملك الكلام والشعر، مما يجعل له قيمة مضاعفة إزاء قيصر، لذا تفقد بلاد المنفى، بلاد قيصر، (المكان الآخر) أية قيمة أو أي معنى إذا ما حضرت بلاده (المكان الأول) برموزها التاريخية المشرقة التي تدفعه لمغادرة بلاد المأوى والمنفى.
وكما يتبدى من استخدام سعدي يوسف اللافت والمكرور لضمير المُخاطَب – هنا- أنَّ ثمة انشطارًا للذات أو لنقل حوارًا بين شطري الذات أو تمظهرين للذات: الذات المثالية التي تعود بأناها نحو جذورها التاريخية وهويتها الثقافية الغائرة في مقابل الذات الموضوعية، تلك الذات التي تعيش مغتربةً بالمكان الآخر، فتسعى الذات المُتكلِّمة إلى تبصير الذات المُخَاطَبَة بلاملائمة المكان الآخر لها وإعادتها إلى جذورها التاريخية والثقافية، “وأيًّا ما كانت الإمكانات والآثار الناتجة عن استخدام ضمير المخاطب، فإنّ الأمر الذي تنتج عنه هذه الآثار المختلفة يكاد يكون واحدًا، أعني ارتباط هذا الضمير بوجود درجة أعلى من الانفعال والعاطفة، يعانيها المتكلِّم في النص (الشاعر، أو الكاتب، أو الراوي، أو البطل)”([18]). فالذات المتكلِّمة تدفع الذات المُخَاطَبة إلى اتباع امرئ القيس بوصفه أيقونة ثقافية وعلامة تاريخية.
ومن تبديات الصراع المعتمل في أغوار الذات في مكانها الآخر أنَّ هذه الذات دائمًا ما تكون في تموضعها بالمكان الآخر مأخوذةً نحو مكانها الأوَّل:
في الضفة الأخرى: عمّي.
في شاطئنا: كان أبي.
في شط العرب:
الزورقُ مختبئٌ بين البرديّ. وحيدٌ([19]).
فيما يتبدى من تلك القصيدة المُوَقَّعة بـ”نيقوسيا” أنّ الذات بينما هي تقف على شاطئ المكان الآخر إنّما تتطلع للضفة الأخرى، مكانها الأول، وفيما يتبدى من الإضافة لضمير المتكلِّم الجمعي (شاطئـ نا) أنّ ثمة شعورًا بالانتماء الجمعي- لدى الذات- يأخذها نحو مكانها الأول، هذا الانتماء الجمعي هو الذي يُشعر الذات بالألفة، ثم ما يلبث شعور الذات بالاغتراب والوحدة أن ينعكس على تمثلها الزورق بشط العرب مختبئًا وحيدًا؛ الاختباء خوف ما من مواجهة مصير ما أو خطر، والوحدة من غياب الناس ونأيهم، وهو ما يعكس بشكل غير مباشر غياب الأب والعم وفقد الذات لهم.
والغالب على قصيدة سعدي يوسف- كما يتبدى هنا في هذا المقطع- توظيفها التلغرافي للأشياء والعناصر بوصفها دوالاً في اقتصاد تعبيري واكتناز قولي واختزال تركيبي، فسعدي يوسف- كما يراه صلاح فضل- “هو أحد القلائل من الشعراء العرب الذين تمكنوا من تخليق إطار متبلور للنظام المقطعي في القصيدة، بحيث تمتلك شكلًا نصيًّا محددًا دالًا، ووظيفة مجازية بارزة، تعتمد على أقصى درجات الاقتصاد في اللغة وتماسك بنية الدوال ووضوح الإشارات الشعرية، لكنها لا تقع نتيجة لكل ذلك في أسر محدودية أو أحادية المدلول، بل تتميز بالقدرة الرامزة الكفيلة باختزان طاقات شعرية هائلة تتفجر من كلماتها القليلة. كما أنّها تعتمد على تقنية خاصة في تركيب الوحدات النصية تفتح السبيل لقراءات عديدة ومتباعدة في الآن ذاته”([20])، فتعدد المدلولات للدال الواحد واستحالة المدلول دالًا مفضيًّا إلى مدلول آخر هو سمة بادية في شعر سعدي يوسف.
وكما هو متبدٍّ، فإنَّ البحر، كفضاء ترتاده الذات في المكان الآخر، غالبًا ما يَدْفعُها نحو مكانها الأول، نحو ذلك الأمل المراوح بالعودة إلى الوطن، فيقول سعدي يوسف:
قد كدتُ أبْلغُ برشلونةَ في نسيم الفجرِ،
كان البحرُ يهدأُ
والنوارسُ تنفضُ الميناءَ نفضًا صائحًا
والبحرُ أبيضُ.
أين تمضي، أيها المخبولُ، بالأطفالِ، بامراةٍ معَذّبةٍ؟
كأنّكَ قاصدٌ بغدادَ!
هل أنصتَّ للعصفورِ ينقرُّ تمرةً؟
يا ضيعةَ الأيّامِ!
لو لم تقطع البحر الخفيفَ
ولم تحاوِرْ نَقرةَ العصفورِ
يا ولَدي…
لو التففتَ ببرشلونة بُرْنُسًا
ونسِيتَ بغدادَ التي تنأى، وتَبْرُقُ كالسراب…([21]).
تبدو الذات في المكان الآخر، دونَ برشلونة، مجذوبةً نحو مكانها الأول، بغداد. وبينما تسمع الذات صياح النوارس نافضةً الميناءَ بمكانها الآخر إذ بها تسمع أو بالأحرى تتوهم “العصفور ينقرُّ تمرة”، والتمرة هي ثمرة النخل الذي هو علامة أيقونية ترمز إلى المكان الأول وتُذكِّر الذات بوطنها، وكأنَّ حنين الذات لمكانها الأول قد حدا بها أن تنسلخ من واقعها والانفعال بمؤثرات المكان الآخر، كصياح النوارس، لترتدَّ بخيالها ووهمها نحو مكانها الأول، حيثُ تتوهم “العصفور” ينقرُ “تمرة”.
وكما يتبدى من التفات الصوت الشعري الضمائري من ضمير المتكلِّم في الأسطر الأربعة الأولى من هذا المقطع إلى ضمير المُخَاطَب في بقية أسطر المقطع تأشيرًا إلى الذات أنّ ذلك تَمثيل لانتقال الوعي من التَمثُّل الموضوعي لوجود الذات الواقعي في مكانها الآخر بمحايثة “برشلونة” إلى التَمثُّل الوهمي، حيثُ تتوهم الذات حضورها بمكانها الأول، بغداد.
ويبدو التفات الصوت الشعري من ضمير المُتكلِّم إلى المُخَاطَب كتجلٍّ لانشطار الذات تمثيلاً للوعي الشقي الذي يتنازع بداخله صوتان للذات أو بالأحرى صوتان لذاتين هما أقنوما “الأنا”: الذات الموضوعية التي تعيش في المكان الآخر، في مقابل الذات الحالمة أو المُتَوهِّمة التي تهفو إلى مكانها الأول، وتحنُّ إلى وطنها.
وبالتنقيب في أغوار النص نبشًا في بنيته التحتية بحثًا عن “النص الغائب” سنجد أنّ الصورة أو الدعوة التي يبثّها صوت الذات المضادة التي تحاول أن تثني ذاتها المُتَوهمة عن هفوها إلى مكانها الأول: (يا ولَدي…/ لو التففتَ ببرشلونة بُرْنُسًا/ ونسِيتَ بغدادَ التي تنأى، وتَبْرُقُ كالسراب) يردُّنا في “تناص منحسر” الذي يكون- بحسب جان ريكاردو- بوشائج لنص ما للكاتب في كتاب له تستدعي نصوصًا سابقة من كتب أخرى له([22])، فتسدعي الصورة التي يبثّها صوت الذات المضادة التي تتمثّل التفاف الذات “ببرشلونة بُرْنُسًا” صورة الأخضر بن يوسف الذي يُمثِّل قناعًا للذات في شعر سعدي بوصفه ذاتًا ظلّية وهو يتبادل مع الذات، كلُّ قميصَ الآخر، أو قد يتمسّك ببرنسه الصوف حين يحتدُّ على الذات:
كان يلبس يوما قميصي
وألبس يوما قميصه،
ولكنه حين يحتدّ
يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف([23])
وكأنّ “البرنس” هو رداء الذات وتمظهر هويتها، وكأنّ دعوة الذات المضادة للذات بالالتفاف “ببرشلونة برنسًا” تحمل ضمنيًّا، بالاستماع إلى صوت النص الغائب، دعوة للذات بالتخلي عن هويتها التاريخية وكينونتها التي كثيرًا ما رافقتها المُتَمثِّلة في قناع “الأخضر بن يوسف”.
إنّ ارتباط الذات بمكانها الأول في عز اغترابها بالمكان الآخر يتبدى في تعلقها بجذورها التاريخية كما في قصيدة “أمير هاشمي منفيٌّ في لندن”:
كلَّ صباحٍ أفتحُ عينيَّ على الغيمِ
الممطرِ دومًا
والأبيضِ أحيانًا.
أنا لا أتصوّرُ ما قالوا لي عن شمسٍ ثابتةٍ
فوقَ حِجازٍ…
قالوا أيضًا إنّ بلادي تلكَ،
وإني سأُتَوَّجُ فيها ملكًا يومًا ما…
أنا لا أرغبُ في أن أُمسي ملكًا.
لكنّ الأجدادَ يُطلّون عليّ من الجدران
ومن غرفةِ مكتبتي
ينتظرونَ،
وقد سكنوا أُطُرًا ذهبًا، ودفاترَ يوميّاتٍ
وفصولًا من كتبٍ لن أقرأها…
لُغتي اختلفتْ
وثيابي
حتى عيناي هما زرقاوانِ([24]).
ثمة مراوحة تقابلية تعتمل في فضاء القصيدة بين المكان الآخر بغيمه الذي تفتح الذات عينيها عليه كلَّ صباح في مقابل المكان الأول بشمسه، غير أنّ المكان الأول الذي تستدعيه الذات- هنا- (حجاز) يبدو مجازيًّا، مستعارًا عن الوطن كمملكة بكينونتها التاريخية يتوج الشاعر ملكًا عليها، في إشارة لتجذُّر انتماء الذات تاريخيَّا لمكانها الأول، هذا الانتماء المتبدي فيما تشعر به الذات من إطلالة الأجداد عليها من الحوائط والدفاتر اليومية والكتب فيما يُمثِّل منازعة من المكان الأول القار في وعي الذات وذاكرتها الثقافية للمكان الآخر.
وفيما يتبدى من تصريح الذات باختلاف لغتها أنَّ ثمةَ وعيًا ما يُداخل الذات بتغيُّر لغتها واختلافها وفقًا لتغيُّر السياق الاجتماعي باعتبار “أنَّ اللغة تتنوع طبقًا للهويات الاجتماعية للأشخاص أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعض، ولأغراضهم التي يحددها المجتمع، وأطرهم الاجتماعية”([25])، ويصاحب اختلاف لغة الذات في المكان الآخر اختلاف ثيابها أي المظاهر الثقافية المادية للذات في مكانها الآخر.
ويتأجج الإحساس بالصراع النفسي المحتدم بداخل الذات نتيجة الصراع بين مكانين وثقافتين: المكان الآخر والمكان الأول، فالمكان الأول يلازم الذات في مكانها الآخر ويغالبها، فيقول سعدي يوسف:
في لندن الخضراءِ تأخذني الشوارعُ نحوَ نبتي
لي نخلةُ في أولِ الدنيا، ولي في النخلِ سعفةْ
والكأسُ ماءُ الطَّلعِ… يا ما كانت الأيامُ رشفةْ!
يا ما، ويا ما… فلتَغِمْ عيناكَ، ولْتُجفِلْكَ رجفةْ
الليلُ يُضويني… أنا المقطوع عن ولَدي وبنتي
“أنا يا صديقةُ متعَبٌ حتى العياء فكيف أنتِ؟”([26]).
فيما يبدو أنّ موضوعات المكان الآخر وأشياءه مثل الشوارع الخضراء تحيل الذات إلى مكانها الأوَّل، الوطن، الذي تسمه بأنّه “أوَّل الدنيا” بما يشي بما يُمثِّله ذلك المكان الأول بالنسبة للذات من أنّه بمثابة مركز الوجود ومنبع الحياة ومستهل العالم أي مبتدأ وعي الذات بالدنيا وإحساسها بالحياة، فسعدي يوسف ما يلبث أن ينشغل عن مكانه الآخر بمكانه الأول إذ “يبقى العراق في قصيدته عشقًا مبرحًا يمض به كلما امتنع عنه وعز الوصول إليه كانت تلك العاطفة وراء سعيه إلى التنقيب في تضاريس الأمكنة البعيدة عما يميزها من غيرها، ملمحها الشعبي أو طقسها لكي يقارنها بأماكنه الأولى”([27]).
ويستدعي ارتباط الذات بمكانها الأول، موطنها بالنخلة والسعفة عديدًا من المآلات الأسطورية كارتباط النخيل والسعف بالمسيح في حفاوة استقبال الجماهير له، من أهل وطنه، في أحد الشعانين مرحبين به بسعف النخيل- وفقًا للقصة المسيحية- ثم انقلابهم عليه بعدها بأيام قلائل بما يعكس عبث الجماعة بمصير الذات الفرد وبما قد يحيل أيضًا إلى انتماء الذات جذريًّا لمكانها الأول، في حين تُحرم من ولدها وبنتها في إشارة للانقطاع عن الأهل من المكان الأول في منفاها بالمكان الآخر وهو ما يُفاقم إحساسها بالوحشة.
وبتشريح البنية الهيكلية لهذا المقطع وباستجلاء تمظهراته المورفولوجية بل للقصيدة المتألفة من خمسة مقاطع على شاكلة هذا المقطع السداسي الأبيات نفسها بناءً ووزنًا وتقفية (أ ب ب ب أأ) حيث تتفق الأسطر (1 و5 و6) من كل مقطع في الإتيان بحرف التاء رويًا موصولًا بحركة الكسر في مقاطع القصيدة الخمسة مع ثبات السطر الأخير الذي يقتبسه الشاعر من عبد السلام عبد العيون كلازمة مكرورة فيما يشبه كثيرًا بنية شعر الموشحات وكذا شعر التروبادور الذي شاع في أوربا في القرون الوسطى وتأثر به الأندلسيون، فيما تبدو “اللازمة” كـ”تقليد فني قديم يُمكن أن يُقال دون خوف من الشطط إنّه قد استخدم في أكثر فنون الشعر الشعبي في العالم. فهي توجد في (كتاب الموتى) المصري القديم، وفي المزامير العبرية، وأغاني الرعاة اليونانية التي كتبها ثيوقريطس وبيون، وفي قصائد الزفاف اللاتينية التي كتبها كاتوللوس. وتبدو اللازمة ملمحًا عامًا من ملامح الشعر البدائي والقبلي، مصاحبًا للرقص والعمل الجماعيين. ورُبما أمكن العثور على البدايات الحقيقية للشعر في صورة كلمات أو عبارات مكرورة، هي التي تُشكِّل اللازمة”([28]) وكأنّ شاعرنا يستعيد مكانه الأول على صعيدين؛ الأول: مقولاتي اعتمادًا على الصور ذات الفاعلية الإحالية إذ تحيله شوارع لندن الخضراء لنخيل بلاده، والآخر: كتابي تقني؛ باستعادة قالب شعري كلاسيكي ألصق بالجذور الثقافية للذات الجمعية التي تبدو الذات طرحًا منتميًّا إليها.
فيما يتبدى أنّ صور المكان الأول بعناصره ومكوناته تطغى على ما تعاينه الذات من آثار المكان الآخر، فيقول سعدي يوسف:
والآنَ… ماذا يفعلُ العصفورُ؟
ثمَتَ نخلةٌ بأبي الخصيبِ أحَبَّها رُطَبًا جَنِيًّا
جَنّةً
مأوى
وكان إذا تقاذفت الرياحُ الكونَ يأوي تحتَ سعفٍ سابغٍ منها؛
لقد طُمِرَ النخيلُ...
أبو الخصيبِ مضى، كما تتضاءلُ الذكرى مع الأيّامِ؛
ماذا يفعلُ العصفورُ؟
تورنتو التي لا تُنْبِتُ النخلَ… الحديقةُ؟
أهي تورنتو، إذًا… يا سيّدي العصفور؟([29]).
إذًا، يتبدى “النخل” الذي يلحُّ على وعي الذات بوصفها علامةً أيقونية من علامات المكان الأول كأثر غائب، مُفتَقد في المكان الآخر؛ ففي شعر سعدي يوسف “تتحول النخلة إلى رمز متعدد التجليات للوطن الذي ينأى، امتدادها الشامخ يرشق حضوره في الفضاء الذي يغدو ممتدًا بطول المنافي، وجذورها القوية الضاربة في الأرض تغدو أشبه بالأوتاد التي تشد خيوط المرتحل المنفي إلى أصل هويته، يربط بينهما حبل سُرِّي لا سبيل إلى انقطاعه، مهما تعددت مدائن المنفى وبلدانه وصحراواته، بل حتى نسائه”([30])، فيما تتبدى الذات كعصفور يفتقد مأواه وجنته. وإذا كانت النخلة رمزًا للعراق فإنّها، فضلًا عن ذلك، بوصفها شجرة، حيث “ترمز الشجرة أسطوريًا إلى المكان الذي يرتكز عليه الإنسان بثبات، في مرحلة تمهيدية لعملية تالية هي الارتقاء إلى السماء. فتجربة التعالي إلى عالم آخر فوق الحسي، حيث يبتعد الإنسان عن كل ما يتعلق بالحياة الأرضية، تجربة تحتاج إلى منطلق غالبًا ما يكون الشجرة”([31])، فضلًا عن كون النخلة شجرة تتصف بالخصوبة وتجدد الحياة ما يعني أنّ إحساس الذات بفقدان النخلة إنّما هو إحساسٌ بالجدب وافتقار الرسوخ الذي يرتبط بـ”أبي الخصيب” بوصفها منبت الذات ومركزها في المكان الأول التي تُمثِّل للذات مأواها وجنتها المفقودة.
أما كناية الذات عن نفسها بالعصفور فيعكس إحساسًا ما برقة الحال فضلًا عن توق للتحرر باعتبار أنّ الطيور عمومًا هي “أجسام تطير دون أن تتأثر بالنار أو اللهب. كما أنّ من تفسيراتها النفسية النزوع إلى الحرية في الفضاء بعيدًا عن العالم الأرضي المليء بالمتاعب”([32]). فضلًا عن أنّ تشبيه الإنسان نفسه بالطير عمومًا رُبما ينبثق من لاوعي جمعي شعبي باعتبار أنّ “الظن القائل بأنّ الطير ليس إلا أشكالًا اتخذتها الأرواح البشرية، هذا الظن أساسه قدرة الطير على التحليق والطيران، وهي القدرة التي يرى المعتقد الشعبي، أنّ روح الإنسان تشارك الطير فيها”([33])، وكأنّ الذات عصفور يتوق لمأواه، نخيل أبي الخصيب.
إنّ غياب النخل عن تورنتو، المكان الآخر، يدفع الذات لاستدعاء مكانها الأول، “أبي الخصيب”، بنخيله وحدائقها، وفيما يتبدى من تكرار السؤال: (ماذا يفعل العصفور؟) أنَّ ثمة إحساسًا ما بالعجز والحيرة إزاء إحساسها بالفقد، فقد مكانها الأول، الذي يُلِحُّ عليها في المكان الآخر، ليقتلعها منه، لتعود باحثة عن جذورها بالمكان الأول.
ثم يعبِّر التساؤل الآخر: (تورنتو التي لا تُنْبِتُ النخلَ… الحديقةُ؟) عن نفي- يتبطن بنبرة استنكار- أن تكون توريتنو التي لا تنبت النخل هي “الحديقة” التي ألفتها الذات وتتوق إليها كما في أبي الخصيب بمكانها الأول، وطنها، العراق، فالتساؤل يُعبِّر عن إحساس بالفقد واغتراب الذات في مكانها الآخر لافتقادها مكانها الأول، بعلاماته كالنخل الذي في أبي الخصيب.
ويبلغ إحساس الذات بالاغتراب في ابتعادها عن مكانها الأول ذروته حين تحس نفسها كالابن الضال:
أنا، الابن الضالّ، المسكين
الضائع بين سماوات القارات
كنجمٍ أفلتَ…
…………………….
…………………….
…………………….
يا أمي:
غطّيني بحرير ترابكِ
بالنور الدافقِ من عتمة قبركِ([34]).
هل يعكس شعور الذات بأنّها في مكانها الآخر كالابن الضال في ابتعادها عن مكانها الأول إحساسًا بالفقد فحسب؟ أم أنّه يحمل، كذلك، إحساسًا بالإثم والندم لمغادرة الوطن والرحيل عنه حتى ولو كان رحيلًا قسريًّا؟
بعيدًا عن مكانها الأول تبدو الذات ضائعة بين سماوات القارات رُبما في إشارة لمداومة الترحال بواسطة الطيران واللااستقرار بمكان معين بالمكان الآخر والتقلب بين المهاجر. وفي المقابل تحن الذات لتراب الوطن وما تتمثّله نورًا دافقًا من عتمة قبر الأم الذي يرمز رُبما للرحم الوجودي الذي تفتقده الذات وتحن إليه.
2- استعادة آثار المكان الأول
تعمل الذات بمنفاها في المكان الآخر مع شعورها بحدة اغترابها فيه على استعادة آثار المكان الأول، الوطن، الذي تعيد إنشاءه بواسطة فعل الاسترجاع الذاكرتي وعمل التخييل باستعادة آثاره من أماكن وأزمان عاشتها الذات فيه وشخوص كعلامات أيقونية دالة على هذا الوطن المفقود، لتمارس الذات المبدعة في مكانها الآخر نوعًا مما يُمكن أن نسميه “كتابة الآثر” التي يتبدى عبرها الوطن، مكانها الأول، أثرًا بارزَ الحضور في وعيها الوجودي ورؤيتها العالم، وتتنوع استعادات الذات لمكانها الأول، الوطن، ما بين أماكنه التي تستعيدها وتعيد رسمها، وأزمنة تعود الذات إليها، وشخوص ترتبط الذات عبرهم بمكانها الأول.
2- 1- استعادة أماكن المكان الأول
تعمل الذات في مكانها الآخر على استعادة أمكنة اقترنت بها وعلقت بذاكرتها من المكان الأول، فتبدو أماكن ذلك المكان الأول منبثقة من جيوب اللاوعي وكأنّ الذات تعمل على استرجاعها مقاومةً لاغترابها في المكان الآخر وتأكيدًا على انتمائها للمكان الأول وتقويةً لعرى اتصالها به، حينها يمسي المكان تشكيلًا ذاتيًّا أكثر من كونه موضوعًا للتمثُّل التجريبي، فيأخذ المكان الأول الذات من مكانها الآخر، فتستعيد الذات مدن العراق ومراكزها كما في قصيدة “شهادة جنسية”:
عربيٌّ من العراق…
أنا: البصرة، بيتي ونخلتي. وأنا النهرُ الذي سُمّيَ باسمي ورملةُ اللهِ دربي وخيمتي. الآثلُ الشاحبُ سقفي وملعبي، وخليج اللآلئِ- الوعد لي، والبحرُ لي. والسماءُ دومًا سمائي.
*
عربيٌّ من العراق…
أنا: الكوفةُ، ما خُطَّ في العروبة خَطٌّ قبلَها. والعواصم الألفً
ما كانت سوى من كنانتها. بيتُ عليِّ، والمسجدُ الجامعُ، والنهرُ. هل تخَطِّينا الكتابةَ؟ الحرفُ كوفيٌّ، وقرآنُنا وصىٌّ عليها.
*
عربيٌّ من العراق…
أنا: المَوصلُ، خيلٌ وخُضرةٌ. كان سيفُ الدولة الأميرَ، وكانت حلبُ أختَها. السفائنُ في النهرِ. المُغَنّون في الضفافِ. هنا صاحبُ البريد أبو تمامٍ. المرمرُ الصقيلُ هي الموصلُ، والأهلُ، والنضالُ الطويلُ([35]).
يتبدى انتماء الذات لمكانها الأوَّل العراق، الوطن متعدد الأوجه، ما بين انتماء قومي متمثلًا في الكينونة عربية الهوية فضلًا عن انتماء وطني للعراق، إضافة لفروع هذا الانتماء المتبدية في الارتباط بمدن العراق ومراكزه الرئيسية، على نحو أفقي، باستعادة ملامحها المكانية وعلاماتها الأيقونية البارزة كالبيت والنخلة والنهر والجامع، وعلى نحو رأسي، باستعادة تاريخها النضالي كعلاقة سيف الدولة وأبي تمام بالموصل، وما تتسم به هذه المراكز من ممارسات ثقافية تاريخية كالكوفة كالخط الكوفي والموصل من الغناء.
وفيما يتبدى من علاقة الذات بالمكان في عياناته المادية أنّ ثمة تماهيًّا بين الذات والمكان وأنَّ ارتباط الذات بمكونات مكانها الأول كالنهر والسماء وغيرها يصل حد التوحد؛ لتستحيل الذات والموضوع، المكان، واحدًا فيما يُشكِّل نوعًا من “وحدة الوجود” ما بين الذات وعناصر المكان:
عربيٌّ من العراق…
أنا: هذا الفراتُ، الذي يُوحِّدُ أهلًا، وبلادًا، وأُمّةً. كلُّ كفٍّ من مائهِ
موعدٌ في جنةِ الخُلْدِ. يا صبايا الفراتِ، صبرًا! لكُنَّ النهرُ والفخرُ…
سوف يأتي زمانٌ للتهاليلِ. نحنُ نُقسِمُ بالنهرِ، وباللهِ، والسوادِ الأصيلِ.
*
عربيٌّ من العراق…
أنا: بغدادُ، موصوفة بما ليس في الوصفِ. الكتابُ العصيُّ. والجنّةُ.
الدربُ المؤدِّي إلى الدروبِ. أتاها كلَّ عصرٍ برابرةٌ. لكنّها أحكمت الأنشوطةَ.
العزيزةُ بغدادُ.
والأسيرةُ بغدادُ،
والأميرة بغدادُ…
والجدارُ الأخيرُ([36]).
تواصل الذات الشاعرة استعادتها لمراكز العراق ومدنها الرئيسية وكذلك شريانها المائي، نهر الفرات، الذي يبدو كأنّه الحبل السري الذي يربط مراكز العراق، وتأكيد هويتها العروبية وانتمائها لمكانها الأوَّل، العراق، عبر تكرار الجملة التصديرية “عربيٌّ من العراق” في مستهل مقاطع القصيدة فيما يُعرَف بتقنية “الأنافورا” “Anaphora” أو “«تكرار الصدارة»، وهي نوع من التكرار يُستَخدم في الشعر كما في النثر؛ إذ يكرر الشاعر أو الناثر كلمة أو عبارة في بداية مجموعة من الفقرات المتوالية، أو مجموعة من الأبيات المتوالية، أو حتى مجموعة من الجمل”([37]) فبحسب صلاح فضل فإنَّ هذا الفعل “يفجر قدرًا كبيرًا من غنائية التكرار الشبحي وربط الصيغ بخيط منظور وغير ممجوج مثل السجع. كما أنّه يُعد المدخل الطبيعي لعملية أثيرة في الكتابة الغنائية وهي الاستبطان واستحضار العوالم الداخلية، فكأنّه مفتاح يلج عبره المتكلِّم إلى دنياه وأحلامه ورؤاه. وإذا كانت الغنائية تعني فرضًا إرادة البوح، وضرورة التعبير عن الوجدان الذي يعكس وحدة الشخصية فإنّ من يُمارس البوح بقوة أشد هو الذي يقترب من روح الشعر”([38]). وبقدر ما تتجسد الجملة التكرارية الأنافورية إيقاعًا موسيقيًا بارزًا ولازمة صوتية بقدر ما تُجسِّد إيقاعًا نفسيًّا داخليًّا لما يُساكن الذات من شعور قوي بالانتماء لمكانها الأول.
وللبصرة المحافظة العراقية التي تضم بين أكنافها أبا الخصيب مولد سعدي يوسف ومنشأه حظ وافر في استعادات الذات للمكان الأول:
لم يبق من النخل سوى أعجاز خاوية
إن سماء بيضاء
سماء كانت خضراء
تمد يديها نحو سماء ثالثة:
“أنا عريانة
أنا عريانة
ذهبت بالنخل مدافعهم
ذهبت بالأهل مدافنهم
أنا عريانة”
والبصرة يدخل تحت شوارعها
تدخل تحت الماء أجاجا
تدخل تحت الكتب المصفوفة
تدخل في الروح ولا تخرج الا والروح..
مدينتنا !
من ضيع عادات النورس؟
من جاء بغربان الجثث الأولى؟
من جاءك بالأكياس الرملية يا فيروز الشطآن؟
من غطى سباخك بالقتلى؟([39]).
فيما يبدو من توقيع سعدي يوسف بتدوين تاريخ ومكان القصيدة في (نيقوسيا، 12/ 4/ 1987) أنّ الذات في استعادتها البصرة مدينتها التي تعد ثاني أكبر المدن العراقية وعاصمة الجنوب العراقي إنّما ترثي البصرة فيما تعرضت له من خسائر أثناء حرب الخليج الأولى التي دارت رحاها بين العراق وإيران في الفترة من 1980 حتى 1988.
تبدو الصورة التي تُشكِّلها الصياغة الشعرية لمدينتها “البصرة” (لم يبق من النخل سوى أعجاز خاوية) خارجة من سياق قرآني، إذ تبدو متناصة مع الآية القرآنية: ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾([40]) التي تصور صرعة القوم بأعجاز نخل خاوية في حين تستثمر الصورة الشعرية لدى سعدي يوسف الصورة القرآنية وتدعمها تركيبيًّا بالنفي بـ(لم) والاستثناء بـ(سوى) ما يؤكِّد على شمول الفناء أهل المدينة وهو ما تعاود الصياغة الشعرية إنتاجه تأكيدًا لذات المعنى فيما يتبدى في السطرين الشعريين: (ذهبت بالنخل مدافعهم/ ذهبت بالأهل مدافنهم) من حيث تماثلهما التركيبي الذي يُحدِث سيمترية إيقاعية تجعل القصيدة في هذا المنعطف كنشيد بكائي، فيما يعمل “مونتاج التماثل Similarity Montage ويتم بأخذ لقطة ومواجهتها بلقطة أخرى تتشابه مع محتواها”([41])– على إحداث الموازاة الاستعارية بين الأهل والنخل من ناحية والمدافع والمدافن من ناحية أخرى في وقوع فعل الذهاب الذي بمعنى المحو والإزالة والإفناء.
وفيما يتبدى من تَمثُّل الذات للسماء التي تعاين تبدُّلاتها بوعي سوريالي أنّ ثمة تحولًا لونيًّا في لون السماء من الأخضر إلى الأبيض في إشارة للتحول من لون الحياة والإثمار إلى لون يعكس شحوبًا ثم تعلن تلك السماء عن عريها فيما قد يعكس إحساسًا يداخل الذات بفقدان الغطاء والحماية أو رُبما الانتهاك بفعل الحرب الدامية في حين أنّ البصرة لتبدو مقترنة بالكتب الموصوفة أي في ذاكرة الكتابة التي تعني ذاكرة الوعي الجمعي كما تدخل في الروح.
وفيما يتبدى من التشكيل السوريالي للصورة قيام فاعلية التخييل السوريالي بما يشبه عملية التوليف الديالكتيكي ما بين الحدود والعناصر المتقابلة كما في هذه الصورة ما بين سماء بيضاء بما يوحي به اللون الأبيض من الشحوب والجدب، وسماء خضراء بما يوحي به اللون الأخضر من الحياة والحيوية ما يفضي إلى تَشكُّل سماء ثالثة؛ فنجد أن السورياليين قد أفادوا من فكرة الديالكتيك الهيجلي في بناء صورهم؛ حيثُ “أفاد فكرُ هيجل بريتون فيما يتعلَّق بالتوفيق بين تأكيده الأولي على استكشاف اللاوعي من ناحية، وبين التزامه بالتغيير في العالم المادي الذي صَاحَبَ ولاءه، وولاء السوريالية، للشيوعية بعد 1926، من ناحية أخرى. لقد كان القالب المثالي لفكر هيجل الأكثرَ أهميةً وحيثية على الإطلاق. في الفلسفة التقليدية بشكل معقد لهيجل، يتعرّف العقل على نفسه، أو الروح على نفسها، من خلال سلسلة تدريجية من التوليفات الجدلية. وبالنسة إلى بريتون، تعمل الصورة السوريالية بالمثل عبر التصادم بين مصطلحات متضاربة بُغْيةَ إنتاج وحدة جديدة «أعلى»”([42])، فالصورة السوريالية ديالكتيكية التوليف بما يناظر عالمًا جدليًّا ووجودًا ديالكتيكيَّ التكوين.
وعلى صعيد أيديولوجي، نجد أنَّ ثمة صلةً ما بين السوريالية والأيديولوجية الشيوعية والفكر الماركسي؛ فقد اعتُبِرت السوريالية “مناوئة للبورجوازية في جوهرها، لكنها كانت أكثر انغماسًا فيما هو غريب وعجيب”([43]).
ولكنّ لِمَ غلب على صور سعدي يوسف في استعادته مكانه الأول في عز اغترابه بمكانه الآخر طابعٌ سورياليٌّ؟ فيما يتبدى أنّ غلبة السوريالية على صور سعدي في استعادته مكانه الأول تُعبِّر عن وعي ما بكون الاستعادة الحقيقية أو العودة الحقيقية للذات إلى مكانها الأول، وطنها، بمثابة وهم، فتتخطى الذات الحواجز المنيعة التي تفصلها عن مكانها الأول وتحجبها عنه بحركة سوريالية في إنشائها التخييلي.
ويتبدى من الأسئلة المكرورة في أداة الاستفهام (من) فجيعة الذات لما أَلَمَّ بالمدينة من موات وفناء، وإدانة المسؤول عن ذلك الخراب؛ وهو ما يتبدى بضياع النورس، النورس طائر رامز للتوق إلى الحرية والتعرض الدائم لخطر قنص الصيادين في آن، فهل تأثر الشاعر في استحضاره النوارس التي ضاعت عاداتها بما يشي بغيابها بمسرحية طائر النورس لتشيكوف؟ وفي مقابل النوارس تحضر الغربان بما تحمله كنذير شؤوم وسواء في السماء حيث تغيب النوارس وتحضر الغربان بما التهمته من جثث القتلى أو على الأرض حيث تُغطى الأسباخ بالقتلى؛ فبقدر ما تمنح أداة الاستفهام (مَن) الإيقاع الموسيقي تدويمًا لمكروريتها بقدر ما تجسد اضطراب الإيقاع النفسي للذات وفي مرثيتها لمكانها الأول الذي طاله القتل والفناء، فالموت هو المُهيمن على المشهد والحال في فضاءاته:
مدينتَنا!
سنظل- وإن شبنا- أطفالك
نحمل طلعك في جيب الدشداشة
نشربه في حشرجة الماء…
مدينتنا !
ما ضعتِ
وما ضعنا،
لكن, ضيعنا الأعداء….([44]).
يبدو ارتباط الذات في كينونتها ذات الهوية الجمعية بمكانها الأول “البصرة” عبر زمكان المدينة الأم- الطفولة، وهو ما يبقي الذات في زمن الطفولة بما يجعلها تتعالى على الزمن وتحولاته وكأنَّ ارتباط الذات بمكانها الأول يحفظها من الشعور بالشيخوخة ونيل يد الزمن منها.
ولكن أية وشيجة تربط النخل بالطفولة؟ يبدو أنّ “الطفولة كالنخلة في العلاقة بأصل الهوية في هذا النوع من حنين البدايات، كلاهما يستدعي الآخر، موصولاً به في زمن البدايات وفي زمن النهايات على السواء، فالنخلة هي طفولة الزمن الذي شهد الوعي المغترب سماءه الأولى في موطنه العراقي، والطفولة هي النخلة العراقية المستعادة في استرجاع الأصل الذي تحن إليه الهوية كما تحن إليه الهوية كما تحن الأغصان إلى الجذور”([45])، فإلحاح النخلة والطفولة على وعي الذات الشاعرة، لدى سعد يوسف، في استعادة المكان الأول هو حنين للأصل والبدايات كما في الطفولة وإلى الجذر الوجودي الراسخ كما في النخل.
ويعمل هذا التكرار الندائي لـ(مدينتنا) على إلحاح الذات على طلب مدينتها الضائعة كما تعمل إضافة المدينة لضمير المتكلم الجمعي (نا) على إبراز الفقد المُضَاعف للمدينة كمكان تعرض للتشويه بفعل الحرب وفقد الذات جماعتها التي ترتبط بها وتنتمي إليها.
لذا تبقى البصرة لصيقة بالذات في مكانها الآخر كرمز حميمي دال على المكان الأول في استعادات الذات له، فيقول سعدي يوسف:
أمّا أنا… الحارسُ الأبديُّ المُوَكَّلُ بالبصرةِ النخلِ
فالليلُ لي
ليلُ هذا السبيلِ العجيبِ
السبيلِ الذي ينجلي
في زجاجِ القناديلِ
في قطرةٍ من نبيذ...
*
على كاتب السطور أن يتدخّل الآن. ليس لأن النصّ اكتمل
بل لأنّ النصّ يبدو كأنه اكتمل. سيفرح أحدهُم ويقول:
ألم أُخبرْكم أن سعدي يوسف يقع في فخِّ اعتياداتِه؟
كاتبُ السطور يقول: الأمرُ حقٌّ. لكن سعدي يوسف
حذِرٌ أيضًا. بمعنى أن بمقدوره إنقاذَ سُمعتِهِ في اللحظةِ
الأخيرة([46]).
تُحسُّ الذات في علاقتها بمكانها الأول، ومدينتها الأم “البصرة” بمسؤولية ما تجاه مدينتها، “الحارس الأبدي”. وكأنّ الذات تشعر بأنَّ عليها دورًا يجب أن تؤديه بحراسة مدينتها وحمايتها وأنّ هذا الدور هو دور أبدي، لا نهاية له ولا تقاعد منه. كما أنّ اقتران الذات بمدينتها يكون في زمن “الليل” الذي تستجليه الذات عبر وسائط عديدة كما “في زجاجِ القناديلِ/ في قطرةٍ من نبيذ” لتسعى إلى فك شفراته.
ثم ينتقل الخطاب الشعري في المقطع التالي في التفاتة مباغتة إلى حديث الصوت الشعري عن ذاته بـ”ضمير الغائب” وعن نصه وحول ما قد يتبدى من اكتمال “النص” وضرورة تدخُّل كاتب النص حينها فيما يُشكِّل نوعًا مما يُمكن أن نسمه بـ”كسر الإيهام الشعري” و”تعطيل التخييل” فيخرج عن الصوت الأول للنص الباث خطابه بضمير المتكلم صوتان: أحدهم باث الخطاب بضمير الغائب عن كاتب هذه السطور مرة وعن صوت آخر يحكي عن سعدي يوسف (الشاعر) مرة أخرى في تمثيل لتمظهر الذات والذات المضادة، شبح الذات الذي يبث نبرات النقد والانتقاد والتقويم لتلك الذات.
وبالتوازي مع انتقال الخطاب المبثوث من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ثمة انتقال آخر من السطر الشعري المكتنز المحدود التفاعيل إلى السطر المرسل بما يجسِّد انتقال الخطاب من تمثيل الذات كساردة تمارس فاعلية الإيهام والفعل التخييلي إلى الذات المنشطرة التي تعمد إلى إيقاف فاعلية الوهم الشعري وإبطال مفعول التخييل رُبما إشفاقًا على المُتلقي من التماهي مع الذات في عذاباتها واغتراباتها، تلك التقنية البريختية التي ترمي إلى “التغريب” إشعار للمتلقي بغرابة الواقع المبثوث عبر النص التخييلي وإيقاف فاعلية التخييل في آنٍ.
وتتوالى وتتنوع استعادات الذات لأماكن مكانها الأول، فتستدعي مدينة “سامراء” بحضورها التاريخي، فيقول سعدي:
“أرى العراق طويلَ الليلِ، مُذْ.“..
مطرٌ على النوافذِ،
والأشجارُ هابطةٌ،
والغيمَ...
كان المساءُ الجهْمُ يدخلُ في لوح السلالمِ مقرورًا،
ويدخلُ في أناملي؛
كيف لاحتْ، بغتةً، وبلا معنىً، مَدارجُ سامرّاء؟
كيف نمَتْ مَلْوِيّةٌ في يدي؟
كيف صار البئرُ مرتشَفي في اللحظةِ الصِّفْرِ؟
أمواهٌ مُعَجَّلةٌ كالخيلِ، تتْبَعُ سِحرَ البحتريِّ...
تقولُ: سامرّاءُ. سامرّاءُ،
حمحمةٌ وبَلوى؛
يا بساطًا من مِهَفّاتٍ وخِضْرِمةٍ،
ويا دربًا إلى المهديِّ...
يا بلدي، سلاما!([47]).
يستهل الشاعر نصه بمقطع لسلفه القديم المتنبي “أرى العراق طويلَ الليلِ، مُذْ.“.. ولكأنّه يُنشئ حوارًا مع سلفه أو أنّه يستثمر مواجد سلفه فيما عاينه من معاناة العراق ليراكم عليها مواجده هو واغتراباته.
وبينما يعاين الشاعر مساءًا جهمًا، غائمًا في المكان الآخر وفي معاينته السلالم ينتقل في التفاتة أقرب ما تكون سحرية لمدارج سامراء في نقلة مونتاجية ليس فقط في ثنايا المكان من المكان الآخر إلى المكان الأول، بل عبر الزمان أيضًا حيث صار الزمن في “اللحظة الصفر” بما يعني تحييد الزمن أو تجميده والخروج عنه باستعادة زمن تاريخي مضى، و”سحر البحتري”، حيث عهد مجيد كانت فيه العراق في العصر العباسي مركز الثقل للإمبراطورية العربية الإسلامية.
ولا تقتصر استعادات الذات لأماكن مكانها الأول على مدنه ومراكزه فحسب، وإنما تستدعي “الفرات” النهر الذي يُمثِّل شريان الحياة الرابط بين ربوع العراق:
يغيضُ عن “الرّقةِ” الماءُ كي يدخلَ الطبقاتِ الخفيّةَ من لحمِنا،
نحن أبناءِ تلكَ الضفافِ التي أنبتتْ قصبًا للأسِنّةِ والأغنياتِ. الفراتُ
هنا ضلّلَ النورسَ. السمَكُ المتحدِّرُ من فُوّهاتِ الجبالِ ارتضى في
الفراتِ مراعيَهُ، وارتدى الفضّةَ. الخيلُ تعبرُ، غرثى، مَخاضاتِهِ.
والجِمالُ الأبيّةُ تعلِكُ في الصّهَدِ، الشيحَ. ماءٌ تغلغَلَ في الرملِ. في
وجْنةِ الطفلِ. ماءٌ يَظلّ بكفيكَ، لا يتبدّدُ. ماءٌ هو البَسْملةْ.
(…)
يا خيطَ أسمائنا وتواريخِنا، يا قرانا، وذكرى مَمالكِنا. يومَ جئتُكَ
أحمِلُ أوزارَ خَطوي تحمّلتَني، وانتظرتَ إلى أن وثبتُ خفيفًا من القاعِ.
ضوءٌ على جسدَينا. وضُوءٌ. أهذا هو السلسبيلُ؟ أهذي هي السّنبلةْ؟
*
فيافيكَ، حيثُ الذئابُ التي تأْلَفُ النارَ. جنّاتُ عدْنِكَ حيثُ الصقورُ التي
تأْلَفُ الناسَ. مَرْعاكَ حيثُ الزهورُ به كَمْأةٌ. والنساءُ اللواتي يَخُضْنَ
بأثوابِهِنَّ المُوَيجاتِ إذ يتبرّدْنَ. هل كان صوتُ المُغَنِّي شبيهَ عرائسِكَ؟([48]).
يحضر الفرات ليس بوصفه مكانًا علاماتيًّا كأيقونة دالة على العراق وحضارته فحسب بل باعتبار ما للماء من رمزية أسطورية؛ فالماء في الكتب المقدسة، خصوصًا الشرقية، كالتوراة والقرآن هو أصل الحياة ومصدرها إذ “تكاد أساطير العالم القديم تنتهي إلى أنّ الماء أصل نشأة الكون والأحياء”([49])، بل “إنّ دراسة النصوص الأسطورية للسومريين والبابليين يتضح لنا منها أنّ أصل النشوء الأول كان من المياه”([50]). فضلًا عما للماء من تجذّر متمدد في أساطير العراق القديمة بوصفه عنصرًا حاضرًا في الوعي الأسطوري الجمعي للشخصية العراقية إذ “تروي أسطورة سومرية عن الإله أنكي إله الماء وإله الحكمة في نفس الوقت، وكيف أنّه كان يؤدي مجموعة بأسرها من الأعمال الحيوية لخصوبة الأرض وقدرتها على الإنتاج، حيث بدأ متجهًا إلى ملء دجلة بالمياه العذبة المتلألئة المانحة للحياة. ولقد كان أنكي على هيئة ثور هائل تزوج النهر الذي صُوِّر على هيئة مهاة. ولكي يتأكد من حسن أداء دجلة والفرات عَيّن الإله (ابنيلولو) مشرفًا عليهما”([51])، فالماء قار في الوعي الأسطوري القديم حيث “يعتقد البعض لا سيما أتباع مدرسة التحليل النفسي أن نظرية الميلاد المائي لدى الشعوب القديمة تُعدّ انعكاسًا لذكرى كامنة في لاشعور الإنسان حول حالة الجنين في ماء الرحم للأم سابحًا في بحره الأول”([52]). وهو ما يبرز بعدًا مثيولوجيًّا في تكوين المكان الأول الذي يستعيده الشاعر.
فثمة علاقة عميقة وذات بعد سحري تربط الإنسان بالماء في مكانه الأول، حيث “يمتلك الماء في هذه المقطوعة سيولة دلالية جارفة، فهو يغيض عن وديان «الرقة» المشتركة بين سوريا والعراق لينفذ ويفيض في طبقات اللحم الحي لأبناء ضفافه”([53])، فثمة ما هو أقرب إلى “الحلول” الذي يُسْكِن الفرات في جسد أبناء ضفافه. كما أنّ علاقة الذوات في حركتهم نحو “الفرات” والتصاقهم به تبدو نشدانًا للتطهر؛ فالذات قد جاءت “فراتها” تحمل “أوزار” خطوها فيما يعكس اعتقاد الذات في فاعلية الماء التطهيرية وكأنّ الذات في مكانها الآخر تُحسّ بفقدان الإحساس بالتَطهُّر وتُمسِك بها لوثة المكان الآخر وتتلوث في اغترابها فيه فتعمل على أن تستعيد ذلك الفرات باعتباره موضعًا للتَطهُّر بمكانها الأول.
وفيما يتبدى أنّ كينونة الماء وفاعليته تتخطى حيزه المادي والطبوغرافي في المكان، فالماء أو الفرات هو الرابط للأسماء بما تعنيه الأسماء من كينونة الذوات وهويتهم، غير أنّ هذا الماء الفُراتي يبدو نبعًا متمددًا ولانهائيًّا: (ماءٌ يَظلّ بكفيكَ، لا يتبدّدُ) فثمة التفات بالانتقال من ضمير المتكلم في حديث الذات عن نفسها إلى ضمير المخاطب في حديث الذات مع أناها الأخرى أو رُبما مع قارئها ومتلقيها؛ فقد “أصبح ضمير المُخاطَب هذا يشير إلى الرواي المتكلم وهو مُنقسم على ذاته يًكلمها ويُذكِّرها، كما يُشير في اللحظة نفسها إلى القارئ الذي لا يستطيع أن يتفادى الاصطدام بهذا الضمير، فيفاجئه ويربكه”([54])، وهو ما يُشرك القارئ في فعل التَمثُّل التخييلي.
عمومًا، يعمل الالتفات نحو ضمير المخاطب على رفع درجة غنائية الشعر، “ووفقًا لمقولة جون ستيوارت مل: إن الشعر الغنائي لا يُستمع إليه، بل يُسمع عرَضًا وبالمصادفة. «إنّ الشاعر الغنائي يدّعي عادة أنّه يتحدث إلى نفسه أو إلى شخص آخر: إلى روح الطبيعة أو عروس الشعر، أو صديق شخصي أو عاشق أو إله أو شيء مجرد ماثل أو شيء من أشياء الطبيعة.. وهكذا يتحدث الشاعر مُعطيًا ظهره لمستمعيه»”([55]). كذلك فثمة نوع آخر من الالتفات باستعمال ضمير المخاطب في تعامل الذات مع الأشياء كما في مخاطبتها النهر؛ ذلك “أن تقوم بالالتفات يعني أن ترغب في حالة من الانخراط، أن تحاول استدعاء هذه الحالة بأن تطلب من الجمادات أن تطوع نفسها لرغباتك. بهذا المعنى ستكون وظيفة الالتفات أن يجعل من أشياء الكون قوى منطوية على احتمال الاستجابة: يُمكن أن يُطلب من هذه القوى أن تقوم بالفعل، أو أن تُحجم عنه أو حتى أن تستمر في سلوكها المعتاد نفسه. والشاعر الذي يقوم بالالتفات يدرك الكون المحيط به وكأنّه عالم من القوى الواعية”([56])، فالذات تُشخص “الفرات” لتضفي على علاقتها به حميمية مُفرِطة:
تسيلُ الهُوَينى…
قرونًا تسيل الهُوَينى…
وتمنح أهلَكَ خبزَ الضفافِ وقثّاءَها
والأغاني.
تسيلُ الهوينى…
قرونًا تسيلُ الهوينى…
يمرُّ بك العابرون:
الجيوشُ، اللصوصُ ذوو الخُوَذِ، السائرونَ إلى حتفِهِم في الظلامِ… السماسرةُ،
السُّحُبُ الصيفُ، أوباشُ نا، والقياصرةُ، الطامعونَ…
وأنتَ تسيلُ الهوينى
قرونًا تسيلُ الهوينى….
وتمضي
كأنّك لا تعرفُ المسألةْ([57]).
في المقطع الأخير من هذه القصيدة يُكثِّف الشاعر علاقة الفرات بالزمن وبصروف الدهر وصموده وتجاوزه المحن والنكبات؛ فقد “أصبح الفرات، وكان دائمًا، نهر الزمن المتدفق بمشاهد التاريخ، فهو في حركته البطيئة الواثقة الرفيقة، يسيل بنعومة ورقة- مثل حسناء الشاعر العربي القديم التي كانت تمشي الهوينى بوجل. لكن الزمن في ضميره لا يُحسب بالأعوام؛ فعندما يشرف صوت القصيدة على مشهد القرون العابرة تتضاءل الغزوات، وتتقزم الكوارث، ويمضي موكب الجيوش المرتزقة، واللصوص المأجورة المنتحرة، والغريب أنّهم من منظور الشاعر ليسوا دائمًا أغرابًا، فبعضُهم سماسرة منا، «أوباش» تعرفهم كل الشعوب، وقياصرة طامعون، كلهم يسيرون جنب سحابات الصيف العابرة، ليبقى الفرات، مانح الخبز والقثاء والأغاني”([58])، فتتحقق لدى سعدي يوسف وحدة الوجود بتشابك ما هو إنسانوي بما هو شيئي وطبيعي.
ولنا أن نلاحظ انتهاء مقاطع القصيدة في كل مقطع منها بكلمات موحدة الروي: (البسملة- السنبلة- المسألة) لتكون بمثابة وشائج إيقاعية تربط مقاطع القصيدة تقفيةً وكأنّها بمثابة “مصبِّ” إيقاعي ودلالي لمقولات الدور الفراتي في توثيق انتماء الذات لمكانها الأول، الوطن، من ناحية، والتأكيد على دور هذا الفرات في توحيد البلاد على مستوى مكاني جغرافي، وزماني تاريخي من ناحية أخرى.
وفي ارتباط الذات بموضوعها “الفرات” يبدو التعالق بينهما كارتباط أيروسي، إذا تستدعي جملة “تسيل الهويني” جملة حاضرة في غرض الغزل لدى الشاعر العربي القديم “تمشي الهوينى” التي يكررها الشاعر في المقطع الأخير ست مرات تأكيدًا على إيقاع النهر المنعكس في وعيه الذي هو شريحة من الوعي الجمعي، وفيما هو متبد من المراوحة الإيقاعية في البنية العروضية لنصه بمعاودته- في هذا الأخير من القصيدة- التكوين المكتنز في بنية السطر رُبما لخلق نقلة إيقاعية متمهلة تجسِّد حركة النهر المتمهلة في الزمن كسير الهوينى.
وحديث الذات المبثوث إلى موضوعها، “النهر [الفرات]/ الماء بحركته الالتفاتية باستعمالها ضمير المُخَاطَب في خطابها عن النهر يؤكِّد ذلك التماهي بين الذات والموضوع، “النهر”، “وإذا كان شعر ما بعد التنوير- ونحن [جوناثان كَلَر] نميل إلى هذا الرأي- يسعى إلى تجاوز اغتراب الذات عن الموضوع، فإنّ الالتفات حينئذٍ هو الذي سيأخذ الخطوة الحاسمة، لتشكيل الموضوع وكأنّه ذات أخرى، تنخرط معها الذات الشعرية في علاقة متناغمة. يُجسِّد الالتفات هذا التوافق بين الذات والموضوع”([59])؛ حيث يُمسي الالتفات “طريقة لتكوين قناع شعري، من خلال تبني علاقة خاصة مع الأشياء”([60])، فكأنّ الفرات قد استحال قناعًا عن المكان الأول، الوطن.
2- 2- استعادة زمن المكان الأول
إذا كان الزمن في جوهره هو عيان مجرد، نفساني، نسبي، ذاتي أكثر من كونه موضوعيًّا فإنّ الذات هي التي تتمثل الزمن بل تصيغه وتصنعه، كذا فإنّ الزمن قد يكون تمظهرًا منعكسًا لإحساس الذات بالمكان، فالزمن هو وجه العملة الآخر للمكان الذي يتعالق به أو بالأحرى انعكاس المكان على وعي الذات به. الزمن متغير لكونه نسبيًّا، يتغير ويتمايز بتمايز الذوات الذين يتمثلونه، كذلك فقد يتبدل وعي الذات نفسها بزمن ما بعينه من حال لآخر ومن زمن لآخر.
والذات في مكانها الآخر الذي تغترب فيه كما تغترب في إحساسها بالزمن في ذلك المكان الآخر تعمل على استعادة أزمنتها في مكانها الأول، فيقول سعدي يوسف عن ليله بالمكان الآخر:
أصابعُ القَدَمِ اليسرى، تُنَمِّلُ…
جسمي واهنٌ
وعلى مَشْتى البسيطةِ، كان الليلُ
أطولَ حتى من مُعلَّقةِ امرئ القيسِ([61]).
تبدو الذات مُنهكة في مكانها الآخر، واهنة الجسد ما يشي بضعف الذات وتعسر حركتها أو بالأحرى بطئها في المكان ما يُفضي لإحساس الذات بتباطؤ إيقاع الزمن وتعسر حركته وهو ما يتبدى في شعورها بتمادي الليل/ الزمن في المكان الآخر في طوله حتى أنّه يتجاوز الليل طولًا في معلقة امرئ القيس، وهو ما يحيل إلى أبيات امرء القيس:
ولَـيلٍ, كَـمَوجِ البَحرِ أَرخَى سُدولَهُ *** عَــلَـيَّ بِـأَنـواعِ الـهُمـومِ لِـيَـبتَلِي
فــقـُلــتُ لَــهُ لَــمَّا تَـمــطَّى بِـصـُلــبِهِ *** وأردَفَ أَعـــجـــازًا ونــاءَ بِـكــَلـكَـلِ
ألا أيٌّـها الَّـليلُ الطَّويلُ ألا انجَلِي *** بِـصُبحٍ, ومـا الإصباحُ منِكَ بِأَمثَلِ
يرتبط نص سعدي يوسف في بنيته “النصيّة التحتية”([62]) بنوع من المحاكاة التهكمية، “البارودي” مع نص امرئ القيس، تلك المحاكاة الساخرة تقليد لكاتب ما، وتعتمد على المبالغة عمدا لإحداث تأثير ساخر يتحقق من خلال التشبيه والمغالاة([63])؛ فالبارودي يؤدي دور المجاز في الشعر مع تَضمّنه شحنة من السخرية التي قد تُضمر شعورًا ما بالأسى أو الدهشة. وهذه المحاكاة الساخرة تعكس إحساسًا عاجزًا يُداخل الذات إزاء الزمن في مكانها الآخر المتمادي في تطاوله. كذلك فإنّ الذات تجعل المعيار في تَمثُّل الزمن في مكانها الآخر هو الزمن في مكانها الأول، زمن امرئ القيس الذي هو زمن ثقافي نفساني.
ص346.
وقد تأتي استعادات الذات لأزمنتها في مكانها الأول في أحلك اللحظات وأقسى الأوقات، فيقول سعدي يوسف في قصيدة “غرفة المشنقة”:
آنَ أُغمِضُ عينيّ … تأتي إلى راحتَيَّ البلادُ
البلادُ التي عرّفَتْني بأني امرؤٌ ليس يُسْمى،
امرؤٌ قَدْرُهُ النعلُ
(كم مرةٍ كنتُ تحت حذاءِ المفوَّضِ … )
بل أنّ لي نُدْبةً ما بوجهيَ، من صفعةِ الشُّرَطِيّ…
البلادُ التي كنتُ أعرِفُ
ما عرفَتْ، مرّةً، أن تكونَ بلادًا؛
بلادي الرهيبةُ
قد أدخلَتْني إلى غرفةِ المشنقةْ
ذاتَ ليلٍ …
………………
………………
………………
كان ذلك في 1963
نقلونا من “النُّقْرةِ” الفجرَ
لا أتذكّرُ كيفَ:
القطار البطيء، أو الحافلات التي هي أبطأُ…
في الليلِ كنّا مساجينَ “بَعقوبةَ”.
ما كان في السجنِ متّسَعٌ للجميعِ.
تقدَّمَ لي حارسٌ:
“أنتَ تدخلُ في غرفةِ المشنقةْ”!([64]).
يصبح حضور البلاد، المكان الأول، الوطن آليًّا بالتآني مع إغماض الذات عينيها، تلك البلاد، المكان الأول، التي شعرت الذات فيها بفقدان الاسم وسلبها الكينونة والهوية، تلك البلاد المتمثلة في سلطتها السياسية والأمنية قد لاحقت الذات بالانتهاك والقمع حد خطر الإعدام. ورُبما يشير الشاعر لمكانه الأول، الوطن، بالبلاد لتعدد الأوجه التي عاينتها الذات لمكانها الأول بين الاحتضان ثقافيًّا من نخبتها الثقافية لا سيما مثقفيها الطليعيين، في مقابل التعرَّض للملاحقة القمعية والوقوع تحت مقصلة الاستبداد سياسيًّا.
وتعتمد بنية القصيدة- لدى سعدي يوسف- على لعبة التحولات والنقلات؛ فالأسطر الثلاثة المنقوطة- هنا- تُمثِّل فاصلًا وجسرًا في آنٍ؛ إنّها برهة زمنية في فعل القصّ الشعري بمثابة وقفة أو نقلة من جمل تقريرية إلى وصف مشهدي لتلك الليلة من العام 1963 حين كان الشاعر مُعرَّضًا للإعدام بعد اعتقاله في الحركة الدموية التي قام بها النظام العراقي ضد محاولات التمرد والثورة الشيوعية، ولكأنّ هذه الوقفة المتمثلة في الفراغ تمثل انتقالاً من السرد إلى “ما فوق السرد” كتكنيك سردي لـ”مما لا يُروى” باعتبار أنّ “«كل ما لا يقبل السرد» يتضمن الأحداث التي تستعصي على السرد، فهو يولي الصدارة لعجز اللغة، أو للصورة البصرية حتى يحقق التمثيل الكامل، حتى للأحداث الخيالية. وما فوق السرد يُمثِّل الفئة التي كثيرًا ما تُشكِّل المناسبة اللازمة لما أسميه [بحسب روبين ر. وورهول] «عدم السرد»”([65]) ثم تتبدى نقلة أخرى في المقاطع التالية من القصيدة:
ولكنّكَ المرهَقُ الأبديُّ
المُرَحَّلُ ما بين سجنٍ وسجنٍ…
أنت تُغمِضُ عينَيكَ في الغرفةِ المستحيلةِ
والحبْلُ منعقدٌ، مثلَ أنشوطةٍ.
أنتَ تُمْسِكُ بالحبلِ
حتى تنام …
………………
………………
………………
يا بلادي التي لستُ أعرفُ غيرَ زنازينِها:
لكِ مني السلامْ!([66]).
برغم قسوة ما تحمله الذات من ذكريات إليمة من مكانها الأول حتى صار الإحساس بسجنية الوجود منطبعًا على كل مكان ترحل الذات إليه مما يُشعِر الذات بأبدية الإرهاق ودوام الإحساس بالإنهاك- غير أنّ الذات لا تحمل لزمكان البلاد- المعاناة؛ فالذات تحن لزمانها الأول في المكان الأول- على ما فيه من إلم لإحساسها باغتراب زمني- مكاني في المكان الآخر ما يجعلها ترتد لزمنها بالمكان الأول، ذلك الزمان الذي لم تعرف فيه الذات من بلادها غير الزنازين، إلا أنّها تحمل في نفسها سلامًا لذلك الزمن الذي يربطها بمكانها الأول.
2- 3- استعادة شخوص المكان الأول
من آثار المكان الأول التي تستعيدها الذات في مكانها الآخر شخوصه الذين يمسون علامات دالة على المكان الأول ووجوهًا أيقونية له؛ فالذات المغتربة في مكانها الآخر تسترجع عددًا من مثقفي الوطن ومبدعيه لا سيما شعراءه في ارتباط حميم وتعلُّق أثير بمكانها الأول بغض النظر عن علاقة الذات الشخصية بهؤلاء الشخوص الذين يستحيلون كمرايا تسترئي الذات فيهم وجه الوطن، مكانها الأول، وكأنّ الذات تأتنس بهؤلاء الشخوص في وحدتها واغترابها بالمكان الآخر.
ويحفل شعر سعدي يوسف باستدعائه أعلامًا وشخوصًا من مواطني مكانه الأول، أبناء وطنه ومثقفيه ومبدعيه وشعرائه، وممن يستدعيهم سعدي يوسف من شعراء العراق معروف الرصافي في قصيدة يحمل عنوانها اسمه:
أتذكّــرُ تمثالَكَ في الساحةِ ضخمًا وثقيلًا
مثل تماثيل الكولومبيّ الواخِـزِ: بوتيــرو …
لكَ أن تتعالى في الساحةِ
أن تُعلِـنَ وقفتَكَ …(النحّـاتُ ذكيٌّ(([67]).
يستدعي شاعرُنا شاعرًا كمعروف الرصافي بتذكُّر تمثاله الضخم الذي يبدو كعلامة على الشموخ والتأبي الذي يُذكِّر الشاعر بتماثيل الفنان المثّال الكولومبيّ فرناندو بوتيرو التي يتلاعب فيها بميكانزم “الحجم” لا سيما بتضخيم أحجام كائناته وشخوصه مع تغيير النسب بين أبعادها وأجزائها؛ فيما “يؤكد بوتيرو أنه لا يرسم أشخاصا بدينين بل إنّه يسلم دور البطولة للحجم فقط كي يجعل من فنه عملًا كما الأكل قابلا للتذوق ويوضح: «الحجم هو العنصر الأهم في لوحاتي. في أعمال فان غوخ وماتيس كانا يمجدان اللون. كل فنان يمجد عنصرا معينا. أنا مهووس بالحجم. اهتمامي بديهي، والحاجة للتعبير عن قوة أو إحساس معيّن سمح لي بالذهاب للتفكير شيئا فشيئا بأهمية الحجم واللون كذلك. هذا غذّى أعمالي طوال الـ65 سنة. أشتغل على الخيال”«([68]) فيما يبدو أنّ وعي الذات الجمالي قد تأثّر بفعل التثاقف بفناني المكان الآخر، وإن كان استدعاء الشاعر لـ”بوتيرو” قد يكون بأثر تضامنه مع العراق بعد وقوعه بعد الاحتلال الأمريكي في 2003، حيث قَدّم بوتيرو “أكثر من سبعين عملًا يتحدث عن التعذيب الذي لاقاه الأسرى العراقيون في سجن أبو غريب؛ ما يمثل انتقادًا مباشرًا للإمبريالية الأميركية ولأساليبها الدموية”([69]).
ولكن هل يكون استدعاء الشاعر لمعروف الرصافي وبوتيرو لتشارك الأخير مع الرصافي في استعماله فنه للتنديد باستبداد الطغاة من الحكام والساسة؛ إذ “تتخذ أعمال فرناندو بعدًا ساخرًا لاذعًا في ما يتعلق بنقد السّاسة، فقد رسم الجنرالات والرؤساء والعسكر ورموز السلطة في أجواء مرفهة كالحانات وغيرها، وها هو يصوّر لنا الرئيس وزوجته في إحدى لوحاته وهما يقضيان وقتا في الغابة مرتدين لباسهما الرسمي، هي بفستانها الطويل وقفازيها البيضاويين وهو بقبعة وربطة عنق وحزام ملتف حول كرشه، غير عابئين بأجواء الغابة الحارّة الرطبة في سبيل الأناقة الزائفة للسلطة”([70])، فكأنّ الشاعر باستدعائه بوتيرو إنّما يجدد التأكيد على سمة الثورية التي يتشارك مع الرصافي فيها لكونهما مثقفين عضويين.
وممن يستدعيهم سعدي يوسف من الشعراء مظفر النواب، الشاعر الذي عُرِف كصوت شعري قومي عروبي، فضلًا عن ثوريته، فيقول سعدي:
أمظَفّرُ النوّاب
ماذا سوف نفعلُ، يا رفيقَ العُمْرِ؟
عرسُ بناتِ آوى… أنتَ تعرفُهُ قديمًا:
نحن نجلسُ في المساءِ الرّطبِ تحتَ سقيفة القصبِ؛
الوسائدُ والحشايا من نَديفِ الصوفِ
والشايُ الذي ما ذقتُ طعمًا، مثله، من بعدُ،
والناسُ...
الظلامُ يجيءُ، مثل كلامنا، متمهِّلًا
والنخلُ أزرقُ
والدخانُ من المواقدِ كالشميمِ،
كأنّ هذا الكونَ يبدأُ…([71]).
يستعيد سعدي يوسف باستحضاره مظفر النواب رمزًا من رموز المبدعين العراقيين المنضالين كعلامة تشير إلى الوطن ووجهٍ من وجوه المكان الأول. وربُما ترتبط هذه الاستعادة لزمكان المكان الأول/ الماضي بإحساس الذات بالعجز إزاء المستقبل وفقدان القدرة على الفعل المتبدي في ذلك التساؤل المنهزم: (ماذا سوف نفعلُ، يا رفيقَ العُمْرِ؟) الذي عكس شعورًا بالحيرة والاستسلام المنكسر لتصاريف القدر.
ويعكس تكرار نفس السؤال، سؤال الذات عن مدى قدرتها على الفعل في غير موضع شعورًا ما باليأس في استعادات الذات لمكانها الأول كأنّ إحباطًا أوديسوسيًّا [نسبة إلى أوديسيوس الذي اغترب عن وطنه إيتاكيا وتطاول ابتعاده عن مكانه الأول، فبات رمزًا للشتات وفقدان الأمل في العودة للوطن]- يخامر الذات في مكانها الآخر حينما تستعيد مكانها الأول.
وكأنّ الشاعرُ باستدعائه رفيق عمره مُظفر النواب إنّما يستدعي شريكًا وشاهدًا على زمن ولى ومكان أول غابت الذات عنه وحُرِمت من ناسه الذي كان بمثابة بدءًا للكون. وفيما يتبدى من شعور الذوات بالطمأنينة والأمان أنّ تَمثُّلها مجيء الظلام متمهلًا في حركته كما يتبدى أيضًا في الإحساس برطوبة المساء ولطف وقعه على الذوات.
وكما هو ماثل من استدعاءات سعدي لمن يستحضرهم من شخوص المكان الأول استعماله “الالتفات” بمحادثته لهم بضمير المخاطب بدلًا من الغائب؛ إمعانًا في تأكيد حضورهم. هذا وقد “كان البلاغيون قد أدركوا من قديم، الدورَ الذي يمكن أن يلعبه ضمير المخاطب، وأدركوا أنّ استحضار شخص (أو شيء) ما، عبر مناجاته وتوجيه الخطاب إليه، أقوى بكثير من مجرد الحديث عنه؛ لأنّ ذلك يبث الحياة فيه، وكانّما يضعه على خشبة المسرح، ولأنّك في هذه الحالة لا تسمع أخبارًا عن هذا الشخص (أو الشيء)، وإنّما تستحضره وتعاينه”([72])؛ فكأنّ الذات تبثُّ الحياة بمكانها الأول بإحياء شخوصه واستحضارهم من خلال استعمالها “الالتفات” بضمير المخاطب حال استدعائها لهم.
ومن شخوص المكان الأول ورموز العراق الذين يستدعيهم سعدي في مكانه الآخر، سركون بولص الشاعر العراقي المجدد والطليعي في قصيدة بعنوان “إلى سركون بولص”:
المدينةُ التي لم تتشكّلْ بَعدُ
المدينةُ التي ليس فيها شارعٌ واحدٌ
المدينةُ التي لا تصنعُ إلاّ السجائرَ
المدينةُ التي أضاعت مفتاحَ بوّابتِها
المدينةُ التي تنتظرُ البرابرةَ
هذه المدينةُ سوف نشقُّ فيها نهرًا للهتاف.
*
ولْـيَـكُنْ !
قـد تكونُ أثِـينـا وأبوابُها المائةُ، الآنَ، في مَدخَلِ السـجنِ !
نضحكُ في وجهِ سَـجّـانِنا. الليلُ في القلعةِ اكتظَّ بالنجمِ أحمرَ.
والليلُ يلعبُ في النهرِ. كانت أثِـينـا تَـلُوحُ. وكانت تُـلَوِّحُ
والسجنُ يطفو خفيفًا على الماءِ. كنّا على الماءِ نمشي([73]).
يبدو استدعاء سعدي يوسف لرفيقه سركون بولص تعبيرًا عن شعور ما بفقد أحد رموز المكان الأول الثقافية، سركون بولص الشاعر الطليعي الذي وصفه سعدي بأنّه”الشاعر العراقي الوحيد” في مقال له يرثيه فيه:
وأقول إنّه الشاعرُ الوحيدُ…
هو لم يكن سياسيًا بأيّ حالٍ.
لكنه أشجعُ كثيرًا من الشعراء الكثارِ الذين استعانوا برافعة السياسة حين تَرْفعُ…
لكنهم هجروها حين اقتضت الخطر!
وقف ضدّ الاحتلال، ليس باعتباره سياسيًا، إذ لم يكن سركون بولص، البتةَ، سياسيًا.
وقفَ ضد الاحتلال، لأن الشاعر، بالضرورة، يقف ضد الاحتلال.
سُمُوُّ موقفِه
هو من سُمُوّ قصيدته([74]).
فيما يتبدى أنّ استعادات سعدي يوسف لسركون بولص لأنّه لم يتاجر سياسيًّا بموقفه من الاحتلال، غير أنّه لسمو وتجاوز فنيين صار راية شعرية للمكان الأول، تُعبِّر عن هموم الوطن دونما تورط في خطابية التعابير عن السياسة بما يُضعِف من القيمة الفنية لشعره، وكأنّ الفنان بإخلاصه لفنه هو أكثر تسيسًا من السياسي نفسه أو الفنان الرافع رايات السياسي حتى ينكشف زيفه حال الخطر.
ويستعمل الشاعر “أثينا” المدينة العظيمة التي سقطت تاريخيًّا رمزًا وقناعًا للمكان الأول، الوطن في سقوطه ووقوعه تحت براثن الاحتلال. وكأنّ بغداد التي سقطت أو العراق الذي سقط تحت الاحتلال هو “أثينا” أخرى، أي يوتوبيا مركزية وبؤرة إشعاع حضاري. وإذا كان سركون بولص هو الشاعر الذي ترك وطنه وغادر مكانه الأول بحثًا عن مدينته الحلم التي لم يجدها فيما تبدى منذ ديوانه الأول الوصول إلى مدينة أين إذا كان سركون شاعر اللامكان واللاوصول، فهل يشاطر شاعرُنا سركون بولص في إحساسه بالمتاهة والضياع بعد الرحيل عن مكانه الأول؟
4- رثاء المكان الأول تحت الاحتلال
تتبدى ذروة استعادات الذات لمكانها الأول، الوطن، فيما تذهب إليه الذات من رثاء وطنها وبكاء مكانها الأول تفجعًا لاحتلاله، فيبرز بشكل لافت، في المرحلة الأخيرة من شعر سعدي يوسف، لا سيما فيما بعد العام 2003، مرثيات الشاعر لمكانه الأول، العراق، بعد وقوعه تحت الاحتلال الأمريكي، واستباحة حرمات الوطن ونهب ثرواته والسعي لنسخ هويته ومحو الشخصية الجمعية العراقية، فيما يظهر من تَفاقُم أزمة الذات الوجودية وتَضاعُف شعورها الاغترابي بفقدها الوطن نفيًّا عنه، وضياع الوطن نفسه بوقوعه تحت الاحتلال.
وبعد أن صار القتل حدثًا يوميًّا وفعلًا مستدامًا يمارسه الاحتلال إزاء الوطن يمسي الوطن المهدرة دماء أبنائه جرحًا لا يندمل ووجعًا يؤرق وعي الشاعر الذي يقول في قصيدته “الشيوعي الأخير يدخلُ في النفق”:
كان صباحًا صيفيًّا حقًا…
لم يتحرّكْ “س”
ظلَّ على جلستِهِ بالشُّرْفةِ
لم يُتْمِمْ قهوتَهُ
لم يُنصتْ للموسيقى.
أمسِ، تلَقّى، عبرَ الإنترنتْ، الخبرَ:
الأمريكيّونَ أقاموا حفلةَ قتلٍ لعراقيّينَ شبابٍ.
-أينَ؟
-متى؟
*
كارل ماركس تنبّأَ:
إنّ الخُلْدَ الأحمرَ يحفرُ في النفقِ([75]).
يشير الصوت الشعري إلى الشاعر سعدي بالرمز الحرفي المجرد “س” رُبما في شعور ما بالتضاؤل أو اتساقًا مع ثقافة عصر معلوماتي تستعمل تقنيات حديثة وقتها كـ”الإنترنت” حيث يوقع الشاعر قصيدته بـ(لندن، 9/ 6/ 2006) لتختزل الذوات في إشارات مجردة وعلامة مكثفة بعد أمسى العالم في عصر التقدّم التقني المعلوماتي قرية صغيرة من حيث التبادل المعلوماتي.
وفيما يتبدى من حركة الذات في المكان الآخر أنّ ما يدور بمكانها الأوَّل من حرب واستلاب لوطنها يُخيّم بظلاله على فعل الذات وحركتها بالمكان الآخر التي أصابها الجمود والسكون بالمكان وعدم اكتمال الأفعال المعتادة التي كانت تمارسها الذات كشرب القهوة أو عدم القيام ببعضها كسماع الموسيقى نظرًا لتدفق أنباء الحرب والقتل التي تستعمل الذات أسلوب تهكميًّا ونبرات ساخرة في التعبير عنها “حفلة قتل” تجسيدًا لإحساس الذات بالعجز والذهول.
ومع تفشي القتل الذي يمارسه المحتلُّ الأمريكي بالمكان الأول، الوطن، العراق، يصبح هذا المكان كمسرح لأحداث الإبادة الدموية فاقدًا للتحديد المكاني والتعيين الزمني عبر سؤالين عن الـ”أين” و”الـ”متى”؛ إذ “تظل هذه الـ«أين» والـ«متى» بلا جواب، لكنهما في العمق تحملان في ذاتهما الجواب: شهوة القتل الأرعن التي يؤججها الأمريكيون، والظمأ الشرس لدماء الأبرياء، وتعميم شعائر القربان العمياء في كل العراق”([76])، بعد أن صار المكان، الأين، مكانًا للقتل، والزمان، المتى، زمنًا للقتل أيضًا.
ولا يفوت الشاعر أن يستلهم كارل ماركس بوصفه نبيًّا مُبشرًا بالخلود والفوز بالخلد المتلّون باللون الأحمر، لون الدم، من خلال فعل الحفر في النفق، في إشارة إلى التضحية. ولكن، لِمَ يربط الشاعر التضحيات الوطنية في مواجهة الاحتلال بتأسيس ماركسي؟ أيمنح الشاعر فعل التضحية الوطنية صكًا ماركسيًّا ويؤدلجه وفق منظور شيوعي؟
ولا تتوقف الذات عن هجاء الاحتلال ووحشيته الدموية بل تهجو أيضًا عملاءه الذين باعوا الوطن للمحتل الأجنبي كما في قصيدة بعنوان “الإستباحة”:
السمتيّات الأميريكيّة تقصفُ أحياءَ الفقراءْ
والصحف المأجورة
في بغدادَ
تُحَدِّثُ قُرّاءً أشباحًا عن أرضٍ سوف تكون سماءْ…([77]).
يبرز الخطاب فداحة الانفصام بين ما يجري على أرض الواقع من ممارسات استعمارية وانتهاكات الاحتلال واستباحته دماء العراقيين لا سيما الفقراء منهم، وعمل الصحف بوصفها، بالتعبير الألتوسيري، إحدى أجهزة الدولة الإيديولوجية على تزييف الوعي الجمعي وتصدير الوهم للشعب المُستباح والواقع تحت مقصلة الاحتلال.
يعمل الشعر، هنا، على أن يفضح تآمر أجهزة الدولة الإيديولوجية على الوطن ومحاولتها خداع مواطنيها لتمرير الاحتلال وشرعنته ليكشف فساد “مؤسسات المجتمع المدني، التي احتلت المركز الأول في مجال الدعاية الكاذبة والتزوير والفساد”([78]) حيث قام الإعلام ومنه بعض المنابر الشيوعية بمحاولة تعبيد الأرض العراقية سعيًّا لتمرير الاحتلال.
فنجد أنّه “إذا كان الإعلام اليومي، المحترف والهاوي، قد حاول بكل طاقته مسايرة الجهد العسكري لقوات الاحتلال وسياستها الإجرائية ساعة ساعة، من طريق ضخ التعليقات والأخبار ومقالات الدفاع والهجوم، فإنّ الجهاز القديم، الذي تولى مهام التخطيط الأيديولوجي في حقبة وجود المنظومة الاشتراكية، وجد مساحة جديدة للحركة، على هامش الثقافة الدعائية، من طريق التحول إلى مراكز بحثية خاصة، على أنقاض ما عُرف سابقًا بالمكاتب الحزبية «المختصة». أي تحويل «المختصة» حزبيًّا إلى مختصة سياسية تجارية، لا ترتبط بقيادة الحزب كالسابق، ولكن ترتبط بأفراد وجماعات أجنبية ومحلية ممولة ومسوقة، تتحكم بمادة التسويق الثقافي، التي أطبق عليها اسمًا مُفرغًا من الدلالة الحزبية «البحوث والدراسات»، التي تخصصت في معالجة الجانب الآخر من الإعلام التعبوي: التعبئة النظرية”([79])، فيما يتبدى من تحول تكتيكي وتغيّر في استراتيجيات المؤسسات الثقافية والأجهزة الإيديولوجية تكيفًا مع أغراض الاحتلال.
ويستعمل الشاعر أدوات الموسيقى الصوتية فيما يستخدمه من روي بحرف الهمزة مسبوق بحرف (الألف) كإسناد بين كلمتي (الفقراءْ/ سماءْ) وكذلك الموسيقى المعتملة في المعنى بالتضاد بين كلمتي (أرض/ سماءْ) لتأكيد البون الشاسع بين الوهم الذي تصدره أجهزة الدولة الأيديولوجية والكذب الذي تمارسه، والواقع المؤلم والبائس.
يعمل شعر سعدي يوسف ليس على تجسيد فعل القتل اليومي الذي يمارسه الاحتلال الأمريكي بالعراق ولكن القتل المعنوي أيضًا كما في قصيدة بعنوان “إلى شيخ عشائر الـ…”:
(حتى وأنا في الريفِ بأقصى لندن)
أعرفُ أنكَ ملقىً:
وجهُكَ للأرضِ
وجزمةُ جنديٍّ أمريكيٍّ تسحقُ فِـقْـراتِكَ حتى الأرضِ؛
زمانٌ مختلفٌ؟
لا بأسَ …
إذًا، ألصِـقْ إحدى أذنيكَ بأرضكَ !
ألصِـقْـها كي تسمعَ
ألصِـقْـها كي تسمعَ، مثلَ الخيلِ، مُـغارَ الخيلِ
وألصِـقْـها كي تسمعَـني
) أرجوك)
أتسمعُـني؟([80]).
يأتي اعتماد الصوت الشعري على ضمير المخاطب في في حركة التفاتية جديدة لمحو المسافة بين المكان الآخر حيث تتموضع الذات “في الريفِ بأقصى لندن“، والمكان الأول حيث العراق، الوطن، حيث يكون انهمام الذات بوطنها وانشغالها وتعلُّقها به، حيث يمتهن المحتل أهل الوطن ويعمل على سحق رموز عشائره.
وتعمل بلاغة القطع في عنوان القصيدة “إلى شيخ عشائر الـ…” بعد “الـ” التعريف رُبما إلى التعميم والتكرار أو إشارة لمحو المحتل بانتهاكاته المهينة اسم العشيرة وهويتها بإذلاله شيخها. ورغم الإهانة والانتهاك الحالين بشيخ العشائر رمز القبلية العراقية فإنّ الذات الشاعرة تحاول أن تبثّ روح المقاومة والتمسك بالوطن فيما يتبدى من إضافة (أرض) لضمير المخاطب (ك) استمساكًا بالأرض ودفاعًا عن تراب الوطن.
ورغم ما يتبدى من ألم يعتصر الذات لوقوع وطنها فريسة للاحتلال الأجنبي فإنّ سعدي يوسف نفسه سبق وأن وقع في خطأ التعويل على الأجنبي في تخليص بلاده من حكم الطاغية، كما في قصيدة “الشاحنة الهولندية: الخزّان” التي كتبها سعدي يوسف في (لندن، 19/5/ 2000):
هل لي أن أسأل توني بْلير:
إن كنتَ تُريد لـ”لندنَ”
ألاّ تُمسي “مستعمرةً” لعراقيين
فلماذا لا تطردُ صدّام الواحدَ
كي نرجعَ نحنُ،
ونحن ملايين أربعةٌ
نحن ملايين أربعةٌ من عشرين…
1/5 الأرض
و1/5 خطوط العرضِ
و1/5 القرن الواحدِ والعشرين… ([81]).
يرجع تاريخ هذه القصيدة لما قبل وقوع العراق تحت الاحتلال بأقل من ثلاث سنوات فيما يتبدى من وقوع الذات تحت سذاجة التصور بإمكانية أن تعوّل على الأجنبي كمُخَلِّص للوطن من قبضة الديكتاتور ومحرر لبلاده من الاستبداد وحكم الطغيان.
لقد وقع بعض مثقفي العراق والمعارضين السياسيين في خطأ أو ربُما خطيئة اللواذ بالأجنبي والاستعانة بالاحتلال تخلصًا من حاكم مستبد، حيث “كان جميع أطراف المعارضة يقرّون سرًا بنظرية «خيار الضرورة»، لكنهم كانوا جميعًا يمارسون إعلاميًّا سياسة تضليلية قائمة على إنكار القبول بخياري الحرب والاحتلال. وحتى أكثر القوى سفورًا في موضوع القبول بالحرب والاحتلال لم تكن تجاهر بموقفها علنًا”([82]). فيما يُمثِّل ازدواجًا في الشخصية وخداعًا للشعب؟
ولقد كانت لندن مسرحًا لتدبير مؤامرة العدوان على العراق واحتلاله وهو تفطن إليه بعض مثقفي العراق وعقولها الحرة فيكتب القيادي الشيوعي عبد الرازق الصافي يفضح تآمر المعارضة وانتهازيتها على حساب الوطن قائلًا: “إننا نعتقد أن فرقًا كبيرًا بين أن تتفق أطراف المعارضة العراقية، على مشروع وطني ديمقراطي للتغيير، وتطلب دعمًا خارجيًّا لتحقيقه من المجتمع الدولي ممثلًا بالأمم المتحدة بما فيها أميركا، وبين أن تتولى الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تحقيق التغيير عن طريق الحرب، وتُعطي لأطراف المعارضة دور تهيئة الغطاء لهذه الحرب وتبريرها، رغم ما يمكن أن تحمله من أخطار وما تجلبه من دمار لا يعرف أحد مداه وتسمية الثمن الباهظ الذي يُمكن أن يدفعه شعبنا «ببعض الآلام»”([83]). ولقد انجرف شاعرُنا، فيما يبدو، وراء الاعتقاد الساذج بإمكانية أن يكون المحتل الأجنبي مُخلِّصًا للعراق من حكم استبدادي.
ولكن ما تبديه الذات من ألم لاحتلال الوطن وما يخالجها من إحساس بالفجيعة إزاء مكانها الأول المُستلب يكشف ضمنيًّا عن ندمها إزاء تحبيزها السابق لخيار الاحتلال تخليصًا للوطن من حاكمه الطاغية، وهو ما يتبدى في مرثيات الذات المتفجعة للوطن الذي تتبدد هويته، إذ يقول سعدي:
لم يَعُدْ في العراقِ امرؤُ عربيٌّ؛
ولا فيه من ينطقُ الضادَ([84]).
ينعي الشاعر على العراق فقده هويته العربية وتراجع اللغة العربية التي كانت بمثابة حبل المشيمة للذات العراقية والرابط الهوياتي والقاسم الثقافي المشترك العابر للاختلافات العرقية والجامع للتنوّعات الثقافية وهو ما يبرز فعل الاحتلال المدمِّر لوحدة العراق بتأجيجه نيران الطائفية؛ إذ “إنَّ تغليب مفهوم الشراكة السياسية على أسس طائفية وعرقية- رغم حشر كلمة العبور على الطائفة في كل جملة ترد فيها هذه العبارة- هو سوء فهم جدي للواقع العراقي. لأنّ التجمع السياسي التحاصصي… لا يقود إلا لتأسيس شراكة طائفية وعرقية، على حساب مبدأ المواطنة”([85]) وهو ما أفضى إلى شرذمة العراق هوياتيّا وتبدد وحدته.
ومع قتامة الحال وجهامة الأفق لا يفارق الذات الأمل بعودة الوطن واستعادته الذي تحلم الذات بتحريره:
سوف يأتي العراق الجميل
سوف يأتي العراق
بعد أن يرحل الأمريكيُّ
والخادمُ الفارسيُّ المعممُ…
هذا العراق الجميل
قادم في الهواء الذي نتنفسُ
في الشاي عند أعالي الفرات
وفي العرق المرِّ في جبهة النهر… ([86]).
لقد استحال الوطن “العراق” والشاعر، كلاهما مرآة للآخر، فبعدما يصرِّح الشاعر برغبته في مغادرة المنفى، المكان الآخر، رغم ما يوفِّره له من مأوى، أي حلم العودة إلى مكانه الأول، بلاده، “العراق”، يعود ليعلن عن رغبته وحلمه بأن يعود العراق، فكما أن الشاعر مستلب ويشعر بالفقد في غربته، بالمثل يشعر بأنّ الوطن ضائع، وأنّ عودته مرهونة برحيل المحتل الأمريكي وحكام البلاد من الموالين للغزاة والفرس، ثم يعود ليؤكد على حضور الوطن الرمزي والوجداني في مظاهر الحياة، فبعد أن ضاع الوطن كحقيقة في الواقع، ظل حاضرًا كفكرة على مستوى الرمز والخيال.
ومع الحلم والأمل الذي راود الشاعر بعودته إلى وطنه وعودة الوطن إلى أبنائه، أخيرًا يستبد اليأس به ويفقد أمل العودة كما في قصيدة “اعتذار”:
مضى صيف القرنفل…
لا تقل لي: أجيء غدًا إليكَ
وثمَّ كأس ستجمعنا
وأسماك
ونخل
ولا تلجأ لسومر والمراثي ببابل والسوادِ…
إلخ
إلخ
لا!([87]).
لقد مضى الصيف وحان الخريف، فصل الذبول، الذي يمثِّل لذبول الأمل، لذا فقد فَقَدَ الشاعر الأمل في غده، فقد الأمل في اللقاء بندمائه أو بمن يحب، ويعتمد الشاعر- هنا- طقسًا كلاسيكيًا من الشعر العربي القديم متمثلًا في مخاطبة النديم رفيق الكأس والمجلس، الذي غالبًا ما يكون استدعاء الشاعر العربي له قرينًا باستعادة عهود الأنس وذكريات الألفة والبهجة، غير أنّ شاعرنا قد ملكه اليأس من الالتقاء بنديمه أو الوقوف والمرور بمعالم العراق كسومر وبابل والسواد، ثم يدل تكراهر لـ(إلخ) مرتين على فقدانه الأمل في استعادة أي شيء وكل شيء، فقد ضاع العراق بكل ما فيه:
مضى صيف القرنفل
واستقرت عميقًا وردة الزرنيخ.
أبعدْ
ولا تأتِ.
العراق الذي أحببتَ لم يعدِ.
العراق الذي أحببتَ لم يعدِ…
انتظرنا
وانتظرنا.
قد مضى صيف القرنفل
وانتهينا…([88]).
يبدو الشاعر- هنا- في هذه القصيدة متماهيًا مع عراقه ومتوحدًا به، فالصوت في القصيدة هو صوت العراق يحدِّث شاعره، قد امتزج الصوتان: صوت الشاعر بصوت الوطن، فما صوت الوطن إلا صوت الشاعر يائسًا من استعادة الوطن بعد طول انتظار، فبعد أن كان العراق أو صوت الأمل في داخل الشاعر يدعوه لمغادرة مكانه الآخر، منفاه بلندن؛ لأنها ليست بلاده، ها هو يصرفه عن فكرة العودة، ويدعوه للبعد عن الوطن، الذي استقرت فيه ورود الزرنيخ تنفث سمومها القاتلة، فأي تناقض واضطراب يعيشه الشاعر؟ وأي تردد وقلق يعصف به؟ فبعدما كان الشاعر والوطن يتقاسمان الأمل في عودة هذا الوطن لأبنائه وعودة أبنائه إليه، تُحسم المسألة بعدم استعادة الوطن مؤكدة بالمضارع المنفي بلم الذي يحمل معنى الماضي وحسم القضية، التي انتهت وانتهى معها الوطن وأهله. هذا ويدل التكرار الثلاثي لجملة (قد مضى صيف القرنفل) على دائرية الأقدار التي تلف مصائر الوطن وأبنائه، كما يدل تكرار جملة (العراق الذي أحببتَ لم يعدِ) على التأكيد على ضياع العراق وترديد هذا المصير القاسي الوقع على وعي الشاعر ووجدانه بما يُبرز مكابداته ومواجعه لفقده الأليم لوطنه الحبيب.
فالذات مع استمرار الحلم باستعادة وطنها دونما تحقيقه تشعر بالتعب فيقول سعدي يوسف في قصيدة كتبها في 12/ 11/ 2014 بعنوان “تعبت يا عم”:
لم يَعُدْ جسرٌ ليوصِلَني إلى “حمدانَ” حيثُ ترابُ أُمي …
لم يَعُدْ لي من ترابٍ:
لا ولاءَ
ولا صليبةَ …
أيُّ معنىً للبلادِ؟
وأيُّ معنىً للعنادِ …
تعِبْتُ يا عَمُّ!([89]).
لقد فقدت الذات الجسر الذي يربطها بوطنها ومكانها الأول وانقطعت صلتها بمنشأها ومسقط رأسها “حمدان”، ففقدت بالتالي معنى البلاد ثم فقدت المبرر للعناد أي فقدت الدافع للمقاومة والتمسّك بحلم استعادة الوطن، فيما يتمظهر من حوار الأنا مع أناها الأخرى مُسفرة عن إحساسها بالتعب وفقدانها الدافع والطاقة للحلم باستعادة الوطن.
غير أنّ الذات التي يبلغ بها اليأس المدى من استعادة مكانها الأول، الوطن، العراق بشكل واضح في النصوص الأخيرة لسعدي يوسف تفضل الخلود إلى الراحة وتناسي الهم الوطني لفقدانها الأمل؛ فيقول سعدي في قصيدة كتبها في 14/ 11/ 2014 بعنوان “دعوة إلى السبات”:
دومًا تنام بإحدى مُقلتَيكَ …
ألم تتعبْ؟
وتعرِفُ … لستَ أنتَ الذئبَ
تعرفُ أنّ حقّكَ، وهو أوّلُ، أن تنامَ،
تنامَ ملءَ جفونِكَ؛
الأيّامُ …
إنكَ في الثمانين !
الوسادةُ، لم تَعُدْ صوفًا …
ولِصْقَكَ، دائمًا، تتمدّدُ امرأةٌ
إذًا: نَمْ !
لا تَقُلْ إن العراقَ يُجَرِّحُ الجفنَينِ .
………………
………………
………………
إن عراقكَ الأبديَّ غابَ
وصارت الورْكاءُ قاعدةً لطيّارينَ جاؤوا من أريزونا …
لقد شُـفِيَ الصبيُّ من الخرافةِ؛
لا تَقُلْ إني من الوركاءِ …
إنكَ في الثمانين!([90]).
تبدو هذه القصيدة “دعوة إلى السبات” التي كُتِبت بعد يومين من القصيدة السابقة “تعبت يا عم” كاستئناف ونتيجة لها، وكأنّ الإحساس بالتعب يدعو إلى السبات. كما تبدو الذات في انشطارها، هنا، في حوارية بين شطريها؛ وكأنّ الأنا الموضوعي وقد استبدّ اليأس بها تدخل في محاججة مع الأنا الأخرى المتشبثة بالأمل، الأنا الحالمة، باستعادة مكانها الأول، واسترجاع وطنها المحتلّ، فيعمل ضمير المخاطب، الأنت، هنا، على تأجيج خطاب المواجهة بين شطري الذات التي يغالبها اليأس في عودة وطنها.
والذات التي بدأت تشعر بالشيخوخة ربُما من إحساسها بالإنهاك جراء الحلم المجهض باستعادة وطنها تدعو نفسها إلى النوم، السبات، الراحة، التي قد تُضمِر رغبة نفسية دفينة بالانسحاب من الواقع المؤلِم في مسلك هروبي من الحقيقة القاسية التي بدأت تتملك الذات بأفول الوطن وذبول الحلم باستعادته.
ومجددًا، يستثمر الشاعر الفراغ النصي، قاطعًا خطابه بالصمت، الصمت الناطق بمعانٍ كثيرة والحامل فيوضات مشاعر متمددة، ولئن كان “«الأدب بما هو لغة هو نظام من الرموز وكيانه يكمن في النظام لا في الرسالة وهو يتكوَّن من تقديم مستمر للمعنى، ومن إخفاء مستمر لذلك المعنى في الوقت نفسه» لأنّ وظيفة إخفاء المعنى هي واحدة من أهم بؤر النص المحدِث، التي نراها ماثلة في (الصمت) الذي يُمثِّل الإخفاء المستمر للمعنى لا سيما في نصوص اللامعقول التي تؤسس عملية اتصالها واستفزازها للمتلقي ببؤر الصمت الكامنة في الإخفاء المستمر للمعنى، وهو بهذا يحقق أحد شروط عملية التلقي المحدثة بوصفه حاملًا رسالة مخفية ذات شفرات قابلة للتفكك”([91])– فإنّ هذا الصمت يدفع المتلقي لاستنطاقه تفتيشًا عن الدلالات الخلفية وبحثًا عن المعاني الغائبة.
إنّ تلك المساحات الصامتة، التي تُمثِّل الغيابات النصية هي تبديات لـ”لا شعور النص” وترتبط- على نحو أو آخر- بالأيديولوجيا القابعة خلف النص؛ حيث “ينطوي النص الأدبي، بعيدًا عن تشكيل وفرةٍ موحدة من المعاني، على علامات محفورة داخله، على بعض الغيابات الحاسمة الفاعلة التي تحرِّف دلالاته المتعددة وتحولها إلى صراع وتناقض. هذه الغيابات- أي «ما لا يقوله» العمل- هي ما يربطه ويقيده إلى إشكاليته الأيديولوجية. إنّ الأيديولوجية حاضرة في النص في صورة غياباتها البليغة”([92])، فمساحات الصمت في النص الجمالي هي مناطق غيابات عالقة بالأيديولوجيا.
إنّ المساحات الصامتة التي تتخلل النص تجعل مهمة الناقد أن يسعى لاستنطاقها ومحاولة الربط بينها كلامقول نصي والمقول النصي بشكل يسمح بانفتاح وتعدد الدلالات التي يُمكن أن تنبثق عن هذا الغياب النصي، فـ”ليست مهمة النقد، إذن، أن يُموضِع نفسه في الفضاء ذاته الذي يُموضِع النص نفسه فيه جاعلاً النص يقول، أو يكمل ما تركه، بالضرورة، وأغفل قوله. في المقابل، فإنّ وظيفته هي أن يضع نَفَسه في الموضع غير المكتمل، إطلاقًا، للعمل لكي يُنَظِّره- ليشرح الضرورة الأيديولوجية لـ«اللا- مقول» الذي يُشكِّل المبدأ الأساسي لهويته. إنّ غايته هي لا شعور العمل، تلك المنطقة التي ليس العمل واعيًّا بها، ولن يكون، وبدقة، اختلاف المعاني، وانفصالها. إنّه يتمفصل مع الفضاء الذي يقسم معاني النص المتعددة ويُوثقها معًا. إنّ مهمة النقد هي أن يُظهِر ويشرح كيف «يتجوّفَ» النص بوساطة علاقته بالأيديولوجية”([93])، فمهمة الناقد، إذن، أن يبرز تعدد المعاني الممكنة التي تعد به الغيابات النصية ومساحات الصمت.
هذا وقد يُعبِّر الصمت عن عجز الذات عن التعبير بالكلام الملفوظ عما يجيش بداخلها من معانٍ أو فقدانها القدرة على استيعاب ما يدور في العالم، أي عجز الداخل عن التعبير عما تعاينه الذات في الخارج، العالم الذي تجاوز حد المعقول فأصاب الذات بالذهول؛ لذا “يرى (مارتن إسلن Martine Esslin) أنَّ الصمت يحمل علامة درامية لها القدرة على التعبير التي استثمرها الكُتّاب المحدثون في نصوص اللامعقول، فتمظهر الصمت وهو يُمثِّل «التناقض الحاد بين عقلانية الواقع وجوهره العبثي». ولما كانت فلسفة العبث تعمل في البحث عن الوعي في منطقة اللاوعي فقد وجدوا في الصمت «الوعي الداخلي لما وراء الكلام» فهو يؤكِّد فشل لغة التواصل لأنّه يُمثِّل منطقة القلق الوجودي لإنسان هذا العصر الذي سحقته الحرب والتكنولوجيا”([94])، فقَد يكون الصمت تعبيرًا عن فقْدِ الذات المنطق الذي يُفسِّر العالم.
ولما كان الصمت انقطاعًا، ولو على مستوى ظاهر، فقد “يُرى الصمت تعبيرًا عن المكان المنعزل… لذلك يتمظهر الصمت في هذه الحالة من أنّ «طبيعة اللغة الرمزية التي يُعبّر بها عن الخبرات والمشاعر والأفكار الداخلية وكأنّها تجارب حسية أو حوادث في العالم الخارجي. إنّها اللعبة التي لها منطق مختلف عن منطق اللغة الاصطلاحية»”([95])، فالصمت هو تمظهر ميتالغوي له شفراته التي تنفك بالتفاعل الجدلي بين الصوت والسكوت، والكتابة الخطية والفراغ، والتدفق والانقطاع الذي قد يُبدي انقطاعًا شكليًّا في البثّ الصوتي للحديث، في حين يضمر حديثًا منطويًّا للذات.
وتُمثِّل مساحة الصمت، المتبدية هنا، في الأسطر الثلاثة المنقوطة، حالة الإيغال في الاستسلام المتشائم المستشعر ضياع الوطن، كما يكون الصمت، هنا، بمثابة معبر نفسي لانتقال الذات من حالة التمسك بأهداب الأمل بعودة العراق إلى التخلي اليائس عن ذلك الحلم، بل تناسي الانتماء إلى المكان الأول، “الوركاء”، الذي صار قاعدة للمحتل، في الآن الذي تحسّ الذات فيه بالشيخوخة لبلوغها الثمانين مما يكرس إحساسًا عاجزًا بالانسحاق الوجودي أمام الزمن بالتزامن مع إحساس الفجيعة لفقد المكان الأول وضياع الوطن.
…………………………………..
الهوامش
*(نقلاً عن “أخبار الأدب، العدد 1260، الأحد 17 من سبتمبر 2017)
[1]– إدوارد سعيد، صورة المثقف، ترجمة: غسان غصن، مراجعة: منى أنيس، (بيروت، دار النهار، الطبعة الأولى، 1994)، ص ص58- 59.
[2]– اعتدال عثمان، إضاءة النص: قراءة في الشعر العربي الحديث، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، 1998)، ص8.
[3]– اعتدال عثمان، إضاءة النص: قراءة في الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص8.
[4]– سعدي يوسف، صفحة سعدي يوسف على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك Face Book)، بتاريخ 8/ 8/ 2016.
[5]– محمد بدوي، “واحد وعشرون بحرًا” (قراءة في ديوان للشاعر أحمد دحبور)، مجلة فصول، المجلد الأول، العدد الرابع، 1981، ص253.
[6]– إيفون دوبليسيس، السِّوريالية، ترجمة: هنري زغيب، (منشورات عويدات، بيروت- باريس، الطبعة الأولى، 1983)، ص58.
[7]– إيفون دوبليسيس، السِّوريالية، مرجع سابق، ص35.
[8]– إيفون دوبليسيس، السِّوريالية، مرجع سابق، ص59.
[9]– ديفيد هوبكز، الدَّادئية والسِّريالية، ترجمة: أحمد محمد الروبي، مراجعة: محمد فتحي خضر، (القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، سلسلة مقدمة قصيرة جدًا، الطبعة الأولى 2016)، ص32. وما بين التنصيص نقلاً عن” البيان السوريالي الأول لبريتون 1924.
[10]– ديفيد هوبكز، الدَّادئية والسِّريالية، مرجع سابق، ص80.
[11]– إيفون دوبليسيس، السِّوريالية، مرجع سابق، ص68.
[12]– إيفون دوبليسيس، السِّوريالية، مرجع سابق، ص ص67- 68.
[13]– ديفيد هوبكز، الدَّادئية والسِّريالية، مرجع سابق، ص82.
[14]– المرجع سابق، ص31.
[15]– المرجع سابق، ص82.
[16]– رائد الحواري، “ملحمة جلجامش- الثور السماوي”، شبكة المعلومات (الإنترنت)، موقع الحوار المتمدن. الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=396028
[17]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء السابع: ديوان قصائد هيْرفيلد (2013)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص ص153- 154.
[18]– خيري دومة، أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)، (القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، سلسلة رؤى نقدية، 2016)، ص201.
[19]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الثالث: ديوان محاولات (1990)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص120.
[20]– صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، (الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة كتابات نقدية، العدد54، أغسطس 1996)، ص ص416- 417.
[21]– سعدي يوسف، محاولات في العلاقة، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2016)، ص14.
[22]– محمد القاضى وآخرون، معجم السرديات، (مادة تناص)، (تونس، 2010(، ص115.
[23]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله (1972)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص146.
[24]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (2002)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص411.
[25]– نورمان فِيركِلَف، اللغة والسلطة، ترجمة: محمد عناني، (المركز القومى للترجمة، العدد 2555، الطبعة الأولى 2016)، ص39.
[26]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (2002)، مصدر سابق، ص430.
[27]– فاطمة المحسن، سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث، (دار المدى، سوريا: دمشق- لبنان: بيروت، الطبعة الأولى، 2000)، ص85.
[28]– عبد الهادي زاهر، صلة الموشحات والأزجال بشعر التروبادور، (القاهرة، مكتبة الآداب، 2000)، ص49، نقلاً عن: .Princeton encyclopedia. P. 686.
[29]– سعدي يوسف، ديوان الأنهار الثلاثة، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2015)، ص63.
[30]– جابر عصفور، تحولات شعرية، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016)، ص ص192- 193.
[31]– علياء الداية، الرموز الأسطوية في مسرح وليد إخلاصي، (سوريا، دار الحوار، الطبعة الأولى، 2010)، ص89.
[32]– علياء الداية، الرموز الأسطوية في مسرح وليد إخلاصي، مرجع سابق، ص21.
[33]– ألكزندرز هجرتي كراب، علم الفولكلور، ترجمة: رشدي صالح، (القاهرة، دار الكاتب العربي، 1967)، ص396.
[34]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (2002)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص ص423- 424.
[35]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان أغنية صياد السمك، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص249.
[36]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان أغنية صياد السمك، مصدر سابق، ص ص249- 250.
[37]– خيري دومة، تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة: (1960- 1990)، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، 1997)، ص190.
[38]– صلاح فضل، أساليب السرد في الرواية العربية، (دار المدى للثقافة والنشر، سورية، دمشق- لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، 2003)، ص107.
[39]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الثالث: ديوان محاولات (1990)، مصدر سابق، ص121.
[40]– القرآن الكريم، سورة “الحاقة”، آية 7.
[41]– محمد عجور، الأسلوب السينمائي في البناء الشعري المعاصر، سلسلة كتابات نقدية، (الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، 2011)، ص 127.
[42]– ديفيد هوبكز، الدَّادئية والسِّريالية، مرجع سابق، ص ص121- 122.
[43]– المرجع السابق، ص12.
[44]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الثالث: ديوان محاولات (1990)، مصدر سابق، ص122.
[45]– جابر عصفور، تحولات شعرية، مرجع سابق، ص ص193- 194.
[46]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص343.
[47]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان صلاة الوثني، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص57.
[48]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة، مصدر سابق، ص ص207- 208.
[49]– ثناء أنس الوجود، رمز الماء في الأدب الجاهلي، (القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة 2000)، ص25.
[50]– أسامة عدنان يحيى، الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم: دراسة في الأساطير، (العراق، بغداد، دار آشور بانيبال للكتاب، الطبعة الأولى 2015)، ص23.
[51]– ثناء أنس الوجود، رمزية الماء في الأدب الجاهلي، مرجع سابق، ص29.
[52]– أسامة عدنان يحيى، الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم: دراسة في الأساطير، مرجع سابق، ص24. نقلاً عن: سيد القمني، قصة الخلق أو منابع سفر التكوين، (القاهرة، المركز المصري لبحوث الحضارة، 1999)، ص42.
[53]– صلاح فضل، شعر هذه الأيام، (القاهرة، دار غراب لللنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016)، ص33.
[54]– خيري دومة، أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)، مرجع سابق، ص188.
[55]– جوناثان كَلَر، “الالتفات”، ترجمة: خيري دومة، مجلة فصول، العدد 85/86، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، ربيع/ صيف2013)، ص496. وما بين التنصيص الداخلي نقلاً عن:
Northrop Fryee, Anatomy of Criticism, Princeton University Press, 1957, pp. 249- 250.
[56]– جوناثان كَلَر، “الالتفات”، ترجمة: خيري دومة، مجلة فصول، العدد 85/86، مرجع سابق، ص497.
[57]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة، مصدر سابق، ص 208.
[58]– صلاح فضل، شعر هذه الأيام، مرجع سابق، ص35.
[59]– جوناثان كَلَر، “الالتفات”، ترجمة: خيري دومة، مجلة فصول، العدد 85/86، مرجع سابق، ، ص500.
[60]– جوناثان كَلَر، “الالتفات”، ترجمة: خيري دومة، مجلة فصول، العدد 85/86، مرجع سابق، ، ص501.
[61]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء السادس: ديوان غرفة شيراز، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص238.
[62]– دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، ترجمة طلال وهبه، (المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008)، ص346.
[63]– Literary Devices, Definition and Examples of Literary Terms, Parody, the internet, https://literarydevices.net/parody/.
[64]– سعدي يوسف، محاولات في العلاقة، مصدر سابق، ص ص58- 59.
[65]– روبين ر. وورهول، “السرد الجديد: أو أسلوب التعبير عما لا يُمكن سرده في القصص الواقعية والأفلام المعاصرة”، مقال بكتاب: الرفيق إلى النظرية السردية (الجزء الأول)، تحرير: جيمز فيلان/ بيتر رابينوفيتز، ترجمة: محمد عناني، (المركز القومى للترجمة، العدد 2723، الطبعة الأولى 2016)، ص370.
[66]– سعدي يوسف، محاولات في العلاقة، مصدر سابق، ص60.
[67]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيس، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص104.
[68]– غدير أبو سنينة، “الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة”، جريدة “العرب“، (لندن، العدد 9506، 23/3/2014)، ص16.
[69]– غدير أبو سنينة، “الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة”، مرجع سابق، ص16.
[70]– غدير أبو سنينة، “الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة”، مرجع سابق، ص16.
[71]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (2002)، مصدر سابق، ص478.
[72]– خيري دومة، أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)، مرجع سابق، ص ص197- 198.
[73]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان قصائد الحديقة العامة، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص435- 436.
[74]– سعدي يوسف، “سركون بولص الشاعر العراقي الوحيد”، جريدة “السفير“، (لبنان، 23/10/2007)، ص1.
[75]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير فقط، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، 2014)، ص189.
[76]– سعيد المولودي، “رماد الحلم: قراءة في ديوان «الشيوعي الأخير يدخل الجنة» لسعدي يوسف”، مدونة “سعدي يوسف“، الإنترنت. الرابط:
[77]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان صلاة الوثني، مصدر سابق، ص7.
[78]– سلام عبّود، المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)، (منشورات الجمل، بغداد- بيروت، الطبعة الأولى 2014)، ص85.
[79]– سلام عبّود، المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)، مرجع سابق، ص93.
[80]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الخامس: ديوان صلاة الوثني، مصدر سابق، ص ص40- 41.
[81]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة (2001)، مصدر سابق، ص 313.
[82]– سلام عبّود، المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)، مرجع سابق، ص144.
[83]– سلام عبّود، المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)، مرجع سابق، ص141.
[84]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء الثالث: ديوان محاولات (1990)، مصدر سابق، ص78.
[85]– سلام عبّود، المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)، مرجع سابق، ص88.
[86]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء السابع: ديوان قصائد هيْرفيلد (2013)، مصدر سابق، ص149.
[87]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء السابع: ديوان قصائد هيْرفيلد (2013)، مصدر سابق، ص205.
[88]– سعدي يوسف، الأعمال الشعرية، الجزء السابع: ديوان قصائد هيْرفيلد (2013)، مصدر سابق، ص ص205-206.
[89]– سعدي يوسف، ديوان الأنهار الثلاثة، مصدر سابق، ص17.
[90]– سعدي يوسف، ديوان الأنهار الثلاثة، مصدر سابق، ص ص14- 15 .
[91]– سافرة ناجي، الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجًا، (سورية، دمشق، دار الينابيع، الطبعة الأولى 2011)، ص ص28- 29. والتنصيص الداخلي نقلاً عن: المسدي، عبد السلام، النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1983.
[92]– تيري إيجلتون، النقد والأيديولوجية، ترجمة: فخري صالح، (مصر، القاهرة، دار رؤية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2016)، ص ص178- 179.
[93]– تيري إيجلتون، النقد والأيديولوجية، مرجع سابق، ص179.
[94]– سافرة ناجي، الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجًا، مرجع سابق، ص36. والتنصيص الداخلي الأول نقلاً عن: المسدي، عبد السلام، النقد والحداثة، دار الطليعة، بيروت، ط1، ،1983، ص ص7- 8. والتنصيص الداخلي الثاني نقلاً عن: الكيلاني، مصطفى، الميتا- لغوي- النص والقراءة، منشورات دار مية، تونس، 1994، ص7.
[95]– سافرة ناجي، الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجًا، مرجع سابق، ص ص49- 50. والتنصيص الداخلي الأول نقلاً عن: كورك، جاكوب، اللغة في الأدب الحديث: الحداثة والتجريب، ترجمة: ليون يوسف عزيز عمانوئيل، دار المأمون، بغداد، 1989، ص155.